الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
موارد العنف -8-
جميل حسين عبدالله
2017 / 5 / 7دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
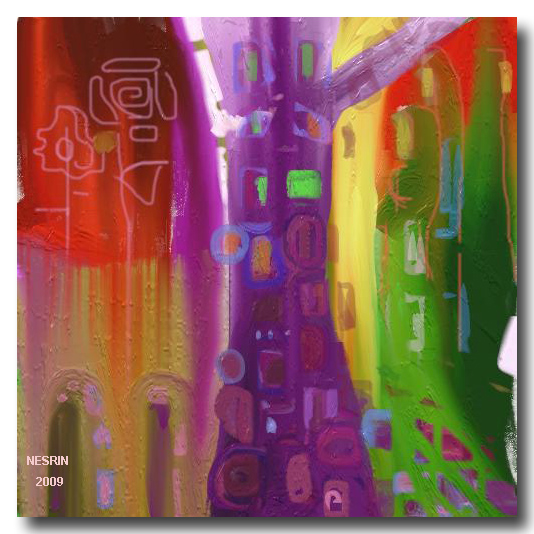
موارد العنف
قراءة في عقلية الكراهية
-8-
النهاية
ولذا يكون العنف مرضا عضالا عند بعض المدارس النفسية، والاجتماعية، لأنه يعبر عن حالة عدم التوازن بين القوى المشكلة للذات الفردية، وبين البنى المعرفية التي تحرك الجماعة، لكن ما يمكن استظهاره من ذلك؛ أن العنف الذي نعنيه، هو ذلك العرضي الذي ينشأ فعله من ارتباك الشعور بالانتماء إلى هوية معينة، يحكمها نظام ديني، وأخلاقي، وينظمها عقد يحدد إطارها النظري في كل القضايا الكونية، والإنسانية، لأن نهاية ما نقصده بالعنف، هو تلك الأفعال التي تنزل على الآخر بعدوانيتها المفرطة، إذ هو في صوغ القضية من جزئيات، يبتدئ من الغلو في تقديس الذات، ثم يتطور إلى التوسط بكل فعل إجرامي ينزف بسوداوية خانقة، لأن تسويغ هذا الأثر الذي يلحقه العنف بالآخر، وقبوله في حركية المجتمع، وسيطرته على موارد الاكتساب، والامتلاك، لن يكون مستحسن الصورة، إلا إذا كان منطلقه في الصيرورة، هو الرضى عن الذات، ومنتهى سيره، هو ما يظفر به الإنسان من مكاسب، ومجالب، إذ العنف هو في الحد الأدنى حماية للذات المغترة بغرور نظرها الشخصي، وفي الحد الأعلى تدمير لحقيقتها الجماعية. وسواء كانت ذات المتعنف الذي يتحقق تميزه بعدوانيته، أو ذات المتضرر الذي تأذى بأفعال غيره المشينة، لأنهما لا ينفعلان في واقع حقيقتهما، إلا إذا كان كل واحد متأثرا بما يفعله الآخر في سياق ما هو مشترك بينهما، إذ عملية الامتزاج بين النيات، والغايات، هو الذي يشخصن عملية الالتفاف حول السياق العام، ويشيء حقائق كليته، ويصبغها بطابع الأنانيات الفردية المستعلية، والمتجبرة.
ومن هنا، يكون العنف تعبيرا عن ألم مكنون الذات، وخوفِ نزاعاتها الداخلية، وجشعِ نزوعها نحو تحقق عالمها الخارجي بما يكسبها صورة قوة كينونتها، وتفاعل صيرورتها، لأن أقسى ما في العنف من شقاء، هو ما يكظمه من كمد، وغيظ، إذ هو الشرارة التي تتقد بها جمرة الصراع في الذات العليلة، لأن إيثار رغباتها الذاتية على مسمى الاتحاد في القصد، والاشتراك في النتيجة، هو الذي يحدد نوع وسائلها التي تعرب عنها في حماية حوزتها، والذود عن بقعتها، إذ تصلب هذا المبتغى في شرايين العقل المستوفز إلى كسب قضاياه الوجودية، وتوقد حرارته في الحرص على صيانة هويته الشخصية، هو الذي يخلق ثراء المورد في مصادر التخويف، والترهيب، لأنه يحرك الأفعال في دائرة التنافس على كسب الحظ من بهجة الكون، والسيادة على جمال الطبيعة، إذ هي المبتغى في الصراع الذي تدبره أيد آثمة باسم المحافظة على الإنسان، ولو فقد خطابها كل خصوصياته العقلية، والقيمية، لأن واقع العالم المرتبك، يبدي عكس ما يظهره الشعار، إذ هي لا تريد إلا السيطرة على خيرات هذا الكوكب الأرضي، ووأد كل معنى يجمع المجتمعات على فضيلة الحب، والإخاء، ويبني مهاد السلام بين بقاعة المتحاربة، والمتقاتلة. وذلك ما يبعدنا عن قيم الإنسانية المشتركة، ويفقدنا مسمى الحقيقة التي نبحث عنها بين الحياة، والموت.
ومن ثم، فإن العنف، ولو كمنت بوادره في الباطن المستعر الشهوات، والمختلط الأهواء، يصدق ظاهريا على ألوان تحرفه عن مقتضى الأخلاق في المسؤولية الفردية، والجماعية، لأن إدراك مناط الفرق بين صنوف العنف، وضروبه، هو الذي يجعلنا نحس بوظيفتنا في الكون، ودورنا في الطبيعة، لأن التمييز بين مداراتها، والفصل بين متعلقاتها، هو الذي يصبغها بحكم عقلي، يمكن له أن يبين لنا معالم الذات في بناء مركب حقيقتها، أو هدم ما فيها من معاني السمو الروحي، والنفسي، والاجتماعي، إذ واجبه الذي يقوم به في صيرورة الأشياء المتعارضة، والمتعاقبة، هو ما يفرق به بين قيمتي القبح، والجمال، وحكمي الخبيث، والطيب، لأن وضع كل شيء في حد معين، وحصره عن التداخل مع غيره، هو الذي يمنحنا القدرة على ترتيب المعاني في سياق متكامل، ومتناسق. وهكذا، فإن محدودية تطبيقات المسؤولية في آحاد الأفراد، هي التي تسبل علينا صفاتنا في الوظيفة الوجودية، والكونية، لأنها توضح كامن القدرة في الذوات الواعية بالحياة على الطبيعة، إذ لا يكلف ضعيف بما يثقله، ولا يمنع قوي مما يطيقه، لأن استثقال العاجز لما ينوء به من عبء ثقيل الكد، والسعي، ولا ينال إلا بصفاء المورد، ونقاء المحتد، لن يجعل للفعل غير المكسوب له طبيعةً أيُّ روح عليا، ومثلى، لكي يكون أثره فاعلا في لغة الأزل، إذ لا يطالب إلا بما في حوزته من حدود الإرادة، وقدرة العزيمة، لأنه إن اتصف بوصفه الذي إذا لبسه، كان حلية له، وزينة، وصار ذلك أكمل في إقامة واجب الأدب مع نظام الأشياء القائم سببها على مقتضى الكفاءة، والأهلية، إذ لا تقوم الأشياء بحقيقتها التي تكوِّن ماهيتها، ثم تكون واقعا يصدق عليها في الحياة البشرية، إلا إذا تضمنت كمال عقيدة فاعلها، وسَكَنَها جمال خُلق صانعها، لأنه لا فعل يستوجب حظ البقاء، إلا إذا صار أثره نفسا رحموتيا في الكيان، والآخر.
ولذا يتولد العنف من عقدة النقص الخفية بين كنه الذات، لأنها تنطوي على حقيقة ما تركب فيها من تصورات، وخيالات، وتحتوي على كل الرسوم الضابطة للنظر، والسير، إذ لا يجوز لها أن تسم الأفعال بوسمها، وتشي الأشياء بوشيها، إلا إذا نفخت فيها ما استعر بين مراماتها من أسباب خوفها، وألمها، وحزنها، لأنها لا تنطبع بمعنى الفعل، وتنفعل بلازم الأثر، إلا إذا كان الإدراك قوي التحديد، والتعريف، والرغبة متوهجة في صناعة عالم مطبوع بالرحمة، والمودة، إذ شعور مجتمع العقلاء بترتيب هذه الأدوار بين الطاقات، والمهارات، وتنظيمها بما تقتضيه وظيفتها في سلم الوجود، والاستفادة من حقيقتها بين مكامن الطبيعة، والاشتراك في غايتها الممتنعة عن الظلم، والاستبداد، هو الذي يجعل الأحكام سارية على مواقعها، ونازلة في منازلها، لأن معرفة حدود هذه المنطلقات بمنطق الانفعال في القصود، والتفاعل في المرامات، ودرك ما فيها من روابط متشابكة، وعلاقات متداخلة، هو الذي يعبد الطريق إلى قبول التنوع بين الألوان التي تشكل وحدة المجتمع النفسية، والاجتماعية، ويرشد إلى النتائج التي تقيم موازين العدالة في الحريات الشخصية، والجماعية، إذ وعي هذه الصورة المنطبعة بالكثرة، ولو تمثلت لنا في سياق الوحدة، هو الذي يظهر ملامح الحقيقة بجلاء، ووضوح، ويبرز ما في السياقات من أنماط التفكير، والتقدير، وهو الذي يصنف عضويتنا في النسق العام القائم بفلسفته الأخلاقية، والقيمية، ويرتب واقعنا بما تستلزمه عهودها من سعادة، ورخاء.
وهكذا، فإن القول بتضمن كل عنف لخلل ذاتي، أو زلل عرضي، واحتوائه على أنانية الفرد في سياق الجماعة، سيربك قرارنا في قراءة الأبجديات المعرفية التي يجب أن يقوم عليها التنظيم الفردي، والاجتماعي، والأولويات الأخلاقية التي نجهد جميعا من أجل الوصول إليها في عالم متنوع، ومتنازع، لا يزفر فيه إلا صوت الحروب، والخراب، لأننا إذا اعتبرنا العنف قصدا بالعدوان، والإضرار، فإننا سننفي عنه كثيرا من الموارد التي يكون فيها نوعه خفي الدلالة، لا يدركه إلا الملاحظ الدقيقُ النظر في ماهيته، إذ هو كما يكون عنوانا على الفرد، فإنه يغدو مطلوبا لحماية الناموس في سياق الجماعة، ولو لم يكن موصوفا بوصفه، ومنعوتا بنعته، لأنه يدل على معنى الحماية التي تسوغ السبل المتناقضة. وذلك ما يضفي عليه اسما آخر، ولونا خاصا، ولو اتحدا في القصدية، واختلفا في النتيجة. وعلى هذا يكون العنف نوعا من أنواع المقاومة الذاتية، والجماعية، يبديه الفرد أو الجماعة لحراسة السياق الذي يضمن الحياة، والبقاء، لكنه يلبس في صيغة الجمع لون النظام المؤسس للكيان المحصور بقيود أذواقه، وأنظاره، فيكون سالبا لحرية الفرد، ونازعا لإرادته، وزاريا بقدرته على حدس الحكم اللازم في القضايا التي يتألف منها مصيره بين المسارب البشرية.
ولذا، فإن العنف الخفي الذي تنتجه الإيديولوجية المتحكمة في الكينونة، هو الذي يدبر كثيرا من مسارات الصراع حول الحدود المشتركة النتيجة في الصيرورة، لأنه لا يُدرك بما يبديه من حدث في الآخر، إذ يلتبس مع ضده في الأثر، فيصيران متشابهين، أو متقابلين، بل فيما يضمره من نيات تخفي غايته بين الجوانح، والسوانح، وسواء ما كان ناتجا عن الفرد العاقل، أو ما كان واقعا في ظاهرة الجماعة، إذ معناه لا يدل على عينه، ومبناه لا يتضمن ما نتج عنه، لأن حيازته للأشياء بغير موجب حق مقبول، أو باستحقاق الملكية للعين المجردة، دون الالتفاف حول مطلق الروح، ولو لم يظهره شبحا عنيفا بين الموارد، لن يخلق في مقابله إلا عنفا مضادا، يصير هو المدان، لا ما كان سببا في إنتاجه، وإبرازه. ومن هنا، فإن العنف الخفي، هو ذلك الفعل الذي يضطر إليه الإنسان، ولم يكن مقصودا له إلا بالتبعية للازمه، إذ ما تقوم به حقيقته في واقعه، لا ينظر فيها إلى سببه غير المنجلي، وإنما إلى ما أفرزه في تداوله من صراع، ونزاع.
ومن هنا، فإن العنف يتولد بعضه من بعض، وسواء ما كان سمة نفسية للمتعنف، ولو أخفاها بسبب من الأسباب، أو ما أبرزه من ردود أفعال، تحولت مع حدة الخلاف إلى تخويف، وترهيب، لأنها تتضمن حماية الذات من الزوال، ووقايتها من الابتذال، إذ ما يؤدي إليه الظلم، والاستعباد، لن يكون إلا عنفا بين موارد المفسدين، وصونا للدائرة في سبيل المصلحين، لأنها لا ترى لها قيامة شأنها إلا في سيادتها على حظها من الوجود، والطبيعة. ولذا، يكون كثير من الصراع في الكون متسما بالعنف، ولو لبس جبة الطهر، والنقاء، لأنه تعبير حقيقي عن الذات المستعرة باللذات المرغوبة، والممنوعة، وهي فيما تقي به حصونها، وثغورها، لا تحس بعنفها، ولا تقبل أن تدان به، لكونه ينطق برغبتها في الخلد، والبقاء، إذ لا يحق لها أن تستهين بما يهدد استقرارها، ويبدد استمرارها، لأنها تعادل بين وجودها، والتضحية ببعضها في صيانة كلها، إذ لا يجوز في منطق القضايا، أن تسمى الذات كيانا، إلا إذا كانت متميزة بسماتها، وشياتها، لأنها هي التي تمنحها ماهية في الطبيعة، وهوية في الحياة، وبها تطيق أن تشارك بنصيب في عالم الإرادات، والأفكار، والقيم. ومن ثم، فإن القيود التي صاغتها العقود الدينية، والعهود الاجتماعية، لن تكون قابلة للتنفيذ بالإلزام، أو الالتزام، ما لم تكن اختيارا جماعيا، وعنوانا كليا، يقبل ما في مجالها من حقول إنسانية، وكونية، ويرفض ما في مدارها من رغبة الاستفراد بالملكية، والسلطة. ولهذا، يكون العنف مربكا، ومحبطا، لأنه في ضرورته القائمة بألوانه، وأشكاله، يتجسد في صور تدل على فقدان الذات لقوتها على نيل رغباتها بطرقها المحدودة الطاقة، والإرادة، وضياعها بين السبل المترعة بصراع المتناقضات، والمتشابهات.
فلا غرابة إذا تقوت الذات بوسيلة العنف لكسب لغة القوة، والمناعة، لكي تعبر بعنفوان عن صدامها مع ألم ذاتها المكتنزة لصورة حقيقة مطلقاتها في الفكر، والرأي، والموقف، لأن دلالة العنف على الحرمان المصحوب بإحباط، وملل، وضجر، هو الذي يجعل العنف مسوغا بصورة قصدية، وبمعنى ائتلافي بين الذات، ومطلوبها في مجالها المادي، إذ كونه يرغب فيما يحمله من عداوة، وإذاية، هو الذي يجعله محلا للمساءلة، والمجازاة، لأن ما يتلقاه الإنسان من ضغوطات حياتية، تصير محلا لتوارد الخواطر التي تدفعه إلى تحصيل الغاية بكل الوسائل الضامنة لها في حقيقة الامتلاك، ولو خرجت عن سياق العقود السائدة، وانحرفت عن الضرورة التي تنظم سير العلاقات الاجتماعية، لأن أساسها التي تربي عليها أجيالها، هو ما وضعته من أسس لحماية الأمن، ورعاية الأمان. وإلا، فإن تسميتها بالمواضعات الاجتماعية، لا قيمة لها في المعنى، ما لم تكن محل الحكم عليها بالرفض، أو القبول، إذ لا دليل عليها في الممارسات الجماعية، إلا فيما تبنيه من سيادة الحق، والنظام. ومن هنا يكون للتربية على خلق اللطف، واللين، دور أساس في تقوية هذه الروابط التي تعوق الأنانيات الفردية، وتكبح جماع الرغبات الشخصية، لئلا تؤدي إلى فعل الإضرار بالآخر، ومهما كان الاختلاف حاصلا معه في العرق، واللغة، والدين، لأنها تمثل قواعد السلوك التي يجب أن يتحلى بها الأفراد، والجماعات، ويتزيى بها الواقع الذي ننشد عذوبة أذواقه، وليونة أخلاقه، إذ هي التي تزيل كل المعيقات التي تحد من فاعلية الأخلاق الإنسانية على هذا الكوكب الأرضي. ولذا، تكون هذه التربية علاجا، ووقاء، لأنها تدبر أمر الممنوع والمحروم بطرق متبصرة، ومتعقلة، وتحمي الدائرة من كل ما يجوز له أن يصير حرمانا في الطبيعة البشرية، يؤدي إلى تطلاب حقيقة العنف، والإرهاب.
وإذا كان العنف يضمر كثيرا من الأوجاع الذاتية، فإن منتهى ذلك في عمق المتعنف، هو ما يشعر به من خوف يذود ذاته عنه، لأن فقدان الأمان في الحوزة، هو الذي يدفع بها إلى أن تخشى ما هو مضمر من مجاهل بين الموارد، إذ لا تفصح عن سلاسة قوتها إلا بصلابة في الكسب، وصلادة في القصد. وذلك ما يصير سبلها عسرة في الوصل، والاتصال، لأنها تتفاوت فيها الإرادات الضعيفة، والقدرات القوية، لكونها تتضمن كل السلوك البشري الذي يرغب في حبكه حين يقاوم حرمانه، ونسيانه، ويواجه كل الظروف التي تحدق به في محيطه، وواقعه، لأن وجود روافد العنف في المحيط النفسي، والاجتماعي، لا يؤدي إلا إلى الاقتتال حول حدود المصالح المشتركة، والاحتراب حول مجالب العيش الحر الكريم. ومن هنا، يكون الخوف من حدوث الشيء غير المتوقع سببا رئيسا في وجود نوازع العنف في الذات، لأنها تحتمي به من مجهول حرصها على رفض كل المعيقات الذهنية، والمثبطات الفكرية، لأن الخوف لا يكون فعلا ضروريا من الخائف فحسب، بل يصير حاجة في المخوف منه، إذ كلاهما لم يكن عذرا له، ولا قابلا للتحصن به، والاستتار بخفائه، إلا حين أحس كل واحد منهما بأن الآخر سبب في زوال عينه، وإنهاء أمنه، لأنهما معا ينابذان ما يخشيان ظهوره في العلاقات المشتركة بالحتمية الجماعية، إلا أن ذا يستعمل عنفه في إثبات حقيقته، وذاك يتوسل بوسيلته إلى إرغام عدوه المنتظر لنهاية طبيعته.
وسواء كان ذلك العنف واقعا بأسباب مباشرة؛ كأن يضربه، أو أن يجرحه، أو أن يختطفه، أو أن يعذبه، أو أن يقتله، أو كان نازلا بوسائل غير مباشرة؛ وهو أن يفرض معانيه الذاتية في محيط الآخر، على اعتبارها كمالات واجبة في بقاء السياق، أو صيانة الأيديولوجية. وذلك ما نعنيه بالعنف الرمزي، إذ ما فيه من مقتضى الإرغام، والإجبار، هو الذي يستكنه مسمى القهر الذي يمهد سبل التضييق لمجالات الحرية، والاستقلال. وهكذا، فإن عامل الخوف علة كامنة في العنف، ولو برزا في واقعيهما بمظهر القوة، والاستحواذ، لأنه إذا كان يختفي من ورائه شخص غير متزن البنيات، ومستوي الآليات، فإن استدعاء القوة بتلك الوسيلة المتعسفة، هو غرة في المتعنف المغتر بجوهر عينه، لأن الاعتداد بخصائص الذات، والاعتزاز بشرعية مرجعيتها في الاستعلاء، هو الفعل الذي يفضي بعنفه إلى إكراه الآخر، وجبره على داعي الرضوخ، والخنوع، إذ هو نوع من أنواع مركب السادية التي تُخضع الغير لآلام أمراضها الحسية، والباطنية، لأنها فرض لرأي واحد، وقرار محدد، يحمل سمات المريض بعقد ذاته، وخصوصياته النفسية، وميولاته الاجتماعية.
وإذا كان الاغترار بالذات محلا لولادة نشوز العلاقات الاجتماعية في تركيبة المجتمع البشري، فإن أجلى مظهر فيها، وأظهر معلم منها، هو ما يعيشه الفرد بين محاضنها من مثبطات تعطل السير نحو الأمل المنشود في الحياة المطلوبة، إذ يخضع لمقتضيات الذات التي تتضمن مزاعم منتفشة في عمقها، ومنتشرة في محيطها، وهي التي يندفع إليها الظاهر في صورته المثلى، ويدافع عنها بغيرته المتمثلة في الترهيب، والتخويف، لأنها ومهما ظهرت بزي الصلاح المزيف، أو تجسدت في بريق لونها المفتن، فإن ما يختبئ فيها من أنانية مفرطة، وذاتية مغالية، هو الذي يفسر مضمون حركيتها القائمة على تلبية ما فيها من حاجات، وضرورات، إذ صيرورتها التي تكتمل بها أدوار حركتها في مجالها الطبعي، والكوني، لا يمكن لها أن تتجاوز ما هو محدود في قعرها من رغبات مكبوتة، وشهوات مكتومة، لأنها في ردود أفعالها تجاه ما هو متعسر ومتمنع عنها، لا تتوسط إلا بهذه الوسيلة المحتضنة لأسباب الحقد، وروافد الضغينة، لأن منطق الكراهية كمظهر متجسد في مجموعة من القيم المشكلة لماهية العنف، وألوانه، لا ينشأ عن المظلوم فقط، بل مورده الأول، هو الظالم الذي أطال ذيله في حقوق غيره، إذ هو الذي أظهر في لحن السلوك العام نشازا، ونفورا، وأبرز حذر الخوف بين الديار، والأدوار. ولولا ما ينبثق عن واقعه من جراح في الذات، وأوجاع في الحياة، لانتكست كثير من الأفكار التي تثير الرعب، والهلع، لأن غالب أحوال المتعنف؛ وهو الذي يحتد صراعه مع خارجه حين تغيب عنه شمس الأخلاق، وتصير الروابط هزيلة الاتصال في عمقه الممتحن، لا تميل إلى فضاء العدوان، إلا إذا كان العنف سمة قائمة في تفاعل وظيفتها مع باطنها، وظاهرها.
ومن هنا، يكون الحقد دليلا على العنف، وقائدا إليه، لأنه تعلقٌ بشيء غير مكسوب للذات المتعنة، والمتحرجة، ولا مقدور لطاقتها الفاعلة، والمنفعلة. وهو ذلك المعنى الذي يحس المتعنف في فقده بخيبات أمله، وانكسار حظه، لأنه في استحالة وجود علة ضرورته في كبده الفردي ضمن بؤرة سياقه الجماعي، يكون مطلق العدوان مصدرا لبلوغ المنى في كسبه، والوصول إلى ما يَطمئن إليه في حرزه، إذ حزونة التكيف مع مقتضى طاقة الكيان في خاصيته الفردية، وحدودها النسبية في وظائف الذات الجماعية، ومدارات حركتها في سبيل بقاء مبادئها الجامعة لكلية أنواعها المتعارضة، وألوانها المتقابلة، لا يفضي إلا إلى إبراز ما هو كامن فيها من عقد مغروسة في أحشائها، ومزروعة في أنحائها، وأعراض مرضية تكونت معها في مهد التربية، ثم تطورت عللها مع نشوء القصد بين محاضن الحرمان، والفقر، والجهل، والمرض، لأن لهذا الأثر المستتر في العمق مكونات عميقة الدلالة، لا يرى نتاجها إلا في الأفعال الفاقدة لحاسة ذوقها الروحي، والأخلاقي، إذ فيها تظهر قيمة المعنى المستتر بين طيات الباطن، ومدى تعلقه بما يحكم الفرد من غرائز، ورغبات، وينظم علاقاته مع أعراضه الخارجية، والظاهرية، لأنه هو الذي يضفي عليها طاقة الحياة الفاعلة، ويجعلها أثرا بالغا إلى الغير، وقصدا واصلا إلى الغاية، إذ فيها يظهر حرص الذات على الولاء لمقتضيات أنظمة الجماعة، وسلوكها بين الموارد المتشعبة البدايات، والنهايات.
ولذا، فإن مطلق الإحساس بالحاجة، ليس فيما يمكن التجاوب معه نفيا، أو إثباتا، بل فيما يفرض على الذات من كيفيات، ووضعيات، لم تحدث فيها تواصلا، وتفاعلا، ولم تفرز فيها شبعا، ولا ريا، لأنها هي التي تجعل معنى الاحتياج شقاء، وعناء، وتصيِّر رغبة الافتقار إلى استدراك ما ضاع من روحها بالعجز والقصور مستعرة بالعدوان، والإذاية، إذ الغاية في تحصيل الأشياء المغرية بالجبلة، والطبيعة، هو ما تضيفه من حياة وديعة إلى الفرد، والجماعة. وذلك ما يبعد النجعة، ويصير الفرصة مستحيلة، ويعلِّم الذات كيف تكون عنيفة في مواردها التي تغشاها بهمومها، وكروبها، لأن الخوف على انفلات اللحظة من حرص الإنسان الباحث عن متع الحياة الطرية، والناعمة، والطالب لما يريح الذات من لذة بدنية، وسعادة عقلية، هو عنوان الحاجة في الرغبات التي تسجن كثيرا من الإرادات المتنوعة بين قفص كبدها، وجهدها، إذ توجيه الفعل إلى استكشاف تلك الغاية التي تحدد الهوية الشخصية، وترسم معالم الذات الجماعية، هو الذي يخضع الكيان لقوة الخوف المتجذر بين الموارد بأساليبه المختلفة، لأن تمام ضغطه على حصر صوره المتجسدة في الواقع، وقصرها على ما خفيت فيه اللذة، والسعادة، لا يُدبر وضع سلوكه، وبلوغه، إلا بما يثيره الحاقد من عنف في طريق كل صراع يتوخى به نيل مزاعمه الكامنة في بعده النفسي، والاجتماعي.
ومن المؤكد أن الحقد دليل على وجود العنف ضد شيء مرتقب الظهور، إذ هو الذي يعبر عن علاقة الذات بمجموعة من الخصائص التي تتمايز بها بين الكيانات البشرية، وإن لم تحصل لها بالحظ الأوفر، ولا بالاستقلال الممرع بالحرية، والكرامة، لأن الحاقد شأنه شأن الحاسد، ومرده معادٌ للجاهل، إذ تنطلي عليه صورة الخدعة التي افتتن بانتقاء منظرها، أو الرضى عن خبيئة مظهرها، فيرى صلاح سربه فيما يسبله عليه يقينه بفساد الموارد من إزار الطهارة، والعفة، ويشهد جمال ظاهره فيما يبرز من رياش عليه، ولو اقتضى تسويغ تسلطه عليه بوساطة حيله، وخدعه، وإن طعَّمها بمقتضى العقيدة، والديانة، إذ ما يحدث من خلل في البنية الوظيفية للعقل الفاعل، هو الذي يقتضب المعاني الذاتية المتسامية في مسمى الأنانية، لكي يستولي بها على الممنوع عنه، وهو مغر بطبيعته، ومفيد ظهوره على الخارج البارز بفتنته، وإغرائه، لما فيه من قوة تخلب البصر، وتسلب العقول العليلة، لأنها لا تدل في كدحها على قبول التنوع في المظاهر العامة، بل ترشد إلى ثراء المعجم الباطني بتناقضات تشوه وجه المعنى، وتبدد كل صلة تربطها بعالم الحقيقة، إذ الجهل بمقادير الأشياء في نسبة انتسابها إلى سياق منتظم بناموس يتوخى سيادة الأخلاق، هو الذي يبعد المسافات بين الذات المتألمة بأعراضها الخارجية، وبين ما تغرم به من مغريات، ومشتهيات، لأنها في قوة استحواذ الحدود غير الجامعة على لازم الكشف العقلي، تحاول أن تفجر فيما تسعى إليه برغبة مرتبكة قابلية في الذات، واستعدادا في الإرادات، إذ انفصام هذه العلاقة المتشنجة بين الشيء المقرور في العمق الباطني، وعنوانه في العرض الظاهري، هو الذي يصير البحث عن تسويغها دنيئا، وحقيرا، لأنه ومهما بدا لنا دالا على شدة الدهاء في نفخ نفَس الأنانية المختنق بين رسوم المعاني، فإنه يتعرض آليا لتحريف يؤدي إليه تجويز الاستكبار، والاستعباد. وإذ ذاك يكون العنف بكل أنواعه مسوغا عند الحاسد، والحاقد، والجاهل، لأن نسبة الجهل في كل عنف كثيرة، وعنيدة، إذ لا يتأتى إلا بعد ضياع المعتنف بين مهامه العمه، والعماية، لأنه يتحول إلى قوة في ذات المغامر الذي أرسى سفنه على الرغبة الحارقة، ولو لم يدرك ما فيها من معرات أثيمة، وعواقب وخيمة، إذ هي عدم المعرفة بأقدار الأشياء في نظام جواهرها، والجهل بما تشابك فيها من علاقات، وآليات، لأن وعينا بذلك، وفهمنا له، هو الذي يبعدنا عن سبة الجهل الذي يزكي ببلادته كل عوامل العنف، والكراهية.
وإذا كان الخوف والحقد والجهل أسبابا باطنية في فعل العنف، لأنها تتمخض في الذات المستعرة بصراعها، وحربها، فتلد أوضاعا قابلة للعدوان، والطغيان، فإن عدم إدراكنا لقيمة الأشياء في لوحة الأزل، ومعناها في لسان الكون، وحقيقتها في مهد الطبيعة، ودورها في الحياة، وجمالها على الإنسان، قد يسبب عداء بين المنحى الروحي الذي تؤكده كثير من السياقات التي انبت عليها التجربة الدينية في المجتمعات المؤمنة، وبين الاتجاه المادي الذي يعبر عن طاقة الشر، ومخزون الشيطان في النفوس، والعقول، إذ كثير من صراعاتنا في واقعنا المعاصر، هي نتيجة حتمية للنزاع بين المادية، والروحية، لأن الأولى، ترد عليها نوبات الوجع، والفجع، فتخال الثانية سببا رئيسا في فنائها، وزوالها. وهي في الحقيقة التي نوقن بها في حركية الحقائق مع بعضها، وتلازم وظيفتها في مسار الإنسان، لا يمكن القضاء عليها، ولا إنهاء ما فيها من حياة متتالية مع دورات الزمان، والمكان، وإنما تهذب أخلاقها، وتشذب سلوكها، لكي تتضمن معنى الألوهية في مجالها، وحقيقة الربوبية في مسارها، إذ لا يمكن في منطق الأفكار الذي ندافع عنه، ونحن نجزم بقوة تصوره في الأذهان المتسمة بإشراقاتها الروحية، والمعنوية، أن يموت الضد في الصراع، والنزاع، أو أن يفنى النقيض في التجاذب، والتقاطب. وإلا، خرجنا عن الكثرة إلى الوحدة، ونفينا التنوع فيما حقه التعدد، والاختلاف. وفي ذلك خراب للمعنى، والمبنى، لأن إنهاء ما في الحقائق من احتكاك، وانصهار، لن يكون مقبولا في النواميس الكونية، والطبعية، إذ الغاية من قبولها للتنافر، أو التعارف، هو إحداث دينامية بين مفاهيم الخير، والشر، ومعاني القبح، والجمال، لأنهما يحددان نطاق المسؤولية، ومناط الوظيفة التكليفية في الحياة البشرية. ومن هنا، فإن عدم فهم ما في بنى المجتمع من طاقات روحية، وقدرات مادية، وما وجد في مقاماتها من تغييرات على مستوى الممارسة، والسلوك، قد يؤدي إلى العنف، على اعتباره لغة في دعوى الإصلاح الذي يفرض توجها معينا، لا يراعي خصوصية القدر في التكوين، والتشريع، لأنه لسان ينطق باسم حماية المجتمع، ورعاية مكوناته، ولكنه لا ينحو في مجاله التداولي منحى الحوار، والنقاش، وكلاهما في صياغة القضايا بمنطق التدافع، يفضي إلى التسامح، والتراحم.
إن إقامة دعوى الإصلاح بما يعطل سير كل المكتسبات التاريخية، والحضارية، لن ينتج إلا حربا دائمة بين أنصار القديم، والدعاة إلى الجديد، لأنهما لن يستقيما إلا بفهم ما هو ثابت في العلاقات، وما هو متغير فيها من مهاد، ووسائل، وغايات، إذ معرفة الحدود في طي المسافات المتخيلة، أو المساحات المتوهمة، وكبسها بما هو جامع، ومشترك، هو الذي يمتعنا بظلال الوحدة، والائتلاف، لأنهما يتولدان من معين المعرفة الدقيقة بأسرار الإله في الكون، والطبيعة، والحياة، والإنسان. ومن هنا، فإن خطاب الإصلاح الذي تتبناه توجهات معينة، وسواء ما أحدث في مساره الديني، أو السياسي، إن لم يكن واعيا بما يحقق مناط المشترك في المجتمعات البشرية، لن يخلق إلا بؤرا متوترة بالصراع حول الحدود في المعاني، والمفاهيم، لأنه سيكون بما يعتريه من سبة الذاتيات المحكومة لأنانيتها مهدا للطاعة العمياء، وحضنا للخنوع، والإذلال، لأن صناعة المجالات المغلقة بالمطلقات غير القابلة للتجريد، لن يرسم صورة الغد بآمالها الوديعة، وأحلامها اللطيفة، إذ تكبيل حيوية الإنسان، واستغلال خصاصه، واستعباده في حريته، لن يفضي بنا إلى عالم متنوع الإرادات، والقدرات، ومختلف النتائج، والغايات، لأن غاية السلم في الوجود الإنساني، هي التي تجعل العالم فضاء للاختلاف، والتعدد، ومراحا لتحقيق مبتغى الحرية، والعدالة، والمساواة.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. عقوبات أميركية على مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية

.. إسرائيلي يستفز أنصار فلسطين لتسهيل اعتقالهم في أمريكا

.. الشرطة الأمريكية تواصل التحقيق بعد إضرام رجل النار بنفسه أما

.. الرد الإيراني يتصدر اهتمام وسائل الإعلام الإسرائيلية

.. الضربات بين إيران وإسرائيل أعادت الود المفقود بين بايدن ونتن
