الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
التدين...علي الجانب الآخر؛ التدين المسيحي ملامحه وبداياته
ياسمين عزيز عزت
2017 / 5 / 10العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
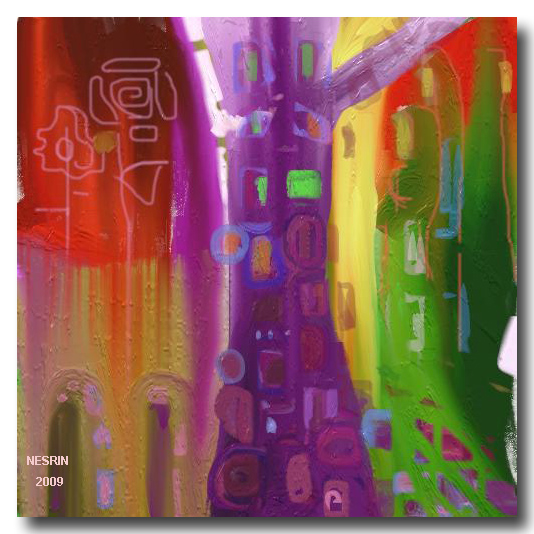
هل كان الانغلاق الذي شهده المجتمع المسيحي وتجلي في الثمانينيات واستمر في التسعينيات وربما حتي الآن لكن بدرجة أقل رد فعل للإتجاه المعادي لمسيحيي مصر الذي تبناه السادات، وأعلنه صراحة في أكثر من موقف، سواء بجعل الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع؛ مما يؤدي لتهميش كل من هو غيرمسلم، من مسيحيين وأقليات أخري لا دينية، وبهائية و غيرها ؟ ثم تحيزه للإسلاميين و تعمده إطلاق يدهم للعبث بأمن وحرية كل من عدهم أعداء له سواء من طوائف اليسار أو من المسيحيين الذين لا أعلم حتي الآن كيف تصور أن يشكلوا خطرا علي نظامه بالرغم من أنهم لم ولا يمثلون قوة سياسية ولم يكن لهم حزب مثلا أو ما شابه في أي يوم، كما لم يلجأوا للعنف الذي يخشي منه علي أمن البلاد، المهم أن ما يجعلني أتصور أن الإتجاه الانغلاقي للكنيسة و لغالبية المسيحيين كان رد فعل لموقف النظام المؤدي لتقليص دور الأقليات وتشجيعه للجماعات الدينية و ما ترتب علي ذلك من تفشي الفكر الأصولي وما صاحب ذلك من تشدد ديني و تعصب لدي بعض المسلمين استمر في التزايد حتي أصبح الوضع كما هو عليه الآن ، أنك تجد كبار السن الذين شبوا قبل تلك الحقبة لم يكونوا بالتدين (الذي يبلغ أحيانا حد الدروشة) الذي تراه في جيل الآباء والأمهات الحاليين الذين عاشوا فترة طفولتهم او مراهقتهم و شبابهم المبكر في السبعينيات. لم تكن صور القديسين و القديسات و كتب السير بهذا الانتشار و لم تكن هناك كل الاجتماعات و الخدمات والرحلات، بالطبع كان للتطور الحضاري أثر في ازدياد عدد و نوعية الأنشطة الكنسية، أقصد بهذا توفر المطبوعات وشرائط الكاسيت وغيرها، لكن هذا الإحتواء الكامل من الكنيسة للمسيحي منذ ولادته وحتي مماته و مصاحبتها له و تعهدها بإرشاده في كافة مناحي الحياة، لم يكن بهذه الصورة أبدا في عهود سابقة، ولا ننسي كذلك تخوف الكنيسة الأرثوذكسية من النشاط التبشيري للكنيسة الأنجيلية الأمريكية في مصر و التي بدأت خدمتها في بلادنا من منتصف القرن التاسع عشر، ولم يكن لهذا سوي أثر سلبي، في رأيي علي الكنيسة الأرثوذكسية التي نشطت في تكثيف جرعة "الأرثوذكسية" من تركيز علي اللغة القبطية (حتي أن المعلمة أخبرتنا مرة في مدارس الأحد أننا سنتحدث بالقبطية في السموات ! )، وكذلك سير القديسين و معجزاتهم والألحان التي يطلق عليها "مدائح" للشهداء المسيحيين من عصور الاضطهاد والمبالغة في التركيز علي تلقين الصغار قصصهم والتي كان أغلبها مأساوي ودموي للغاية حيث اعتدنا سماع كل مراحل التعذيب التي تعرض لها الشهيد أو الشهيدة بسبب إيمانهم، واحتمالهم للألم في سبيل المسيح، وعدم مقابلتهم الشر بالشر وصمودهم أمام الإغراءات ، و كذلك تحفيظ النشء الألحان القبطية الصعبة ، ثم تدريس عقائد الكنيسة الأرثوذكسية بشكل يغلب فيه الإهتمام بإيصال هذه العقائد للنشء و غرسهم فيها أكثر من الاهتمام بتدريس العقيدة المسيحية نفسها والرسالة المحورية للمسيحية وهي الفداء والنعمة وسيرة المسيح و تعاليمه و التي لم يتح لي شخصيا التعمق في دراستها و دراسة الكتاب المقدس إلا عندما انضممت للكنيسة الأنجيلية عدة سنوات قبل أن اتخذ اتجاها آخر و فكرا خاصا بي، و يندر أن تجد في كنائس الثمانينيات الأرثوذكسية اهتماما حقيقيا بدراسة العهد القديم، الذي بالغت الكنائس الأنجيلية، من ناحية أخري، في التركيز عليه، مما يجعلك تشعر بتأثير الكنيسة الأمريكية، المتهودة بعض الشيء، علي قسس وكنائس تلك الطائفة، خاصة الجيل الأقدم منهم. ولكن رغم هذا فلا ينبغي إنكار فضل الكنيسة الأنجيلية في حمل عبء تفسير وشرح وإبراز جوهر العقيدة بغض النظر عن الأسلوب الحرفي الناموسي، الذي ينتهجه غالبية الأنجيليين في فهمهم و تطبيقهم لما يتعلمونه .
لا أبالغ إذا قلت أن الشباب المسيحي في الوقت الذي نشأت فيه (أنا من مواليد عام 1979 ) كان أكثر تدينا من غالبية الشباب المسلم، فبينما كان الشباب المصري يستمع للأغاني و يمرح و يقرأ و يحب و يتمتع بقدر من الحرية، كان المسيحي في المقابل، يستمع لأشرطة الترانيم و الألحان و يقرأ الكتب الدينية، و بالرغم من المظهر العصري للشباب المسيحي، إلا أنه كان غالبا منغمسا بشكل مبالغ فيه في حياة الكنيسة، فأنا أذكر (الميسات misses) في مدارس الأحد واللاتي برغم انهن كن شابات جامعيات عصريات ترتدين التنورة القصيرة التي قد تصل للركبة كباقي فتيات مصر، حسب موضة الثمانينيات، لكن كن جادات متحفظات للغاية و كانت هؤلاء الفتيات في كنيستي بالحي الراقي بمدينتي تنتمين للطبقات المتوسطة و الغنية المتاحة لها كل وسائل اللهو، لكنهن كن يقضين أوقاتهن في اصطحابنا نحن الصغيرات إلي "مدارس الأحد" و دراسة المقررات التي توزع عليهن و تدرس لهن لتدريسها إلينا بدورها، وشراء الهدايا الصغيرة من جيوبهن الخاصة لنا، و السفر مع باقي الفتيات و القسس للكنائس البعيدة و الأديرة لقضاء أوقات تعشن فيها حياة الدير بكل معني الكلمة من اجتماعات صلاة صباحية تبدأ قبل السادسة صباحا، و تستمر التسابيح و الخدمات للمساء !، و كانت فترة بعد الظهر و المساء في حياة هؤلاء الشابات و الشباب أيضا، في غير أوقات الدراسة، كلها تقضي في حضور الاجتماعات المسائية، اجتماعات للشباب والشابات واجتماعات عامة وما يعرف بالعشية وغير ذلك، وهناك اجتماعات لما يعرف بالأسر، إذ ان هناك أسرة لكل كلية تجتمع في الكنيسة للصلاة و لإحداث تقارب أكثر بين الزملاء. هذا غير المساهمة في الأنشطة الخيرية التي تقوم بها الكنيسة مثل افتقاد المرضي ومن يتغيبون عن الذهاب للكنيسة ومساعدة الفقراء بشتي الطرق و هم من يطلق عليهم "أخوة الرب" أما نادي الكنيسة للأطفال والنشء في الصيف فكان يهتم بتعليم وإتاحة ممارسة الهوايات من رسم "لموضوعات دينية" وموسيقي "كنسية طبعا " للفتيات، وكانت هناك أيضا في كنيستي بعض الألعاب التي نلهو بها و هي كالألعاب الموجودة في المنازل كلعبة كرة السلة المصغرة و غيرها حسب ميزانية الكنيسة و المستوي الإجتماعي لأعضائها حيث تنفق الكنيسة علي هذه الأنشطة من التبرعات والعطاءات التي تقدم من الأعضاء، و بعض الكنائس الكبري بها ملاعب صغيرة نسبيا لممارسة كرة القدم و السلة للأولاد . وأصارحك القول، أنني مازلت لا أستطيع استيعاب كيف يروض الإنسان نفسه علي قضاء كل وقته تقريبا، في المرحلة العمرية المفترض بها التفتح للحياة و الشباب، في العبادة أو في جو ديني بحت ! لقد كنت منذ طفولتي، أحب الله، بالفطرة و كنت أتكلف الجهد للذهاب مع شقيقتي الأصغر كل صباح يوم جمعة لحضور "القداس" حيث كنت أتخيل الله، في شخص المسيح الوديع، حاضرا بصورة غير مرئية، في الهيكل، و كنت أكافح الشعور بالملل و الضيق الشديد الذي ينتابني بعد الظهر عندما يحين وقت الذهاب " لمدارس الأحد" التي كانت تصطحبنا لها "الميس" مشيا أو بالميكروباص المجاني أو في أحدي عربات الخدام الخاصة، و بالرغم من أننا كنا نعامل بشكل لطيف للغاية، و ندلل، إلا أنني، لم أكن في حقيقة الأمر استمتع بأي من هذا، كنت أحب الحياة، و كنت أحب الأغاني و الموسيقي بكل أنواعها أكثر من الترانيم فبها حياة أكثر وهي تعبر عن مشاعر إنسانية أكثر تأججا، بالطبع كنت أشعر براحة و مشاعر روحانية سامية للغاية في العبادة، لكن لم أهضم أبدا قضاء أوقات طويلة في ممارستها، أذكر قضائي أوقات طويلة وحدي في سني طفولتي المبكرة للغاية، ألهو أو أتأمل و أتخيل، في حديقة منزلنا الكبيرة المهملة، و التي كانت آنذاك تمثل لي عالما خياليا، فهي تارة قصرا مسحورا و تارة غابة برية أو قرية أو بستان و مازلت للآن أشعر بالإقتراب من الروح الكلية للوجود ومن جوهر الحياة كلما اقتربت من الطبيعة، أما أسعد أوقاتي فكانت تلك التي أقضيها في القراءة، كانت رائحة الكتاب وملمسه تبعث في شعورا لا أستطيع وصفه، يقارب أو حتي يتفوق علي شعور النشوة التي كانت تبعثه في الثياب الجديدة في العيد أو الألعاب .
ربما من أول صدماتي، و صدمات والدي اليساري اللاديني القديم في "الميسات" كانت عندما جاءت إلينا الميس الصغيرة اللطيفة الأنيقة في زيارة من زيارات "الإفتقاد" المعتادة و جلست معي أنا وأبي في حجرة الاستقبال، وبدأ أبي كعادته يثني عليّ وعلي حبي المبكر للمعرفة وقراءاتي، فعلقت الفتاة بأنه ينبغي لي أن أقرأ الكتب الروحية فقط لا الكتب الأخري ! وتراكمت ملاحظاتي و مشاعري التي تصارع الرغبة في التمرد علي المنظومة الدينية المغلقة وتكبتها الرغبة المقدسة لدي في أن أكون دائما الفتاة المثالية، فلابد أن أكون فتاة كاملة تذهب للكنيسة وتمارس الطقوس كما أنني أيضا فتاة متفوقة دراسيا يثني علي المعلمون والأقارب حتي احتدم الصراع وتغلبت عقليتي النقدية وروحي المتمردة في سن السادسة عشرة.
وكنت أحب صديقاتي المسلمات في المدرسة أكثر، دائما كنت أجد نفسي معهن، كنا نعيش الحياة بطبيعتنا فنمرح ونلعب ونغني، بينما كنت أضيق ذرعا بالفتيات المسيحيات المتكلفات المتحفظات، وكنت أبغض التفرقة بين الناس علي أساس الدين، كنا نتعلم أننا ينبغي أن نكون حسني السلوك مع كل الناس ونحب كل الناس لكننا لا يجب أن نندمج أكثر من اللازم مع غير المسيحيين، ولم أكن أطيق سماع مثل هذه الكلمات، لم أكن أعلم بالطبع أن صديقاتي المسلمات أيضا تستمع بعضهن، مع بدايات انتشار التدين الإسلامي من الناحية الأخرى لكلمات مشابهة، بل وربما كانت أقسي كثيرا في بعض الأحيان.
أكدت لي والدتي أيضا أن هذا الإغراق في التدين لم يكن سمة الجيل المولود في الأربعينيات وما قبلها سواء من المسيحيين أو المسلمين، و عندما أشرت لموضوع الأيقونات التي اعتادت الأسر المسيحية تعليقها في المنازل في الماضي و أنها، حسب ما لاحظت، لم تخرج عن لوحات تصور المسيح و العذراء و ربما مارجرجس أحيانا ولم يكن الجيل القديم يعرف كل هذه الأسماء للقديسين والقديسات والتي يتسمي بها الصغار الآن وهذا إحدي ملامح التدين الزائد الذي طرأ بداية من أواخر السبعينيات، فقديما كانت أسماء مثل شاكر، نبيل، حلمي، نجيب و حتي رمسيس و إيزيس وهي أسماء محايدة أو مصرية قديمة، منتشرة بين المسيحيين، أما الآن فتجد كل المسيحيين تقريبا يسمون بأسماء قديسين و قديسات غالبا أجنبية,فإلي جانب مينا و كيرلس و بيشوي و هي أسماء مسيحية مصرية أصبحنا نجد باتريك و بيتر و مارك وستيفن . ومن ملامح هذا التيار أيضا الإغراق في "الأرثوذكسية" كما ذكرت، وأذكر أن منزل جدتي لم يكن يحتوي إلا علي لوحة العشاء الأخير المعروفة لليوناردو دافنشي و لوحة أخري للمسيح و بقية الصور كانت صورا فوتوغرافية عادية لأفراد الأسرة و صور زفاف الأبناء مثلهم مثل باقي المصريين، كما لا أذكر من الكتب الدينية إلا الكتاب المقدس الضخم، الطبعة اللبنانية القديمة . تعجبت أمي من ملاحظاتي هذه ووافقت عليها بشدة . من ملامح هذا التغير أيضا أن المسيحيين كانوا يشتركون في العديد من المظاهر الاحتفالية مع المسلمين، ومن أبرز هذه المظاهر، السبوع للمولود، فكانت تقام المراسم المعروفة للقدماء، من وضع السبع حبات و القلة أو الأبريق، و توزيع أكياس الحلوي و غناء الأغاني المعروفة في هذه المناسبة وترديد العبارات التقليدية للطفل الموضوع في الغربال مع دق الهون، وأعتقد أن المسلمين قد أدخلوا بعض الشعائر الدينية في العقود الأخيرة علي هذا الاحتفال وغيره، بينما المسيحيون قد استبدلوا كل أو معظم هذه الشعائر بصلاة دينية يقيمها الكاهن في المنزل، و أصبحت الخطوبة كذلك لها صلاة دينية يتلوها الكاهن أيضا في المنزل أو يذهب الخطيبان لمباركة الخطبة في الكنيسة، ودخل الدين في كل مناحي الحياة وعرف الصغار ألوانا وأشكالا من الصلوات لم يعرفها آباؤهم الذين كان يكتفي أغلبهم بحضور القداس الصباحي يوم الأحد قبل الذهاب لأشغالهم بالضبط كما كان أغلب المسلمين يكتفون بصلاة الجمعة ثم يصلون في بيوتهم باقي الصلوات، فأغلب المسيحيين يواظبون علي صلاة قبل النوم والقراءة في الكتاب المقدس كما يواظب المسلم المتدين علي الصلوات الخمس بالذات صلاة الفجر . وكان من المعتاد في فترة دراستي الإعدادية والثانوية وحتي في الجامعة أن يسألك كل من يقابلك من المسيحيين يوم الإمتحان، من شفيعك ؟ أي من من القديسين شفيعك لهذه المادة ؟!! فلا يوجد أي احتمال أن ينفرد شخص بالخروج عن القطيع، تذكر أنك في مصر.
ربما بدأ هذا الاستلاب من الكنيسة لحيوات المسيحيين يقل في السنوات الأخيرة بعض الشيء و أغلب الظن أن هذا بسبب تزايد أعداد المسيحيين مع ثبات أعداد الكنائس نتيجة التمييز الديني المعروف الممارس من قبل الأهالي والحكومات، وأيضا لازدياد أعداد القنوات التلفزيونية المسيحية الخاصة التي تحل أحيانا محل الكنيسة .
و لكن أيا كان التدين الأرثوذكسي، فهو لا يقاس بحال من الأحوال بالتدين الأنجيلي "البروتستانتي"، وانسي من فضلك ما رأيته في فيلم (بحب السيما)، وهو بالمناسبة من أكثر الأفلام التي استمتعت بمشاهدتها وأعجبت بها برغم بعض الأخطاء التي تعجبت من وجودها في فيلم بعض صناعه من المسيحيين، فالرجل المتزمت الذي لا يحب السينما ولا الموسيقي ولا أي لون من ألوان الفنون هو صورة كربونية للكثير من الأنجيليين لا الأرثوذكس كما رأينا في الفيلم، وصدقني فهم يعتبرون أن الذي يدخن السجائر مثلا لا يمكن أن يكون مؤمنا، والفتيات لا ترقص في الأفراح و لا في أضيق الحدود حتي في منزلها بين أسرتها، و الكثيرات حتي اليوم لا تضعن أي نوع من أنواع المساحيق و كثيرات لا تلبسن حلي ذهبية، والتدين الأنجيلي قديم العهد، أقدم من التدين الذي اجتاح المسيحيين من نهايات السبعينيات والذي بدأ في المجتمع المصري عموما كما هو معروف منذ تلك الآونة للأسباب المعروفة والتي نوقشت مرارا في السنوات الأخيرة، و إن كان لم يتخذ صورة الإنتشار الطاغي إلا من بداية الألفية الثالثة و بالطبع كان أبرز مظاهره انتشار الحجاب بصورة لم يسبق لها مثيل و في طبقات اعتادت فتياتها السفور قبل الزواج وأحيانا بعده . ويعتبر الأنجيليون كل الآخرين "غير مؤمنين" يحتاجون لصلواتهم و المراقبة المستمرة بغرض توصيل رسالة المسيحية لهم (سواء بشكل مباشر لو كانوا من المسيحيين، أو عن طريق إعطائهم المثل الحسن لو كانوا من المسلمين حيث يجرم القانون كما تعلم تبشير المسيحي للمسلم بالمسيحية في حين يبيح العكس و هي إحدي صور التمييز العديدة )، بما فيهم كل المسيحيين من الطوائف الأخري وحتي من الأنجيليين أنفسهم ما لم يمروا بمرحلة تبدل دراماتيكي من السوء المطلق "والذي ربما لا يتعدي التدخين مثلا للرجال ووضع المساحيق للسيدات"، إلي الإيمان .وهي حياة تبعث علي الجنون، وتذكرني بجماعة التكقير و الهجرة ولكن بالشكل المسيحي اللطيف، فالتكفير هنا هو النظر لكل الآخرين علي أنهم خرفان ضالة تحتاج النعمة "عمل المسيح فيهم" وتحتاج مساعدتهم حتي لا يذهبوا للجحيم اما الهجرة فهي حرفية، هجرة من كل مظاهر الحياة واعتزال لكل ما فيها وانغماس مغالي فيه في حياة الطائفة التي تمثل أقلية ضمن الأقلية، وهذه الحياة تعد خير تمثيل للحرفية المميتة التي يتحدث عنها الأنجيل .
لم تقتصر "رعاية" الكنيسة من خلال الكهنة أو الخدام والخادمات للشباب والشابات والأطفال وحتي الكبار علي الكنيسة، فالقبضة المحكمة تمثلت في زيارات الافتقاد الطارئة والتي كانت تمثل لي إحدي كوابيس مراهقتي و شبابي المبكر، حيث لم أستسغ أبدا تطوع أناس غرباء عني بالتدخل في شأن خاص كقناعاتي الدينية و سلوكياتي، والمتابعة والمراقبة عن بعد، هذا غير الكاهن الذي يفرض عليك موضوع سر"الإعتراف" كأنه أمر مسلم به أن تكون مؤمنا بكل هذا لأن اسمك مينا أو اسمك ميري مثلا ولا ألوم في هذا الكهنة فقط بل ألوم الناس الذين يسلكون دائما سلوكا جمعيا نقليا ولا يحاول المرء منهم أبدا اتخاذ موقف شخصي مستقل بناء علي فكره الخاص أو قناعاته الذاتية . و كما هو متوقع من أي مجتمع ديني و كما تحدث المسيح نفسه، فإنك تجد دائما نوع من الخطايا، بحسب التعبير المسيحي، يغلب علي البعض في هذه المجتمعات، وأولها الإدانة و هي الخطية التي تحدث عنها المسيح كثيرا، فالشخص المتدين قد يحكم علي غيره ممن يسلكون سلوكا متحررا، والفضول والتطفل وربما النميمة أحيانا والتدخل فيما لا يعنيه، هذا في أسوأ الأحوال، وقد يتسم البعض بجمود الفكرو ضيق الأفق وبرود المشاعر . وبالطبع هناك دائما المجموعة النقية والتي تجد فيها التجسيد الحي للفضائل المسيحية.
اعتدنا أنه لو انتقد المرء جماعة، نعده عدوا لها، وفي المقابل، فإنك يجب أن تمدح دائما من تحبهم أو من تنتمي إليهم، وأنا بالرغم من أني لا أحسب نفسي علي جماعة أو تيار، و انتمائي الإنساني هو ما أعرف به نفسي، إلا أنني بتعبيري عن مشاعر ربما تكون سلبية أحيانا تجاه موقف أو فكر، لا أعبر إطلاقا عن شعور سلبي تجاه الأشخاص الذين منهم أفراد عائلتي و منهم أناس عايشتهم في هذه الكنيسة أو تلك، وكان منهم أفراد طيبون للغاية، وإن اختلفت معهم في الرأي فقد أعجبت بطيبتهم وبما يفعله الكثيرون منهم لمساعدة الآخرين حتي لو بوازع ديني لا إنساني . كما أنني عندما انتقد أمورا في الإسلام والمجتمعات الإسلامية، لا أعبر عن كراهية لجميع المسلمين كما يتصور غالبية المسلمين عندما يوجه لهم أو لدينهم النقد و هذا ينطبق علي كل ما أكتب ولعلك لاحظت أني حتي الفكرة لا أتعصب لها بل أناقشها فقد كتبت مثلا عما أحبه ,عما لا أحبه في الكتاب المقدس وهكذا . فالفكر الحر يعني عدم التعصب حتي للأفكار التي تعد تقدمية، بل تحليلها واتخاذ موقف صادق معبر عما تعتنقه فعلا وعما تراه من تأثير لها علي الحياة بحسب كل موقف.وكذلك أفرق بين ما أبيجه لنفسي من التعبير عن شعوري تجاه ما أناقشه من أمور من ناحية، وبين الحقائق من ناحية أخرى.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. عرب ويهود ينددون بتصدير الأسلحة لإسرائيل في مظاهرات بلندن

.. إيهود باراك: إرسال نتنياهو فريق تفاوض لمجرد الاستماع سيفشل ص

.. التهديد بالنووي.. إيران تلوح بمراجعة فتوى خامنئي وإسرائيل تح

.. مباشر من المسجد النبوى.. اللهم حقق امانينا في هذه الساعة

.. عادل نعمان:الأسئلة الدينية بالعصر الحالي محرجة وثاقبة ويجب ا
