الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
كآبة الكاتب -1-
جميل حسين عبدالله
2017 / 10 / 11سيرة ذاتية
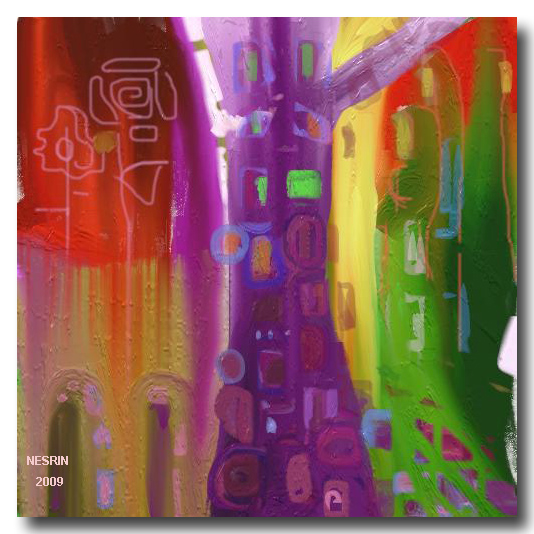
كآبة الكاتب
رقم 1
لعلنا قد أدركنا في سعة هذا المدى الذي يحاصرنا غموضه، أننا قد اجتزنا على مراحل كثيرة، واقتطعنا مسافات طويلة، وارتحلنا من أشياء قد اخترنا لها مهدا في عقولنا إلى حقائق لم تكن من صنعنا، ولا من كدنا، واختلسنا نظرات إلى ما هو أصيل في مكنون وضعنا، أو إلى ما هو هجين في مألوف واقعنا، بل استوقفنا على بابها تلك الأقدار التي تجرنا إلى مصير لا ندرك كنهه، ولا ماهيته، ولا نعرف بدايته، ولا نهايته، ومشينا مقيدين بالأوضار، ومكبلين بالأوزار، وحدونا بالأغاني الحزينة، والألحان الثخينة، وكأننا ما وجدنا لشيء غير هذا الذي زرعت فينا بذرته، وغرست فينا شجرته، وما حططنا رحل الأماني بواد من الأودية، إلا لنجني منه خسارته، ونكسب فيه هزيمته، إذ ما من مرحلة نقطعها، أو مسافة نخترقها، إلا وأدركنا أننا كنا أغبياء، وبلداء، وأيقنا بأننا لم نعثر في دائرة الحقيقة إلا على كلام تشدق به متحذلق، أو رأي فاجر به متملق. وقد بقينا على هذا زمنا حسيرا، لا تأتينا فاجعة، ولا تدهمنا قارعة، إلا وظننا أنها الأخيرة في لعبة الأقدار المتعبة، والأولى في طريق سنعدو عليها إلى أمل يبدو لنا هادئ المناخ، وطري الفخاخ، لأننا لم نتشبث بالوجع، إلا لأننا ننتظر فرجا يفك آصارنا، ويسرحنا من إسارنا. لكن هل أدركنا حصون تلك المدينة العتيقة التي نتَّزر بأسمالها البالية، وصافحنا أهلها المحدقين على شمعة الآمال اليائسة، وجلسنا بين ربوعهم ضيوفا مبجلين، ومقدسين.؟ أم غدر بنا الزمن الغامض الملذات، وصارت الحجارة المبللة بعطر التاريخ رمادا، أو حطاما.؟
شيء من هذا قد حدث مع العواصف التي لم تحترم خريفنا، ولم تشفق على ربيعنا، بل انهالت علينا بما يجعلنا نصدق بحقيقة أخرى، هي في غلوها صعبة على الإدراك، وعصية على قنص ما يمكن فيها من يقين، لأننا كنا فيها بين خيارين متطرفين، لا نحدق في أحدهما بالعين الفاحصة، إلا وانهال علينا الآخر بالرفض، أو الربض، فإما أن نوقن بأننا فقدنا الرشد في الجزء المخصص بواقع نذرف الدموع على فقدان روحه، وإما أن نؤوب إلى حصون أعماقنا المبللة بعطر الذكريات، فنقيم حربا ضروسا على قناعاتنا التي ندمر شاخصها، لئلا يبقى لنا في أحشاء ذاتنا عرق إلا وأدنفه المرض، وأدماه الوجع. كل هذا يحدث في الكيان الدوي، والوعي الشقي، إذ مقتضى هذا الانتهاك الذي نال عزائمنا الخائرة، أن نجرب تحطيم الصنم الذي نملك سره القائم فينا بالإلهام، أو الإحجام، وهي العملية الشاقة التي تبوء في غالب احتمالاتها بالإخفاق، وتقضي في سائر أحوالها على زمن نشاطنا الذهني فوق بساط الوجود، لكي تقربنا إلى الوهن الذي لا نطيق له ردا، ولا صدا، لأن الانتقال من وضع البيئة إلى ملكوت الطبيعة، لن يسرح أنظارنا إلا في أفق المعاني التي نستجلبها بالتذكر، ونستنبطها بالتبصر. وذلك ما تغافلنا عنه حين انطلت الخدعة علينا، وخلنا ما نشهده من نظام صارم لمطالب الحرية، هو القول الفصل في كسب رهان الحقيقة. إذ لو كنا أحرارا في وضع هذه الصورة التي نتفيأ ظلالها، لما تساءلنا عن الماهية، ولما تعاندنا على الهوية، لأن ما نصرح به عندما نحس بحيوية أوجاعنا، وشعورنا بالرغبة الممتلئة بالانتشاء، ليس هو الدافع الذي نذود عنه حين نتعالى بأفكارنا الزائغة، وأوضاعنا الشاردة، بل هو السبب الذي نرتدي قناعه حين نرتب أقيستنا في حصر المادة بين أقفاص تجرنا إلى متاهة الغلط، واللغط، وتدسنا في عتمة الأفكار، وسوداوية الأنظار. ولولا ذلك، لكنا منحازين إلى زمن غير الذي نعيش فورانه بلا شهوة، ولا غاية، وهو متعب، ومقلق، وضجر، وممل، وكئيب، لأنه ينسينا شوقنا إلى غضارة الطبيعة، ووسامة الخليقة، ثم يخدرنا بسمومه التي تفتك بأوصال السعادة، ونياط الكرامة.
مذهل أن نستبطن هذا البرد بين أسوار المدينة المختلفة الطباع، والمتعددة المزاج، ونحن نتقدم بخطوات في بحر الحيرة، ونترجل من مدى رحيب إلى مجهول غامض، ومن حياة هادئة إلى أوضاع صاخبة، لعلنا أن نضع حدا للفكرة، ونقيد حيزها بكل دقة، ومرونة، لئلا نتحسسها في يوم من الأيام التي نستجيب فيها لمثيرات أخرى، فنجدها خشنة، وغير سارة الحدوث، وقد كنا عودنا أذهاننا على تصويرها رطبة، وربما لزجة، لأننا إذا أخطأنا في تركيب وحدات معناها، أو في ترتيبها بين سلم الموجودات التي تلتزم بها صور عقولنا، وننجزها في مدركات واقعنا، فإنها لا محالة، ستكون إحباطا لعملية الخلق، والإبداع، والابتكار، وإسكاتا لصوت الفضيلة التي تتفاوت ماهيتها باختلاف مراحل مرورنا على هذا العالم الآسر بتحدياته الشاقة. وإذ ذاك، لن يفتح اليأس لنا شهية، ولن ينتج فينا صولة، لكي نتعرى من القناع الذي نرتديه بمهارة، ثم نتذوق ما تبقى من طعم الحياة الخالي من شوائب الاضطراب، وعوارض الاحتراب. وما أقبحها حين يكون لونها سوادا قاتما، وحالكا، أو حين تصبح أسبابها مثيرة للعصبية في ردود انفعالنا مع ما ينطبع على قوارير الكون، وصروح الوجود، لأنها لن تخلق فينا لحنا يحمل صوتنا الداخلي، ولا فعلنا الخارجي.
وهنا يبدو لي السؤال محرجا، وفي كثير من ضرورات طرحه معذبا، لأنه سيقضي على حلمنا في المدينة التي نمشي بين دروبها ساعات، وربما أياما، أو أعواما، عسانا أن نكتشف ما كتب على أطلالها من حروف الإنسان المجرد عن ريش كل تصنيف، وما نقش على وجوه المعابد المزينة بمرايا يعلوها الغبار، ويكسوها غضب هذا الراهب الذي أضاع بسمة الإله بين أعشاش العصافير، وروضات الأطفال، وحدائق العشاق، وواحات الحائرين بين الفوق، والتحت، والهائمين بين الماضي، والغد، والتائهين بين التضحية، والخلاص، لكي يخب المقعدون على أريكة الرعب إلى قداس البكاء بذهول، واندهاش، ويسرع المتوحشون إلى ظلال الهيكل المغتصب بريقه، والمسروق حريره، ليعلنوا توبتهم بما ينشدونه من لحن شجي، ويغنونه بصوت دوي، ثم ينتهي المشهد على اكتشاف ما في الصورة من انخرام، وعلى ما في الذوات من انفصام. وإذ ذاك يخرجون، ولا يعودون، وإذا عادوا إلى حطيمه ضحايا، أو حملوا إليه على آلة حدباء، سمعوا أنين اليتامى، وحنين الثكالى، ونظروا إلى ما عاثوا به من لعنة الدمار، ووحشة البوار. فلا غرابة، إذا كان هذا خيارا يوميا يحطم إرادتنا في الفعل، وجريا ملازما للدليل الذي نقتنع بسيره إلى الأمام، ونحن نستكنه للغد حدودا تقيه من الزوال، إذ لا يفارقنا في خروجنا إلى هذا المستشرف الذي نطل منه على البحر الهادر بأمواجه الصاخبة، عسانا أن نسبر أغوار ألغازه المبهمة، ولا يبرحنا في عودتنا الخائبة إلى أرديتنا المبللة بأوحال الطريق، والملطخة بخنين الأطفال المشردين، ونحيب الشيوخ المعذبين.
ذلك الخيار الذي يربك سيرنا بين السكك الملتوية، والمتعرجة، ونشوتنا على أجراف البحر، وشطآنه، وتوهاننا فيما اختزنته ذاكرة المعالم العتقية، والآثار التليدة، هو الذي استسلمنا له حين اختل المزاج في نشاطنا العقلي، وقسى المكان بحزن الأزهار، والأشجار، والأحجار، وهو الذي نواجه به غنوصية الكائن البشري، ودهاليز سره، وكبده، ونعلن به عن عقلانية شرحنا للظواهر اليومية، والعوارض الحياتية، واستبصارنا لمعالم السبل الغضة بالأنواء الساهمة، والأجواء الغاضبة. إذ ليس لنا من مرفأ نلتجئ إلى هدوئه النسبي إلا سواه، ولا ملجأ نحتمي بكفهه إلا ذراه، لأنه هو الذي يمنحنا متعة في محاورة المدينة الصاخبة، ومعاندة لمساءلة الأمواج الهائجة، ومجابهة لمناجاة السماء الداكنة. وإذا غازلنا الحلم بين الآمال الشاسعة، وزعمنا أن في البعد ألما دفينا، لا ينفجر في الذات إلا وأقعدها بالضنى، فقد كذَّبنا ما يجري به قانون التاريخ، وصدقنا وهما يتضمن رواسب أخطاءنا، وخلفيات هزائمنا. إذ البعد هو الذي يعلمنا أن في القرب بينا، وفي الفصل وصلا، وفي الصمت صوتا، وفي الحزن لحنا، وفي الحرف وجعا. ولولا ما انحصر في قاع تفكيرنا من ميل، وما انبعج في تدبيرنا من ملل، وهو الذي يغذي خمود إحساسنا، ويربي همود مشاعرنا، لأيقنا بأن ما نتمتع به من لذة في سكون الأشياء المتصارعة، هو الهدف الأسمى في التخطيط للمستقبل الأكمل، والتجميع لعناصر الحظ الأمثل.
لكن لم يكتف العقل بالمهادنة لما يراه سببا في تنغيص الأسباب المشتركة، ولو لم يهدم كثيرا من شهوات أوثان عقله، ولم يختر سبيل الألم لبناء أسس معاشرته الوجدانية لواقعه، بل أصر على مبارزة ذلك المكان الساحر في ذاكرة الإنسان، وهي الحافظة التي استوعبت الطبيعة البشرية بعواطفها، وعنفها، وخيانتها، وفضائلها، ومخازيها، لأنه أدرك في التورية حبا يعبر عن غزارة طبعه، وجسامة نفسه، وفي الألم كناية تغننيه عن نظام المعاني المتلاشية بين فراغ وصفه، وضياع حظه، إذ لا يحق له أن يلمس الأشياء في تشابهها، وتماثلها، وتناظرها، إلا إذا أحس بما فيها من سذاجة، أو هزالة، أو اصطناع، أو امتناع، ولو اختار الانحناء في معبد المداراة، والتأم مراده على أن يوقف جهاز المعارضة، ويقيد معنى المعاندة، ويعطل إدراكه بما يدبره من رضى، أو بما يفترضه من قبول، لأن غيابه، واغترابه، وبعده، وعبثه، وفوضاه، هي التي تكسبه لغة الأشياء الجميلة، وتعلمه كيف لا يكترث بالأحكام المبسطة، والآراء المركبة. فأحر به في مخاطرته، أن يدرك في معانقة الزوجين تنافرا، وفي مخادنة الخليلين تناكرا، وفي ملامسة الحقيقتين تضاربا، وفي ملازمة الشبيهين تسابنا، إذ هي لا تعبر عن حقيقتها بمجرد الاقتران، أو بمطلق الالتصاق، بل تكون واقعا حين يسمو بها الروح إلى أعلى مراقي الوعي، والاستقلال. هكذا يحس في ذوقه بالنفور، وفي شهيته بالفتور، لأنه يرى صريح العشق خارج قفصه الذي تحكمه ضرورة الصيغ المنسوجة من أقنعة المثالية. وإذا لم يجرب الحظ بمشاركته الوجدانية، ولو بالتحايل الذي يعيش به الاستثناء في عرضه الخارجي، واجتاز شباك العقل الذي يقدس القياس بالتواطؤ، والالتفاف، فإنه لن يظفر بأودات معرفته، ولن يطيق أن يستعير الألفاظ لحروفه، ولا أن ينتقي المعاني لعباراته. وهل العقل في غاية بذله إلا مدرك للقرائن، والروابط، والصلات.؟ كلا، إذا زالت عنه صفته، وفقد استنتاجاته، فلا حرج إن قلنا بأحديته في النظر، والتحليل، والتصنيف، والتأليف. وحاشا أن لا يكون متعددا في مواقفه التي تعتريه بالموت، أو بالحياة، وهو يخترط في صلادة الأماكن طريقا إلى السماء، وفي سواد الفضاء جلباب الأمل، والأحلام الزاهرة.
هذا العبث الذي يشخص الحقائق بما في الذات من فروق بين المفاهيم الملتبسة، هو الذي يريح توقعات العقل، وترقبه للفرج، ويكسبه طرقا لوصل رحم السوداوية الكامنة في عمقه، لأنه ولو أحس بعدم الجدوى في مطارحة خياره، وأضمر الانتحار البطيء في معاندة تياره، فإنه يغدو في وحدته كئيبا، وفي تشاؤمه رهيبا، وإذ ذاك، لا يرى خلاصا إلا أن يزور قبة ذاته التي تحول مادة الصورة إلى خيال جانح، وطيف جامح، وتنقل ما فيها من جو التسلية إلى فعل إيجابي، يرسم تلك الحقيقة الهاربة بين كهوف متغضنة بكائنات عنيدة، وشقية، ومزاجية، وعصابية، ومتعنتة بضجيج، وجلبة، وخصام، وعراك، لأنها هي التي تفتح له آفاقا في تحليل مفردات كيانه، وتجيبه عن كثير من الأسئلة التي تحتاج إلى يد حنونة، وجسة عطوفة، تزيل عنه غي الوعي المصطرخ بأوجاع واقعه، وتمحو من نكهته كل طعم يسلبه لب فكره، ومد نظره. فما أجملها من منة تشمله بوشاحها البنفسجي، وهي تغرقه في المدى السحيق، وتذيبه في المجهول الطليق، لكي تنشئه طفلا غريرا، يسرح بأماقيه في النجوم المتوقدة، ويمرح بفؤاده بين آفاق الكواكب المنيرة، وأجرام السماء العلوية. أجل، فاحتياجه في ملماته إلى إنشاء السلوك المتعلق بباطنه، لا يغذيه النسيان، ولا يطويه الكتمان، لأنه ولو انحبس صوته، وانحصر في سواد جونه، فإنه يصرخ، ويبكي، ويضحك، ويقهقه، ويشتم، ويلعن، وربما في شدة فقده لخيط مراميه، وكنه مقاصده، يجامل حبيبته الساكنة في فؤاده بشيء من الهمس، هو أقرب إلى الشعور من الشعر، فيقول لها في انتعاش سحَره بوارد الفيض الغامر لجوانحه الثملة: أنت لعبة القدر. أنت المنى، والأمل. سأحكي عنك بهمس قصائدي. وأزفر في فضائك بمكتوم حسراتي. وأحلق على ربوة الشوق بجذوة الرجاء العليل. لعل أناملي تلمس ما في نايك من ألحاني. فغني معي، وارقصي. وإن فتر الحس فيك، فانخلعي. فأنا سأغني نفَسي بحرق أصواتي. وأهيل رميم عذري على رفاتي. فرددي معي، أو انحسري. فما أنا وأنت إلا ألوان وردة بين حقول ذابلة. وقد يقول غير ذلك، وهو موقن بضياع حلمه بين عشب النهر، وشعاع القمر، وفقدان أمله في غابة تختبئ وراء آجامها كائنات بشرية، هي أقرب في صورتها إلى الثعابين، والسحالى، ووربما يهدم ما يبنيه بمرسوم شك، ومعلوم حيرة، فيمحو سطوره التي تكتب خواطره، ويحرق ما تبقى من أوراقه، ثم يودع أذواقه مسرعا، ومهرولا، ومجرولا، وكأنه في خروجه عن هذا العالم البائس شعورُه، لا ينحدر إلا إلى بركة هامدة في ذهنه، تنطبع عليها صور هذا الكائن العاقل بشخوصها القاتمة، والداكنة. فلا يكاد يتأمل ما تدل عليه ملامحها من لغة تاريخها، وأدب حضارتها، إلا وعاتبها بأقذع ألفاظه، ونعاها بأفجع أوزانه. وربما من حدة اليأس، وشدة الملل، يبجل الوحدة، فيراها حصنا حصنا، وحرزا أمينا، ثم يختار الصمت، ويطرد هواجسه، ويقتل أفكاره، لعله أن يذوب في لحظة هادئة، تعيد إليه شيئا من سكينته، وطمأنينته.
تلك هي ضرورته التي لا يغضي عنها بعينه، وحاجته التي لم تحقق إشباعها إلا في قاع ذاته، لأنها سبب في الوجود الذي يمنحه نوعا من الزهو، والفخار، وأحيانا كثيرة، يلبسه لباس الرعب، والوجف، فيتشتت بين ذاكرة مهجورة، وغاية مأبونة، إذ لو لم يتجاوز هذه اللحظة في بعض متاهاته التي يلج باب حرفها منفعلا، وغاضبا، وهائجا، ولو في سبات حدسه عن التفكير فيما هو مفتقر إليه من آمال خابية، فإنه سيتيه في قنصها مرتين؛ مرة يبتهج بها حين تذهله ألفاظه التي يكتبها مشوشة، ومبللة بعرق جبينه المتقد بحمية الأنفة التي ورثها من التاريخ المزيف، ومرة يخجل من سرد حكايتها، لأنها تأسر مشاعره بين شهوة الغموض، ونشوة التوري وراء الإشارات المستعرة بالإغواء، والإثارة المجنونة، والمحتدمة بالرغبة المحظورة في سعادته المنكوبة، وعلاقاته المهدورة. وأنى لها أن تكون حقيقة إلا في مثاله الذي يأسره نصه المتعالي عن قيود دائرته، وهو علة تأليمه، ووجه تعذيبه، إذ لا يقاومها إلا لكي يخرج منها كائنا مشتتا بين طاقة سجينة، وحيوية رديئة. فهل تحقق منها شيء في زمن من أزمنته، فاستطاع أن يشعر بأنه حر في إرادته، وسلوكه.؟ لا، لو لم تكن لها صورتها المعنوية في معاني ذاته، وقالبها الذي هو قلبه المظلم، وقلبها القاسي، فإنه سيتضيق من مكنونه الذي يتلذذ بمضمره في ساعة سارحة بين أطياف الأمنية الكليلة. وإذ ذاك، سيعيش بين مهامه الضجر، ومغارات الكمد الذي ينحت صورة أخرى للكون، والطبيعة، ويهيأ لها مهدا تنعطف فيه الهامات لسخرية القدر، وازدراء الإنسان، واحتقار كل الفلسفات التي لم يستطبها العقل المنكسر إلا حين استعبدته، ولطخت وجهه بعار الذل، والمهانة. وذلك ما يعيشه حقيقة عند حافة الغابة التي يستبطنها غوره، لأن البحث عن بقيتها في أعراض الإنسان الخارجية، لم يفارقه في طريقه المستغرق لكل أوحال فكره، وأوزار عشقه، وربما يضيف إليه ذلك ألما حادا، فتعدو احتمالاته غير قادرة على معرفة ما يفيده من تعليمات، وتوجيهات، إذ احتمال العثور عليها، ولو في هذا العالم الذي يعزف ألحانه في قلبه، هو الذي يروح عن نفسه، ويصيره قابلا لما تجود به الساعات من هناءة، ومهما بدت مجوفة، وفارغة، وغير كاملة في مداعبة مواطن فكره، ومغازلة مفاتن عقله، لأن اختلاط الحسي بالمعنوي في الصورة التي تتضمن خصائص شخصيته، ومعالم كنه المثالي الذي يتعاظم به لرغبة التوازن، يركب فيه نشوة نبيلة، تساعده على تسويغ يأسه، وانحساره عن الخوض في علاقات لا تعبر عنه، أو لا يطيق تحمل تبعات مسؤوليتها في الالتزام، والمشاركة. وما أجملها حين تنطبع على صفحة ماء البحر الهادر، وهي توجز قصة العقل الحائر، وتختصر حكاية الأمل الذي يعبر جسر المدن المتدفق تيارها بالظلمة إلى زوايا ذلك المحيط الأبيض المشاعر، والأحاسيس، لأنها أغنية يسمعها بفؤاده، فتشد على عضده، وتغرس في صدره نزوة تهديه إلى معايشه بشريته في أقفاصها الذهبية.
هذا الناسك المتحنت، يداعب جوارح صوره الذهنية في معبد وجداني، ويغازلها في طقس طفولي، وهو يشعر بارتياح يفوق تكهنه، ويربو على تخرصه، لأنه يؤلف ذاته في توليفة تسمو عن عقل الأرض التي فقدت ألحانها المغرية، وأنغامها الممتعة، لكي تستوعب قلب الطبيعة المترع بالأحاسيس الظريفة، والمعاني اللطيفة، ثم يتجرد من كل تصنيف، ويتخلص من كل تنميط، إلا من تفكيره الذي يراه محتاجا إلى فعل يختزن دموعه، ومشاعره، وحاجاته، ورغباته. فأي حدث سيحدث هذه الطاقة المفعمة بالصوت الخافت، وهو في جنون الحلم الذي يدرأ معرة ألغازه، تثبطه معيقات شتى، لا يطيق أن يزيل غصتها، ولا أن يبرأ من شرتها، ولا أن يطاوع وضعها في قرارها المختلف عن خياره، والمبتعد عن صراعه، لأنها بمقدار ما تلبس عباءة الطهر بين الديار المبتهجة بخريف الأحلام، والأماني، فإنها تزداد في غلوها اهتياجا، وتحررا، ولو أنكرها اللسان بالبيان، وحاربها بما يتقيه من عواصف العري، والسفور، إذ هي القيد الذي لم يقع محل الاختيار عند صياغة العقد المحصل للغايات، ولا موضع الرجاء فيما يحبره العقل من توقع، وانتظار. ولو أعيد النظر في تركيب صورتها، وتحديد مدارها، وكان للاختيار محل مضمخ بالأمان، ومكلل بالسلام، لانتهى كثير منا إلى نبذ أحدوثتها، وطرح أسطورتها، لأنها غشاء يحكي خلله عن أزمة الإنسان حين يفقد بشريته بكره، ويفارق كيانه بعنف، ويلتزم بحدود تفصل بين فضائه الداخلي، وعنوانه الخارجي. فهي إذن شيء ابتلعه الكائن العاقل في غفلة، أو في سرية، ولم يتذوق ما فيه من شروق، ولم يستكنه ما يحوم حوله من غروب. فما هو مستقبلها الذي يعد به الكاهن حين يعتلي ربوة غروره، فيرى عبث أطفال المدن خروجا عن جادة الصواب.؟
تتألم الروح حين تنتابنا الحسرات، وتعتادنا العبرات، ولم نجد في غمرة الكمد إلا أن نقول: يا أيها العقل المخدوع بهذه اللحظة الآسرة، تعال نطرح قديم السؤال، ونستفهم ما وراء جبة العراف من مقال: هل من حقنا أن نسرع الخطى على الطريق اللاجب بأنين المارة، وأحزانهم الغائرة، ونلتزم الصمت، ونحتقن الغربة، ونغيب عن مشاهدة ما نجتازه في مهيعنا من شفاه الأشجار العسلية، وعيون الأحجار الزرق.؟ إن لم يكن من حقنا ذلك، ولم لنا في سالف العهد ود، ولا ذمة، فعلمنا كيف نتمهل في تتبع فضولنا، وكيف لا نستعجل في تأمل فصولنا، بل بين لنا كيف لا نستهدي في ترنحنا إلى جمال الظلام الساطع، والسواد البارع. لو فعلت هذا، واستطعت أن تقيد مشاعرنا بأحلامك الواهنة، وتضع لكل صورة ظلالا تناسبها في أفكارك الخاسئة، فإن ما يزفر في جوننا من توهج، وما ينطوي عليه فراغنا من توجه، لن ير النور بين مراح الربوع المثقلة بالهموم، والمكبلة بالغموم، ما حيينا بين هذه الدروب التي تدبر مصيرنا بعمليات معقدة في التركيب، ومختلة في الترتيب. لكن لا تنس أن الزمن يخب سريعا بلا التفات، والمدى طويل المسافات، والمجهول عليل المساحات، والرواحل التي تحمل توابيت الأسرار مزمومة، والأدلة التي تفقه لغة الأنواء مكتومة، والطرق التي تهتف بالحلم زافرة بالمتاعب الفجة، والمفاجآت الغضة، فلا تدعنا نثق بوعدك المأبون، أو بصدق المحتوى الذي تدندن به في توددك المأفون، فتنتشي به في مغازلتك، ونترنح به في مداعبتك، ثم نضيع في عشقنا المفصول عن حركة سؤالنا، ودبيب آمالنا المستلهمة لوجودها من امتعاضنا، وأحزاننا، وإحباطنا.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. قبل عمليتها البرية المحتملة في رفح: إسرائيل تحشد وحدتين إضاف

.. -بيتزا المنسف- تثير سجالا بين الأردنيين

.. أحدها ملطخ بدماء.. خيول عسكرية تعدو طليقة بدون فرسان في وسط

.. سفينة التجسس بهشاد كلمة السر لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

.. صراع شامل بين إسرائيل وحزب الله على الأبواب.. من يملك مفاتيح
