الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
الشيء في ذاته ومبرراته الكانتية
يحيى محمد
2017 / 10 / 20الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
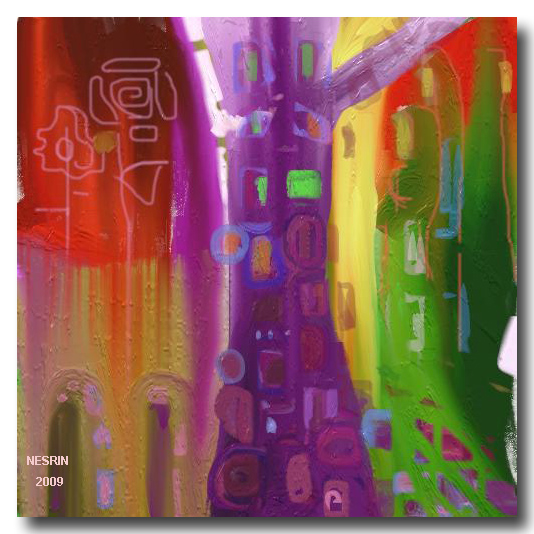
يقسّم الفيلسوف الالماني الشهير (عمانوئيل كانت) الشيء المدرك إلى ظاهر تجربي وشيء في ذاته مجهول حيث لا تمتد إليه المعرفة بحال. فمهما كانت معرفتنا واضحة ومهما توغلنا في الظاهرة إلى قعرها فنحن لا نعرف قوام الأشياء في ذاتها تماماً، وان قوامنا الذاتي هو بالضبط ما يعين صورة الموضوع كظاهرة. فالادراك الذهني مقصور على العلاقات بين الأشياء وليس الأشياء في ذاتها. فالمكان والزمان هما شرطان ذاتيان لحدسنا، وان جميع الموضوعات المتعلقة بهما هي مجرد ظواهر وليست أشياء في ذاتها. فحقيقة الأشياء الخارجية هي غير ما نحدسه، بما في ذلك المكان والزمان، حيث يختفيان كما يختفي كل قوام للأشياء وعلاقاتها اذا ما تجردت عن ذاتنا، فكلها توجد فينا لا في ذاتها، ويبقى الشيء في ذاته مجهولاً رغم انه يعتبر علة الظواهر التي ندركها .
بداية لا يشير (كانت) صراحة إلى كون الشيء في ذاته (النومينا) هو الواقع الموضوعي خارج الذات البشرية. وكما يرى ان الشيء في ذاته هو ليس ظاهرة بل علة الظاهرة، ولا يمكن التفكير فيه ككم ولا كواقع ولا كجوهر.. الخ، لأن هذه المفاهيم تستلزم صوراً حسية تعين فيها موضوعاً.. ولا نعرف عنه إن كان يوجد فينا أو حتى خارجاً عنا، وما اذا كان يختفي باختفاء الحساسية أو يظل جانباً. مع ذلك ففي كثير من الأحيان يشير إلى ان ما يُفترض خارج الذات والحساسية يمثل شيئاً في ذاته، لكنه غير خاضع للإثبات والمعرفة. فمثلاً يبدي أحياناً لو ان للمكان وجوده المستقل عن الذات والحساسية لكان شيئاً في ذاته. كما ويفترض بأن الشيء في ذاته مستقل عن الذات البشرية كظاهرة، فنحن لا نعرف ذاتنا الخاصة إلا كظاهرة وليس ما هي في ذاتها . وبالتالي فالشيء في ذاته ليس عالماً مكانياً ولا زمانياً ولا مادياً، بل عالم معقول ذو صلة بالعقل العملي.
وعلى العموم يرى هذا الفيلسوف ان اثبات الشيء في الواقع الخارجي الصرف هو اثبات للشيء في ذاته، بمعنى ان هذا الواقع يحمل الأشياء في ذاتها، وانه يخلو من مصاديق المقولات والحدوس والمبادئ القبلية؛ كالسببية والزمان والمكان وغيرها. لكن المشكلة هي كيف يمكن لنا اثبات ذلك؟
إن لفكرة الشيء في ذاته مكانة مركزية لدى فلسفة (كانت)، فهو يصفه بمواصفات خاصة تجعله يختلف جذراً عن الظواهر التي يقوم بصنعها، مثلما يختلف عن عالم القوانين المتعلقة بتلك الظواهر. مع ذلك فهو يقيم صلة وصل بينه وبين الظواهر، فابتداءاً انه ينفي ان تكون الظواهر أشياءاً في ذاتها، اذ لو قال ذلك لعرضه الأمر للوقوع في المثالية الذاتية. وكما قال: ‹‹ان متنوع الظواهر يتولد دائماً على التوالي في الذهن، فلو كانت الظواهر أشياء في ذاتها لما كان بإمكان أحد ان يتبين في تتالي تصورات متنوعها كيف هو مربوط في الموضوع. ذلك انه لا عمل لنا إلا مع تصوراتنا، أما كيف يمكن ان تكون الأشياء في ذاتها وبصرف النظر عن التصورات التي بها تؤثر علينا›› فأمر يخرج كلياً عن فلك معرفتنا . ومع انه ليس للعقل قدرة على معرفة الشيء في ذاته، لكن من الممكن ادراكه والتفكير فيه، بل والاستدلال عليه من خلال الظاهرة، وهو استدلال بالشاهد على الغائب.
إن الشيء في ذاته غير مشروط بالشروط التي تشترطها الظاهرة من الزمان والمكان والسببية وما اليها. فالزمان مثلاً هو شرط الظواهر دون الشيء في ذاته، فلا ينشأ ولا يفنى أي فعل في الشيء في ذاته، ومن ثم لا يخضع هذا الشيء لقانون التعيين الزمني ولا لقانون كل ما هو متغير، أي قانون السببية المتسلسل .
ولكون الشيء في ذاته غير مشروط فانه يظل عصياً عن المعرفة. فالحساسية هي شرط للشيء لذاتنا وليست شرطاً للشيء في ذاته. لذلك لا يمكن تطبيق المقولات على الشيء في ذاته أو النومينا، فليس للمقولات فعل مناسب إلا بالنسبة إلى وحدة الحدوس في المكان والزمان، ولا ينفع تطبيق عدم التناقض لأن دوره سلبي، فلا بد من الحدس المناسب له، أي لا بد من حدس آخر غير الحدس الحسي كي يكون النومينا بالمعنى الموجب لا السالب. لكن ذلك خارج عن قدرتنا المعرفية تماماً. فاستعمال المقولات لا يمكن باي شكل ان يمتد إلى ما وراء حدود موضوعات التجربة. وقد يكون ثمة كائنات فأهمية ليس لقدرتنا الحسية الحدسية أي صلة بها قادرة على ان تمتد إلى ما وراء حدود الموضوعات التجربية. لذا ما نسميه نومينا انما هو بالمعنى السالب . هذا بالرغم من ان (كانت) يضفي على النومينا أو الشيء في ذاته طبع الحرية غير الحتمية لينيط به بحث العقل العملي وحل المشكلات الميتافيزيقية بطريقة عملية كما سنرى.
ومع ان هذا الفيلسوف رأى بأنه لا يمكن للمفاهيم والمقولات ان تنطبق على الأشياء في ذاتها، لكنه مع ذلك احتمل ان ‹‹يكون للأشياء في ذاتها تطابقها الضروري مع القانون حتى بمعزل عن أي فاهمة تعرفها›› .
لقد نفى (كانت) ان يمتد مبدأ السببية إلى الشيء في ذاته ليثبت بذلك حرية الإرادة المتحررة عن كل القوانين الحتمية، اذ تنبسط هذه القوانين على الظواهر أو على الأشياء لذاتنا فحسب، دون ان تمتد إلى الأشياء في ذاتها .
ما يعني ان هناك عالمين: أحدهما هو الشيء لذاتنا، أو عالم الظواهر الحسية وقوالبها الحدسية، فهو يحمل طبيعة ذاتية حسية صرفة، وهو يخضع لشرط المفاهيم التنظيمية القبلية. أما الآخر فهو عالم الشيء في ذاته، وهو لا يخضع لقوانين الأول ولا إلى تصوراته، ويظل مجهولاً وعصياً عن المعرفة، رغم ان من مفارقات هذه الفلسفة هي التصريح بوجود خصائص محددة لهذا الشيء، أهمها انه يحمل إرادة حرة وانه أساس وجود العالم الأول، كما سنعرف..
إن التسليم بوجود عالمين، هما عالم الظواهر وعالم الشيء في ذاته، جاء على خلفية ما بدى لفيلسوف بروسيا من تناقضات لدى بعض القضايا، كما هو الحال فيما يتعلق بمبدأ السببية الحتمية، اذ اعتقد ان هذا المبدأ هو حقيقي وموضوعي لدى عالم الظواهر الطبيعية، لكنه منتف لدى الإرادة الانسانية الحرة، وهو ما جعله يسلّم بوجود عالمين مختلفين للشيء الموضوعي الخارجي. فبالإضافة إلى الشيء كظاهرة طبيعية؛ هناك واقع حقيقي مجهول يقبع خلف هذه الظاهرة، ويتمثل بالإرادة الحرة كشيء في ذاته. مع ذلك فمن مفارقات هذا الفيلسوف هو انه حاول ان يستدل على وجود هذا العالم الخفي عبر مبدأ السببية العامة، وهو يعي ان هناك نوعين مختلفين للسببية، أحدهما يتمثل بسلسلة العلاقات الحتمية لدى الظواهر الطبيعية، فيما يخلو الآخر منها، وهو ما راهن عليه في الربط بين الإرادة الحرة وعالم الظواهر.
السببية على نوعين: حتمية وحرة
لقد صنّف (كانت) مبدأ السببية ضمن المبادئ الفاهمة، اذ اعتبر هذه الأخيرة على نوعين قبليين: انشائي كالرياضيات، وتنظيمي كالفيزياء الدينامية. والمبادئ الرياضية ضرورية غير مشروطة، أما المبادئ الدينامية فهي مشروطة بشرط التفكير الامبيري في التجربة، وإليها يعود مبدأ السببية، ويُعنى به: لكل حادثة سبب ما، وهو من هذه الناحية يعتبر مقولة قبلية لكنه ليس من المبادئ التي تعرف بالعقل وتملى به؛ باعتباره يعمل على إمكان وحدة التجربة من دون ان يستعير شيئاً من العقل. فلولا الصلة بالتجربة الممكنة لما امكن لمبدأ السببية ان يملي الوحدة التأليفية لها .
وتتمثل حاجة مبدأ السببية إلى التجربة في مفهوم التغير، فهو مستنبط منها فحسب، وعليه يترتب الحكم. فهذا المبدأ يبين لنا بدءاً كيف يمكن ان يكون لدينا عن (ما يحصل) مفهوم تجربي متعين. فمفهوما (السبب وما يحصل) لا يستنتج أحدهما من الآخر. فمثلاً لا يمكن استنتاج مفهوم ظاهرة تمدد الحديد من مفهوم آخر هو الحرارة أو الضغط كسبب لهذا التمدد، فلا يمكن اشتقاق المفاهيم بعضها من البعض الآخر، وبالتالي كان لا بد من التجربة ان تكشف عن ذلك، بخلاف الحال مع الرياضيات حيث يمكن اشتقاق مفاهيم محددة من مفهوم معين. وبالتالي لا بد من اقتران المفهومين في السببية وفق التجربة .
وعادة ما يخلط (كانت) بين السببية العامة والخاصة. فالأخيرة لا يمكن تحديدها إلا من خلال التجربة والاستقراء، وهو ما لا ينطبق على السببية العامة التي اخضعها هذا الفيلسوف للنقد. فمن حيث السببية الخاصة لا يمكن اشتقاق مفهوم من آخر، وهي بذلك تختلف عن الرياضيات دون أدنى شك. لكن فيما يخص السببية العامة فان المبدأ كفيل للتطبيق على الجزئيات، مثلما نطبق حساباتنا الرياضية عليها رغم اختلاف طبيعة الضرورة لدى كل منهما عن الآخر. وفي كلا الحالين نحتاج في التطبيق على الجزئيات إلى معرفة الواقع كي يكون التطبيق صحيحاً غير خاطئ. فمثلاً في الهندسة الرياضية كل ما نحتاجه هو معرفة إن كان الموضوع المتعين مستوياً أو غير مستو لتطبيق الرياضيات عليه بالطريقة الاقليدية أو غير الاقليدية. وكذا هو الحال مع السببية، فالمبدأ العام صحيح عقلياً كالرياضيات من دون ان يستنتج أو يشتق من الحس والتجربة، لكنه من حيث التطبيق والتعيين لا بد من ان يستعين بمعرفة الواقع، وبالذات لا بد من معرفة إن كانت هناك حادثة أو ظاهرة جديدة لكي نحدد عقلاً بأن لها سبباً ما وانها لم تخرج من العدم من دون سبب مطلقاً، وكل ما يمكن محاولته هو تعيين هذا السبب بشكل أو باخر عبر التجربة والاستقراء والافتراضات الذهنية القائمة عليهما، كالذي يزاوله العلم الطبيعي بجدارة. وبذلك يتضح ان المبدأ العام للسببية هو من الحدوس غير الحسية كالرياضيات خلافاً للفهم الكانتي.
ولدى (كانت) ان السببية وإن كانت قبلية لكنها ليست محضة، فهي بحاجة ليس فقط إلى التجربة بل إلى الحدس الزماني ايضاً، إلى درجة انه اعتبر التوالي الزمني هو المعيار الامبيري الوحيد للسببية. ولو أُهمل التتالي الزمني فانه سوف لا يوجد في المقولة المحضة لمفهوم السبب ‹‹أكثر من ان ثمة شيئاً يمكن ان نستدل منه على وجود شيء آخر. ولن يمكن للسبب والمسبب ان يتميز أحدهما عن الآخر››. هذا بالرغم من انه في محل سابق قد كشف عن ان علاقة السبب بالمسبب ليست مجرد تتالي وتتابع فحسب، بل قد يكونان معاً من دون سبق زماني، فمثلاً ان حرارة الغرفة مربوطة بسبب وجود الموقد ‹‹ففي اللحظة التي يبدأ فيها المسبب بالحدوث فانه يكون متزامناً أبداً مع سببية سببه، اذ لو توقف هذا لحظة من قبل لما أمكن لذاك ان يحدث›› .
لقد حدد (كانت) فعل السببية بعالم الظواهر دون ان يتعداه، فالظواهر ليست ممكنة كموضوعات للتجربة إلا وفقاً لهذا القانون، كما انه لا يمكن التدليل على الأخير إلا بالنسبة إلى أشياء التجربة، فما ندلل عليه هو بوصفه مبدأً لإمكان هذه الأخيرة ومن ثم لمعرفة شيء معطى في الحدس الامبيري لا بمجرد مفاهيم محضة. وهو ما يعني انه لا يمكن تطبيق السببية وغيرها على ما هو خارج السياق الامبيري . فهي قانون لا يتجاوز الظواهر الفيزيقية بما تتأطر فيه من المكان والزمان.
وقد أورد هذا المفكر ثلاثة حقول لا ينطبق عليها قانون السببية، وهي الحلم ، والشيء في ذاته، وقضايا الميتافيزيقا.
مع ذلك فالغريب انه قد اعتبر الشيء في ذاته يحمل بعض الخصائص المعلومة، أبرزها انه يتضمن سببية من نوع مختلف له علاقة بالإرادة الحرة. وهو لم يوسم هذا النوع من السببية بسمة أو عنوان آخر يميزه عن القانون السابق. بل ان افتراضه لهذا النوع جعله يقع في تناقض صارخ، اذ تعامل مع السببية المفترضة خارج حدود الحاجة إلى الزمان والمكان والتجربة الممكنة، ومع ذلك لم يبحث عن مصدريتها، فلو كانت عائدة إلى المقولات القبلية؛ لما جاز لها أن تتعدى الظواهر الحسية، في حين انها ليست مشروطة بهذه الظواهر، كما انها ليست من الحدوس التي حددها بالشأن الحسي فحسب، بل انها ترسندالية محضة، لذلك فمصادرته لها تكفي للقضاء على مجمل نظريته التي أطّرها بالإطار الحسي. والغريب انه لم يتعرض إلى هذه المعضلة ومحاولة علاجها رغم انها تنسف كل ما شيّده وبناه بفعل التناقض المشار إليه قبل قليل.
وأول ما يفاجئنا بهذا الصدد هو ادعاؤه بأن مفهومه الثاني للسببية لا يختلف عما لدى الفلاسفة القدماء، فقد اعتبر ان عليه اجماعهم باستثناء البعض، اذ أشار إلى انهم اجمعوا على القول بحرية فعل المحرك الأول باستثناء فلاسفة المدرسة الابيقورية . بمعنى انهم ضمّنوا السببية خاصية الإرادة الحرة دون الحتمية فيما يخص فعل المحرك الأول بالذات. رغم ان من الواضح بأن هذه النسبة غير صحيحة، فيكفي ان نظرية الفيض وحتمية تنزلات المراتب حسب قاعدة الإمكان الأشرف الأرسطية فضلاً عن مشاكلات الوجود، كل ذلك لا يتسق مع الأخذ بفكرة الإرادة الحرة. ومن المعلوم ان المذهب الأرسطي على الأقل لا يعترف بمثل هذه الإرادة المزعومة .
ما يهمنا في النتيجة هو ان هناك نوعين من السببية لدى (كانت)، احداهما تأتي وفقاً للطبيعة، وهي من المقولات التي تتصف بالصورية والربط، وانها بحاجة إلى المضمون التجربي والى الزمان والمكان، لربط الظواهر بعضها بالبعض الآخر ضمن مصادرة كونها حتمية الطبع. وفي قبالها سببية ثانية ترتبط بالشيء في ذاته وتتعالى عن كل ما وصفناه قبل قليل، وعلى رأس ذلك اتصافها بالحرية لا الحتمية. ولتمييز الثانية عن الأولى سنستخدم اصطلاح (العلية) اتباعاً لما اختاره الاستاذ موسى وهبه مترجم (نقد العقل المحض) .
هكذا فلمبدأ السببية طابع مزدوج لا يخلو من مفارقة، فهو من جانب يحمل طبيعة ذاتية باعتباره ينتمي إلى القضايا القبلية النسبية ذات العلاقة بعالم الظواهر الطبيعية؛ من دون ان يكون معنياً بعالم الشيء في ذاته. لكنه من جانب آخر يمتلك خاصية موضوعية للربط بين عالم الظواهر وعالم الشيء في ذاته، وهو المسمى بالعلية، فالعلية هي شرط كل ما يحصل، وان حريتها لا مشروطة. فيما السببية على العكس من ذلك تكون مشروطة وتتصف بالسببية الطبيعية بالمعنى الضيق. ويسمي (كانت) المشروط في الوجود بعامة حادثاً، واللامشروط ضرورياً .
وبعبارة أخرى، تتصف العلية بأنها حرة متعالية تختص بالذات الفاعلة العاقلة كشيء في ذاته، دون ان تدخل في سلسلة الشروط الامبيرية التي تجعل الحدث ضرورياً في العالم المحسوس. كما لن تكون الذات الفاعلة خاضعة من حيث طبعها المعقول لشروط التعاقب الزمني وقانون التغيرات . وهي بذلك تختلف عن السببية المعنية بالظواهر وارتباط بعضها ببعض لدى العالم الحسي، كما تتكشف من خلال اطرادات الطبيعة وقوانينها الحتمية الصارمة.
إن مبادئ الفاهمة المحضة لدى (كانت) هي ذات استعمال امبيري لا ترسندالي. وعليه نتصور ان اللامشروط في الظاهرة يكون شرطاً معقولاً لا ينتمي إلى سلسلة الظواهر كطرف. وهو الحل الذي قدّمه هذا المفكر على خلفية النزاع الديالكتيكي الذي لا ينتهي إلى نتيجة. وحلّه يتعلق بوجود علية لا مشروطة هي شرط في التسلسل الدينامي، وتتصف بأنها غير مجانسة ولا هي جزء من السلسلة، بل شرط معقول أو غير حسي يقوم خارج هذه الأخيرة. فالعقل يضع اللامشروط في مقدمة الظواهر، وليس ضمنها، باعتبارها تبقى مشروطة دائماً .
إن للنوعين السابقين للسببية ارتباطاً محدداً في فلسفة (كانت)، فالعلية هي أساس نشأة السلسلة السببية. وبحسب هذا الفيلسوف انه لو كانت الظواهر أشياءاً في ذاتها لما كان هناك وسيلة لانقاذ الحرية، بمعنى انه لو كان للظواهر واقع موضوعي مستقل لانتفت الحرية، حيث ان كل شيء محدد وفقاً لصرامة قوانين الطبيعة، لكن حيث ان الظواهر هي تصورات مترابطة وفق قوانين امبيرية؛ لذا يجب ان يكون لها اصول ليست بظواهر، أي من صنف آخر وهو العلية. وبذلك فان العلية هي أساس السلسلة الامبيرية وخارجها خلافاً للمعلولات التي هي ضمن هذه السلسلة.
ففي الظواهر ليس هناك ظاهرة لا تخضع لسلسلة الأسباب والمسببات والتي تفترض التسلسل الزمني. لكن رغم ما تتضمنه السببية الامبيرية من تلك السلسلة فانها تكون معلولة لعلة لا امبيرية بل ذهنية، أي معلولة لفعل اصلي لعلة ليست ظاهرة، بل معقولة من حيث انها قدرة أو حرية، رغم ان السببية الامبيرية تبقى تابعة كلياً للعالم المحسوس كحلقة لسلسلة النظام السببي في الطبيعة. فالقدرة على الفعل للعلية لا تستند إلى شروط امبيرية بل إلى دواع فهمية. وفعل هذه العلة في الظاهرة يبقى مطابقاً لكل قوانين السببية الامبيرية .
ويلتقي هذان النوعان للسببية في أثر واحد بعينه. فالعلية هي ‹‹معقولة وفقاً لفعلها من حيث هو شيء في ذاته›› كما انها في ذات الوقت تمثل ‹‹سببية محسوسة وفقاً لمسببها من حيث هو ظاهرة في العالم الحسي››. وبالتالي فهناك مفهوم امبيري عن قدرة مثل هذا الفاعل، ومفهوم آخر ذهني عن عليته، ويلتقي المفهومان معاً في ذات الأثر الواحد. اذ يترتب عن الفاعل طبعان، أحدهما طبع امبيري حسي يتحدد بالظواهر المترابطة فيما بينها وفقاً لقوانين الطبيعة الثابتة، حيث يكون الفاعل بحسب هذا الطبع مجرد ظاهرة يخضع للربط السببي بموجب كل قوانين التعيين، وهو جزء من العالم المحسوس، ولا مجال لمعرفته إلا بالتجربة. أما الطبع الثاني فهو معقول، اذ من خلاله يكون الفاعل علة لتلك الأفعال بوصفها ظواهر، لكنه لا يخضع لأي شرط من شروط الحساسية باعتباره ليس بظاهرة. فهو حرّ من كل تاثير للحساسية ومن كل تعين للظواهر، وهو في أفعاله مستقل ومتحرر من كل ضرورة طبيعية كتلك التي توجد فقط في العالم المحسوس. وهو ليس فيه أي تغيير يستلزم الزمان ولا الاقتران بالظواهر بوصفها أسباب. وهو يبدأ من ذاته معلولاته في العالم المحسوس من دون ان يبدأ الفعل فيه. والمعلولات ستكون متعينة دائماً من قبل بالشروط الامبيرية في الزمن المتقدم. والطبع الامبيري هو مجرد ظاهرة للطبع المعقول. ويمكن تسميته بطبع الشيء في ذاته مقارنة بالطبع الأول، وهو طبع الشيء في الظاهرة. وعليه توجد الطبيعة والحرية معاً من دون تنازع ولا تنازل .
هذه هي خلاصة المزواجة بين الطبعين للفاعل: الامبيري والمعقول، أو الحتمي والحرّ معاً. فالأول يتميز بالحسية كما يبدو في ترابط الظواهر الفيزيقية بعضها بالبعض الآخر وفق قوانين الطبيعة الثابتة. فيما يتصف الثاني بعليته لتلك الأفعال أو الظواهر. ويتمثل الأول في طبع الشيء في الظاهرة، أما الثاني المعقول فيتمثل في طبع الشيء في ذاته. وبالتالي فالحرية هي أساس الحتمية ونقيض الضرورة، دون ان يكون هناك تناقض بين العلاقتين، فطبيعة السببية هي نتاج معلول صادر عن الحرية من دون تناقض. فالأساس هو الحرية ومنه القانون الصارم للسببية الامبيرية. فهي علة ذهنية لا امبيرية باعتبارها معقولة وليست ظاهرة محسوسة .
وينطبق هذا التحديد على الفعل البشري. فالعقل هو علة قادرة على احداث الأفعال، خلافاً لنظام الطبيعة السببي. فأفعال الانسان تتحقق كظواهر من خلال مبادئ العقل وفق العلية. اذ العقل المحض هو قدرة محض معقولة، وهي علية وبالتالي حرية، وكل فعل بمعزل عن العلاقة الزمنية هو معلول طبع العقل المحض، وهو لا يخضع للزمان وتسلسله، وعليته في الطبع المعقول لا تتولد في زمن معين باحداث معلولها، وإلا صار العقل خاضعاً لقانون الظواهر الطبيعية والتسلسل الزمني للسببية، كما لصارت العلية طبيعة حتمية لا حرية. فالعقل حر في أفعاله من دون شرط مسبق، ومن ذلك انه ليس هناك فرق في الزمان بين الأفعال العقلية خلافاً للظواهر. والحرية هي قدرة العقل على ان يبدأ من ذاته سلسلة احداث كشرط غير مشروط لكل فعل ارادي، على الرغم من ان معلوله يبدأ في سلسلة الظواهر انما من دون ان يشكل فيها أي بدء أول باطلاق .
وبعبارة ثانية، ان للواحد منا قدرة على ان يبدأ من ذاته حالة لا تخضع سببيتها بدورها لسبب آخر يعينها من حيث الزمان وفقاً لقانون الطبيعة. فالعقل يبتدع فكرة عن تلقائية يمكن ان تبدأ من نفسها الفعل من دون ان يكون قد سبقها سبب آخر وفقاً لقانون الاقتران السببي .
وبالتالي فنظام العقل وفق العلية هو غير نظام الطبيعة. فأفعال الانسان بوصفها ظواهر هي نتاج مبادئ هذا العقل.
يبقى السؤال الذي لا جواب عنه بحسب (كانت)، وهو لماذا يعطي الطبع المعقول هذه الظواهر بالضبط وهذا الطبع الامبيري ؟.
إن مفهوم العلية غير قابل لأي وصف تجربي، وهو ذاته مفهوم الحرية، والأخيرة هي فكرة ترسندالية محضة لا تتضمن بدء أي شيء مستمد من التجربة، فهي تتحرر من السبب، أي لا تخضع سببيتها لسبب آخر ولا إلى زمان. وعلى ذلك يتأسس مفهوم الحرية العملي ومن ثم الأخلاق .
لقد حدد (كانت) فعل العلية الحرة من خلال الأوامر الأخلاقية. فالعقل يمتلك حرية وعلّية بدلالة هذه الأوامر، فالوجوب الأخلاقي هو نوع من الضرورة هي غير تلك المتعلقة بالعلاقات الزمنية للطبيعة. فالشروط الطبيعية لا تتعلق بتعيين الإرادة نفسها، بل فقط بمعلولها ونتيجتها في الظاهرة مهما كانت الحوافز. ومن ثم فهناك فارق بين العقل الطبيعي وفعل الواجب الأخلاقي، استناداً إلى السببية الحتمية والحرية .
هكذا هو الجمع ما بين العلية الحرة والسببية الطبيعية، وان احداهما ليست في تنازع مع الأخرى . فالأولى تثبت بالقانون الأخلاقي، والثانية بقانون الطبيعة. وبوصف الانسان كائناً في ذاته فهو على علاقة بالقانون الأخلاقي، وبوصفه ظاهرة فله علاقة بقانون الطبيعة . وهذا هو التلاحم ما بين العقلين العملي والنظري. بل يقع على عاتق نقد العقل العملي وجوب توقيف العقل النظري أو المشروط تجربياً عن الادعاء بأنه وحده الذي يصلح لأن يكون مبدأ تعيين الإرادة .
ففي العقل العملي يبدأ السير المعرفي للنقد من المبادئ أولاً ثم إلى المفاهيم، ومن هذه إلى الحواس. في حين انه في العقل النظري يحصل العكس، أي يبدأ السير من الحواس فالمفاهيم ثم المبادئ .
النظرية والمفارقات
إن ربط (كانت) للشيء في ذاته بالعلية المتضمنة للإرادة الحرة يجعل القارئ لفلسفته يتأرجح وسط تأويلات شتى عن طبيعة هذا الشيء والغرض منه. فهو يضفي عليه صفات إلهية في القدرة والحرية ما يجعله أساس خلق عالم الظواهر وقوانينه الحتمية، رغم انه مجهول المعرفة والهوية. فهل كان غرض هذه المصادرة لأجل انقاذ النزعة الأخلاقية والدينية وفق التفكير البراجماتي فحسب؟ أم ان هناك مبررات إضافية جعلت فيلسوف بروسيا يبسط الحالة الانسانية على الوجود عامة؟ خاصة وهو يفترض انعدام السببية الحتمية لدى ذلك الشيء لارتباطها بالزمان، والأخير منعدم لكونه يمثل صورة ذاتية. لكن ما الدليل على كون السببية مرتبطة دائماً بالزمان؟ فالفلاسفة القدماء لا يربطون بينهما من حيث الحقيقة وفق ما يعبّرون عنه بالعلية. فالتصورات الفلسفية القديمة تعطي لمفهوم السببية أو العلية ما يجعلها تتعالى على الزمان والمكان ومع ذلك فانها تتصف بالحتمية لا الحرية..
ولا يخفي (كانت) ما قد يبدو لقارئ اطروحته في الحرية بأن ذلك هو ‹‹في غاية الحذلقة والغموض››. بل انه لم يبالِ من اعتبار تسليمه بالعلل المعقولة تبدو ‹‹مجرد خرافة››. فقد اعتبر ذلك لا يضير الفاهمة في شيء، ورأى بعدم ممانعة ان تجتمع العلية الحرة مع السببية الحتمية معاً من دون تناقض، حيث يمكن للطبع المعقول المتمثل في العلة الحرة الترسندالية ان يفسر وجود الظواهر وترابطها وفق قوانين السببية الصارمة. لكنه للتخفيف صرّح بأنه لا يهم لو أهملنا الطبع المعقول للشيء في ذاته باعتباره مجهولاً، فيكفي البحث في المسائل الامبيرية ووجوب تفسير الظواهر بموجب القوانين الطبيعية، لكوننا ننصاع إلى طبعها الامبيري المحض .
لقد لوّح (كانت) إلى ان حل مسألة إمكان الحرية جاء على خلفية الأدلة الديالكتيكية للعقل المتنازعة والتي لا تعطي نتيجة نهائية. فليس من حل سوى الحرية كأساس. واعتبر التضاد بين حرية الانسان وحتميته يمكن ان يتبدد عملياً. فالفرد ما ان يدخل في الفعل من الناحية العملية فانه سيختار مبادئه بموجب الغرض العملي فحسب. ورأى ان الاعتراف بواقعية الظواهر يقضي على كل حرية. لذلك فهو يجمع بين الحرية والطبيعة الحتمية .
هكذا صادر (كانت) الحرية من غير دليل، وهو يعي ان احساسنا بها قد يكون وهماً. فكل خيار ينتابنا هو نتاج فكرة أو خاطر، وان لتلك الفكرة أو الخاطر سبباً يدعونا للخيار كالذي أشار إليه الفلاسفة القدماء، فهم قد افترضوا عوامل سببية فاعلة وخفية تؤكد مضمون الترجيح بالمرجح الخفي، وبذلك تتحول القضية من معنى السببية ذات العلاقة بالغاية إلى معناها الصارم المنكر للقدرة وحرية الاختيار. وعليه أجاب بعض الفلاسفة المسلمين على مسألة ما يبدو من ترجيح الإنسان لبعض الأمور المتكافئة بدون مرجحات، مفترضاً ان هناك عوامل خفية تسبب الترجيح في نفس المختار من دون ان يشعر، كعوامل التأثيرات الخفية للأوضاع الفلكية والأمور العالية الإلهية . ولا شك ان دلالة مثل هذه التأثيرات (الخفية) ليس مجرد الترجيح للأمور المتكافئة؛ بقدر ما يكون لها من معنى دال على تسيير الإنسان وسلب الاختيار منه كلياً . وحتى الاشاعرة والمتصوفة اعتقدوا بمثل هذا الدور من التأثير الخفي الذي يمنع أي أثر ممكن لحرية الانسان، ومن ذلك ما عرضه الغزالي من مثال الكاغد والحبر والقلم للكشف عن الجبرية المسلطة على الانسان .
إن (كانت) يعي هذه القضية الجدلية، وقد أولاها أهمية ضمن جدله الترسندالي. فالحرية الترسندالية مضادة لقانون الطبيعة ولكل تجربة ممكنة، وانها تبقى تشكل معضلة قائمة. وعليه رأى انه لا ينفع مع الحرية الاثبات، اذ لا قيمة للدلالة في المزاعم الترسندالية. وهذا ما دعاه إلى التوضيح لا الاستدلال والاثبات؛ باعتبارها احدى القدرات التي تتضمن علة ظواهر العالم الحسي. فالاستدلال بهذا المعنى غير ممكن باعتباره ترسندالياً لا يشتغل إلا بالمفاهيم، وليس من الممكن الاستدلال على شيء من دون قوانين التجربة. فالحرية فكرة ترسندالية يبدأ بها العقل سلسلة الشروط في الظاهرة .
لقد جاءت مصادرة (كانت) للحرية انقاذاً للقانون الأخلاقي المتأسس عليها. فهي لم تخضع للدليل رغم ان الشيء في ذاته المفترض حراً قد أخضعه للدليل. مع هذا نقول ان من الممكن الاستدلال على الحرية تجريبياً، اذ يمكننا ان نمارس تجربة واعية تثبت لنا الإرادة المحضة عندما نريد ان نرفع اذرعتنا متى شئنا. فهذه التجربة الواعية على بساطتها كافية لاثبات ارادتنا المستقلة نسبياً. وبالتالي فالشيء المفارق وغير المشروط لا يمتنع ان يستدل عليه بشيء مشروط. فهناك صلات متعددة تربط بينهما، ومن ذلك صلة قانون السببية وعلاقة الأثر بالمؤثر، كذلك صلة المنطق الاحتمالي الذي يمتلك سببية من صنف آخر مختلف ينطبق على جميع مجالات المعرفة، كالذي بحثناه في دراسة مستقلة .
ونجد بهذا الصدد تشابهاً بين ما قدمه فيلسوف بروسيا وما وردنا عن المفهوم التقليدي للفلاسفة القدماء حول علاقة العلية بالعقل والزمان. فلو أننا نحينا جانباً فكرة الحرية، واعتبرنا ان نظام الطبيعة والكون والوجود هو نظام حتمي كما كان يراهن على ذلك الفلاسفة القدماء، فان الظواهر المتغيرة الكونية تصبح بحسب الفلاسفة القدماء هي نتاج العلية الثابتة للعقول المجردة، والتي تفعل من دون ان تنفعل ولا تخضع للزمان خلافاً للشروط السببية المعتبرة ضمن المعدات. فهذه الفكرة التي ركز عليها (كانت) انما تعود إلى الفلاسفة باستثناء ما اضفى على العلة العقلية صفة الإرادة الحرة، بل انه قد نسب إليهم القول بهذه الصفة. لذا فعلة الظواهر التي تحدّث عنها هذا الفيلسوف واعتبرها مجهولة بتمثلها في الشيء في ذاته؛ هي نفسها قد اعتبرها الفلاسفة معلومة وان لم تكن محسوسة، فهي ليست معروفة إلا للفلاسفة عبر استنتاجاتهم العقلية الخاصة، اذ تم تشخيصها بالعقول الفعالة التي تقف خلف جميع الظواهر الكونية والأفعال البشرية.
هكذا تمثلت محاولة (كانت) النقدية من خلال الجمع بين الحتمية والحرية لدى الشيء الواحد، مظهراً وجوهراً. فقد نظر إلى قوانين الطبيعة فرآها مضطردة حتمية، لكنه في الوقت ذاته نظر إلى تصرفات الانسان فرآها حرة إرادية. وكانت المهمة الملقاة على عاتقه هو الجمع بين هذين العالمين المختلفين ضمن كيان موحد، خلافاً للفلسفات الأخرى التي إما ان تفصل بينهما من خلال الاعتراف بأن للانسان حريته المستقلة عن عالم الطبيعة من دون أي روابط سببية تربط بينهما، أو انها لا تعترف إلا بخاصية واحدة هي الحتمية مع إنكار الحرية الانسانية.
وقد فات هذا الفيلسوف ان من الظواهر الكونية ما لا يخضع للحتمية، هذا بالاضافة إلى انه لم يقدم أي دليل يتعلق بهذه الحتمية أو باضطرادات الطبيعة، وهي من القضايا المتعلقة بمشكلة الاستقراء والتعميم كالتي تناولها ديفيد هيوم بالنقد والتحليل.
ونعتقد بأن (كانت) قد وقع في مفارقة مفضوحة، فمبدأ العلية هو نوع من السببية ويقوم بذات الفعل في إحداث الحدث، وبالتالي كيف يمكن اعتبار مبدأ السببية من المبادئ الذاتية فيما يكون مبدأ العلية من المبادئ الموضوعية؟ وما الذي يجعلنا نعتقد بهذا النوع من التمييز الجوهري، فأحدهما من حقل، والآخر من حقل مختلف؟
وبعبارة ثانية، ما الذي جعل هذا الفيلسوف يفكك بين نوعي السببية في علاقتهما بالعالمين بحسب القيود التنظيمية لهما؟ لماذا كان مبدأ السببية يتحكم في عالم الظواهر فيما تتحكم العلية في سلسلة تطبيقات هذا المبدأ بفعل إلوهية الشيء في ذاته؟
واذا كان للشيء لذاتنا أصل هو الشيء في ذاته؛ فما هو مصدر هذا الأخير؟ وهو لم يجد جواباً سوى مصادرته بأنه اعتبر الأشياء في ذاتها يمكن النظر إليها بوصفها تابعة من حيث وجودها لعلة اجنبية، وبالتالي لا يمكن تطبيقها على الظواهر كموضوعات ممكنة للتجربة .
كما نتساءل ما الدليل على وجود الشيء في ذاته؟ فكل ما نمتلكه هو عالم الشيء لذاتنا من الظواهر وقوانينها الصورية، وبحسب هذا الفيلسوف ان الظواهر ليست شيئاً في ذاته، لذلك تحتاج إلى تفسير يكشف عن سبب تولدها، وهو لم يجد غير ما وصفه بالشيء في ذاته، مع انه يعترف بأن سبب تصوراتنا كما هي يبقى مجهولاً، اذ لا يكون موضعاً للمعرفة طالما انه لا يخضع لاعتبارات الزمان والمكان لكونهما شرطين للتصور الحسي ومن دونهما ليس بوسعنا ان نفكر في أي حدس ممكن .
والعجيب ان (كانت) قد اعتمد على مبدأ السببية لاثبات هذا الشيء المجهول من دون تصريح، وكما قال: إن من الخُلف «أن يكون ثمة ظاهرة من دون ان يكون ثمة شيء ليظهر» .
فالمعنى واضح، وهو أن إثبات الشيء في ذاته قائم على مبدأ السببية الذي يضمن بأن الظاهرة لم تنشأ من العدم المحض، رغم أنه اعتبر السببية من المقولات الرابطة وليست من الحدوس الكاشفة. وانه لأجل ذلك اضطر – كما عرفنا - إلى الإقرار بأن للسببية صنفاً آخر هو ما يشكل صلة الوصل والعلية بين الشيء في ذاته والظاهرة الطبيعية، وهي مصادرة تضاف إلى كثرة مصادراته الفلسفية مع ما تتضمنه من مفارقة وتناقض.
ان هذه الظاهرة - وشروطها من الزمان والمكان - كما يتحدث عنها (كانت) لا تمثل واقعاً حقيقياً، بل إنها صورة ذهنية مصاغة وفق قبليات نسبية وذاتية ، وبالتالي كيف يمكن إثبات ما يقبع خلفها من واقع حقيقي كالشيء في ذاته مثلاً؟ فإثبات الأخير يتوقف على وجود الظاهرة (الذهنية) من خلال قضايانا القبلية، ومنها السببية، لكن هذه القضايا تظل نسبية وذاتية بحسب (كانت)، فكيف يتأسس عليها إثبات هذا الشيء؟ فإمكان التجربة الإدراكية يعتمد على المبادئ القبلية وعلى رأسها مبدأ السببية، رغم ان هذه القضايا رهينة للبعد الذاتي للإنسان، وقد صادرها (كانت) في الموضوعات الامبيرية. وبالتالي فهو لا يجد تبريراً منطقياً يدعم فكرة وجود الشيء في ذاته، ولا ما ينقذه من النزعة المثالية الخالصة، عند ربطه بين التصور والواقع الموضوعي رغم نقده لها ومحاولته اثبات الواقع الموضوعي طبقاً لاعتبارات الزمان وعلاقته بالجوهر الثابت، وهو لم يعلّق اثبات هذا الواقع على الشيء في ذاته؛ باعتباره مجهولاً حتى من جهة إن كان يوجد فينا أو خارجاً عنا، وما إذا كان يختفي باختفاء الحساسية أو يظل جانباً ، كالذي فصلنا الحديث عنه في دراسة مستقلة.
وليس هناك من تفسير معقول لنظرية (كانت) سوى انها إما ان تكون غارقة في المثالية، أو غارقة في المصادرات الميتافيزيقية، وأحلاهما مر. فأساس الربط بين العلية والسببية قائم على فعل الفاعل العقلي الحر، وهو محدد بطبع الشيء في ذاته. فالربط بينهما ليس له من تفسير سوى النزعة المثالية أو الميتافيزيقية، وذلك ان سبب وجود الظواهر وسلسلة الأسباب الحتمية له افتراضان: أحدهما ان يعود الوجود المذكور إلى فعل العقل البشري، وهو عين المثالية الصرفة، اذ يكون لهذا العقل طبعان: حر كما هو في ذاته، وامبيري كما هو في الظاهرة. لكن في جميع الأحوال إننا لا نتجاوز هنا الذات البشرية، حيث هي الحقل الذي يتوارد فيه الظواهر الحسية وهي من التصورات. أما الافتراض الآخر فهو ان الشيء في ذاته الحامل للطبع الحر هو عالم قائم بذاته ومستقل عن الذات البشرية، لكن في هذه الحالة إننا نفترض له خصائص حرة ومعالم أخلاقية هي التي تؤسس ما عليه الظواهر الطبيعية أو الصور المثالية الذاتية. وفي هذه الحالة سندخل عالم الميتافيزيقا من أوسع أبوابه. فكيف شاء لهذا الفيلسوف ان يمنع الميتافيزيقا وينكر إمكانية اثبات وجود الصانع نظرياً؟ مع انه يعطي للشيء في ذاته صفات هذا الصانع، من حيث استقلاله الموضوعي وعدم خضوعه للحس الامبيري ولا شروطه الزمانية والمكانية، وفوق كل ذلك فانه يتصف بالحرية التامة وكونه علة وجود الظواهر الطبيعية وسلسلتها الحتمية ضمن الشروط المكانية والزمانية من دون ان يكون هو ذاته داخلاَ ضمن هذه السلسلة الطبيعية. لذلك ما الفارق لو اننا اطلقنا على الشيء في ذاته بأنه المبدع الصانع أو الإله المتعالي غير المشروط؟
وبعبارة أخرى، إن من مفارقات هذه النظرية هي انها تمنع قيام علم للميتافيزيقا نظرياً، لكنها تزودنا بالأدوات القابلة لاقتحام هذا العالم عبر مبدأ السببية. فلهذا المبدأ صيغتان كما عرفنا، إحداهما مناطة بعالم الظواهر والأخرى تتعلق بالشيء في ذاته، وهو العالم الحر غير الخاضع لقوانين عالم الظواهر، لكنه يمثل علة وجود الأخير. وهذا كل ما يراد له من تأسيس علم الميتافيزيقا نظرياً. اذ يمكن ان نعبّر عن الشيء في ذاته بأنه الإله الصانع المتصف بالحرية وانه أساس وجود الظواهر وقوانينها الحتمية.
هكذا فنظرية (كانت) تتيح لنا ان نبسط ذراع مبدأ السببية على العالمين الفيزيقي والميتافيزيقي من دون موانع ذاتية، سواء كان لهذا المبدأ صيغة حتمية موحدة كالذي عوّل عليه الفلاسفة القدماء، أو كان له صيغتان حتمية وحرة كما هي اطروحة (كانت) التي خصصت الأولى لعالم الظواهر الفيزيقية، والثانية لعالم الشيء الميتافيزيقي. وفي جميع الأحوال ليس لدينا غير السببية مناط يربط الفيزيقا بالميتافيزيقا..
أما غرض (كانت) من مصادرة العلية الحرة فهو لأجل الدخول إلى العالم الميتافيزيقي من وجهة النظر الدينية. فلم يسعه ان يجعل العلاقات متوحدة ضمن السببية الحتمية كما هي رؤية الفلسفة التقليدية. فهو يعي ان ذلك يمنعه من تأسيس الدين عقلياً، اذ الأساس الذي يقوم عليه الدين هو الإرادة الإلهية المطلقة من دون ان يحدها حدود. وتُذكّر هذه النظرية بجماعة من قدماء المعتزلة والامامية الاثني عشرية الذين اعتبروا بأن لله القدرة على الخلق وايجاد الفعل، لكن لهذا الخلق والفعل مترتبات لزومية حتمية تتجاوز حدود القدرة ذاتها، فمثلاً ان الله قادر على خلق النار وفنائها، لكنه لو خلقها لكان من طبيعتها حتمية الاحراق إن لم توجد شروط مادية مانعة .
وبذلك نعرف ان محاولات هذا المفكر هي خليط مخطط نابع من التأثيرات الفلسفية والدينية، أو انه أراد ان يدعم رؤاه الدينية بمنطق فلسفي، فظهرت فلسفته مصطنعة متكلفة لا تمتلك المبررات الكافية لقيامها.. فقد وضع العديد من المصادرات الملائمة مع النزعة الدينية أو الأخلاقية مع اعترافه بأنها تفتقر إلى الأدلة النظرية، وأحياناً نجده ساكتاً عن بحث الأساس المتعلق بهذه المصادرات، مثل البحث عن أصل وجود الشيء في ذاته، وهو الذي وصفه بأوصاف إلهية.. ويزداد الأمر تعقيداً إذ انه تعمّد استخدام لغة صعبة للغاية، فالاستخدام المعقد للغة يلهي القارئ عن النقد ويجعله يبحث في مسالك الفهم التأويلي، فتكون غايته العظمى هي فهم الموضوع بدلاً من نقده وتحليله.
غريبة حقاً فلسفة (كانت) وأغرب ما فيها كثرة مفارقاتها وتناقضاتها..
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. -بيتزا المنسف-.. صيحة أردنية جديدة

.. تفاصيل حزمة المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل وأوكرانيا

.. سيلين ديون عن مرضها -لم أنتصر عليه بعد

.. معلومات عن الأسلحة التي ستقدمها واشنطن لكييف

.. غزة- إسرائيل: هل بات اجتياح رفح قريباً؟ • فرانس 24 / FRANCE
