الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
شام-الفصل الثاني
منير المجيد
(Monir Almajid)
2019 / 3 / 11
الادب والفن
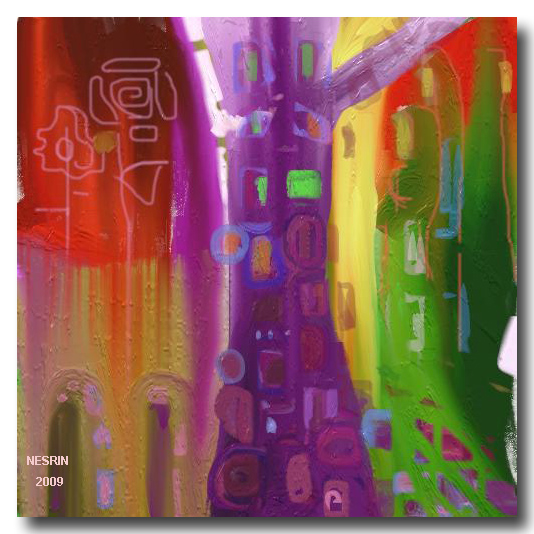
على صوت قرقعة الباص الصغير المليء بشبان خضعوا لماكينة حلاّق ثكنة هنانو، كنّا نتجه إلى مدرسة المُشاة، شمال مدينة حلب. بضع رجال ونساء كانوا يطلبون من السائق الوقوف ويغادرون الباص كلمّا اقتربنا من هدفنا.
كنت أراقب السهوب الشاسعة بمرتفعاتها المتواضعة والتي فيها أشجار الفستق الذي ينتمي بإسمه لحلب، من خلال النافذة الملوثة بآثار أصابع المسافرين وبقايا جثث حشرات عابثة لم تكن حذرة بما فيه الكفاية.
لم أشأ التحاور مع أحد، بل غصت في ذكريات رحلتي الأولى، تلك السنة التي التحقت بجامعة دمشق.
في الواقع، الآخرون أيضاً لم يكونوا في مزاج التحاور. كنّا متوجسين.
كم كنت ساذجاً وغبياً حينما رضخت لخطط العائلة الإستراتيجية ووافقت على أخذ فرشة ثقيلة يصعب التحكم بها، فها هي تهتز كقطعة جيلاتين عملاقة. مخدة أسطوانية طويلة داخل كيس أبيض أطرافه مخرمة كثياب النساء الداخلية، ولحاف مربع كبير بلونين. الأبيض يلتّف على الأزرق بمقدار عشر سنتيمترات وخُيّط حتى يصعب فكّه وغسيله. ومن ثمة حقيبة فيها بعض الثياب والكتب ولوازم مطبخ بسيطة.
لم أكن أعرف أن إيجاد غرفة مفروشة في دمشق أسهل بكثير من واحدة فارغة. إلا أن العائلة عرفت حينذاك، من مصادر ما، أن الغرف أو الشقق المفروشة باهظة الإيجار.
بعد أن حُمّلت كل هذه الأشياء على سطح الباص، مع عتاد وأشياء صبحي وبقية المسافرين الآخرين، بالإضافة إلى عنزة قاومت بشدة فكرة ربط أقدامها وتغطيتها، ثم شدّ هذه الهضبة التي شكّلها عمال الكراج بكل حرفية، رامين طرف الحبل من جهة لاخرى.
خرخر الباص مرتين، ثم أصدر صوت حشرجة كبيرة، وبدأ بالتحرك بينما كنّا، صبحي وأنا نُلوّح لأفراد العائلة.
كانت الساعة تُشارف على العاشرة مساءً حينما اجتاز باصنا شوارع الحسكة الخالية من الناس. عواميد الكهرباء النحيلة كانت تبعث بضؤها الباهت الضعيف.
ربما أوقظ الباص الناس النيّام بصوت محرّك الديزل الذي يعود إلى الأربعينات، أو قد يكونوا، بفعل العادة والإعتياد، يغطّون في نوم عميق.
بعد الحسكة مباشرة تبدأ بادية تمتد إلى دير الزور. لم يسنح لي الظلام من رؤيتها تلك الليلة، لكنني فوجئت بقبحها الشديد فيما بعد، حينما اجتزتها مرات عديدة.
والبادية برمالها ونباتاتها الشوكية القليلة تستمر بعد دير الزور مروراً بالرقة وحتى مشارف حلب. فقط أطراف نهري الخابور والفرات تبقى مُخضّرة بما تمتصه من رطوبة المياه.
هكذا كانت منذ آلاف السنين.
سرعان ما غطّ بالنوم الذين كانوا قد تحضّروا جيداً لهذه الرحلة ولفّوا أنفسهم بعباءات سوداء لها فرو خرفان، وسمعنا أصوات شخيرهم.
إستراحات دير الزور والرقّة لم تفتح شهية إلّا عدد قليل جداً من الركاب المنهكين والمقتولين بالبرد.
وحده السائق كان يجلس على كرسي مهترئ قرب طاولة مهترئة، وثمة رجل يُقدم له مشاوي فاحت رائحتها اللذيذة، وُضعت في صحن كان أبيض اللون فيما مضى وغُطيت بخبز مرقّد.
وصلنا في ساعة مبكرّة إلى كراج حلب الصاخب والحيوي، مستنفدين من قلّة النوم. وبسرعة رُتّبت أمور نقل حاجياتنا إلي باص دمشق، الذي ظل رجل ينادي بصوتٍ عالٍ لمدة ساعتين «راكب واحد إلى الشام»، رغم توافد الركّاب الذي لم ينقطع.
مدّة إنتظار إكتمال نصاب المسافرين قد تمتدّ إلى ساعات مرهقة. البديل هو السفر بسيّارة «ديزوتو»، لكن كيف، بحق السماء، يُمكن نقل هذا الأمتعة الثقيلة؟
في كل الأحوال لم تكن الديزوتو مريحة أيضاً، فالسائق كان، حسب مزاجه، يدفع بركاب إضافيين ويُحمّل سيارته بما لا تستوعبه.
كان الوقت يقترب من الظهيرة حينما اكتمل عدد الركّاب، فتحرّك الباص أخيراً شاقّاً طريقه بين الحافلات الاخرى، عربات تجرّها الحمير، ومشاة لم يأبهوا كثيراً للباص المُحمّل على نحو كبير، وفي كل مرة يتمايل نحو اليمين أو اليسار، كنّا نسمع صوتاً يشبه احتكاك الصفائح المعدنية.
المشهد في الخارج كان مريحاً أكثر من مشاهد باص القامشلي-حلب.
هنا قرى ليست ببؤس بادية الجزيرة.
توضحّت الفكرة تماماً، حين توقفنا في معرة النعمان. رائحة الشواء دفعتنا إلى تناول السندويش. وحينما تبولنا في العراء خلف المبنى الطيني، سمعنا صوت تشغيل محرك الباص، فركضنا للحاق به.
مررنا بحماة وحمص، وأثارتنا، لسبب ما، شارة «الرستن».
في استراحة النبك، أُعدنا طقساً مشابهاً.
(الفصل الثاني من رواية «شام»)
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. الفنان الراحل صلاح السعدنى.. تاريخ طويل من الإبداع

.. سر اختفاء صلاح السعدني عن الوسط الفني قبل رحيله.. ووصيته الأ

.. ابن عم الفنان الراحل صلاح السعدني يروي كواليس حياة السعدني ف

.. وداعا صلاح السعدنى.. الفنانون فى صدمه وابنه يتلقى العزاء على

.. انهيار ودموع أحمد السعدني ومنى زكى ووفاء عامر فى جنازة الفنا
