الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
قصة قصيرة / أكاماكو
غانم عمران المعموري
2020 / 7 / 4الادب والفن
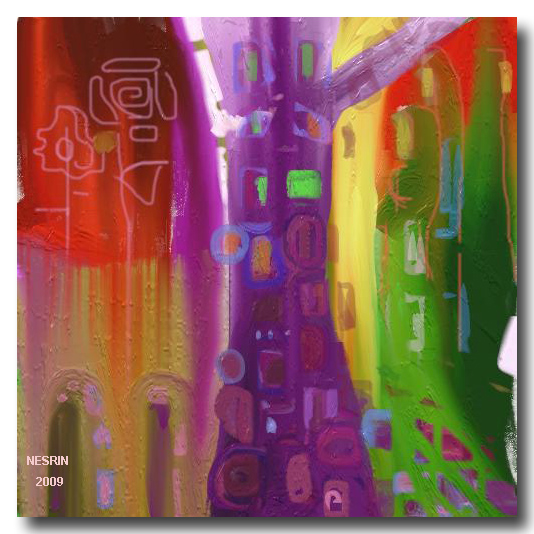
هَبَت رياح صفراء مُحملة بالأتربة في عصر ذلك اليوم مِن شتاءٍ قارص يُصاحبها الغبار لم يشهدها البلد منذ سنين سابقة ربما كانت السماء قد رمت جُلَّ غضبها على أهلِ الأرض لكثرة الظلم والفساد في البر والبحر وما آلت إليه نفوس البشر من حُب القتل والإعتداء والحصول على المكاسب والغنائم, كُنا نجلس مكتوفي الأيدي صفاً صفاً مُقيدين بخُرّقٍ من أقمشةٍ قديمة إلى الخلف والأترب تعلو الوجوه وتلتصق مع الطين والدخان على الملابس فإذا نظرتَ إلينا كأننا ليسوا من العربِ وإنما من أقوامٍ جاءت مع الريح أو أن الأرْض قد لفظتهم من باطنها, لا تسألني يا أخي القارىء ما اسم هذه المعركة ومن هم الأطراف فيها ومن الخاسر الوحيد فيها وما هي الأرْض التي حصلت فيها حيث إن حطام الأبنية وألسن النيران كما يقول المثل قد حرقت اليابس والأخضر وصراخ ذلك الطفل الصغير المعصوب الرأس على والده المُقيد في وسطنا وبكاءه ومحاولته القفز على الأسلاكِ الشائكة التي تم وضعها لتفصل بيننا وبين الأطفال والنساء وبين الأرض الملتهبة قد سَلب لُبَّ عقلي وأنساني في تلك اللحظة بالذات من أنا ! ومن هؤلاء ! ومن نحن ! وهل كل الذي أراه أمام عيني حقيقة أم خيال؟ بَقيتُ فترة طويلة وأنا مُقيد يجول نظري في الوجوه التي يحتك جسدها بجسدي ويختلط أنينها بأنيني, نتشابه إلى حد كبير فكلانا يتنفس ذات الأتربة وكلانا يتلقى ذات الإهانات وكلانا يفكر ماذا يحل بنا بعد هذه السويعات, هل هو القتل؟ قد يكون القتل أرحم ؟ التعذيب, إن التعذيب من البديهيات؟ يا موسى هل يقدموا لك الورود وهم ينظرون لكم كمجرمين ؟ عندما ضجت السماء بالدخان عاد صوت الطفل ذو التسعة سنين يبكي ويُريد اجتياز الأسلاك, نَهَرهٌ أحد المُسلحين وطلب منه العوده إلى أحضان النّساء, سمعتُ من أحد الجالسين قُربي بأن أُمه قد توفت ولم يبقى له بهذه الدنيا غير أبيه المُقيد الذي ينتظر مصير مجهول, تعالى صوت الطفل بالبكاء بنشيج حزين, فرْت دمعة من عيني تخيلت ساعتها ابني بدلاً من ذلك الطفل دون أب وأم ..كيف له أن يكمل حياته ؟ وهل يستطع الصبر وهو بعيداً عن والده الذي بقي له في هذه الدنيا, تعالت الأصوت من العَسكرِ بالإهانات والوعيد والخطابات الغير منتجة, استمر الحال ساعات معدودة حتى أُمرنا أن نصطف الواحد تلو الآخر ونحن مُقيدين على أن نُمسك بأسنانا ثوب الذي يكون أمامنا من الظهر بعد إن وضعوا العِصابة على أعيوننا , إنحجبت الرؤيا عني تماماً لا أرى إلا القليل, صور مشوهه لا أستطيع تمييزها بحيث لا أعرف من يتقدمي ومن خلفي, حتى تم دفعنا في سيارة نوع إفا عسكرية تحمل أرقام إنكليزية على مايبدو لا أعرف أهي روسية الصنع أم أمريكية أم ألمانية, سمعت من أبي رحمه الله – الذي استشهد في الحرب العراقية الإيرانية عام 1984– يقول بأن أكثر السيارات العسكرية نوع إفا هي ألمانية الصنع, سارت بنا العجلة ونحن في قعرها وفوق رؤوسنا مسلحين يتلفظون بكلماتٍ نابية, سبّ, قذف ولعن, امتلأ أنفي بالغبار وجسدي يرتجف من حركة السيارة على طريقٍ مُتعرج إلا إن كثرة العدد الذي يحيط بي يجعل وقوعي على الجهةِ الأُخرى مُحال, نصف ساعة توقفت العجلة وكان الليل قد خَيّم, أنوار المصابيح الكبيرة يخترق قطعة القماش التي تُعصب عيني, بدأ أحد الجنود يدفعنا واحداً عُقب آخر لا يأبى بأية عواقب, إن جُرح أو كُسرت أضلاع جَسد أي شخص فلا يُحاسب على ذلك, أصبحنا أكوام بشرية, انهالوا علينا بالضرب بالعصي والأسلاك وركل بالأقدام حتى تم سحلنا إلى قاعة كبيرة دون أفرشة, تلك الليلة كانت شديدة البرودة, الجوع, العطش يقبض على أحشائنا, رغبت التبول التي لا نستطيع كبحها جعلت كلٌ منا في حالة هيجان لكن الخوف والرعب خفف منها, رُفعت قطعة القماش من أعيوننا, كلٌ منا ينظر يميناً ويساراً إلى الخلف والأمام يتفقد أخاً له أو أب أو ابن أو قريب أو صديق, وعند الاطمئنان نكتفي بهزّ الرأس, ساعة مرّتْ بين القلق والحيرة والارتباك حتى دخل أحدهم ببزته العسكرية يحصر رأسه بقبعةٍ حمراء ويضع مسدس في خِصره وهو يحمل قناني ماء قام برميها صوبنا, أحسسنا بنوع من راحة البال بعدما رشفنا القليل من الماء, الكثير منا تبول في قنينة الماء الفارغة للترويح عن نفسه, ليلة قضيناها وكأنها دهراً كاملاً كل لحظة يتم سحب أحدنا, منهم من يتم ارجاعه وآخرين لا نعرف مصيرهم, هَمستُ إلى شقيقي وسألته عن صحته وكيف قضى وقته الذي مضى هزّ رأسه قائلاً: لا تسألني يا أخي كل شيء تحطم واحترق البيوت والأشجار أصدقائنا وأخوننا قد قُتلوا, نكس رأسه نحن لا نعرف ماذا يفعلون بنا في الصباح وقد لا أكون بجانبك إعتني بنفسك, صحونا فجراً على صوتِ الشتائم واللعن من قبل الحرس, ارتبكنا خوفاً وأصبحنا كالأغنام عندما يدخل عليها الجزّار ليختار واحدة منها للذبح, كل واحد منا ينتظر مصيره المجهول, فكلما نظرت حولي, أحسست بأن كل الذي أراه مجرد صورة تتقلب أمامي وليس حقيقة رغم مرور ساعات طويلة على اعتقالي وإني أعيش شعور بأني أنا لا يشبهني أنا الذي أعرفه سابقاً, وإنما صورة كلصور الأخرى الذي أراها أمامي تتحرك وتتقلب بيد من يُمسك بألبوم الصورة فليس لصاحب الصورة أن يعترض إذا مزقها ورماها في سلةِ القاذورات, أختفت كل الأحاسيس وأصبحنا نتحرك دون شعور, دخل عسكري ينظر في الوجوه يتفقد أحد أو له من بين المعتقلين صديق أو قريب لكنه يخشى الكلام من مسؤوله الأعلى, تكلم بصوتٍ حزين قائلاً : فليخرج كل خمسة أشخاص إلى الخلاء للاستنجاء, تسلل لنا نوع من الاطمئنان وتخيلنا لحظة حديثه إن كل الحراس على شاكلته, خرجوا, دقائق عادوا والخوف والامتعاض يُخيّم عليهم كنت أنا من ضمن الخمسة الآخرين, تم اقتيادنا على ممر مبلط ضيق يلتصق مع طول القاعة وخلفنا حارس يحمل بندقية نوع كلاشنكوف وأمامنا أيضاً حارس وحارسين آخرين يسيرون معنا, نظرت إلى نورِ النهار الذي ظننت بأني لم أشاهده أبداً ونسمات الهواء البارد تلسعني وتصفع خدي, كنت ثالث شخص في المسير أنتظر دوري في الدخول إلى الخلاء لقضاء حاجتي, بابٍان من خشبٍ مثقوب من عدةِ جهات, كان أحد الحراس عند دخول أحدنا يحسب له إلى العشرة وبسرعة ومن ثم يركل الباب بقدمه بقوةٍ ويخرجه حتى لو لم يكن قد قضى حاجته, تَنْمّلَ جسدي وتمنيت أن لا أخرج مع المتبولين وأفعلها في قنينة الماء كما فعلتها في اللية الماضية دون إهانة أو ضرب, وصل دوري ركضت بسرعة وقمت بافراغ البول وأسمع الحارس قد ذكر: ستة سبعة ثمانية تسعة ..وقبل أن ينطق ..عشرة فتحت الباب وخرجت وبقايا قطرات البول على بنطالِ حتى تجاوزتُ الإهانة, لم ينتهي التحقيق بهذا القدر من التعذيب وإنما تم إيداعي مع تسعة أشخاص في الخلاء وهي بطول أثنان بواحدٍ وسط رائحة كريهة, كنت أقف على أطرافِ أصابعي يلتصق صدري بصاحبي وكذلك ظهري, أتنفس زفيره ويتنفس زفيري وكأننا في زجاجة ماء قد أُحكم سدادها, أحسستُ بضربات قلبه التي تُحاور دقاتُ قلبي دون أي كلام, كنت أحاول أن أترجم ما تقوله دقات قلبه المتسارعة ربما كانت تتشابه إلى حدٍ معين مع ما تُريد أن تقوله دقات قلبي ما دُمنا جميعاً في نفْس المكان إلا أنا كنتُ في قنينة الماء الفارغة التي ينتهي عٌنقها بسدادٍ, حاولت التزحلق على جدارها الأملس لكني سُرعان ما سقطت لايوجد أي نتوء أو شيء خَشن حتى أستطيع التَمسك به لكي أصل إلى فوهة القنينة, بدأتُ أصرخ بأعلى صوتي .. لا مُجيب فكلما أحسستُ بضيقٍ في التنَفس ازداد ضجيجي بالضرب على جدران الزجاجة بقوةٍ .. لا أحد يسمع, كنت أنظر إلى ذلك الرجل الكبير وهو يلهث ويفتح أزرار قميصه ولم يساعده أحد فإن كل الملتصقين به في حالة غثيان, حزنتُ عليه كثيراً شاب آخر يتقيء بشدةٍ, وضعتُ يدي على رأسه لكن جدار القنينة الزجاجية أعاقني, ضربتُ يداً بيد, أما الثالث أراه يُمزقُ قميصه ويضرب باب الخلاء بقوةٍ ويصرخ بصوتٍ لا أسمع ما يقول ولكني أرى تعابير وجههُ وفمهُ يخرج لُعاب سائل .. حاولتُ دفع الزجاجة لكن وقعت في قعرِها, حركتُ يدي أمام عينيه وضربتُ على جدار الزجاجة بقوةٍ لكن لم ينتبه إلي حتى الرجل الكبير الذي يلتصق ظهرهُ بجدار الزجاجة لم يسمع صوتي والضَجّةُ التي أحدثتها داخل القنينة, فكرتُ بأن أُمزق قميصي وأصنع منه حبلاً حتى أتسلق الزجاجة وأصل إلى سَدادِها لكن الرجل الطويل ذو الثوب الأبيض رجع يقترب مني شيئاً فشيئاً, فرحتُ كثيراً, رأسه يصل إلى عُنقِ الزجاجة ويديه جبارتين, بضربةٍ واحدةٍ يُهشم جُدار الزجاجة, نظر ليّ وكأنه يقول ليّ ماذا تُريد الخروج من هذه الزجاجة الصغيرة جداً التي تخشاها ولا تستطيع الخروج منها أم ماذا ؟ قلتُ له : إن رفعت سداد الزجاجة أو هشمتها خُذنيّ معك .. ما أجمل اللحاق بك عندما أتعذب بين جدران هذه القنينة, تركني وذهب, رأيتُ التسعة الآخرين خارج الزجاجة يتوسلون به ويبكون ويصرخون .. تَرَكنا جميعاً دون جدوى لا أستطيع الخروج من تلك القنينة اللعينة, حاولتُ دفعها بيدي لكي تسقط وتتهشم .. ولكن يا موسى سوف تسقط عليهم .. لا يارجل .. حاول مرة .. أثنان .. ثلاثة حتى تستطيع الخروج من عُنق الزجاجة, انتشر الضباب حول جدران الزجاجة, فركتُ عيني بباطنِ يدي .. لا أرى أي شيء حولي فقد اختفى الرجل الكبير والتسعة أشخاص المحجوزين معي, صرختُ بكل قوتي .. يا حارس يا حارس سوف أموت .. ! يا موسى ألم تسمع صاحبك يُنادي على الموت فلا يسمعه .. تركتُ الصياح وبدأت أهرول خلف الرجلٌ الذي يرتدي ثُوباً أبيضاً عرفتُ بأنه الموت الذي لاذ بالفرار عندما سمع صوتي .. كلما اقترب منه يتركني ويذهب إلا أني رأيته يبتسم للرجل الكبير ويقترب منه, حَسدته وصرختُ وأنا أضرب الجدار .. أنا هنا .. هنا , لم يلتفتْ ليّ, سمعتُ نَقرٌ على جدار الزجاجة بطرقاتٍ قوية حتى تفطرت من كل مكان حتى ضننتها شجرة الخريف بفروعٍ كثيرة كانت تلك الشجرة جرداء خالية من أي حياة حاولت التمسك بأحدِ فروعها, قفزت إلى الأعلى وسقطتُ على رأسي, بصيص من نور تخلل عيني, أحسستُ بثقلِ رأسي الذي كان في حِضن أحد المُعتقلين وهو يُردد .. الحمد لله أنت بخير فقد أربكتنا يا موسى, كان الرجلُ الكبير السن يحاول الجلوس لعدم قدرته بالوقوف فترة طويلة, جَلس لكن صدره بدأ في ضيق بالتنفس وكأن الخلاء قد فرغت من أي نسمة هواء حتى ثاني أوكسيد الكانون قد انتهى, وبصعوبة جداً حشَرتُ نفسي بينهم, حتى أتمكن من مساعدته كان يتنفس من فمه والعَرق يتصبب من جبينه , فتحتُ أزرار قميصه وقمت بتحريك يدي بسرعه أمام وجهه لجلب الهواء, لكنه أُغميّ عليه, صفعتُ خده حتى يعود إلى وعيه, سَبْلَ عينيه, هَززتُ كتفه, استنشق بقوة وزفر, نظرت إلى سقف الخلاء بدأت تُقطر ماءً علينا وكأن غيوم قد تشكلت من الغازات المنبعثة من أجسادنا, سمعت أحدنا يقول : اريد الموت ..
أريد أموت ..فأجبته : لا ياصاح .. الموت لا يأتي لمن يشتهيه وإنما يأتي عندما نكون متمسكين بالحياة بأسنانا ..
نظرت إلى أرجاء الخلاء بمتريها فقد تشكلت طبقة من البخار وكأن الشحوم في أجسادنا قد احترقت رغم برودة الطقس في خارج الخلاء, الرجل الكبير لم يستطعْ السيطرة على نفسِه, تغوط وتبول على ملابسه, اختلطت رائحة أجسادنا مع رائحة الغائط حتى أحسست بأني سوف يُغمى عليَّ لكني تحركة قليلاً إلى فتحت الشُباك الصغير لألتقط نسائم الهواء التي تأبى الدخول إلى داخل الخلاء حاولتُ أن أعيش لحظات كأني خارج حدود جدران الخلاء لكن الروح والجسد لاينفصلان أبداً ولا يمكن لجسد أن يتعذب به والروح خارج اطار الجسد فالعذاب أصلاً للروح .. كرر صاحبي النداء على الموت قائلاً : يا موت خُذني من هذه الحياة, لكنه لا يسمعه أبداً ما دام يُناديه حتى فقد وعيه وتبعه الآخر ثم الآخر, تعالت الأصوات ولكن السجان لايرد, تلمستُ ملابسي كانت مُبلله تماماً وكأني تحت شلال ماء وسقف الخلاء لا زال يُقطر الماء الذي تبخر من أجسادنا, تلمستُ باب الخلاء كانت مُقفلة, نظرتُ في الوجوه كانت صامت مع أنين موجع, تبادلنا الأدوار منا من يجلس والآخرين وقوف وبالعكس, فقد جسدي كل السوائل وأصبحت أصابع يدي كالغريق قطعة بيضاء كقشور السمك, لايوجد في الخلاء سوى فتحة صغيرة في الأعلى, نظرتُ من خلالها كان الحارس يحتسي الشاي وهو يمزح مع صديقة لا يأبى بمن هو داخل الخلاء يتعذب وينادي بألم .. استمر الرجل الكبير بالصراخ : أرجوكم أنا أختنق, تسللت بصعوبة أرفع قدم وأضعها ببطء أتحاشا وقوعي على أجسادهم, كان العَرق ينزّ من جبهته وكأنه يستجدي الهواء فلا يجده شاحب أصفر الوجه, طوقت عيناه هالة سوداء طَلبتُ من يُساعدني كان بجانبي شاب بدأنا بتهويته عن طريق الأيدي, شهق بقوة وسقط رأسه بحضني مغمى عليه واللعاب يسيل من جهتي فمه, صرخت بأعلى صوتي وتظافرت معي الأصوات : أرجوكم مات الرجل الكبير افتحوا الباب, رد الحارس من خلف الباب : إلى جهنم, استغربتُ من كلامه هل هذا إنسان بمشاعر واحاسيس مثلنا أم من خُلق خاص, تعالت الأصوات من داخل الخلاء مما اضطر الحارس فتح الباب وطلب منا إخراج الرجل الكبير الذي فارق الحياة, سجلوا بالمحضر .. الوفاة قضاء وقدر وكأن شيء لم يكن, أما حقوق الإنسان التي خصصت لها آلاف المجلدات والكتب وتحدث عنها المتفلسفون وشرعتها الدول في قوانين فقد تيقنتُ بأنها حبراً على ورق فقط مجرد دعايات انتخابية أو لتقاضي مبالغ طائلة عنها تحت مسمى حقوق الإنسان, فحقوق الإنسان لم تدخل معك في غرفِ التعذيب وانتزاع أقوالك بالقوة والضرب والتعذيب وعندما تُسلب حُريتك في التعبير والرأي فما قيمة تلك الحقوق, نظرت إلى جدرانِ السجن حروف وأسماء وعبارات منها مفهومة فأحدهم ربما ترك حبيبته نجلاء فأراد أن ينقش اسمها على جدران الزنزانة لكي يحدثها في كل وقت وآخر يناجي أمه ويكتب أمي قطعة من كبدي وآخر يكتب السجن مقبرة الأحياء وحروف وقلب الحب يقطر دماً من أثر سهام أحد العُشاق وآخر قد رسم صورة طفلة بجدائل طويلة, وأحدهم كتبَ شعراً لمظفر النواب* :
مرة أخرى على شباكنا تبكي
ولا شيء سوى الريح
وحبات من الثلج على القلب
وحزن مثل أسواق العراق
مرة أخرى أمد القلب بالقرب من نهر الزقاق
... يا إلهي رغبة أخرى إذا وافقت
أن تغفر لي بعدي أمي
والشجيرات التي لم أسقها منذ سنين
وثيابي
فقد غيرتها أمس بثوب دون أزرار حزين.
نظرت إلى أرضية السجن تبسمت مع أمل بدأ يُحلق بجناحين ورديتين عندما تذكرت قصة هروب عمي من ذات السجن الذي أقبعُ فيه, كنت صغيراً أصغي له مع أخوتي بكل حواسي, تصورته بطلاً مغامراً كالسندباد وعلي بابا في المسلسل الكارتوني أو طرزان عندما يتصارع مع النمور, كان عمي فلاحاً بسيطاً لايعرف القراءة والكتاب ولا يعرف إن كان الحكم ملكي أم جمهوري ولكنه كان يرفض ظلم الاقطاعيين الذين كانوا يمارسون سلطة الاستغلال وابتزاز الفلاحين وأخذ محاصيلهم الزراعية ولايعطونهم إلا اليسير بحجة ملكيتهم لتلك الأراضي والتي تملكوها عن طريق عَمالتهم وخيانتهم للوطن وسمسرتهم مع الأجانب, خيّم الليل بهوجسه المخيفة والأفكار السوداوية تَنبشُ عَقلي, وطُّ الخُفاش الصغير وهو يرتطم في نافذة القاعة أدخلني في عالم الأفلام المُرعبة ومصاصي الدماء, حاولت اخفاء رأسي تحت الوسادة إلا إن صرير الجُرذان الجماعي عند الإنقضاض على عُلبة اللبن المركونه تحت الأسِره مُرعب جداً بأعدادها المهولة تخيلتها وكأنها تسحب نزيلاً من قدميه وتخرجه من النافذه الصغيرة والبقية ينظرون إليَّ وبأيديهم فؤوس وسكاكين حادة ربما أكون وليمة كبيرة لهم ليوم واحد فهم قبائل كبيرة جداً كنت أشاهدها يومياً خلف جدار القاعة المُحاطة بسياج عالٍ من الطابوق متجمعة بأعداد تَسد عين الشمس كما يُقال وهي تسرح وتمرح وتجتاز بسهولة ذلك السياج اللعين الذي يفصلني عن العالم الخارجي عالم الحياة, ذلك الكائن الذي طالما احتقرته كان حُراً طليقاً يتحرك ويتسور الجدران دون رقابة أو خوف من حارس يحمل سلاح على كتفه, أما أنت تعجز أن تكون مثل ذلك الجُرذ إلا أن نزعة الخوف والإشمئزار من الجرذان تحولت إلى حنان وتعاطف عندما تخيلت نفسي في الفيلم الكارتوني الأمريكي (الفأر الطباخ) وهو يُعلمني أفضل الأكلات حتى أصبحتُ أفضل طاهي في العالم, تبسمتُ عندما شاهدت مجموعة من الفئران تسحب قطعة من الدجاج المقلي وتلّوذ بالفرار, بعد أشهر حضر الطفل المعصوب الرأس مع مجموعة من المواجهين يتفقد أبيه من بين النُزلاء إلا أن مدير السجن قدم له قرار براءة والده (الرجل الكبير) مع شهادة وفاته ...أكتفى بكلمة: نحن نعتذر لما حصل لأبيك.
العراق
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. الحكي سوري- رحلة شاب من سجون سوريا إلى صالات السينما الفرنسي

.. تضارب بين الرواية الإيرانية والسردية الأمريكية بشأن الهجوم ع

.. تكريم إلهام شاهين في مهرجان هوليود للفيلم العربي

.. رسميًا.. طرح فيلم السرب فى دور العرض يوم 1 مايو المقبل

.. كل الزوايا - -شرق 12- فيلم مصري يشارك في مسابقة أسبوع المخرج
