الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
في يوم عيد
أحمد جدعان الشايب
2021 / 7 / 8الادب والفن
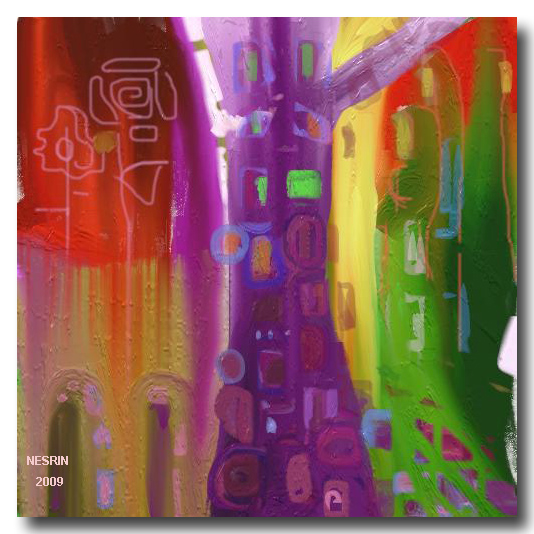
الفجر في ذلك اليوم غناء سرمدي، والكون هادئ، ينفذ في ردائه النقي ترانيم تكبيرات العيد، تستقبلها الأذن فتسري في عمق الروح لتريحها، كأن من يسمعها يرى الله بجماله وروعته في كل أشياء الكون، إنها مناسبة لها مذاق خاص نما في وجداننا، فصار له سحره وهيبته وقرحته.
أحسست بلساني يردد التكبير مع المكبرين، تلفت حولي، كانت أمي تنهي صلاتها وتختمها بدعوات لي ولإخوتي.
ما يزال النسيم يحمل شيئا من البرودة، وتحولات الطبيعة من الشتاء إلى الربيع، توحي للمرء بأن المرض والصقيع ولى، وبدأت تنتشر دفقات من الدفء المحبب، لقد سئم الناس الكمون خلف الجدران الطينية، وتاقت نفوسهم للانطلاق وللحرية.
أصوات جوقة المنشدين المكبرين يأتينا متماوجا، يتأرجح تبعا لاتجاه النسائم، أيقظتنا أمي وحيتنا بتحية العيد، وأعطت كل واحد عيديته بعض النقود القليلة، ثم داعبتنا قائلة:
( يا لله يا شباب.. واحد منكم سيأخذ البقرات إلى الوادي ويعود إلى عيده).
نظرنا إلى بعضنا، عيناها تستكشف دهشتنا وعلامات التذمر على وجوهنا واحدا فواحدا، استقرت علي أخيرا، فهي تعرفني بالتجرية، أكثرهم طاعة لأوامرها، وتعرف أني رغم صغر السن، أحس بحاجتها لطاعتنا وأنها تستحق الطاعة، قالت مشجعة:
( ما عندي غيرك شاطر).
بصري قاصر عن سبر المجهول في عمق المساحات، يبحث فيما حولي في اللحظة الآنيَّة، خطواتي بطيئة، جفوني تعركها ظهور أصابعي، جسدي نحيل شاحب في داخل كيس متسع مفتوح الصدر، مثل كل أطفال القرية، مررت على رفاقي ورفيقاتي، ساقوا بقراتهم أيضا حتى ابتعدنا عن البيوت، تنبسط الطبيعة حولنا كسجادة خضراء، ممتدة ومطرزة بألوان الأزهار البرية في جوانبها، وأنفاس الأرض تنبعث من بين سنابل القمح الغضة كأبخرة الموالد، بيضاء ما تكاد ترتفع عن السطح قليلا حتى تبدو في اتساع الفضاء، وتسللت شعاعات الشمس متناثرة مستقيمة، فتحولت النسمة التي توشح الوجه إلى دفء راح يسري في كل أعضاء الجسد.
صرنا نجري ونلهو ونقفز بمرح، والبقرات أمامنا هادئة على مهل، والعجول الصغيرة تلهو مثلنا وتعدو، لكن التراب المبتل بالندى صار طينا علق بأحذيتنا حتى صارت ثقيلة وكبيرة، واتسخت ثياب العيد وتلطخت ببقع بنية.
فجأة شد نظري أمام البهائم شيء غريب، لم أسمع به ولم أره من قبل، تلعثمت وتلفظت ببعض الكلمات المتعثرة، وأشرت لرفاقي نحو الأمام بدهشة.
كان على مسافة ليست بعيدة، أمام البهائم، شيء يشبه الخيام الرمادية المتلاصقة، تمتد على طول الأفق أمام العين، وترتفع رؤوسها أمتارا عدة، وهي تخفق، تنهض وتنحني، كأنها خيام هبت فيها عاصفة، لكنها لا تلامس الأرض وليس لها صوت. للحظات قليلة خفنا، وتساءلنا، ثم سرت بيننا صياح وبلبلة، تحولت إلى لعب وعبث وضحك.
أخذنا نضرب البهائم لتمشي وتسرع لنلحق بالخيام، لكننا لم ننتظر ، نفذنا من بينها وركضنا بعصيّنا الصغيرة، نلوح بها ونضرب الهواء، مشى أمامنا كأنه مجموعة خيام من خيش، أو قافلة من الجمال تهتز اهتزازا بطيئا، تذكرت الجمال التي تأتي إلى قريتنا لتحمل الغلال والتبن، ونحن نغني لها أغنية تعلمناها، ولكي نسلي بعضنا بدأنا نغني:
يا جمال السارحة........سلمي على صالحة
صالحة تحب النبي......هربت في حضنها صبي
خبته في البرية........ أنا شفتها البارحة
قال واحد منا:
( هذه جمال تائهة شاردة).
وقال آخر:
( لالا إنها خيام الغجر).
فقلت لهم:
( سنلحق بها إلى أن نمسك بها.. ونعرف ماهي).
كان حوارنا مبتورا، والرموز مجهولة، ومفاهيم خاطئة تتكون لدى الصغير والكبير أمام مشهد غريب، كأنه لغز، لكننا يومها لم نره لغزا، كنا نراه شيئا من الحقيقة أو من الواقع، رغم علمنا أنه ليس قطيعا من الجمال، ولا هو خيام الغجر. هو شيء يشبه هذا وذاك، لكنه هلامي يكاد يتفتت ويذوب.
مشت رفيقاتنا البنات خلف البهائم، بينما نحن الذكور رحنا نعدو ونتبع الخيام، فإن أسرعنا سبقتنا، وإذا تباطأنا تمهلت، وما تزال تهتز وتعلو وتنخفض. عبث وضجيج وصخب، انسد الأفق، ولم نشاهد على أطراف الوادي غابات التين والزيتون المغروسة على مساحات ممتدة طولا وعرضا. ابتعدنا عن الطريق، تشتتنا في الأرض، ونحن نحمل أثقال الطين في أقدامنا كأنها سلاسل قيدت أرجلنا في معتقل لتمنع عنا حرية الحركة والقفز. وصلنا طرف الوادي، ولكن لم يتبق أمامنا أي شيء مما كنا نعتقده، لا خيام غجر، ولا جمال سائبة.
توقفنا، الوادي عميق وفسيح، تنبعث نداءاتنا في داخل كل واحد منا، تساءلنا بلهفة، بحثنا في كل الاتجاهات عن جمل تائه أو خيمة واحدة، انتهى كل شيء وتبدد قبل أن يرتد إلينا طرفا.
جلسنا نستريح حتى وصلت إلينا البنات، هبطنا نحو الوادي، جمعنا أبقارنا في ساحة معشبة، لازرع فيها ولا شجر، وعدنا مسرعين لنلحق بالعيد.
صرنا نحس بأن عددنا غدا أقل، ولم نحاول عد المجموعة، ولم ندر أننا فقدنا واحدا منا.
صرخت إحدى البنات: ( أين جمعة؟).
توقفنا نقرأ وجوه بعضنا، تلفتنا حولنا، لا أثر لجمعة، رجعنا لنبحث عنه في أول الوادي، توزعنا في جميع الاتجاهات، كأننا نبحث عن مفتاح ضائع، أو قطعة نقود عيدية سقطت من أحدنا، والبعض ينادي: ( جمعاااااااا.. يا حمعااااااا.. ).
لا أحد يجيب، إلا رجع صدى يردد نداء أصواتنا المرتعشة، التي تتلاشى في أطراف الودي.
نمت نبتتة خوف في صدورنا، الصخور في المنحدر تحتفظ بأسرارها، واختفت سيرة الجمال والخيام كأنها لم تكن.
نداء مخنوق يتناها إلى أسماعنا، كأنه يأتي من أعماق بئر رومانية، يحمل استغاثة ولوعة.
( تعالوا .. تعالوا.. هذا جمعة.. جمعة هنا).
حاولنا تحديد مصدر الصوت، لم ندر ما نفعل، اجتمعنا، وجوه البنات تغير لونها، وقبعن خلف بعضهن، وأعيقت حركتهن، وصرنا نخيف بعضنا. قالت واحدة: ( من الذي ينادي؟ ).
قالت أخرى) : يا أمي أنا خائفة) ، وبدأت تبكي، فانتشر ذعر بننا.
قال آخر: (أنا لا أرى مصطفى.. أين هو؟ ). قلت ملهوفا: ( إنه مصطفى .. نعم .. مصطفى الذي ينادي ).
قفزنا باتجاه الصوت، تولد عندي إحساس أن اختفاء جمعة لم يكن عاديا، اقتربنا من مصدر الصوت ونحن ننادي مثل كورال يردد لازمة نشيد، ( مصطفى أين أنت... أين أنت يامصطفى).
صاح: ( هنا .. تعالوا تعالوا .. هنا هنا ).
كان جسده ينتفض ويهتز كنبتتة غضة، صرنا نرتعد جميعنا، أما جمعة، فكان يتمدد دون حركة، يتنفس بشكل منتظم ويبتسم، أوقفناه على قدميه، كان لينا رخوا كأنه منوّم، البعض يعرف أن في طباع جمعة شيئا من الغرابة، وأنا أولهم، كنا نسخر منه في كثير من المواقف، وكان يحتمل كل تعليقاتنا، يقضي معظم أوقاته منفردا كبومة، شاهدناه أكثر من مرة، يحفر حفرة صغيرة في التراب، وينبطح على بطنه واضعا وجهه في الحفرة، ويغطي جانبي وجهه، كي لا يسمح لأي شيء الدخول إليها أو الخروج منها، يلقي بعض الجمل التي لا نفهمها، وربما لا يفهمها هو أيضا، وبين كل مجموعة من الجمل يهتز ويصرخ، وهذا يجعلنا نصدق أنه يكلم أحدا يسمعه، فنعجب به، وحين ينتهي يغطي الحرة بالتراب وينفخ عليها، ثم يقف متعبا يكاد الدم ينفر من وجنتيه، وتبرز عيناه وتنقلب أنفاسه إلى لهاث، ومن طباعه أنه حين يفرح فرحا حد النشوة ينفجر بالبكاء.
تحول جمعة بين أيدينا إلى جسم رخو مثل قطعة قماش مهترئة، تلوح أطرافه دون انتظام، وتدلى رأسه على صدره، ناداه واحد: ( جمعة.. اصحى يا جمعه)
قال آخر: ( هل تريد ماء يا جمعة؟.. أنت عطشان؟..)
رد جمعة بكسل شديد: ( لا.. لا.. لست عطشان).
( أنت نعسان؟.. تريد أن تنام؟..)
( لا أعرف).
مشينا به إلى أن اقتربنا من أول بيوت القرية، فانتفض فجأة، رافعا رأسه، وشد جذعه بقوة، وانفلت من أيدينا قائلا: ( أين كنتم؟.. ماذا جرى؟.. أين الخيام؟.. أين الجمال؟).
اتسعت دهشتنا، أسرع في مشيته فأسرعنا نلحق به، فاقتربت منه، كنت مشدودا لمعرفة أي شيء منه، لم أدر ما هو، لكنه يعتمل في نفسي ويلح علي بفضول، قلت له: ( يا جمعة.. لم يبق شيء .. كل شيء رأيناه اختفى أول الوادي).
حاولت أن أعرف ما جرى له ، لكنه لم يقل شيئا، وقفز مختفيا بين البيوت. توقفنا على بيدر القرية الكبير، مسحنا أحذيتنا من طينها الثقيل، وتفرقنا في تعرجات الأزقة الضيقة.
مرت على تلك الحادثة سنوات طويلة، كنت حينها طفلا، لكن السؤال ظل يلاحقني، يبحث عن حقيقة أو جواب، وكنت قلقا لم تستقر نفسي إلى شيء.
لكني أخيرا قصدت شيخ الجامع وسألته عن حقيقة ما شاهدت صباح يوم عيد، فرد باقتضاب، ودون أن يعيرني اهتماما أو يلتفت إليّ: ( ما شاهدته حقيقة.. تظهر كل أربعين سنة.. في إحدى صباحات العيد.. إنه موكب الأربعين شهيد.. ومن أولياء الله الصالحين.. إن دعوت ربك حينها بما تشاء.. يستجب لدعائك وتكون من المحظوظين في دنياك.. فهؤلاء لهم كرامات وبركات).
تركني ومضى وهو يشد طرف جلبابه، دون أن يسمح لي بالكلام، أو يضيف كلمة أخرى، ولم أحس ساعتها بالتعاطف مع رأيه، فقد أهملني وهو يبحث بعينيه عن رجل له معه مصلحة شخصية، هكذا خمنت، وتأكدت من حدسي حين رأيته يسرع نحو المختار ليسلم عليه، ثم يهرعان معا إلى صاحب مزرعة الدجاج، فيلتقون مع مسؤول الحزب في القرية ومدير الناحية.
وجدت نفسي منفردا وسط الشارع الرئيسي، أتلفت حولي بارتباك وخجل، وكأني رفعت صوتي قليلا حين هجست لنفسي: ( وهل هذا الكلام كاف لتفسير ما شاهدت.. وقد عزمت أن تحكيه للناس؟).
كان المارون حولي يلتفتون إليّ باستغراب، وبعضهم أراه يبتسم، وإذا التقت عيني في عينيه يخجل مني ويسلم علي، يعرفونني وأعرفهم، رغم أن قريتي كبرت واتسعت، صارت أزقتها الطينية الضيقة شوارعاً عريضة بأرصفة، ومُدت تحتها أنابيب المياه ومجاري الصرف الصحي، وأنارتها الكهرباء والمدارس، ووصل البناء في أرضها إلى أطراف الوادي الذي ابتلع الخيام أو قافلة الجمال، منذ أكثر من خمسين سنة، وارتفع فوق كل بيت عدد من الأطباق المتصلة بالمحطات الفضائية والأقمار الصناعية.
بعد قليل وجدت نفسي على الرصيف في آخر الشارع، وقبل أن أنعطف باتجاه الغرب، حيث ينعطف الشارع الكبير المهم، توقفت أتأمل أفواج الطلاب وهم يلاحقون الطالبات المختبئات خلف غلاف قماشي أسود، وقد خرجوا جميعا لتوهم من الا متحان، وهم يلغطون ببعض الإجابات حول امتحان مادة الفلسفة الذي قدموه اليوم. فقفز إلى ذهني اسم ( ديكارت) الذي أسس لعلم ما يزال يتطور باستمرار. كنت أراه فيلسوفا عبقريا، وفي نفس الوقت أعنّفه لأني أرى فيه جبانا رعديدا، أو منافقا مداهنا.
أصوات الطلاب تتلاشى، أفقت من شرودي، فوجدت نفسي أمام بيت شخص يكبرني بضعف عمري، بيت أبو صلاح يبعد عن الشارع مئات الأمتار ، أقف أمامه دون أن أخطط لزيارته، لأني لم أدخله في حياتي، فتراجعت خطوتين وفكرت بالعودة من حيث جئت، اكتشفت أني مشيت مسافة طويلة دون أن أدري، ولم يسبق أن تحدثت مع أبي صلاح، لكني أسمع أنه يلتقي مع بعض الشباب، وتدور مناقشة لموضوع مهم هنا في بيته، مع أن الناس ينعتونه بالكفر والزندقة والخروج عن عاداتهم وأفكارهم، ماذا سيقول الناس عني، وماذا أفعل أنا الآن، أأترك نفسي عرضة للقيل والقال، سيصفني الناس بالكفر والزندقة والخروج عن كل شيء اعتادوه، ولكن لماذا لم نتعلم سماع الرأي الآخر دون خوف أو حرج.
هنا يمكن الافتراض أني خائف، ومتردد، فهل أعذر ديكارت، أم أحزم أمري وأطرق الباب لأجلس مع أبي صلاح، ثم أسأله في أشياء كثيرة ومن بينها المشهد الذي رأيته في طفولتي، لاأدري ما أفعل، الوقت وقت غداء وقيلولة، وهذا أفضل وقت للقائه بعيدا عن أصدقائه، ولكن، هل يزور أحد أحدا وقت الغداء، ماهذا الإحراج، عليّ أن ألتقي به لموعد مسبق، انعطفت لأعود، إذ بالباب يفتح ويقف أمامي ابنه وجها لوجه، قلت له بلهفة: ( الأستاذ أبو صلاح موجود؟ ).
( نعم موجود.. تفضل).
(عذرا .. أريد أن أسأله سؤالا فقط)
لم يغب ابنه غير لحظات حتى جاء الأستاذ أبو صلاح باشا ومرحبا، شدني من يدي بفيض من الكرم، وأحسست أننا أصدقاء حقا، قلت له: ( معذرة.. ليس هذا وقت زيارات.. لكني وجدت نفسي المتحيرة فجأة أمام بابك.. و.. ) . قاطعني قائلا:
( لا تكمل.. ولماذا الاعتذار.. أنت في بيتك .. وسنتناول طعام الغداء معا.. الآن ). أحسست بسعادة لم أشعر بها منذ زمن، إنه صديق ممتاز، وكنز ثمين، حين غادرني ليطلب لنا شيئا من الضيافة ريثما يكون الغداء جاهزا.
قفز إلى ذهني مشهد صديقنا جمعة، تذكرته في أكثر من موقف، وخاصة حين اختفى عند أطراف الوادي يوم كنا صغارا، وقارنت بينه وبين حالته اليوم، فهو أكثر الناس ثراء، من مهنة الدجل والسحر والرقى وعلاج المرضى بالشعوذة.
جاء أبو صلاح مرحّبا ترحيبا ينم عن سعادة حقيقية بلقائي، فارتحت وحكيت له ما شاهدته، ولاحظ اندفاعي وارتباكي، من خلال طريقتي في سرد وقائع المشهد، ومن إشارات يدي، وعلامات التأزم على وجهي، لكنه ضحك ضحكة أخجلتني، وقال:
( نحن في بلادنا ما يزال التعليم قاصرا عن إشباع العقل من العلوم التي تتفق معه.. وبعيدا جدا عن البحث والاكتشاف..)،
وتابع يشرح لي متى وكيف تتشكل مثل تلك الظاهرة الطبيعية التي شاهدتها في طفولتي، قال:
( طبعا كان الوقت مبكرا.. أثناء طلوع الشمس.. تكون درجة حرارة الأرض والزرع أبرد من الهواء الذي تخللته أشعة الشمس.. هذا جعل رطوبة الأرض والزرع تتبخر بكثافة.. وتزول أمام العين.. ولكنها في الواقع لم تزُل نهائيا.. ولكن ضغط عليها تيار هوائي بدرجة حرارة معينة.. فشكل منها سماكات متعددة على شكل هياكل شبيهة بالسراب تماما.. ترتفع وتنخفض حسب حركة الجسم والعين .. وحسب شدة ضغط التيار الهوائي.. فتبدو كأنها تمشي.. ولو جربت أن تقف لتوقفت.. وما أن وصلت إلى أطراف الوادي زالت.. لأن الوادي دافئ أصلا.. وماتزال الشمس بعيدة عنه.. فلم يحدث للهواء فيه ما حدث قبله.. أما جمعة.. أنت تعرف ماذا يفعل .. إنه ما يزال يكذب ويحتال على الغريب والقريب.. ويكفي أن نعرف أن بعض الشعوب يقدسون قوس قزح ويعبدونه).
سعدت كثيرا مع أبي صلاح على طعام الغداء، لأني أشبعت عقلي بفكر علمي مهم، وما أن انتهت كأس الشاي، استأذنت وشكرته، وهو يودعني عند باب بيته، وقف رجل وامرأة من قرية مجاورة لقريتنا، سأل باهتمام عن دار الشيخ جمعة، فضحكنا ونحن ننظر في وجوه بعضنا، ونهز برأسينا أسفا وحسرة، ثم قال لي أبو صلاح: ( أرأيت يا صديقي!؟.. الآن عليك أن تدل هذا الرجل على بيت الشيخ جمعة.. هو الآن أمانة بين يديك.) .
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. المخرج الاردني أمجد الرشيد من مهرجان مالمو فيلم إن شاء الله

.. الفنان الجزائري محمد بورويسة يعرض أعماله في قصر طوكيو بباريس

.. الاخوة الغيلان في ضيافة برنامج كافيه شو بمناسبة جولتهم الفني

.. مهندس معماري واستاذ مادة الفيزياء يحترف الغناء

.. صباح العربية | منها اللغة العربية.. تعرف على أصعب اللغات في
