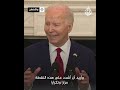الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
مبهمات الذاكرة
جميل حسين عبدالله
2016 / 11 / 13سيرة ذاتية

لم أكن أظن أن ما يكتبه الحرف سيكون قادرا على تجاوز الزمن العتيد، وتمدد صوته إلى الأمام العنيد، لكي يقطع الأفق البعيد، فيتدلى بين الثريا كعنقود عنب مطلسم بالمعاني الأبدية، لا يرتشف نجيعه متوله عاشق، إلا وانجذب إلى الحضور في صعقة الفناء، والذوبان. شيء أستوحيه من النص القديم الذي نقشه الحظ في دائرة الذاكرة، وأنا أقرأ فيه ذاتي التي تلاشت بين عينيها غمامة كثير من اليقينيات التي اكتسبناها في صغرنا بلا يقين، ونحن في زمنها نجر الذيل وراء أناس يعلموننا كيف نفهم الأشياء، ويحددون لنا كيف نفكر في الحقائق، وربما من شدة حرصهم على بقاء ذلك الخيط الرابط فيما بيننا وبين اختيارهم للأنسب من العقائد، والسلوك، لا يتركون لحظة تمر على الديار بصوارفها السريعة، إلا ويحصل معها شديد لهجة التنبيه، ومزيد فكرة التحذير، وأحيانا يكون صونها لضرورتها الوجودية بنبرة التقريع المغالي إلى حد يبدو معه الفرد غير قادر على كسب معرفته بالحوادث القائمة في حياته. وربما قد يؤدي ذلك إلى نمط سلوكي متشنج بالمصارمة، والمقاطعة. وربما إن لم يكن الأمر قابلا لكل ما يجوز له أن يعيدنا إلى حظيرة الانتساب، تتحول كثير من الأحكام إلى إخراج عن الدائرة التي لا تغفر الانحدار عنها بسبيل من السبل المسلوكة بإذعان. وسواء حدث ذلك بهذه الطريقة، أو بغيرها من وسائل الوقاية، والحماية، لكننا نكتشف من هذا السلوك مقاومة، وممانعة، ونستظهر منه ألما، وخوفا، وكأنه يستهدي منا أن ننافح عن حياضه، وندافع عن واجب حقه، لئلا تذوب حقيقة الامتلاك بين ما يغزو الأماكن من أطياف أخرى، تستهوي الكبار قبل الصغار.
والأدهى أنها من شدة غرابتها تغري الأعيان، وتثري الأبدان، وتحدث لها في عين التصورات أشكالا، وألوانا. كل ذلك لم نفهم علة وجوده، وظهوره، ولا سبب انكماشه، وانطوائه. لكن لو تجاوز آباءنا مسارب الخوف من الاستحالة، والاضمحلال، وعلمونا أن الحفاظ على الحوزة القابلة لانضمام الكيان إلى صيانتها للمعنى الجماعي، هو العقد الأول الذي يربطنا بتاريخنا، وحضارتنا، لانتفت كثير من الاعتراضات التي سببت الاحتقان بين الجيلين المنتهيين إلى مكمن واحد في المحتد، والمنشأ. لكنها بمغبة هروبها إلى مرفأ الذات المنغلقة على حركتها في القول، والفعل، وفرت زمن الانتعاش لغزاة يطوفون علينا بأحلامهم الوبيئة، وآمالهم الدنيئة. والأغرب أنها من شدة الذهول الذي عكس على المرآة جباها خائفة من المجهول الغريب الأنفاس، والأجراس، ومن حدة ما يبدو سره هاتكا لقيمة الشرف، ومعنى العرض، لم يدركوا عمق ما يجري، وغور ما يسري، فظنوا أن أساليب النهي، والمنع، والحظر، هي أقوى الأسلحة في رعاية الذات المتفاعلة مع ما يتركب في حياتها من أنماط، وأنساق، وسياقات. ذلك هو لباب عقيدة أناس قاوموا الاستعمار بحديد العزيمة، وسحر العقيدة، وحاربوا كل ما يدل على الانزياح عن المكانة التي يكتسبها الإنسان من انتمائه إلى قوة لها فتوة، وصولة. وعذرهم في زمني الذي أعيشه مخمورا بعشق وحدة الإنسان على المشترك الإلهي، هو صفاء النظرة التي رأوا بها الأشياء الخالدة، وجلاء تلك الصورة التي شاهدوا بها غاية وجودهم بين الأكوان خافقة الرايات، وبارزة العلامات.
لكن ما يؤرق جوانحي، ويقض جوارحي، هو ما خضناه من حروب بين الأصيل العريق، والمعاصر الدقيق، لأن كشف الحقيقتين على ما وجدت كل واحدة منهما لأجله، لم يكن سهلا، ولا ميسرا، لكوننا قد عشنا بين تيارين متموجين، ومتضاربين، لا وسط بينهما، فإما يمين، وإما يسار، وإما عدو، وإما صديق. بل من قوة البحث عن الاصطفاء، والانتقاء، يغلب عليهما ما يطغى من ثنائيات على عقل كل مساراتنا الفكرية، والاجتماعية، والسياسية. ومن هنا، كان التمييز بينهما، ومعرفة مكامن الاختلاف، والائتلاف، وتحديد مناطق القوة، والضعف، هو أصعب معادلة احترنا في فك لغزها، ودرك رمزها، لأنها تدل على مفهومين صارخين بالتناقض، والتباين. إذ لكل واحد منهما حجته التي يقنعنا بجدواها، ودليله الذي يستدل به على صدق ما يروي، وما يدعي. والأخطر من هذا، هو نشوب الحرب بين الديار بسبب تهور المراد، والغايات، وسطوع عصر يستلزم من وجودنا ضمن دائرة معينه، أن لا يكون لنا رأي إلا رأيها، ولا طلب إلا طلبها، وإلا كان ذلك خيانة للانتماء، والولاء. فكيف سنواجه هذا القديم الذي يصهرنا في عمق جماعة معينة، وهو يُنبش بجديد تولد منه، ونشأ في تربته، أو يطمس بحديث ليس له من الملامح المميزة إلا بعض خصائصنا العرقية، واللغوية.؟
شيء مربك في حقيقة التقدير. فالجيل الذي تربينا على يده، لم يكن جلفا بعيدا عن أشواقه، وأتواقه، لكي نقول بأنه يحارب عن هويته المهددة بالانقراض النوعي، بل كان لصوت الناي عنده مقام، ولرقصاته المعبرة عن أحلامه معنى. ولولا ذلك، لما خلد مقامات موسيقية تنزف من عمقه، وتعبر عن غوره. لأن الدليل الحقيقي على وجوده، هو نطقه بصوته من صمت الجماد. فالناي، لم يكن ناطقا إلا بما انحبس حرفه في الذوات الجذلانة بألمها، أو أملها، ولم يجد له من صوت يدل عليه إلا بديع هذا النغم الشجي، الطري. لكن هذا الخوف الذي يغرد به عندليبها فوق الروابي الشاهقة، لم يكن إلا تحصنا من وارد يفد على لحظة الانتشاء بالميراث الخالد، فيغير الأذواق بما ينهي عبق التاريخ، وفوح الحضارة، وشذى الإنسان.
شيء طبعي نقبل به بين الوجود الذي نعتقد فيه أنه ضرورة لبروز صورتنا الكونية، هو حقيقتنا التي تميز ألواننا عن نوعنا في تاريخ البشرية، ولكنها تجمعنا مع جنس عائلتنا التي تسكن وهاد هذه البسيطة. وما دام هذا الجيل قابلا لعاداته، ومدافعا عنها، فهو جيل بكل الملكات، والطاقات. إلا ما حدث من تناقض بين المسالك المستوفزة من الغد المعلول، والمغلول، لم يقع في قيمة الاستحقاق الذي نستحق به الوجود ضرورة، أو حقيقة، بل حدث ذلك فيما نزح بين الديار من قيم مادية، ومعنوية، لم يتآلف عليها موفور العرف، والتقليد، ولم يتكاثف حولها جهد البناء، وكبد الرعاية. لذا، لم يكن بعض الاختيار لما نواجه به الملمات صائبا، لأننا لم نفرق بين ما نزف منا، وما ساح من غيرنا. إذ لو ميزنا بين الصوتين، والصورتين، لأيقنا بوجود حياة فينا، ما دمنا نعبر عن حقيقتنا، ولو مع اختلاف في اللون، والشكل. لأن ما نريده في نهاية خوفنا، هو حماية الذات من التلاشي، وسياسة المرابع بما تتفي به نوازع الزوال. وتلك هي عقدة حب البقاء فينا، وسواء عبر عنها الأفراد، أو الجماعات. فالخوف هنا، لا مسوغ له في المنطق الخبير بالعواقب، والمغبات، لكون ما نظهره في الرقص المحبر بين أوزان القديم، والحديث، لن يكون إلا تعبيرا صادقا عن احتراق معناه في باطننا، وانسحاق مبناه في ظاهرنا. فلذا لا نستغرب تمردا يحصل في المظهر، ما دام المعنى الجميل الذي يتضمنه في الباطن ثائرا، ومنتفضا. فطريقة تصفيف الشعر، وتركيب اللباس، وتدبير الذوق بما يقتضيه السلوك الاجتماعي، هي أعمال مستمرة في الإنسان، وممتدة معه بين الأزمان، والأكوان، إذ بها يواجه صميم وجدانه، وصريح شعوره. ولا غرابة إذا تغير المظهر في تركيب الصورة بين دوائر المعنى، ما دمنا ننسج سجادة واقعنا من نجيع آمالنا في الحرية، والانعتاق.
وهكذا، فإننا حين ذهلنا بصوت الموسيقى الغيوانية، لم ننظر نحن جيل السبعينات (على رغم صغر سني) إلى المظهر النافر من الركود المصاحب لسكينة خوفنا، بل طرق سمعنا هذا الصوت الندي الألحان، والأوزان، وهو يحمل ما كمن فينا من مكامن غائرة، وحائرة. فصرخات بوجميع، وباطما، والدرهم، (1) لم تجد لها نهاية في سعة أعماقنا، وأغوارنا، بل سبحت فينا مع تكون الزمن معنا، وما زالت هي الغناء المعبر عنا، والناطق بحقيقتنا. ولأمر ما أتذكر هذا الصوت برائحته المشمومة في جوني، لا لكونه يدل على أول انجذاب، أو انصعاق، بل أتذكر فيه صوت الحقيقة الذي يعبر عن أحوالنا الباطنية، والروحية، واسترجع معه ذكريات حركتني من زيف الحال إلى مقام الحقيقة. فلذا لا يستغرب مني أن أدعو إلى تصنيف الموسيقى الغيوانية تراثا روحيا، كونيا، وإنسانيا. لأنها نسمة نزفت من عمق الذات، وسارت مترنحة مع الزمان، وبقيت ممتدة في المكان، تذكرنا ببداية الصراع، وأبجدياته، وأدبياته، لكون فنون الموسيقى في الشعوب العظيمة، تحمل بوح الإنسان بكل أحلامه، وآلامه. وإلا، فما فائدتها إذا كانت أشلاء جسد متحرك كالمومياء، لا يستفاد منه تعبير يضيق إلى جرعة آلام الفداء نصيبا، لعلنا نتحرر ببساطة اللفظ، ودقيق الدلالة, وعميق المعنى، لا أن نستعبد الجسد المرهف بالأحاسيس الناضجة بفقر العقول عن المعاني المقدسة، والمغزول في الخيال المخملي الناعم الحواشي المزخرفة. أجل، فكثير من الأصوات المتداعية للسقوط، والانهيار، لم تكن أنغاما سارحة في فوضى أفقنا المجلل بسحابة غرائزنا المفلسة، إلا لكونها تغنى في كاباريهات المسعورين بحمى الجسد الممشوق. إذ الموسيقى الحقيقة، لا تعزف في نوادي السهر المقرور نبلُه بشراء عهد الأجساد المهدورة بأنجس الإرادات، وأبخس المساومات، بل تصيح بين الساحات العمومية المتهدمة الأطلال، والمتحيرة الأشواق، حيث المسامع تتآلف، والأذواق تختلف، وتضج على بساط المسارح المطلولة بلغة الحزن، والألم، لأنها تخفف العناء، وتزيل غشاوة الشقاء، وتحدث فينا عنفوانا، ونشاطا. بل صوت الناي، لا ينزف إلا على حصيرنا الطاهر لخلوتنا، وجلوتنا، وإذا أجاده أحد فينا، قبلنا له الثرى إجلالا، وتعظيما.
هنا كان صراخ الغيوانيين بحمولة حيه البيضاوي المترنح بين أفياء الألم العنيدة، وبصوته المدمر لطراوة المدن بفوح بداوته النامية بالمعاني التليدة، هو أول دليل على وجود شيء يدعوني إلى النص القديم الذي يختصر قصة الوجود بلغة الحكمة، والشعر، و يجيب عن سؤال الضرورة في عقلي المنحاش إلى عمق الصحراء الساحرة بأصواتها المتفجرة من ذلك الغور المجهول، والمنحاز إلى غموض المعنى، وحزونة المبنى. لأن قدري المجاهر بحقيقتي، هو ما كتب حرفُه معاناة الذات من انجذابها نحو الصورة البريئة، صور الشاحنات التي انطلقت قرب قرية "العزيب بإنشادن"، (2) وهي تمخر عباب هذا اليم الغامر بالغرائب العجيبة، إظهارا لعظمة السلم في صناعة التحرير للأوطان. أشياء جميلة تتقابل فيها الأصوات، والأشخاص، والألحان، لكي تفصح عن المكنون الذي يغرد به شحرور الحرية بين خبايا الذوات المحبة للأمن، والسلام. وحقا، شيء مذهل في عقلي، حين أضغط على زر التحكم في التلفاز، وأنا أنتقل بين القنوات التي تصنع الرعب في فلذات أكبادنا، وتحدث في أعماقنا صليلا مجلجلا، وتركب في علاقاتنا عقد الصراع بين الطوائف، والأفكار، والقيم. وربما من شدة العار الذي لطخ جبين الإنسانية، أقول صارخا: لم نسترزق بشؤم الحروب، ودمارها، وخرابها.؟ فالإعلام يسترزق بالصور المجسدة لجريمة الإنسان في حق أخيه، وابن قريته، وابن مدينته. والسياسيون كذلك، لأنهم وبدون أن تقطع الرقاب، وتهراق الدماء، سيسألون عن حصيلة العمل الذي نجسوا من أجله أصفى ما في ذواتهم من مناطق الضمير، والاستقامة. لاسيما إذا كانت الرقابة قوية، والحكامة جيدة، وإذ ذاك سيكون الجواب مخيبا لآمال هذا الإنسان الذي ينتظر من الساسة أن يصنعوا له مهد الأمان بين الديار المنكوبة بحفظ السلام. ومالكوا قرار العالم كذلك، إذ بدون استشعار الشعوب لقوة مرعبة تتربص بها الدوائر، وتتصيدها بأقبح الجرائر، لن يكون للسلاح أي معنى، بل من غباء هذا المجنون المستعلي بطيشه، وسفهه، أنه ظن امتلاك السلاح سببا في تحقيق صك الأمان لحوزته النازفة بالفرع، والهلع. ومتى أنتج السلاح ضده.؟ إذ هو لم يصنع بعقل طاغ مستبد بالمعرفة لناموس الطبيعة، وقانون الكون، إلا ليكون رعبا بين مشاعب الإنسان المتعددة، لا لتأكيد قوته على صناعة النظام، والاعتدال. ومن هنا أرى فجيعتي فيما تعرضه كثير من القنوات المتاجرة بدم الإنسان ضرورة قائمة في الاعتبار، وهو ترسخ حقاره همه في الحرية بين أنياب هذا الغول المتوحش. لكنني حين أعرض صوري المخزونة في تابوت قدري، أحس بصدى عميق لهذه الشاحنات التي حملت السلام إلى الصحراء المغربية، وكأني بها تؤكد حقيقة دقيقة، ربما قد يرددها بعض خداعا لخلل في وظيفة العقل المزيف المنطق، واللغة، لكنها في اعتبار الباحثين عن قبس الحب والوئام من أجلى الحقائق، وهي شعورنا بالمسؤولية على كل حبة رمل في أرض آبائنا، وأجدادنا، لأنها النص القديم الذي يحتوي على معاني تراثنا، وتاريخنا، وحضارتنا، وهي الوصية التي تنفجر منها ينابيع الصلادة في تمثلاتنا، وتجسداتنا.
ولا عيب فينا إذا لم ننتج الطائرات، والصواريخ، أو لم نحكم بقانون العبودية على صيرورة الإنسان، وجغرافيا الأوطان، لأننا نفتخر بكوننا أنشأنا شدو الموسيقى الروحية، وأحدثنا بها خللا في القصائد، والمقامات، وأضفنا بذلك إلى لحن الإنسان أنغاما جديدة، يعبر بها عن أحزانه، وآلامه. بل لا عيب فينا، إذا صافحنا شعوب العالم بلوننا في الإبداع، والاختراع، لأننا لم نصنع ما يحرق الأرض، ويلوث الفضاء، ويقتل الإنسان، بل صنعنا من القصب نايا، ومن شجر العرعر هجهوجا، فأنطقناهما بين النجوع باستعاراتنا، ومجازاتنا، عسانا أن نفسح الأمل لمن يرغب في قراءة أحلامنا، وآمالنا. وإذا ما عَنَّ لغيرنا أن يرانا جزءا من هذا الكون ا الذي لا يستقيم صفاء لحنه إلا بوجود صوتنا فيه، فإنه سيدرك أن ما أبدعه غموض تجوالنا، وتنوع ترحالنا، ما هو إلا قوة كامنة في تمازج المعاني بين أغوارنا، وأنجادنا، ونحن قد استظهرنا إيحاءاتها رغبة في التواصل، والتفاعل، لا لأجل أن نهزم بها صوتا، أو نهدم بها وزنا، بل صارحنا العالم بغايتنا في التآلف، والائتلاف، ولم تكن لنا من غواية تستغوي ضعفنا، ولا من زراية تستهدي طيشنا. كلا، بل همنا أن تشرق أنوار الشمس الراقصة فوق شطآننا المهذبة على مرمر الكون المجلل بأسوار الحروب، والظلم، والطغيان، وغايتنا أن نلج هذه المعابد بتفويض العزم لمن أوجدنا لرحمته، وفضله، لا لغبن الفتك بالهمم، والذمم.
حقيقة يخطئ من يظن وصولنا إلى قلب الإنسان أتفه شيء أمام وصول مغامراته إلى سطح القمر البهي. وربما من شدة الانتباه إلى لحظة التسامي مع العلم، والحضارة، نردد نص تاريخنا الذي يعبر عن فكرنا الراقي بين تفاهة ميادين لا تقدس الإنسان، بل غيرت وجهته، وحورت وظيفته، لكي يكون عبدا مستلبا للآلة، وقيْنا في مغارة جلاد يسطو على الكون بخفة حيله، ومكره. لكن هل يصح هذا المراد الذي يغير كثيرا من قناعتنا بجدوى النطق بالسلم العالمي.؟ لعلي في كثير من مساراتي التي أتعبتني بالبحث عن خيط المفاضلة بين الجيلين اللذين نشأت في أحضانهما، لا أجدني مطمئنا إلى هذا التغول والتوحش الذي يعبر به هذا الجندي عن قوته، وشدته، ولا ميالا إلى اعتبار كل قيمة ذات معنى فريد، ما لم تكن مستوحية للغات الكون في صناعة الأمن، والسلام. بل من صفاء الذات أن أرى أحوال هؤلاء البهاليل والمجاذيب أقرب إلى صوغ ذاتي من هؤلاء المتفيهقين، والمتعالمين، بل من كثير وسمهم الحظ بالحظوة، ووشمهم بالنخبة. لا لأنني استنكف عن درك الصورة بأبعاد كثيرة، بل لكوني أرى هذا الصنف المنصعق بلحظة الفناء مع الذات المتسامية عن المعنى المادي، الأرضي، هو الذي يجمع صوت العالم بأكمله، ويحتوي على كلية المعنى، والحقيقة.
فلا غرابة أن يوجد هذا الصنف في كل قارات العالم، وفي أديانه، وثقافاته، وحضاراته، ولا في أن يكسر كل الحدود والحواجز التي أقامتها الأنانيات المستعرة بالاستعباد، والاستغلال، ولا في أن يعاقر مدامة الصفاء على خوان العشق لأنوثة الطبيعة، ورجولة الكون، لكونه يحمل من لون القلق ما نحمله، ويعانق من أفق الحرية ما نعانقه. وربما من شدة تركيب الصورة من فلسفة منفتحة على الإنسان في كليته، لا في حدود جغرافية عرقه، ولغته، ودينه، هو أقرب منا إلى الإدراك الحقيقي لهذه الحقيقة الكاملة، بل ربما صار صوته مع نشازنا عن مقامات موسيقى الكون معبرا عما هو مكتوم فينا من أشجان، وألحان. تلك هي الحقيقة الجامعة بيننا، وعلى اختلاف التواريخ، وتعدد مناطق الحضور، والغياب. فهؤلاء لم نر لهم سلاحا يحني جباهنا، أو يقعي أجسادنا، ولم نحس في حضرتهم بالخوف من الغوائل، والحبائل، بل كان صوتهم إشراقا نازفا بالحب لهذا الإنسان الذي اختاره الأزل، وعلى رغم ضعفه، أن يكون صورة تتجلى فيها آيات الله، وعلاماته.
لا أراني محتاجا إلى دليل أقوى مما أطمئن إليه يقينا في عمقي، ولا أعظم وجها في المعنى من هذا الانحياش الذي يحيد بي عن طرق الزيف، لكي أبني ما هدمته على برهان الحق، لا على دليل التوفيق، وأركب ما توارى في عمقي من لغة على إيقاع نغم يحبره الكون في بحيرة الطبيعة، ويستنبطه الإنسان حين تكون غريزته صوت المعنى الأزلي. إذ لو احتجت إلى إقناع يأتيني من حجة تقيمها الضرورة في اللحظة الساقطة، لما تمايلت مترنحا بين دوائر العشق، وأنا أغوص في أعماق الحلاج، وأدنو من بؤرة المعنى الذي باح بسره، فاستحق أن يكون مسيحا يفدي المتولعين بجمرة العشق، والمحترقين بوميض الحق. فالقضية في تركيبها لا تستوجب عندي صراعا، ولا نزاعا، لأن إدراك صوت الناي، واستظهاره، واستنطاقه، هو الذي جعل المعنى يسري بين الدوائر التي تماهى جلال الدين الرومي في تموجاتها، ونمنماتها. ولولاه، لما ارتحلنا بين أمداء العالم بالصوت الرخيم الدال على امتزاجنا، أو الثخين المبين لانصعاقنا. ذلك الصوت، هو صوت البراءة الأصلية النازف من مكنون الطبيعة. إذ هي لا تعبر عن حقيقتنا، إلا إذا كنا لحنا يستحق أن يخرج عن الجسد، لكي يسمع بين براح الأكوان. فهل حرر المتحاربون على مركز النقطة في العدد، والحرف، أكثر مما حرره صوت الحكمة، والفن، والموسيقى.؟
شيء غريب أن لا يكون شخصا عالميا كل من فيثاغور وأفلوطين والسهروردي والحلاج وابن عربي وابن سبعين وابن برجان وابن مسرة ومولانا جلال الدين الرومي وطاغور ودانتي وبيتهوفن وغيرهم، وهم كثيرون بيننا قديما، وحديثا. إذ لو لم يكن هؤلاء أشخاصا كونيين بالمعنى الأدق، لما شعرنا معهم بالرحلة الروحية التي نقطع بها خوف الفيافي، وننغمس بها في شك البراري، ونحن نشتاق في جسيم عنائنا إلى أن نسمع صوت الحب في هذا العالم المتحارب الأخياف، والأطراف، ونمتح من معين المعنى ما يدب في أعماقنا بالوفاء، والصفاء.
فصوت الشاحنات الممزوج عندي بأنغام الغيوانيين، وصدى الشعار المتدفق من الجناجر الولهى، وهي تنادي: فيها أمن و سلام و تاريخ مجد الوطن، بلا حرب و بلا سلاح معجزة السلام ، هو أول صدى يخترق سمعي، ويجعلني متذكرا في كثير من لحظات حياتي لهذا المعنى الأول الذي همس به القدر بين أرجاء أحشائي. ولا أخفي أنني من شدة اندهاشي بهذا الحنجزة، وبهذا الصوت، وبهذا الصدى، وبهذا الشعار، وبهذا الوجدان، أراني ضعيفا في قبول اللاعج المتضرم بين الأحناء، فأذرف دموعا مدرارة. لا أدري، هل هدية مني إلى جمال الصورة التي أسرت اللب في سابق العهد التليد، أو هو وحشة أحسست بها حين عز بين الديار من يتذكر في غمرة الهوس بالماديات تلك الأفياء الفواحة بالمعنى الخالد الفضائل. شيء من ذا، وذاك، يمكن أن يعجن مركب الحقيقة التي أستوحي نسيمها من عمق الروح المتجلية فينا بالظلال اللطيفة، والأفياء الشفيفة. لكن ما أريد بلوغه من هذا المتسع المتشعب الأدوار، والأطوار، هو ما خلته نقطة الارتباط بين الأشياء المتفرقة بالخلاف المُهِين لقدرتنا على صناعة معنى الجمال، والكمال، وحسبته أصلا يحق لي أن أعود إليه حين أتمعن في النص القديم الذي يدبر كليتي بأبعاد محدودة، وأوزان معدودة. تلك هي القصة التي جعلتني أرى آباء يكدون من أجل حماية الدائرة، وأسمع أصواتا تنزف بالعناء، وأشهد عبقرية عظيمة تصنع غرائب السلم برزانة السياسة، وأحس بهجوم صاعق بالبيان المباين للغتنا، وتاريخنا.
أشياء مركبة في الانطلاق نحو صناعة الاقتناع بقناعة الذات، كلفتني البحث هنا، وهنا، وبحذر، ووجل، وكأنني أجترح خطيئة التفكير في صون الدائرة بما أتحمله من آلام التشظي بين الدور التي وصفوها بالطهارة، أو وسموها بالنجاسة. فالدائرة موجودة في الحقائق الجُلى، ومهما كانت الأحوال التي تشكل وعينا بالحقيقة، فهي لن تزول، ولن تحول، ما دام صوتنا يخرق حجب الزمن، لكي يستوطن القادم من الحوادث، كما استحوذ على عمق النظر في الحاضر. فأنا، أو غيري، لن نسمع صدى طفولتنا إلا بين هذه الديار التي هي شكلنا الهندسي المحتضن لكل كلياتنا الموجودة بالمبنى، أو بالمعنى. ومهما تفاخرنا بصحوة، أو بوثبة، فإن ذلك لا يعني سوى أننا نعتنق فم الزجاجة التي نشرب منها عنفوان الانتساب، والاحتساب، لأن صوت الماضي، لن يمسح إلا من فخر دعي زنيم، لا يقيم أوده ما تنتجه الأرض من معاني العزة، والكرامة. إذ الخيانة دليل على سفالة الأصل، وحقارة المحتد، ولا يأتيها إلا مشبوه النسب، ومعدوم الحسب. وإذا ما استحالت إلى فوضى البحث عن الأصل المخروم، كانت خللا في توازن الأدوار، وتعادل الفرص، وتضارب القصود. وإذ ذاك، لن نتسور أسرار العالم بجمالية أذواقنا، وألحاننا، ولن نتجلى لغيرنا بألواننا، وأشكالنا.
(1) لا أرى فصلا بين ظاهرة الغيوان، وما تولد عنها من إيقاعات صدح بها صوت جيل جيلالة، ولمشاهب، والأفلاك، وغيرهم ممن آثروا هذا اللون في التعبير عن الحرية، والانعتاق، لأن ما حملوه من شعلة الفن، وقبسها، لم يكن إلا إحياءا للتراث الروحي المركب في الشخصية المغربية. ولذا، لا أرى سببا للمفاصلة، أو المفاضلة، لكون الموسيقى، لا تعرف الإحن، والأحقاد، بل هي اللحن المختفي بين بستان المتعالي، والمتسامي. وأي خلل يحدث في تقدير النقاد للظاهرة، إن لم يكن هدفه استظهار ما تولد من جديد المقامات، والأوزان، فلن يكون إلا سببا في تمزيق الوحدة، وتفريق الصف. وذلك مرده إلى الفنون التي تخلق الزينة، والخيلاء، لا إلى ذلك الصوت المتفجر من أعماق اللفظ المعرب عن شوقه باطمئنان الذات إلى معنى الجمال الكامن في الوجود، والحياة، والإنسان.
(2) هذه القرية ابتدأت فيها أول تصورات حياتي، وتصديقات عمري، وقد كان أبي إماما مشارطا في مسجدها لسنوات عدة. وهي من أعمال عمالة أغادير سابقا، والتابعة حاليا لإقليم شتوكة أيت باها. وتسكنها أسر نزحت من الصحراء المغربية، لكي تستوطن هذا الربع الثر باللحن الحساني الخالد الأنغام، والأنسام. ومن حسن حظي أنني حين فارقت مهدي بحاحا (الصويرة)، حملتني الأقدار إلى هذه القريةالمطلة على شاطئ تفنيت. وهناك تركبت عندي مجموعة وافرة من الذكريات، والأدبيات، وتعرفت على نمط عبد الهادي يكوت، كناري مجموعة ازنزارن الأمازيغية، وهو يختفي بشراسة عينيه بين غمرات عرينه الذي نحته من الأجراف المحدقة بالمكان. وتعرفت على أنماط وسلوكيات كنا نمتصها بأعيننا من أولئك السواح المتوافدين على هذا الشاطئ الذهبي. وتعرفت على صوت البحر، ولغته، وحدس البحارة، وقوتهم، وشدة مغامرتهم في استكناه المجهول. أشياء توافرت حكاياتها، ورواياتها، ولها مقام في سيرتي الذاتية "ابن الفقيه".
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. التوتر يشتد في الجامعات الأمريكية مع توسع حركة الطلاب المؤيد

.. ما هي شروط حماس للتخلي عن السلاح؟ • فرانس 24 / FRANCE 24

.. استمرار تظاهرات الطلاب المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمي

.. وفد مصري إلى إسرائيل.. ومقترحات تمهد لـ-هدنة غزة-

.. بايدن: أوقع قانون حزمة الأمن القومي التي تحمي أمريكا