الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
ابن الفقيه (سيرة ذاتية) -3-
جميل حسين عبدالله
2017 / 3 / 3سيرة ذاتية
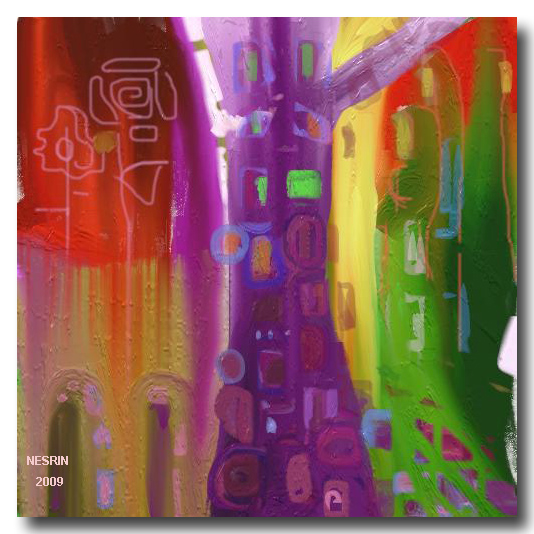
ابن الفقيه
سيرة ذاتية
-3-
يتبع
الأطفال يولدون من رحم الأمهات، وحجور الجدات، وحين يكبرون، ويشتدون، يعاندهم الدهر بخباياه، ورزاياه، فإن نالوا شراسة من أثداء المرضعات، وأحضان الأخوات، كانوا أقدر على اختراق دروب الحياة بوميض يبدد مخاوف السكك المظلمة، والقرى المؤلمة، وإن نالتهم المهاد بمعرة الجمود على تجاعيد الذاكرة المبللة بوسخ البله، والخرف، كانوا أقرب إلى الحمق من العقل، وإلى البلادة من الذكاء. هكذا نولد مع الصرخات، والهتافات. وهكذا تكبر معنا الآهات، والأنات.
الفصل الأول
في البداية كان ابن الفقيه كلمة مسطورة بين صفحات كتاب الأزل، وفي النهاية التي حصل عليها من الأجل، كان معنى مقرورا بين حواصل الزلل، وبينهما كان لفظا مشاكسا يجاري الظلام في إغرائه، ويحاكي النور في إخفائه، لأنه ومهما غنى بلبله على فنن الوجود المتلف على علته، فإنه لم يجد محط قدمه بين الديار التي ارتحل على رمادها قهرا، وانحاز إلى سرابها قسرا، وانتحل في إرضائها أوكد ضروب صفاته، وأنبل نعوت لذاته، لئلا يعيش بين هوج الرغبات غريبا بلا هوية، ويحيى منكوبا في علاقته بذاته، وفي روابطه بغيره. فهل كان القدر معاندا له حين فرق ذكرياته بين الأماكن المطلولة بنجيع شقائه، ونقيع عنائه.؟ إن هذا الغور هو ما يثير لدى السارد تساؤلات تحتاج إلى دقة المواجهة في البحث عن خيوطها، وحدة المغامرة في الإجابة عن ظروفها، وإلا كانت سببا لتأويلات قد لا تنفذ إلى مضمون حياة بشرية اعترض سبيلها ألم المناكب المسعورة بحمى الطلب الأجلب، ولا تصل إلى إدراكات ربما تنفرد بمجموعة من الخصائص النفسية، والمزايا الروحية، أو ربما تستقل بجملة من سماتها المكبوتة، ولذاتها المستورة.
قد يكون هذا مغريا على البحث في حياة ابن الفقيه الذي يطويه الدهر بين تلافيف ظلامه، وتلاوين سواده، وهو عنوان على كل من عاش التجربة نفسها، وأصابه ما ناله من أوضارها، وحازه من أدرانها، ولم يكن له بد من مكابدتها، ومجاهدتها، ولا عوض عن منازلتها بمنتهى أمله في زوالها، وفنائها، لأن تشابه الأطوار، وتشابك الأدوار، قد يجمع النقيضين في غاية من الغايات، أو في مرام من المرامات، فتتوحد النتائج في القصود المرتجاة بحد من الحدود، ولو اختلفت البدايات التي تبني أس العلاقة مع الذات، والأغيار. لكن صوارف الأحداث التي تعتري المكين بين طيات الأماكن المجللة بالقلق، والحيرة، والسؤال، لا تأتي دائما بما يبهج الأوقات، ويسر بمطلعه المسارات، لأن خبايا المجهول عديدة، وقضايا محدثاته مديدة، وهي لا تودع مزورها إلا لكي تخلف فيه بثورا، وتنجب فيه كسورا. تلك هي الحكاية التي أرقت مضجعه، وأحمت مجثمه، وصيرته فسيلة كسلانة في يد شلاء، ووردة يتيمة في فلاة جدباء، إذ ما دبر القدر سببه، لا يمكن أن تبدد علته، لأنها تقوم به في أصله، وما عساه أن يكون نازفا عنه من فروعه، فما هو إلا على سبيل القلة، والندرة. ومن هنا، لم يكن ابن الفقيه مفرد علم في افتقاره إلى مكمن يدرأ عنه غوائل الزمن الكاسر، واحتياجه إلى مأمن يحميه من سبة الحظ الحاسر، بل يقابله في البشر ما لا حد له، ولا حصر، إلا أنه شرب مرارة الألم في صباه، وتذوق جرعة الحزن في حماه، وما زالا يمتعانه بما يحس به بين الديار من غربة، ووحشة، لأنه لم يكن البكر الذي تلقف ثدي الحياة في صغره، ولا الطفل المدلل بين دروب نشأته، لكي يصير حفيا بما ناله، وبهيا بما شمه من روائح تبدد عبقها بعد رفض الزمن العنيد الوفاءَ للأصل التليد في معنى الوجود، وحصره للمكارم في قوة الامتلاك، وقيمة الرفاه، ومعنى اللذة. بل ما أشقاه حين يبحث في حدة ذاته عن تلك اللحظة التي أحس مع أبيه بطعم الاستقرار، وشعر بأنه حط عصا التسيار بواد من الأودية المتوحلة بنكد العيش، وضنك الرزق. لم يكن ذلك مصير أبيه فيما قضاه من زمن بين المجالب التي أودت ببهجة عمره، ومهجة حياته، وأنى له أن يكون سبيله إلى ما لا يأتي إلا من محله.؟
لقد كان هذا قدرا مقدورا على أب يرتحل بين المداشر بحثا عن ريق يبتلعه بنهمة، وبُلغة يزدردها بنكهة، لعله يحمي ذاته من الزوال، ويقي أسرته مما يحتمي بين الأماكن من غوائل الإقلال، لكن أنى له أن يصل إلى ذلك الأمل المترع بطمأنينة البال، وإن وصل إلى شيء من ذلك الرجاء المأمول، ورضي بما حصَّل عليه من بلالة، فإن ما غرسه في قاع ابنه من وقائع صامتة، قد صار مع رديء الحلم جرابا يحتقب بؤسه بين المطالع، ثم استحال حكاية غريبة، يدونها باشتهاء ألمها، وهو ينتقل من مكان إلى مكان، ويرتحل من محطة إلى محطة، وكأنه ما وجد إلا ليعبر عن لحظة العبور التي ظهرت له فيها أشياء مغرية، وغابت عنه معان جمة في واجب الإقدام، والاقتحام. وشأنه في طي ما انطوى عليه العضد من قوة، وما التوى في الزناد من خوار، هو شأن ذلك المتاع الذي لا يستقر بخربة من الخرب، أو بسجن من السجون، إلا وطالبه الرحيل بعهد الترحال، وصارمه المكان بما يقطع دابره في الأمان. إذ لو كان لارتحاله بين الأماكن معنى يبني في الذات شدة المراس، لاستساغ لقيمة عيش يبتلعها مرة مُرَّة، وتارة حارة، لأن ما كان سببا في مفارقة محل تلاده بعد شهور عدة من ولادته، هو الذي ساقه إلى قرية العزيب بإنشادن، ومن بعدها إلى قرية سيدي ميمون، ومن بعدها إلى قرية القليعة، ثم يمتد ذلك الحبل إلى زمن امتلاكه لصوت قراره، ويستمر إلى حين وقوفه عند حافة العناء، وهو يتبلل بشيء من الكسور التي لا لذة فيها عند قصر حريته على كرامة الموارد، وحرية المعاهد. لكن أنى له أن يفارق هذا الطريق المحفور في عمق ذاكرته الفردية، والجماعية، وهو لا يمتلك إلا لحظة يصنع جمالها لغيره، ويهب بهجتها لمن يجد في كلامه تنفيسا عن أوام صدره المفجوع بنحيب الحسرة، عساه أن يستفرد بشيء من الأمل الذي يخبو في سعير عمقه، ويستهدي به إلى أطياف أمنيات لا يكاد يصارحها إلا همسا عند إغماض عينيه، وإحساسه بنوم العيون الرقيبة لخفقان أوردة جسده، وحركات نياط عقله. لكن أليس من حقه أن يتموج بما يطفح من رخاء على جباه أقرانه، ونظرائه.؟ بل ألم يكن من واجبه على الزمن أن يهديه وردة باسمة، وبسمة حانية، لعله يتنفس الصعداء بين عوالم الأحلام الوردية، فينظر إلى الأفق البعيد بعين يستوطنها طائر العشق، والشوق.؟
ربما يغدو هذا متنائيا في النظر القريب إلى أصل علة الفقدان، والحرمان، لأن مقتضى الحكاية أن تبتدئ بمقدماتها الضرورية، ثم تنتهي بنتائجها الحتمية، لكي يكون خيط تسلسل الأحداث منطقا يحكم غاية بناء حقائقِ سياقها في الوظيفة الفلسفية، والأدبية، لكن ما يستوحي ذكر أسٍّ تقوم عليه نفسية ابن الفقيه، هو إحساسه المفعم بالحزن على مصير لا يضمن خيارَ استمراره ضامن، أمين، لأن مفارقته لمهده الأول الذي غابت سماءه بين ظلمة الغربة، لم يكن إلا لكون أبيه قد ودع قريته التي ولد في خريفها مجللا بنوء السعد، وفارقها بعين تضمر حبا رسى في غوره، وطُوي في عمقه، وغدا من شدة الحرص عليه مأمنا واقيا، يأوي إليه من شعر بفقد سر المدينة، ولم يبق له إلا ما انصرم من مجد البادية، وانجدل من لحظاتها الباسمة. لكن لازم الزرق قد استوجب التضحية بصلات الشجر، والحجر، وهبات الزرع، والضرع، واستلزم التنائي عن ديار تعفرت طبيعتها بأوحال الحقيقة، والخيال، وتبلبلت بأصوات الجان، والإنس، وتزلزلت بهزيم الرعد، والرياح، لكي يخب بين دروب السراب الملتوية بين الأماني الفارغة، وينتشي بما تلبد على السماء من ألوان شاحبة، فيكون أجدر حظا بوصل ضروريات الحياة بحبال الاستكانة، والاستسلام. وذلك ما حدث، فقد قاده الخوف مما طرأ على قريته "إبرشان"(1) من غدر وقتل إلى متسع في الفضاء المترامي بين عينيه الغائرين، ربما قد تتيسر فيه بعض سبل الرزق الكأداء، ولو كان محدودا بما تتطلبه خِطته من تكاليف، ومشاق.
ومن هنا، فإن الاستقرار يكسبنا هوية الأرض التي ولدنا على بساطها بلا حمل يثقل كاهلنا، ويتعب عاتقنا، ويمتعنا بما فيها من صفات، وهيئات، وأصوات، ويركب في أعماقنا ما يمر عليها من أوقات، وذكريات، وحكايات، لأنها هي المرفأ الذي نغدو ونروح عليه سراعا، ونجتاز طرقه وسبله خفافا، والملجأ الذي نحتمي به عند احتدام العراك بين الإرادات القوية، واشتداد الصراع بين الرغبات الدوية. فهل أحس ابن الفقيه بهذه الهوية الدفينة في سهوب نظره المتطلع إلى ما هو أبعد من التشبث بقصة المكان، دون ما يثمره الانتساب إليه من عز، ومجد.؟ أم أيقن بأن انتماءه إلى الأرض، لن يكون صليل صوته، إلا تعبيرا مجازيا عن استحقاق الفرع لبطاقة الأصل، ولو لم يتم وصل الزمان بالمكان المستحضر في الذاكرة الواقية لذاتها من النسيان.؟
كلا، إن ما يؤلمه في كثير من شظايا فكره المتوقد بالآلام الخابية، هو نسيانه لكثير من الذكريات التي لا ينظمها نظام المكان في ذاكرته الشخصية، وإن تعرف على بعض دروبها في الزمان المتعري من قيود الذات، وآصار الأفكار، لأن مهده الأول الذي فجر حقيقة الوجود عند إيجاده بين أسارير الطبيعة، لم يستحضر فيه إلا لحظة سارحة بين هباء العماء، لا يكاد يتذكر منها إلا بصيص نور يضيء له دربا في القرية، وفرعا في الأسرة، ومعنى في الحقيقة، وما عداه من المهاد التي غازل فراشُها لحظات في حياته، فقد أدرك بعضا مما تدل عليه في قراره، وما تبقى من فصول الزمن المنفصل عنه، فقد توارى وراء الحدثان، وتدانى إلى الكتمان، واكتفى بما تواتر عن الناس من روايات، وحكايات. كل ذلك لا يضر عدم دركه، ولا يُعدي غزو جهله، لأن استيعاب التفاصيل في العادات، والتقاليد، والأعراف، يمكن له أن يصوغ مناطات الترحل الفكري والمعرفي في سياقها الزمني، ولو انتفت علة المكان عما يرومه في حكايته من أغراض، وأعراض. ولا غرابة إذا نشأ ابن الفقيه بين رحلات فارقت بين مهاده، وعارضت بين أكنانه، لأنه لم يسم بهذا الاسم الذي أراده أن يكون عنوانا عليه، ولم يحبذ أن يتصف به بين فتور أمواج حياته، إلا لأن أباه كان فقيها مرابطا في عرف البلد الذي نشأ عليه بالجبلة، وقائما على أداء الصلوات بالعامة، وإقراء الأطفال في المحضرة، وإعمار أماكن العبادة بالذكر، والتلاوة، وإقامة شعائر الغسل والدفن للأموات احتسابا للمثوبة، وحضور الولائم في الأعراس والمآتم تخلقا، ورعاية.
وإذا كانت هذه مهمة أبيه في ترتيب وضعيات استقرار رزق عائلته، فإن واقع الحقيقة يؤكد عكس ما هو متصور في الأذهان التي تُحرجها مخاضات الحقيقة الغامضة، وتنحاز في صياغتها إلى ما هو جاهز في الأحكام، والآراء، لأن جفاء الحال، وقلق البال، لم يدعا لذلك الشبح ملامح يجوز لنا أن نقرأ منها صولة التاريخ في بنائه للحياة الآمنة، وقوة الإنسان في اندماجه مع المحيط الذي يفارقه حين يكون هم رعاية الأبناء بمقتضيات التمدن غضة أليمة، وغصة حبيسة، إذ انعكس على الذات ما خشن في المقام، وخبث في الأنام، فلم يكن الدليل على الأثر قويا، ولا المعنى واقعا على الحقيقة المدبرة بالمتعذر المحال، لأن الالتفاف على مظهر واحد في السيرة الاجتماعية، لا يتأتى إلا إذا كان المظهر هو المطلوب في الغاية، وكان الكامن في النيات غير مرغوب بين القصود المبثوثة، إذ الالتزام بالحد الأدنى الأعلى في التكليف الاجتماعي، هو ما ضمن الحرية، وأكسب الاستقرار، وإلا، كان الاستمرار بالتنوع بين السبل مستحيلا، إذ المرتجى في إثبات الكيان المحدد لمظهر الشخصية، هو السير إلى جانب المصالح المشتركة في المألوف الاجتماعي، وإن كان ما تتضمنه من غرابة غشاء يدس في حنجرته سر إفلاس دلالة المعنى على المراد به حقيقة.
ومن هنا، فإن ما يلتئم حول ابن الفقيه من معان أجبر على ابتلاع حرارتها، والتهام مزازتها، هي التي كانت مظهرا متساميا في ترقوة أبيه، لأنها تبرز عند انحسار الغطاء على وجه المعنى الذي أثبته كل واحد فيما هو متغير، وانصهاره مع ذاته التي لا تنفرد بشيء أعظم من خصوصية التعقل، والتبصر. وإلا، غدونا بدون ميزات تميزنا عن غيرنا، وقيم تحصننا من سوانا، لأنها هي التي نمتلك في صيغة الوجود الحق، ولو كانت صورة بسيطة للبراءة التي نحلم بها خلسة، ولا نحكي عنها إلا همسا، أو نجوى، إذ هي نحن كما وجدنا عليه في أصلنا الفطري. كلا، بل تتضمن ما اعتصرناه من ذواتنا، وما انصهرنا معه في واقعنا، وتحتوي على تلك النهاية التي نخط بها مصائرنا، ونبني بها مستقبل الذكرى، والحكايات. فهل ابتعد ابن الفقيه وأبوه عن هذه الومضة الحارقة، وهي تجسد القيم العليا لما ترغب الذات في الوفاء له.؟
لم يكن هذا مستعصيا على الإدراك البشري، ولا مستعظما في التعريف الاصطلاحي، لاسيما إذا جعلنا البشر سواسية بلا تفاضل، ووقفنا في حدود رأينا الشخصي عند بداية ما يتترس به الغير من حصون حريته، وانعتاقه، لأن الهدف المشترك بين كل الناطقين باسم العقل الأسمى، هو الوصول إلى هذه اللحظة الجميلة المغنى، والتمتع بما ينفجر فيها من سعادة، ومعنى، وإلا، فقدنا سر الوجود في التأمل لهذا المحيط الكوني والإنساني البديع، وهو كل معنى نبلغه بجهدنا، وفيه أسرار حقيقة ذواتنا. ومن هنا، فإن ابن الفقيه يتذكر في رسوم حياته تلك اللحظة التي تزيح عن أبيه غمامة الخوف، فينزاح إلى مكنون ذاته الذي أخفاه انتسابه إلى فئة يُعرف عنها الزهد، والورع، فيسرد تعبه في حرز رشح الموارد بين أيدي العامة، ثم يرسل شهقة بصوت الأنين الذي يغشى الثكالى، والعطشى، وأحيانا يرحم ذاته، فيبحث بين إضبارة التاريخ عن حنان الأعين، وسلام الألسن، لعله يلمس شيئا من الشفقة على عائلته التي انجتعت منتجعا قل الرابح فيه؛ وهو إما فائز بدنياه، وإما خاسر أخراه، وظافر بأولاه، لأن اعتقاد الأب بأن للمكان المقدس على الأرض التي يمشي حولها الناس مدفعان مصيبان في رميتيهما: واحد مصوبة فوهته إلى الداخل، والثاني إلى الخارج. فإن تصدعت العلاقة في ظاهر الأحوال المعرية لباطنها، كان من نال مفتاح المعبد وسدانته المصاب في ذاته برمية الداخل، لأنه المعني بسوق العباد، وكيف يسوق من يساق.؟ وإن فقدت آثار الاجتماع حول مائدة الطهر في الخارج، كان المهدد بالشقاء أهل الخارج، لأن غاية الاتحاد في الشعائر المهداة للسماء، هو ما تفيده في بارز سيرة الحياة، وآرائها، ومواقفها، وما تبنيه من أسس الفضيلة، والمثل العليا، كل هذا، قد يصير ثقل المهمة صعبة في الوصول إلى الحقيقة، وشرسة في النتيجة. إذ الهدف هو الصدق في نية الحركات، والسكنات، وإلا استحالت شعيرة العبادة فراغا ينتج الصراع حول الاسم، ويفقد المسمى، ويصير شأن الدين، هو الاختلاف، لا الوحدة.
لعل ما انبثق في الدائرة من ارتباط بحفاظ القرآن الكريم، والتزام بتكاليف التاريخ في استمرار الإحساس بميزة الأسرة الكبيرة، وسواء ما ارتبط بالذات في حدود حريتها بالقول، والفعل، أو ما اترتبط بالجماعة من مظاهر يكاد لونها يكون أبيض مثل الحليب، لا تنكت فيه نكتة سوداء، إلا وأظهر جمال الهيأة قبيحا، وحقيرا، لأن سمت الحِرَف في المشهود منها قصدا، هو الوقاء الذي يبرز الاختصاص، والتخصص، وإلا، كانت الأشياء متساوية في نسب مظهرها، ومتقابلة في أشكالها، وغدت معانيها قابلة للابتذال، والانتحال، لم يمهل ابن الفقيه في أن يختار سبيلا غير الذي ترقب حدوثه، ولا في أن ينتحي طريقا سوى ما دفعته إليه القدرة الأزلية، فكان كما كان أبوه، وكما كان جده، وكما كان أجداده في التاريخ المسطور بين طيات الصدور، والسطور، لأن الابن كسب أبيه في الطبيعة الوجودية، وهو في عينه خلاصة لما يروى من حكايات عن أجداده الشامخين تحت القباب المنتشرة بين حاحا، وسوس.
لكن ما يشترك فيه مع أسلافه الذين خاضوا التباس المعاني بوعي جلاَّه الأثر الموروث، هو سيره على الدرب الذي ألفاه بعد زمن قصير بصورة أخرى، لا تبوح بما في روحها من شجوى، وشكوى، بل تشظى الحلم بين الموارد الظلماء، وتمزق الأمل بين زحمة الأماكن المبهمة بالصراعات العجماء، فلم يتذكر سوى ما كان يقوله أبوه في لحظات إحساسه بحرج المواقف التي يندفع إليها عند حدوث أعراض الندم بين أغواره: يا بني؛ وهذا لطف منه في وقت يبتدع له أيسر الكلمات، وأعلاها إفادة بالمعاني المحررات، لأن القسوة في القبض على الأشياء الممنوحة قهرا، أو غلبة، هي السر في تربية البادية، والعلامة التي تضمر رقيق المشاعر، ودقيق الأحاسيس، إذ هي حصيد ما نتعلمه من مكتوم صمت الجبل الشاهق بأكنانه، وأعشاشه، ومكنون حفيف الأشجار المنشدة لقصص الإباء، والشموخ، لأن عتمة السهول تعريها رخاوة الطبيعة، وليونتها، وطراوتها، لكن ما تشبث به الإنسان من حماسة على قنن الجبال الشماء، هو الذي تهدى له مهج الأرواح، لأنه مزيج من الفتوة، والغيرة، والخوف، والفرح، والأمل، إذ المعتقد في حرص الديار على فتل حبل الانتساب إلى تواريخ الأماكن، هو قول من قال:
فقسا ليزدجروا ومن يكُ حازما * فليقْسُ أحيانا على من يرحم
يا بني؛ إن كسب الرزق بهذه المهمة صعب المراس، إذ هي لا تقبل ما يكون جائزا في غيرها، بل تكليفها يبتدئ بخروجك من ربعك، وينتهي بعودتك إلى غموضه، وإن عدت إليه، وطواك الظلام بين أحشائه، كنت صريع ذاتك، وحبيس نظرك. كان هذا الكلام موجزا لتفاصيل مهمة في السلوك الوعر المراد، لم يدركها ابن الفقيه إلا حين فاجأته الرزايا برمية أقواسها الموتورة، فلم يبق له إلا الاعتراف بسر الأسلاف القدماء، وهم أهل ناموس، وحكمة، ووصايا، وذوو مروءة، وشهامة، وشجاعة.
ربما قد يكون هذا اغترارا في باب الاغتراب، لاسيما إذا صاغ كل واحد منا مجدا مزيفا لتاريخه، وبنى هشيش ذاته على حطام أوهام تجرجرها النفوس الكاسدة، والعقول الخامدة، لأن شرف التاريخ بزة لمن زادته جمالا، وسناء، وطلعة بهية لمن تدفق منه نبع النبل، والفضل، لكن ضائع الأصل بين الديار المرتفعة أسوارها بحماية الأنساب، والأحساب، لن يسرق من كيس الفضائل إلا ما يخفي علته، وينفي وجعه، لأن ربط العجز بالحاضر، لن يستقيم في مناهج الاستدلال على قدرة الإنسان الممتدة في الأزمنة، والأمكنة. فلا غرابة إذا صنعنا من رماد الزيف تاريخا يحرق صمام امان ذواتنا، ويقلع أصول الأشجار التي شربت حميا أرواحنا، ويهدم منابت الأحجار الناطقة بأصواتنا المقرورة في سابق الحكاية، ولاحقها، لأنها الوجه الأفصح عن لزوم الإبقاء على الديار بصون صوت التاريخ في الإنسان، والطبيعة.
كان هذا مفضيا إلى حقيقة من حقائق نفس ابن الفقيه المنطفئة، ومؤديا إلى درك معلم من ملامح شخصيته العنيدة. فهو لم يحظ في تمرده بما يغذي به الاستقرارُ هذا الكائن البشري من روابط، وعلاقات، وصلات، بل تفرقت حياته بين الدور، والدروب، والمداشر، وتمزقت ذكرياته بين المشارطة، والهبات، والصدقات. لكن ذلك، ومهما كان حالا ضروريا لولادته في حضن أسرة عرفت بحفظ القرآن، ودرك المتون، وشهرت برسوم الولاية، ومظاهر الصلاح، فإن التصاق الأبناء بالآباء فريضة قائمة في استحقاق إرث الأصل بفرع البنوة، ونسبة محمودة في كسب أمثولة خصوصية الأبوة، إذ مقتضى الانتماء إلى عرش من عروش دوحة العائلة البشرية، لا يكون حقيقة مرغوبة في العقول السليمة، إلا إذا وقع الحافر على الحافر، وكان الابن مماثلا لما هو قيمةٌ معتبرة في الأصول، والفروع، لأن نسمة المناقب الكامنة في إثبات نظافة النسب، لا تقوم بنا إلا إذا كان سرب الأبناء حاميا لفضائل الحسب، وإلا، غدا وخز العرض مدحا، لا ذما. ومن هنا، فإن تجذر هذا المعنى في قلب ابن الفقيه، لم يدع له اختيارا في حرز السبيل الذي ينعطف إليه عند اشتداد الملمات، واعتراك النيات، ولو لم يكن لإحساسه أي معنى في ظاهر الحركات، لأن ما يخطه من خطوط يكتشف فيها مراحل سيره، لم يكن مستوعبا إلا لما حازه من تفاصيل عن تجربته الخاصة، وناله من معان تزف إليه عوارض الانتماء إلى سيرة معينة.
ربما قد يكون بعضها مؤسسا على أوهام لن تتحقق إلا عند العثور على سر امتناع المحال عن الحلول في الذوات، أو ربما قد يصير ما فيها من حقيقة محل أمانه عند شعوره بما ينعش مظهر الظهور بصفات الاتزان، والاعتدال، إذ ما يوضح سبيل المنازل عنده، ويبين نهاية القصود فيه، ليس في الطريق الذي توقف الناس على شفيره، فمنهم من تجرأ بجرأة زائدة، وسار عليه بشجاعة فائقة، ومنهم من أدركه العجز عند تحديد الأماكن المباحة، والمحرمة، فقضى نحبه، ولم يظفر من صحراء الحلم بأمنية، بل فيما يشهده على جدران الزمن من لوحات تتضمن نص الإشارات، والرموز، والألغاز، لأن نهاية القصد في الطريق المفخم الغاية، هو مطلق السير إلى المراد الممزوج بلغة الكيان، والبيان، وسر الزمان، والمكان، لا تحديده بمعلم من المعالم، أو بموقف من المواقف، وإلا كان رحلتنا واحدة، وسفرتنا غير مقصودة، إذ ما نكتب به سيرة السعي إلى الأمام، هو الأصل في النظر العقلي، وما عداه من رحلات بين الأبعاد المتنائية الأمشاج، فمن استحسنه برأي عقلي، فهو لا يريد إلا أن تكون الغاية دالة على الوسيلة.
والناس برءاء في الذمة على التحقيق، ومستأمنون في عهود المواثيق، ولا ينحرف بهم عن الجادة إلا سوء النيات، ورديء الفعال. ولذا، فإن تبين رسم النهايات في البدايات، لم يكن إلا جبرا خاض ابن الفقيه وحله، وواقعا لبى نداءه، لأنه لا يدل إلا على سؤال همس به شوقه حين بحث عن الفحوى، والجدوى، ولا يستجن إلا صورا تراكمت تجربتها على الذات الممتحنة، فصار محتملة لما يعتريها من رعدة، وقشعريرة، إذ ما حصل به التمايز في الإدراك العام للإنسان، هو ما قامت عليه نوبات الوجع من أسرار، وأخبار، لأنها في حقيقتها الجامعة لكليتها سران؛ سر يشمله في ملكات باطنه، وسر يذود به عن حوزته، ويقيم به أود كسبه، لأن تعدد الآراء في كل مسار، وتنوع الروابط في كل مساق، هو الذي يشير إلى حظنا في نوال الحرية، وينهي إلينا علم ما يجب أن يكون قرارا لكل واحد توقف به العقل عند حدود لحظته، وزمنه. وما لم يكن ابن الفقيه واثقا من قيام علاقته بالزمان، والمكان، فأنى له أن يصادف شقاء السؤال بين الأفكار المتناقضة، والآراء المتنافية، لأن ضياع سر الارتباط بالزمن الذي يثبت أصل الوجود، هو الذي يتوه بأحلامنا بين أودية صامتة، لا يزفر منها إلا صوت الرعد، والزمهرير، ولا يصدح فيها إلا لحن الفراغ، والضياع، كلا، بل يذرف فيها السالك دموعا مدرارة، فيحسب أن حظه في المقام هو هذا القفر الغض بعويل الجان، والموتى، والبض بشحوب الأشباح، والأرواح. تلك هي معاني الحكمة في الحكاية التي عرفنا سر استقرارها في حركتها الجامدة، وحوينا فك لغزٍ فيها بما سمعناه من همسها المحاكي لهدير الحمام، ونعيق الغربان.
(1) قرية إبرشان من أعمال جماعة إيداوكرض بحاحا الشمالية الغربية، إقليم الصويرة. وهي محل ولادة راهب الحرف، وكاهن الغموض.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. الجيش الروسي يستهدف قطارا في -دونيتسك- ينقل أسلحة غربية

.. جامعة نورث إيسترن في بوسطن الأمريكية تغلق أبوابها ونائب رئيس

.. قبالة مقر البرلمان.. الشرطة الألمانية تفض بالقوة مخيما للمتض

.. مسؤولة إسرائيلية تصف أغلب شهداء غزة بالإرهابيين

.. قادة الجناح السياسي في حماس يميلون للتسويات لضمان بقائهم في
