الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
كتاب سمير قصير عن -حرب لبنان من الشقاق الوطني الى النزاع الاقليمي-
سمير قصير
2007 / 11 / 4قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
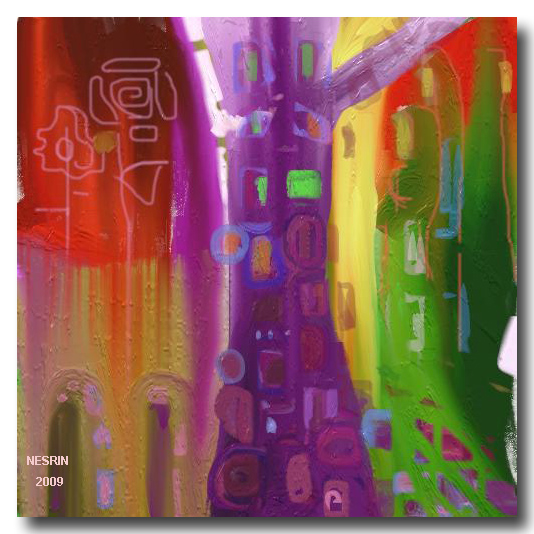
يصدر قريباً في العربية، لدى "دار النهار"، كتاب سمير قصير عن "حرب لبنان من الشقاق الوطني الى النزاع الاقليمي"، ترجمة سليم عنتوري. في ما يأتي فصل من الكتاب:
ليس من غير المألوف سماع سياسيين لبنانيين ولاسيما منهم الذين وقفوا إلى جانب المعسكر المسيحي المقاتل، يؤيدون وجهة النظر القائلة بأن مأساة لبنان لم تبدأ في 1975 بل في 1969، تاريخ إضفاء الصفة الشرعية على وجود المقاومة الفلسطينية. ولا شك في أن هذا التأكيد لا يعبر عن حرص على الدقة التأريخية، بقدر ما يكشف عن حوافز جدالية تتجه إلى تبرئة الذات وتحديد "المذنبين" البارزين أي الفلسطينيين، و"المذنبين" الثانويين، أي المسلمين اللبنانيين. ويقلل بالتالي أهمية الديناميكيات السلمية التي استمرت في الفترة من 1969 إلى 1975. وتبقى هذه الفترة، كما سبق القول، العصر الذهبي للإقتصاد اللبناني، وعصر الإبداع الكبير على الصعيدين الثقافي والإجتماعي. لكن من المتعذر تجاهل هذه المسألة، أيا تكن درجة المواربة فيها، لأنها تكشف ملامح المنعطف الذي شكله العام 1969.
وقد نجم هذا المنعطف عن اتفاق القاهرة الذي أبرم بين الجيش اللبناني ومنظمة التحرير الفلسطينية. لكن أهميته لن تتضح إذا ما اقتصر النظر إليه على مستوى العلاقات اللبنانية - الفلسطينية. فأزمة 1969 تضمنت رهانات لبنانية بحتة، لذلك اعتبرت أزمة وطنية. وحصل الأمر نفسه مع أزمة 1973 التي تمحورت حول مسألة الوجود الفلسطيني، ولم تكن أقل أهمية عبر استقطاب الطبقة السياسية اللبنانية. وأدت من جهة أخرى إلى إعادة طرح مسألة اقتسام السلطة على بساط البحث، وسرعت من وتيرة الخلاف على النظام. ولا تدين هاتان الأزمتان بطابعـهما الوطني، إلى المعترضين وحدهم على الوضع الدستوري الراهن، الذين وجدوا أنفسهم أنصارا للوجود الفلسطيني وخصوم هذا الوجود أيضا، والذي أجج تصورهم لتهديداته الداخلية على المجتمع اللبناني، من حدة رفضهم إياه.
تداخل الصراعات
وحمل اندفاع التضامن الذي فجرته المقاومة في المجتمع اللبناني وتجلى بصورة رمزية خلال جنازة خليل الجمل، على التخفيف فورا من حدة الصراعات اللبنانية - الفلسطينية، التي لم تكن تشمل، كما يقتضي التنويه، الطبقة السياسية اللبنانية بكافة انتماءاتها. لكنها أضيفت في المقابل إلى الإنقسامات اللبنانية. وفي استطاعتنا القول إن هذه الإنقسامات الوطنية هي التي زادت من خطورة الصراعات اللبنانية - الفلسطينية وفي المقام الأول من التناقض بين الدولة والمقاومة.
تضارب مصالح
وقد تميزت العلاقات بين الدولة والمقاومة بالارتياب المتبادل، لا بل بالعداء، منذ بداية النضال الفلسطيني المسلح في 1965. وحاول الجيش في تلك الفترة اعتراض الفدائيين الذين كانوا يريدون شن عمليات عبر الحدود مع إسرائيل. ولم يزدد التوتر إلا حدة، بمقدار الأهمية التي اتخذتها المقاومة الفلسطينية بعد حرب 1967. وسرعان ما تخطت إطار المنطقة الحدودية التي أقيمت فيها قواعد فلسطينية على حساب السيطرة التي يمارسها الجيش، ووصلت إلى مخيمات اللاجئين على مجمل الأراضي. فاصطدمت إرادة حركات المقاومة في تنظيم القاعدة الشعبية برقابة صارمة من الشرطة. وكان ذلك التصادم شبه حتمي، حتى بغض النظر عن الإعتبارات الإيديولوجية. فلم يكن في وسع الدولة اللبنانية التأقلم تلقائيا مع تهديد سلطتها المنبثق بفعل الواقع من وجود مجموعات مسلحة على أراضيها، فيما كانت المقاومة تحتاج إلى ترسيخ حضورها في كل مكان متاخم للحدود مع إسرائيل ويضم تجمعات من الشعب الفلسطيني. وقد نجمت أزمتا 1969 و1973 أساسا من هذا التضارب في المصالح. ووافقت الدولة رسميا على وجود المقاومة الفلسطينية في لبنان، بعد أزمة 1969. لكن التسوية التي انبثقت من الشرعية الممنوحة للعمل الفلسطيني بقيت هشة طالما كان من الصعب الحفاظ على الإنسجام بين "منطق الثورة" و"منطق الدولة"، كما كان يقول كتبة الإفتتاحيات. والواقع أن تناثر الثورة المذكورة لم يسهل الأمور، وتضاءلت بالقدر نفسه إمكانية مراقبة المنافذ على رغم القيام ببعض محاولات التمركز كإنشاء قيادة النضال المسلح الفلسطيني في ربيع 1969 التي ستصبح عمليا الشرطة العسكرية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وزادت تركيبة المجتمع اللبناني والعلاقات المميزة التي كانت شرائحه تقيمها مع الدولة، من خطورة هذا التضارب في المصالح. وسبق القول إن المسلمين والجمهور العروبي عموما، كانوا يتضامنون تلقائيا مع المقاومة الفلسطينية. أما تنامي الوجود الفلسطيني المسلح فسرعان ما أثار لدى المسيحيين كثيرا من المخاوف. وقد برزت تلك المخاوف بعيد حرب 1967. ولوحظت في مستهل 1968 حملة صحافية استهدفت "الغرباء". لكن هذه اللفظة كانت تعني في هذا المجال الغرباء العرب، وتتضمن معاني بالغة السلبية بحيث يمكن مقارنتهم بـ"الدخلاء" حتى لو كانت دلالتها وصفية بحتة. وفي أي حال، فمن الثابت أن تلك المشاعر شجعت على تشكيل الحلف الثلاثي، أي تحالف الأحزاب المارونية، وفوزه في انتخابات 1968. ولم يؤد الإختلاف بين ردود فعل هذا الطرف أو ذاك إلا إلى زيادة حدة التناقض بين الدولة والمقاومة في السنوات التالية. وفيما ناضل فريق من الطبقة السياسية للتخفيف من القيود المفروضة على الفلسطينيين، مارس فريق آخر الضغوط لزيادة تلك القيود. لذلك حصل تحول في مسألة الوجود الفلسطيني والإنقسامات بين اللبنانيين. وستؤدي أزمتا 1969 و1973 الكبريان إلى الكشف عن الخطورة الكاملة التي كانت تنطوي عليها تلك الإنقسامات.
أزمة 1969
ظهرت أولى بوادر الإرتياب العلنية بالوجود الفلسطيني في لبنان، ابتداء من 1968، حين لم تكن المقاومة قد بلغت بعد مرتبة الوجود الشرعي في البلاد. ثم وجه المسيحيون انتقادات إلى رئيس الوزراء عبد الله اليافي الذي كان يعتبر من أشد المؤيدين للمقاومة. وفي سياق الغضب الذي تسببت فيه الغارة الإسرائيلية على مطار بيروت، اضطرت الحكومة إلى الإستقالة في 16 كانون الثاني/يناير 1969. لكن سرعان ما تبين أن المسألة ليست مسألة أشخاص، وأن المواقف من موضوع الوجود الفلسطيني تقاطعت مع الإنقسام الطائفي. وهكذا حض رئيس الحكومة رشيد كرامي مجلس النواب في بيانه الوزاري (31 كانون الثاني/يناير) على الإعتراف بحق الفلسطينيين في النضال من أجل تحرير وطنهم.
وما لبث الوضع الميداني أن بدأ يتدهور. وتتالت التظاهرات وأعمال الشغب والإشتباكات المسلحة في نيسان/إبريل، حتى أن الوضع اتخذ منحى تمرديا في طرابلس في تشرين الأول/أكتوبر، أسفر عن استقالة الحكومة الجديدة. ويضاف إلى ذلك، الضغط الإقتصادي الذي مارسته سوريا عبر وقف حركة المرور وغلق حدودها. وبعد بضعة أشهر، بلغت الأزمة التي أججها تعاقب الأحداث، منتهاها بتوقيع اتفاق القاهرة.
في هذا الوقت، شهدت المخيمات الفلسطينية ثورة حقيقية منحت المقاومة السيطرة على قاعدتها الإجتماعية. وتجاوز اللاجئون المأخوذون بالحماسة الثورية التي أثارها في كل مكان انطلاق الفدائيين، والمتلهفون لاستعادة حرية قمعت فترة طويلة، مسؤولي المنظمات الفلسطينية الذين لم يبسطوا سيطرتهم على المخيمات إلا في أعقاب تلك الإنتفاضة.
وشكل انقسام المجتمع السياسي اللبناني حول مسألة الوجود الفلسطيني، العنصر الحاسم في تلك الأزمة. وقد أدى ذلك الإنقسام، وإلى حد كبير، إلى تفجير الأزمة، لأن جزءا من المجتمع والدولة كان يمارس ضغوطا من أجل الإعتراف بحق الفلسطينيين في النضال انطلاقا من لبنان، ولأن جزءا آخر كان يرفض ذلك. وفيما تماهى البعض بالمقاومة الفلسطينية، ولم يتماه بها البعض الآخر، بات من غير الممكن حصر المشكلة بالعلاقات بين الدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية. فكانت النتيجة أن بدأت الأزمة لدى قمع التظاهرات التي حشدت في نيسان/إبريل 1969 المسلمين وأنصار اليسار المتحدين في دعم المقاومة. لكن ردود الفعل التي أثارها إقدام الجيش على قمع التظاهرات، أثبتت على الفور أنه كان عاجزا، على رغم فرض حالة الطوارىء وحظر التجول، عن السعي إلى فرض سيطرته على الفدائيين، بمعزل عن المجازفة بتفجير حرب أهلية قد تدمر وحدته. وتفشى الفساد الذي بات إذذاك محتوما، وزاد من انتشاره شلل الحكومة، أو بتعبير أدق، غياب الحكومة طوال تسعة أشهر، نتيجة قرار رئيس الوزراء المكلف رشيد كرامي الإحجام عن تشكيل حكومة قبل التوصل إلى اتفاق وطني. ووفَّر إبرام اتفاق القاهرة وموافقة مجلس النواب عليه بشبه إجماع (ما عدا أصوات ريمون إده ونواب كتلته)، الحل لتلك الأزمة. ولا شك في أن اتفاق القاهرة الذي أبرم في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1969، برعاية عبد الناصر، وحمل توقيعي كل من ياسر عرفات الذي أصبح قبل أشهر رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والعماد إميل البستاني قائد الجيش اللبناني، شكل اعترافا بالفدائيين. وأيا يكن التفسير الذي أعطي للإتفاق، فإن حق الفلسطينيين في ممارسة نضالهم المسلح انطلاقا من لبنان، حصل على الإعتراف الصريح. وحظر الإتفاق وجودهم المسلح في المنطقة الساحلية لجنوب لبنان، إلا أنه منحهم حرية تحرك كبيرة في العرقوب الذي كان بالتحديد المنطقة الأساسية لأعمال المقاومة. وخص الإتفاق منظمة التحرير الفلسطينية بنوع من الحصانة السياسية في المخيمات. والتدابير التطبيقية التي أقرت في شباط/فبراير 1970، فوضت إلى منظمة التحرير الفلسطينية، الصلاحية القضائية الكاملة على المخيمات الفلسطينية التي أفلتت بذلك من طوق السلطة اللبنانية.
وسعى وزير الداخلية كمال جنبلاط إلى الإستفادة من النفوذ الذي كان يتمتع به لدى منظمة التحرير الفلسطينية، ليرسم لها حدودها ويمنع تمددها إلى خارج المناطق المنصوص عنها في الإتفاق. وفرض قيودا على تشييع الجنازات، وحظر إطلاق النار ابتهاجا، وارتداء الزي العسكري في المدن، وفرض نقل المواقع العسكرية إلى مسافة تبعد كيلومترا واحدا على الأقل عن المناطق السكنية. ومع ذلك، ختمت الأزمة بحل موقت. ويبقى اتفاق القاهرة جزاء الإنشقاق الوطني، وبهذه الصفة، مصدر كراهية للذين لم يوافقوا عليه إلا باعتباره الحل الوحيد المتوافر. وخير مثال ما حصل بعد أشهر، في الهجوم الذي شنه على موكب فلسطيني عناصر كتائبيون في الكحالة (25 أذار/مارس 1970) والإشتباكات التي أعقبته في ضاحية بيروت. وإذا كانت السنوات الثلاث التالية لم تشهد مواجهات جديدة، فإن خصوم الوجود الفلسطيني لم يطمئنوا ويتخلوا عن أسلحتهم، كما يـثبت ذلك نشوء الميليشيات.
أزمة 1973
بين 1969 و1973 تغير وضع منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان تغيرا تاما. فبعد أحداث 1970 و1971 في الأردن، وغلق الجبهة السورية أمام العمليات الفدائية، أصبح لبنان منطقة حيوية، كما شددت على ذلك قرارات الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني في كانون الثاني/يناير 1973.
وبات لبنان عموما، فضاء الحرية الوحيد المتاح للمقاومة الفلسطينية. وتدفق إلى أراضيه أيضا المقاتلون الذين طردوا من الأردن، مع عائلاتهم أحيانا، وجاءوا ليضخموا كتلة اللاجئين "غير الرسميين"، أي غير المسجلين في لوائح الأونروا. لذلك، فتقدير عدد الفلسطينيين قبل 1975 لن يطرح مشكلة، حتى لو تبين لنا الآن أن تدفق اللاجئين الذي أعقب الحوادث في الأردن كان أقل أهمية مما دأبنا على كتابته.
وتفيد إحصاءات حديثة أن عدد الفلسطينيين عشية الحرب كان 289 ألف نسمة، أي ما يناهز 10% من عدد المقيمين، في مقابل 260 ألفا في 1972. وفي 1968، أي قبل اتفاق القاهرة، كانت مصادر الإدارة العامة للاجئين المنبثقة من وزارة الداخلية تقدر عدد الفلسطينيين بـ 223 ألفا (في مقابل 166 ألفا فقط مسجلون لدى الأونروا). وهذا يعني أن ارتفاع العدد نجم أساسا عن الزيادة الطبيعية التي يقدرها جورج قصيفي بـ 3،6%.
لكن الأمر الأساسي لم يكمن في الأرقام أو في التصور السائد عن الفلسطينيين، بل في كثافتهم التي زادت من وزنهم الحقيقي سواء في نظر خصومهم أو في نظر حلفائهم، وبالتالي في نظر قادتهم. وتلك كانت، أكثر من أي مكان آخر، حالة بيروت التي بلغ فيها تقدير عدد الفلسطينيين في مستهل السبعينات، 16% من عدد سكانها، وفق بعض الإحصاءات.
وكان الإنتقال من الأردن إلى لبنان انتقالا سياسيا في الواقع. واستقرت هيئات قيادة المقاومة ومختلف تنظيمات الفدائيين كلها في لبنان، حتى لو أن المقر الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية كان في دمشق. فمنظمة التحرير الفلسطينية كانت على وشك أن تصبح طرفا كبيرا في سياسة الشرق الأوسط. وسرعان ما أدت هذه الديناميكية إلى تجاوز الإطار الذي رسمه اتفاق القاهرة، خصوصا في جنوب لبنان وحول المخيمات، وأججت الكراهية التي كانت تعتمل في نفوس القادة العسكريين وبعض شرائح المجتمع اللبناني.
وقد أدت مجموعة من الإحتكاكات بين الجيش والمنظمات الفلسطينية إلى اندلاع أزمة أيار/مايو 1973. وزادت الغارة الإسرائيلية على بيروت في 10 نيسان/إبريل 1973 من حدة العداء بين الطرفين. فالجيش الذي لم يحرك ساكنا آنذاك للتصدي للإسرائيليين، أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط الإسلامية. وبعد ثلاثة أسابيع، تسبب حادثان صغيران تمثلا بتوقيف اثنين من الفلسطينيين المسلحين في مطار بيروت، وإقدام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على خطف اثنين من العسكريين اللبنانيين، في اندلاع المواجهة. وكشفت كثافة النيران التي أطلقها الجيش هذه المرة عن عزم على تصفية الوجود الفلسطيني المسلح. وبدأ عندئذ الحديث عن "أيار أسود". واشترك الطيران في المعركة ودك المخيمات. واضطر الرئيس فرنجية إلى التخلي عن مشروعه بسبب المعارضة التي واجهها. فالدول العربية ولا سيما منها مصر وسوريا اللتان كانتا تعدان لحرب أكتوبر، مارست ضغوطا قوية على الدولة اللبنانية. وحملت مصر الأمين العام لجامعة الدول العربية محمود رياض على التدخل، وأغلقت سوريا حدودها، على غرار ما فعلت في 1969. إلا أن خطة فرنجية اصطدمت بالتناقضات اللبنانية.
وكما حصل في 1969، كان قسم من المجتمع اللبناني وثيق التضامن مع المقاومة الفلسطينية. وتوافر مثال على ذلك التضامن بعد الغارة الإسرائيلية على بيروت في 10 نيسان/إبريل. فخلال تشييع جنازة القادة الفلسطينيين الذين اغتيلوا، نزل إلى الشارع زهاء 250 ألف شخص، أي أقل بقليل من 10% من الشعب اللبناني. وعلى غرار 1969، لم يكن ذلك التضامن شكليا، لكنه كان أيضا، وإلى حد كبير، تجسيدا لمشكلة بين اللبنانيين. وإبان المعارك، شوهد عناصر مسلحون من حزب الكتائب في بعض شوارع الأحياء المسيحية وعلى سطوح المنازل. وكان هذا الإنتشار يحصل أثناء حظر التجول وبترخيص من الجيش الذي يسود الإعتقاد بأنه فوض الميليشيا الكتائبية بصفة غير رسمية، مهمة تنظيم الدفاع عن الأحياء الشرقية لبيروت. وفي الجانب الآخر أيضا، شوهدت حواجز أقامها قبضايات التيار الناصري لحماية الأحياء الإسلامية القريبة من المخيمات، من تدخل الجيش. وشارك ناشطون يساريون أيضا في المواجهات إلى جانب المقاتلين الفلسطينيين. وقد يكون اقتران انقسام الطبقة السياسية حول مسألة الوجود الفلسطيني المسلح، في خضم الأزمة، بالتناقضات المرتبطة مباشرة بمسألة السلطة، أخطر ما في الأمر.
وفي سياق الخلاف على الوجود الفلسطيني، انقسمت الطبقة السياسية في الواقع حول قضية الجيش، لتصل بسرعة مذهلة إلى مسألة اقتسام السلطة. وتمثل الفصل الأول في تعاقب الأحداث، بعد الهجوم الإسرائيلي على بيروت، باستقالة رئيس الحكومة صائب سلام الذي أبدى في تلك المناسبة، معارضة شديدة لرئيس الجمهورية، حليفه منذ فترة طويلة، لرفضه إقالة قائد الجيش الذي اتهم باتخاذ موقف سلبي أثناء الغارة الإسرائيلية. وفي أعقاب استقالة صائب سلام، وجد فرنجية نفسه عاجزا عن استبدال شخصية سنية به، فاستدعى النائب من الصف الثاني أمين الحافظ الذي شكل حكومة لم تتمثل فيها الطبقة السياسية خير تمثيل. فقد استعان فرنجية بحكومة ضعيفة لإدارة الأزمة، وواجهت الإنتقادات فور تشكيلها، وقبل أن تمثل في مجلس النواب. وسرعان ما تحولت تلك الحكومة واحدة من عناصر الأزمة. وفي رأي المؤسسة السنية، بدت تلك الحكومة التي لا تمثلها وبرئاسة شخصية غير مكرسة، مؤشرا لاختلال التوازن في السلطة، أو بالأحرى مؤشر تحد. كذلك باتت استقالة الحافظ شرطا لتسوية الأزمة التي بلورت التناقض اللبناني - الفلسطيني والتناقضات الطائفية اللبنانية.
وانتهى فرنجية بالرضوخ لحجج المؤسسة السنية. وباستبعاده صائب سلام ورشيد كرامي اللذين كان اختيار أحدهما سيعني هزيمة حقيقية له، عين تقي الدين الصلح، الشخصية السنية المقبولة، ابن أخت رياض الصلح وأحد صانعي الميثاق الوطني. وحرصا على إرضاء الطبقة السياسية، ضمت الحكومة الجديدة أكبر عدد من الوزراء لم يشهده تاريخ لبنان. في هذا الوقت، لم يتمكن الجيش من فرض سلطته على منظمة التحرير الفلسطينية. وفيما كان قائد الجيش ورئيس الجمهورية ينويان على الأقل تقليص استقلالية منظمة التحرير، إن لم يكن القضاء عليها، أسفرت الأزمة عن نتيجة معاكسة تمثلت بتوسيع جوهري لاتفاق القاهرة عبر بروتوكول جديد عرف باسم اتفاق ملكارت (تيمنا بالفندق الذي أجريت فيه المفاوضات).
تنظيم الميليشيات
وتمخض اختبار القوة في أيار/مايو 1973 عن نتيجة أساسية أثبتت أن حالة الإنقسام في المجتمع والطبقة السياسية لا تتيح تحجيم المقاومة الفلسطينية أو بالأحرى تصفيتها، بمعزل عن تعريض البلاد لمخاطر كبرى. لذلك لم تفقد مسألة الوجود الفلسطيني شيئا من حدتها. وفي المقابل، ازدادت كثافة الحملة التي تناولت موضوع المس بالسيادة والتجاوزات الفلسطينية. لكن بعض المؤشرات يحمل على الإعتقاد بتوافر حلحلة ما. كالحوار الذي بدأ رسميا بين حزب الكتائب ومنظمة التحرير الفلسطينية والتقارب بين الرئيس فرنجية وسوريا بعد حرب أكتوبر، واختيار فرنجية مندوبا عن جميع الرؤساء العرب إلى الدورة الخاصة للجمعية العمومية للأمم المتحدة حول قضية فلسطين في تشرين الثاني/نوفمبر 1974. لكن هذه العناصر لم تخفف من وتيرة التعبئة لدى المسيحيين. وفي مستهل 1975، اتخذت الحملة على الوجود الفلسطيني منحى أشد تصعيدا عندما رفع بيار الجميِّل رسميا إلى الرئيس فرنجية مذكرة انتقد فيها التخلي عن سيادة الدولة، ثم طالب، بالتنسيق مع كميل شمعون، بإجراء استفتاء حول المسألة.
وقد اقترن الحجم الكبير لتلك الحملة بالإعداد الميداني النشط الذي أثبت أن خصوم الوجود الفلسطيني فسروا بطريقة محددة نتائج أزمة أيار/مايو 1973. وأدركوا على ما يبدو أنه إذا لم يكن الجيش قادرا، لأسباب سياسية داخلية وخارجية، على فرض سلطته على المقاومة الفلسطينية، فثمة وسائل أخرى متوافرة لا تمر عبر المؤسسة العسكرية إنما عبر التعبئة الشعبية. فبدأت تنمو الميليشيات الشعبية المرتبطة بالأحزاب المسيحية، بفضل دعم أغدقته قطاعات واسعة النفوذ في الجيش، على أعلى مستويات رئاسة الأركان وأجهزة الإستخبارات.
ولم يكن وجود الميليشيات المنظمة إلى حد ما ظاهرة جديدة بالكامل في الوسط المسيحي. فقد كان حزب الكتائب الذي استوحى اسمه من المنظمات الفاشية الأوروبية، منظمة شبه عسكرية منذ تأسيسه في 1936. وكان ينظم كل سنة في ذكرى تأسيسه استعراضا باللباس العسكري في شوارع بيروت. وشاركت هذه القوة التي كان الهدف من إنشائها في البداية التصدي للشيوعيين والقوميين السوريين، مشاركة كاملة في مواجهات 1958. وكان لدى حزب الطاشناق الأرمني جناح شبه عسكري. لكن الظاهرة لم تبدأ في الإتساع إلا في أواخر الستينات بالتزامن مع بزوغ فجر المقاومة الفلسطينية في لبنان. وعمد التنظيم شبه العسكري للناشطين الكتائبيين إلى تدريبات أشد إتقانا. وفي العام 1973 كانت الميليشيا الكتائبية، كما رأينا، تتمتع بما يكفي من القوة والتماسك للتمركز في الشوارع، وتولي مسؤولية الدفاع عن الأحياء المسيحية. كذلك أنشأ حزب الوطنيين الأحرار بزعامة كميل شمعون، ميليشيا سميت "النمور". وكانت لرئيس الجمهورية شخصيا ميليشيا في بلدته زغرتا. ولوحظ في الوقت نفسه، ميل متنام لدى المسيحيين لاقتناء الأسلحة الحربية الفردية، ولاسيما منها بنادق الكالاشنيكوف (أي. كاي- 47) التي اشتروها من الفلسطينيين في أغلب الأحيان! وابتداء من العام 1970 كانت كمية الأسلحة الآلية المتوافرة كبيرة بحيث أن إطلاق النار ابتهاجا بانتخاب فرنجية استمر ساعات في كافة شوارع الأحياء المسيحية تقريبا في بيروت وفي قرى الجبل.
وبعد العام 1973، أتاحت السياسة البديلة شبه الرسمية التي طبقتها قيادة الجيش بتشجيع من فرنجية، للميليشيات الإستفادة من إمدادات منتظمة بالأسلحة. ووفر لها الجيش أيضا تسهيلات على صعيدي التدريب والتجنيد. وأخذ ضباط متوسطو الرتب على عاتقهم أيضا تشكيل ميليشيا جديدة سميت "التنظيم" الذي سيجند عناصره من البورجوازية المتوسطة الميسورة. وقد تكون الأهم، ظاهرة الميليشيات التي باتت تتجاوز الإنقسامات الحزبية التقليدية، لتبدو معيارا للسلوك السياسي في الوسط المسيحي. ولم تعد دورات التدريب العسكري تشمل فقط منتسبي الأحزاب التي كانت تنظمها. وبات تأمين التدريب العسكري في نظر حزب ما وسيلة مضمونة لجذب مزيد من الأنصار. وبمعنى آخر، كان وجود ميليشيا في حد ذاته أداة تجنيد بمعزل عن التعبئة الإيديولوجية التي كانت ترافقها. في أي حال، كان التطوع في ميليشيا غالبا ما يسبق الإنضمام إلى الحزب المنبثقة منه، عندما كانت تنبثق من حزب.
وكان يملي التعبئة لدى المسيحيين منطق الدفاع عن الدولة حيال المس بسيادتها. وهذا ما تجلى في أي حال، في الخطاب العلني لخصوم الوجود الفلسطيني. لكننا نخطىء إذا ما قلصنا هذا المنطق إلى مجرد برهان دعائي. وأيا تكن حسابات الزعماء المسيحيين، فإن افتتان الناس بالميليشيات يفسر في المقام الأول برد فعل قوامه الدفاع الذاتي. ومن الضروري بالتأكيد، التعامل بترو ونسبية مع مفهوم المس بالسيادة، ليس لأنه لم يكن حقيقيا، إنما لأنه لم يبد على الفور أمرا ملموسا. ويفترض، من جهة أخرى، أن الأطراف الآخرين للمجتمع اللبناني كانوا أقل حرصا على السيادة. وبغض النظر عن معناه القانوني الدقيق، فإن موضوع السيادة ينبع من التصور الذي كونته عن لبنان مختلف شرائح الشعب اللبناني. وإذا كان موضوع السيادة يفسر في إطار المجموعة الطائفية، فهذا يعني أنه مبني على إحساس بخصوصية لبنان ولازمتها، رفض العروبة. فالفلسطيني الذي كان يعتبر شقيقا في نظر المسلمين والمسيحيين من حاملي لواء العروبة، هو في نظر سواهم الغريب بامتياز.
ففي الإمكان إذا، الكشف عن بضعة مستويات لمفهوم المس بالسيادة. فعلى المستوى الفوري، تحيلنا السيادة المنتهكة إلى البيئة اليومية. فرد الفعل العفوي على مظاهر السلطة المستقلة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، كإقامة حاجز على طريق رئيسية، هو نوع من "لم نعد نشعر أننا في وطننا". وفي أعقاب الحوادث الآنفة الذكر في 1970، تمثل "نزاع الجوار" هذا في تموز/يوليو 1974 بمواجهات دارت، على إثر شجار بين مشاغبين من عناصر ميليشياوية كتائبية وفلسطينيين في الدكوانة قرب مخيم تل الزعتر، فكانت تمهيدا لآليات المواجهة في ربيع 1975. وعلى المستوى الثاني، كانت السيادة المنتهكة تعني تشويها للهوية اللبنانية وتشكيكا في الدولة كما أرادها الموارنة. فكان منطقيا في هذا الصدد أن يتصدر الكتائبيون الصفوف الأولى لجبهات القتال، هم الذين كانوا يطرحون أنفسهم البديل من الدولة أو "الإحتياط الإستراتيجي"، حسب الصيغة التي استخدمها كريم بقرادوني. وعلى المستوى الثالث، ونظرا إلى التغير في ميزان القوى الذي أحدثه، فإن الوجود الفلسطيني هو الذي تسبب في اختلال التوازن والإعتراض على الوضع الراهن.
ولم يكن جميع المسيحيين ولا جميع الموارنة يؤيدون هذا الموقف. وإذا كان كميل شمعون وخصوصا بيار الجميل نصبا نفسيهما المتحدثين المفوضين التعبير عن هذا الموقف، فإن ريمون إده قد تميز عنهما، على رغم رفضه الموافقة من جهة، على اتفاق القاهرة، مطالبا بلا كلال أو ملل منذ سنوات باستقدام قوات من الأمم المتحدة ونشرها على الحدود اللبنانية، وكونه من جهة ثانية، أحد مؤسسي الحلف الثلاثي الذي اضطلع التأثير الفلسطيني بدور جزئي في تأسيسه. لكن إده المعروف بميوله السلمية وحرصه الشديد على التمسك بالقوانين، تميز بسياسته المنفتحة وحتى المتحالفة مع أقطاب مسلمين أمثال صائب سلام ورشيد كرامي. وإذا كان موقفه خفف من حدة الإستقطاب الطائفي، فقد أثبت أيضا أن الموقف من الوجود الفلسطيني نابع من الإستقطاب بالدرجة الأولى .
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. فصل جديد من التوتر بين تركيا وإسرائيل.. والعنوان حرب غزة | #

.. تونس.. مساع لمنع وباء زراعي من إتلاف أشجار التين الشوكي | #م

.. رويترز: لمسات أخيرة على اتفاق أمني سعودي أمريكي| #الظهيرة

.. أوضاع كارثية في رفح.. وخوف من اجتياح إسرائيلي مرتقب

.. واشنطن والرياض.. اتفاقية أمنية قد تُستثنى منها إسرائيل |#غرف
