الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
ألبير كامي بعد أكثر من نصف قرن: الأفق الفلسفي وتراجيديا الهوية
أحمد دلباني
2012 / 1 / 6الادب والفن
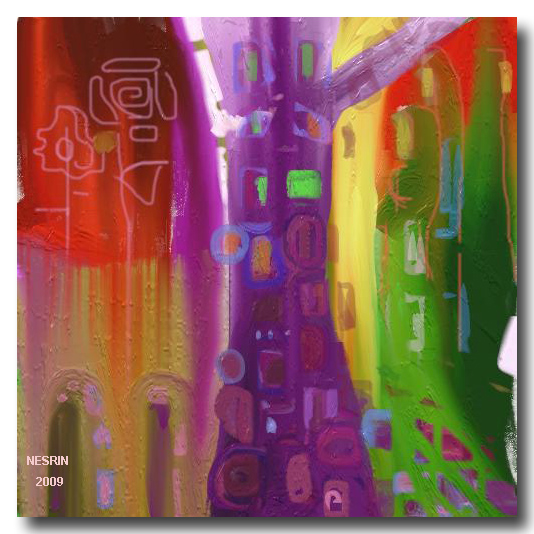
ألبير كامي بعد أكثر من نصف قرن:
الأفق الفلسفي وتراجيديا الهوية
أحمد دلباني
1- حدود النزعة الإنسانية الكلاسيكية:
يحتل الكاتب الفرنسي ألبير كامي A.Camus(1913-1960) موقعا هاما في السجال النقدي الدائر حول الأدب الأمبريالي وعلاقة الغرب الاستعماري ببلدان الجنوب. كما يحتل مكانا خاصا في الأدبيات النقدية التي تروم الكشف عن البنية اللاشعورية للوعي الكولونيالي في القرن العشرين قبل انتفاضة الأطراف وانحسار السيطرة الغربية عنها سياسيا وعسكريا. إنه كاتب متعدد المداخل وشديد الأهمية من حيث هو موضوع للدرس النقدي / الثقافي والما بعد كولونيالي، يتيح أدبه وفكره ونضاله السياسي الوقوف - بصورة جيدة – على محددات الرؤية الغربية الكلاسيكية للآخر، ومكانة المختلف في النسق الثقافي الغربي وريث " الأنوار" التي احتكرت لوغوس المعنى طويلا في العصر الحديث. إن كامي الجزائري ذا النزعة الإنسانية والحساسية الأخلاقية العالية - التي ميزت أعماله ورؤيته ومواقفه - لم يكن ليفلت، بهذا المعنى، من حدود خطاب الهيمنة الغربية ومسلمات الوعي الكولونيالي المتجذرة تاريخيا والتي أسهم، هو شخصيا، في إعادة إنتاجها.
طبعا سيكون من المجحف أن نحصر دراسة كامي في تعرية جوانب النزعة الكولونيالية المظلمة والآفلة تاريخيا في رؤياه الفكرية والإبداعية؛ فهو كاتب ومفكر استحق فعلا أن يكون – إلى حد ما – ضمير عصره ووعي مرحلته التي شهدت انفلات مارد العنف الأعمى من قمقمه وانهيار القيم التي كانت تؤسس لجدارة الحياة ومعقولية التاريخ بوصفه خطة تقدمية تعلن عن مقدم " الصباحات التي تغني ". لقد نشأ كامي في عهد شيخوخة الحضارة الغربية الفاوستية التي باعت نفسها لشيطان أفظع المغامرات إلى أن أفاقت على خراب العالم وقد أصبح متاهة ومفازة لا تنبت إلا شجر اللامعقول. كان ذلك كافيا من أجل الإعلان عن موت التعالي وغرق التاريخ في اللامعنى. هذا هو فحوى فلسفة العبثية واللاجدوى L’absurde التي ميزت وجودية كامي ودعته إلى البحث المضني عن المعنى وشعاع الجدارة الكينونية في ثنايا التعلق بشرف النضال الميتافيزيقي ضد اللامعقول وصمت العالم، وبزرع وردة الخلق على الجليد اللامتناهي. لقد كانت فلسفة اللامعقول – بهذا المعنى – تعبيرا عن نهاية العلو وأفول المعنى من علياء السماء التي أصابها الخرس. إنها فلسفة أعلنت بنبرة حادة عن ميلاد العدمية الجديدة وطلاق الوعي مع العالم واضمحلال الخلاص الذي كان في أساس اليوتوبيات اللاهوتية والدنيوية معا. سيكون، بالتالي، من غير المجدي انتظار غودو كما علمنا بيكيت؛ وسيكون من المجدي للإنسان أن يبتكر السعادة والعدالة في عالم صامت هجرته الآلهة والغائيات التي كانت تؤسس لتعالي المعنى. إن فلسفة اللامعقول – في كلمة - مثلت وعيا جديدا قام على خرائب النزعات التاريخية والرؤى التفاؤلية الكلاسيكية المستنفدة. لقد كان كامي على وعي شديد بفقدان العالم المعاصر كل الأسس التي كانت تضمن للمعنى الأنطولوجي نوعا من الصلابة والعلو في مواجهة سديم التجربة التاريخية. ولكن موت التعالي وانفلات القوة العمياء من إسارها أعاد طرح مشكلة معنى الحياة وجدارتها من جديد. وقد كان تدخل كامي الفلسفي في هذا الشأن متناغما مع لحظته وهو يعلن أن المعنى ينبجس من القلب الإنساني ومن الرغبة الأخلاقية الحارقة في مواجهة العبثية الهائلة، وتأسيس السعادة في عالم إنساني متضامن وعادل. وكان فنه سبيلا إلى تحقيق نوع من التواصل الإنساني والانتصار للمصير المشترك في عالم صمتت فيه السماء الفارغة وأصبح متلفعا بملح باللاجدوى.
لقد مثل كامي برؤيته وفلسفته وحساسيته العامة جيل حداثة غربية خائبة انحرفت عن مسارها التحريري وعن وعودها وبشارتها وغرقت في آلية العنف والتدمير الذاتي. هذا ما جعله ينسلخ عن أسطورة التاريخ كما صاغته السرديات الثورية الغربية الحديثة. وهذا ما جعله يبصر، جيدا، تصدع قلاع المعقولية التي فضحتها التجربة التاريخية الهوجاء لحربين عالميتين مدمرتين. من هنا نفهم إعادة طرحه لأكثر الأسئلة جذرية وهو يراجع مصير الحضارة الغربية، مشرفا على المهاوي التي خلفها غياب التعالي وسقوط سردية التاريخ في هاوية القوة العمياء. هذا ما جعله يجهر باختلافه العميق مع مفكري وفلاسفة جيله الذين أبقوا على إيمانهم بالمسار الإيجابي للتاريخ بوصفه صيرورة حتمية وانعتاقا للإنسان من كل أشكال الاغتراب التاريخي. وهذا أيضا، ربما، ما جعل الكثير من النقاد المعاصرين يرون في تأملات كامي بصيرة افتقدها معاصروه الغارقون في تبرير الوضع المأساوي لانحرافات الثورة والانكفاء داخل شرنقة النظرية على حساب الإنسان المضطهد في دولة الديكتاتورية الشعبية. لم يكن كامي مؤمنا بالثورة على الطريقة السوفياتية وقد وجه نقدا مهما لأسس العمل الثوري الذي رأى فيه انحطاطا وتدهورا لطاقة التمرد الأصيلة في الإنسان؛ والدليل هو ما آلت إليه الثورات من شمولية ونزعة استبدادية وسحق للإنسان باسم التحرير والوعود التاريخية. لقد آمن – خلافا لذلك - بالتمرد الذي يجعل الإنسان ينتفض ضد وضعه وضد عطب كينونته وضد كل ما يحد من تحقق كيانه بالعمل والإبداع والخلق في كنف الحرية.
مثل ألبير كامي، بالتالي، وجها ثقافيا وإبداعيا مهما. وقد كان نتاجه الفكري والأدبي – والروائي منه بخاصة – موضع احترام وتقدير أهلاه لنيل جائزة نوبل العام 1957. وما من شك في أن الكثير رأى في تدخله – بوصفه مفكرا ومثقفا - نزعة إنسانية جديدة ووعيا حادا برهانات مرحلته التي عرفت تفكك اليوتوبيات الكلاسيكية وميلاد ضوء جديد على خرائب العالم المنتهي. كل ذلك مثل دعوة إلى السفر في بكارة المعنى وتحديا للإنسان من أجل ابتكار جدارة الحياة وسط اللاجدوى الفادحة، وضخ الدم من جديد في مومياء أخلاق السعادة التي غيبها تراث طويل من العقائديات المتصلبة. إلا أن ذلك كله لم يكن كافيا في منح نتاج كامي الحصانة إزاء هجمة التفكيك النقدي الذي تنطح لمباغتة مضمرات الحداثة الغربية الكلاسيكية المتمركزة حول ذاتها والتي كان مؤلفنا من أوجهها البارزة والأكثر تمثيلية. من هذه الزاوية يبدو جليا أن كامي كاتب كولونيالي، وأن أدبه ظل وفيا لمحددات الفضاء الأمبريالي الغربي في التعاطي مع الآخر الخاضع للاستعمار كما بين ذلك بعض الدارسين.
يتجلى هذا الأمر في أعمال كامي الأدبية وفي مواقفه السياسية باعتباره مثقفا كانت له كلمته في أحداث عصره وفي طليعتها القضية الجزائرية. فمن جهة أولى لم يناصر كامي النضال الجزائري من أجل الحرية والكرامة، وظل على موقفه الرافض لاستقلال الجزائر عن فرنسا. إذ يعلم الجميع أنه جهر بدفاعه عن أمه قبل العدالة؛ وربما كان يعتقد بإمكان تجاوز نظام اللامساواة الاستعماري بنوع من " السلام الاقتصادي والاجتماعي " كما نعبر اليوم. ومن جهة أخرى لم تكن الجزائر الحاضرة في أدبه إلا طبيعة عذراء تستحم في ضوء الشمس ويقرأ فيها أسفارا وثنية من كتاب الأرض التي حلت محل السماء الفارغة؛ أو لم تكن تظهر إلا باعتبارها ديكورا حضريا وخلفية زمكانية لشخصيات رواياته الأثيرة مثل " الغريب " و " الطاعون " التي تدور أحداثها في مدن جزائرية ولا يظهر فيها الجزائريون إلا بوصفهم " عربا " وأشباحا بلا وجه ولا هوية ولا تاريخ كما لاحظ إدوارد سعيد بحق. لم يكن الإنسان الجزائري حاضرا في المجال المرئي للوعي الغربي الذي صوره كامي مناضلا ضد لامعقولية العالم ومنخرطا في حمى الظمأ الحارق إلى عالم أكثر إنسانية وتضامنا وعدالة.
طبعا هذا لا يقدح في أهمية الكاتب ولا في إبداعيته العالية ولا في مواقفه التي لا تلزم أحدا غيره. ولكننا ملزمون نقديا بالكشف عن حدود النزعة الإنسانية الكلاسيكية المحايثة للعهد الأمبريالي في الثقافة الغربية والتي لم يكن بوسعها أن تفلت من الفضاء العام للوعي الكولونيالي في النظر إلى الآخر. إن كل نتاج أدبي أو فكري عظيم – كما يبين ذلك المنحى الحفري والتاريخي / النقدي الذي اعتمدناه – يتضمن بكل تأكيد أهمية لا تنكر؛ ولكنه يكشف، أيضا، عن حدوده وعن علاقاته الخفية بنظام المعرفة في عصره والذي لا ينفك، بحال، عن ذاكرته الطويلة المشحونة بالتمركز على الذات ومناهضة المختلف والاستعلاء عليه. لقد عاش كامي في نهاية الحقبة الكولونيالية وحمل بعمق جراحها ويأسها العارم وهي تفيق على تصدع هارمونيا العالم الذي نسجته لقرون خلت وبوأها مكانا عليا في نظام التاريخ. من هنا نفهم، ربما، غرق السرديات الغربية في اللامعقول والعدمية التي جسدها الوعي الفلسفي في أعلى ذراه كما رأينا عند كاتبنا. إن نهايتي هي نهاية العالم: هذا هو لسان حال الخطاب الغربي الكولونيالي الذي كان كامي من وجوهه الأكثر تألقا. لقد قرأ في تفكك العالم الأمبراطوري الغربي - بعد حربين عالميتين وبعد يقظة حركات التحرر- انبجاس العدمية من شقوق قلعة الحداثة الغربية المتآكلة وانهيار ما يسند المعنى الأنطولوجي ويمنحه تماسكه في عتمة التاريخ. هذا ما جعله يجتهد في البحث عن سعادة مرة تستطيع أن تكون إكسيرا لجرح الإنسان الغربي وهو يتأهب لأداء دوره الجديد: دور سيزيف الذي يصر كامي على تصوره سعيدا رغم كل شيء. ربما يكون ذلك معقولا، حقا، مع وجود إنسانية حرة ومبدعة تستطيع أن تتحمل ثقل صخرة كينونتها بالخلق والإبداع وابتكار ألق الحياة بعيدا عن رغبة الهيمنة التي لم يشذ خطاب كامي نفسه كثيرا عنها.
2- جزائري أم " حصان طروادة " للكولونيالية؟
ولكن بعيدا عن الحديث عن كامي " الأمبريالي " الذي لم يعد يستحضر إلا لإدانة الأدب الأمبراطوري الغربي في صيغته الفرنسية، نحب أن يعكف النقاش الدائر في الجزائر، اليوم، لا على مضمرات خطابه الفكري والإبداعي فحسب وإنما - بدرجة أكبر- على الهوية الجزائرية التي لم تقارب خارج المنظور الإيديولوجي العربي – الإسلامي أو خارج الشوفينية التي أرادت - منذ الاستقلال – حصر الفسيفساء الجزائرية إثنيا وعرقيا ولغويا وثقافيا داخل قمقم الأحادية العروبية حاجبة، بذلك، الأبعاد المتوسطية والإفريقية للفضاء الحضاري التي تنتمي إليه الجزائر. إن الدولة الوطنية وقعت في أحبولة الأحادية الإيديولوجية التي ثار ضدها كامي تحديدا – منذ خمسينيات القرن العشرين - وهو يتحدث عن الشمولية الأوروبية في صورتيها الماركسية والفاشية معا. هذا ربما ما يصنع راهنيته بوصفه مثقفا ومفكرا وكاتبا غرد خارج السرب، واختار أن يكون نشازا في غنائية الرؤية الأحادية الاستبدادية التي سفحت حرية الإنسان على جلجلة التاريخ مفهوما على أنه مسار حتمي نحو " الصباحات التي تغني " أو الصباحات التي لبست قناع غودو. هنا تكمن قيمة كامي تحديدا. إذ بالنسبة لنا، نحن الجزائريين، أعتقد أن أهمية الرجل لا تخرج عن كونه يمثل مناسبة لإعادة طرح مسألة الهوية الجزائرية المفتوحة من منظور أكثر واقعية، وبعيدا عن الإطار الإيديولوجي الشوفيني وليد الصراع التاريخي المعروف والذي هيمن، إلى اليوم، بأبجدياته الوطنية والدينية الضيقة والتي لم يعد هناك ما يبررها اليوم. ليس في ما نقول حنين إلى الكولونيالية بوساطة الكاموية، وإنما هناك انفتاح جديد على اللحظة العولمية، ومراجعة للتاريخ الصدامي بين ضفتي المتوسط الذي غلب عليه التنابذ رغم وجود إمكانات عظيمة وإرث رمزي وخلفيات حضارية كبيرة لبناء تاريخ مشترك يتجاوز رغبة الهيمنة وإرادات القوة بتجاوز التمركز حول الذات وتجاوز النزوع إلى ادعاء احتكار تراث الخلاص البشري، دينيا كان أو علمانيا إيديولوجيا. يلزمنا، بكلمة، الخروج من الزمن التاريخي والثقافي الذي سادت فيه " أنظمة الاستبعاد المتبادل " كما يعبر البروفيسور محمد أركون. إن الهوية الجزائرية عانت من الحجب المنظم ومن مغامرات الطمس الذي لم يأبه للحقائق السوسيولوجية واللغوية والتاريخية العميقة في ظل حمى الشعارات الإيديولوجية التي واكبت النضال الوطني في سبيل التحرر، وحادت عن مكونات الشعب الجزائري بدعوى استعادة الهوية المفقودة والانفصال عن الزمن الكولونيالي. وقد كان أن وقعنا – كما نعرف – في الأحادية الإيديولوجية والأحادية الثقافية واللغوية. وها نحن، اليوم، نقع تحت ضغط الأصولية الدينية وليدة فشل الدولة الوطنية في تحقيق التنمية وترسيخ قيم العدالة والمساواة والمواطنة. هذه مشكلتنا الكبيرة لأننا لم نفهم الهوية باعتبارها حركة انفتاح على الواقع والتاريخ، أوباعتبارها جدلا دائما مع الآخر واغتناء لا ينتهي للذات بعيدا عن حمى البحث عن " الثوابت " التي تتغير بتغير المواقع والمصالح واستراتيجيات القوة في المجتمع. إن تراجيديا كامي الشخصية، بين جزائريته وفرنسيته، تكشف عن ذلك الشرخ الذي عانته ضفتا المتوسط في ظل تاريخ لا يريد مراجعة مسيرته ولا تفكيك بنيات الهيمنة التي سيطرت – إلى اليوم – على مخيال شعوبه وعلى عمله التاريخي في إعادة إنتاج علاقات القوة القديمة.
لا شك في أن كامي يبقى – رغم كل شيء – كاتبا إنسانيا عظيما تكمن عظمته في كونه جسد في عمله الإبداعي الوعي الحاد بتلك الحساسية الميتافيزيقية التي شاعت في القرن العشرين وجعلته يغرق في العبثية واللامعقول. لقد رأى في إنسان الحضارة الأوروبية الفاوستية - التي باعت نفسها لشيطان المعرفة والقوة – سيزيف جديدا فقد المعنى وضيع، إلى الأبد، بريق اليوتوبيا التي كانت، بكل أوجهها، إمكان خلاص تاريخي للإنسان من آلة العبث واللاجدوى الفادحة. إضافة إلى ذلك نرى أن عظمة كامي تكمن في حسه الأخلاقي العالي الذي جعله ينتصر للإنسان وللعدالة، ويرى في التضامن البشري ضد لامعقولية العالم طوق نجاة من العبثية وانبجاسا لضوء المعنى من صخرة الوجود الذي فقد العلو. ولكننا نعلم، اليوم، انطلاقا من موقف نقدي / تفكيكي ونقدي / ثقافي أن الخطاب الكاموي يتأسس على مضمرات وعلى خلفية ثقافية أوروبية بدأت تتآكل وتتفتت وتكشف عن نسبيتها وعن تمركزها الأوروبي منذ يقظة حركات التحرر الوطني ضد الاستعمار التقليدي. هذا شأن كل خطاب ينتجه البشر في التاريخ ضمن صراعهم الأبدي على احتكار معنى الكينونة التاريخية ومحاولة تأسيس وجودهم الواعي المتطلع إلى ذروة الجدارة الكينونية. لذا أرى أن النقاش الدائر في الجزائر، اليوم، لا يتناول – بالطبع - قيمة كامي بوصفه كاتبا ومفكرا كان له إسهامه في النقاشات المتعلقة بالمعنى وبالمصير البشري في عالم قلق يجابه الدمار والموت والحرب، وإنما بكون كامي كاتبا كولونياليا يضمر الحديث عنه – شئنا أم أبينا – تورطا إيديولوجيا جعل البعض يعتقد بإمكان تحوله إلى " حصان طروادة " يراد من خلاله تمجيد الزمن الكولونيالي وخدمة مشاريع فرنسا الحالية التي لم تتخلص، بعد، من منزع الهيمنة ومن ضغط ذاكرتها الكولونيالية سوسيولوجيا وسياسيا. هذا ما جعلني، شخصيا، لا أركز على كامي أكثر من تركيزي على ضرورة فتح أضابير الهوية الجزائرية في عالم يتجه إلى أن يكون " قرية كونية " قبل البدء بنقد المركزيات والتأسيس لفكر جديد وممارسات جديدة تعيد النظر في بنيات الهيمنة والسيطرة التي حكمت العلاقات في الماضي، وتفتح أفقا لنزعة إنسانية جديدة تراجع مسبقات الوعي المتمركز على ذاته. لقد ظل تفكيرنا في الهوية – منذ الاستقلال – متمحورا حول الشعار الإيديولوجي أكثر من انفتاحه على الواقع، وظل مرتبطا بظروف تاريخية وسياسية صراعية انتهى زمنها الذي ولدها. فهل الهوية الجزائرية أمر تحدده المواثيق السياسية والمواقف الظرفية؟ هل هي نقطة ثابتة ومتعالية كالإسلام أو العروبة أو المرجعية الثورية القريبة مثلا؟ أم هي انتماء لا يختزل في بعد واحد وفسيفساء ذات أبعاد عصية على الطمس؟ هل الهوية الجزائرية – في كلمة – نقطة ارتكاز أم أفق؟ هل هي ماض أم وعد بالتحقق وتفكير في المصير المشترك بالانقذاف الواثق في اللحظة العولمية بعيدا عن أبجديات الماضي وصراعاته المنتهية التي لا ينفخ في رمادها إلا أصحاب المصالح الآنية بين ضفتي المتوسط؟ أعتقد أن النقاش يجب أن يتمحور حول هذه الأسئلة الملحة والجزائر تعيش ضبابية الرؤية في اللحظة الراهنة.
أحمد دلباني
-------------------
------
-
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - تعليق
سيمون خوري
(
2012 / 1 / 7 - 16:10
)
أخي أحمد دلباني الكاتب المحترم تحية لك ولجهدك الكبير في إعداد هذا البحث الهام حول البيركامي . كما أني أعتقدت أنك أصبت في طرح وجهة نظرك حول مسألة الهوية . ويبدو أننا الأن في العالم - العربي - تدور ذات الأسئلة دون إجابات صريحة وواضحة فذاكرة القوة لا زالت تتحكم بأليات تفكير البعض. أخي المحترم تحية لك
.. مخرجة الفيلم الفلسطيني -شكرا لأنك تحلم معنا- بحلق المسافة صف

.. كامل الباشا: أحضر لـ فيلم جديد عن الأسرى الفلسطينيين

.. مش هتصدق كمية الأفلام اللي عملتها لبلبة.. مش كلام على النت ص

.. مكنتش عايزة أمثل الفيلم ده.. اعرف من لبلبة

.. صُناع الفيلم الفلسطيني «شكرًا لأنك تحلم معانا» يكشفون كواليس
