الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
الوفاة
نبيل جديد
2012 / 9 / 14الادب والفن
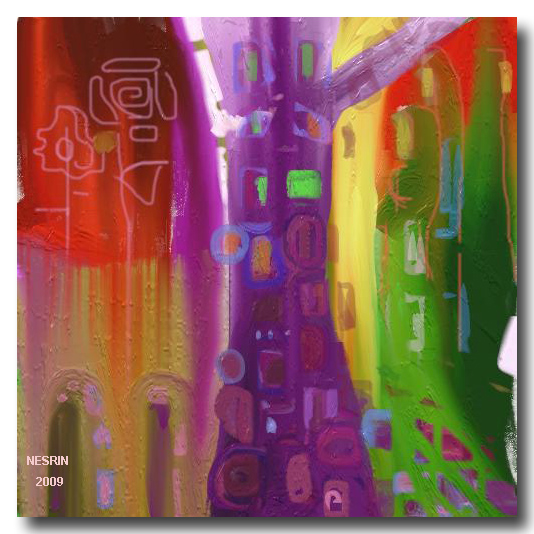
قبل جفاف المكالمة الهاتفية مع والدي ، كنت ألهو ضمن صفحات رواية في الحافلة ، فهي المرة الوحيدة التي يصر بها ويؤكد ثم يلح على ضرورة حضوري مراسم الدفن ، فقد جرت العادة على أن يمثلنا –كامل أولاده- خلال الأفراح و الأتراح ، وبدا لي تمسكه بتواجدي مخيفا إلى درجة جعلتني أتوه في التخمينات .
- ابن عمك توفي ...
وأنا أعرف أنني أكبر سنا من أولاد عمي ، وليس بينهم من هو في سن الوفاة ؟! سخرت من هذا الخاطر واستفسرت :
- أيهم ؟!..
- أبو أحمد ..زميلي في الدرك ..
أدركت عندها مقصده : أحد الأقرباء ، فسارعت إلى السفر مع معرفتي باستحالة وصولي في الوقت المناسب ، لكي أبدو مثل من قام بكل ما عليه ، إرضاء لرجاءات الوالد ، بينما تتنازعني مشاعر الغضب من هذا الواجب الثقيل الذي سيرهقني خلال السفر و الجنازة ، ومشاعر الحزن على أبي الذي بدا كأنه يدعوني إلى جنازته وهو يراقب أوراق الأصدقاء تتساقط سريعا ، ومشاعر الاكتئاب لطريقتي الحيادية في استقبال نبأ الموت ؛ كأننا سكان المدن الكبيرة نفتقد لحلاوة معنى القرابة ؛ ولأن الرواية تتحدث عن موضوع مشابه ، حاولت استغلال الضوء المتبقي من النهار في تقليب صفحاتها ، حتى باغتتني العتمة ، فوضعتها جانبا ، ورفعت نظارات القراءة لأراقب قليلا الفلم ، فلم أستمتع ، مسحت رؤوس الركاب أمامي متخيلا وجوههم ، ثم ألقيت نظرة على من يشاطرني المقعد ، وكان منشغلا بأحداث الفلم المصري ، التفت نحوي ، فتظاهرت بمحاولتي رؤية الطريق من خلال الزجاج ، لكن العتمة الخارجية حوّلت النافذة إلى ما يشبه المرآة ، فاستطعت تحديد درجة اسمرار الشاب ومدى اتساع صلعته و سماكة نظارتيه ، ثم أشحت وجهي باحثا عن جميلة بين الركاب تلهب خيالي ، فأثار انتباهي شعر أشقر منسدل طويل على بعد مقاعد من الصف المقابل ، حاولت تخيل ملامحها ففشلت ، وتسليت بمشهد حركي على التلفاز أثار موجة من الضحك بين الركاب ، ثم سويت مقعدي ليناسب النوم ، لكنني لم استطع الانشغال عن مشاعري المتناقضة ، و التي زادت إرباكا بدخول مسحة من الرضا على نفسي لتصوري مدى سعادة الوالد لاستجابتي له ، فارتحت لابتسامته التي ستبدو غريبة ضمن أجواء الكآبة في القرية ، وتخيلته يفخر بين الأقرباء بحضور أولاده جميعا حتى أبعدهم ، و بافتقار مشهد الفخر هذا إلى مكان ريفي حاولت استكماله ، فتتالت ومضات قريتي ، كأنها نداء حار ينساب عبر العقود ، فعلاقتي معها علاقة ذاكرة متقطعة ، أرى في ذهني دروبا لا تؤدي إلى مكان ، وتحفظ مخيلتي أمكنة لا أعرف طريقا إليها ، و الوجوه تبدو غائمة لا تنتنمي إلى أسماء ، وأسماء الأشخاص – حتى الفتيات – شاردة صعبة التجسيد ، فمنذ كنت في العقد الأول تهتكت الحبال بيننا ، لأن وظيفة " الدركي " جعلتنا كالبدو نبحث عن الكلأ في الأصقاع ، فنبتعد عميقا في الصحراء حينا ، ثم نجمع أمتعتنا ضمن شاحنة لنقترب من البحر حينا آخر ، لكن هبات الصيف –حيثما صرنا- كانت تحملني إلى أحضان قريتي لشهر أو شهرين ، فأختمر عنبا و تينا ، وتملؤني جدتي حبا وحنانا – رحمها الله – وليبقى وجهها في الذاكرة الوحيد الذي ينتمي إلى اسم ، وهاهو يجلدني بسياط تأنيب الضمير لعدم حضوري جنازتها ، فيظهر الألم قلقا يثير انتباه جاري : تسوية الجلوس ، محاولة النوم ، اتكاء جانبي لتفحص الممر الطويل ، مراقبة الشاخصات التي تمرق خطفا عبر نافذته ؛ فأشعر بالارتباك لنظراته ، وأتشاغل عنه ، لكنه سرعان ما يتأبط الفلم الكوميدي الطويل في تلفاز البولمان ، بينما تأخذني الوجوه الريفية إلى بداية عقدي الثاني حيث صرت أرى في استمرار لهوي – صيفا - مع زملاء المدارس في تلك البلدات الصغيرات المتباعدات إغراء أكثر من حجارة قريتي الناتئة و حاكوراتها المتطاولة ، وتحول اللهو فيما بعد عملا في العاصمة باعدني حتى عن عائلة البدو الرحل التي استقرت أخيرا في اللاذقية ، على امتداد الأزرق دائم التموج ، كحقل القمح أمامي الذي تسبح فيه الأصابع اللدنة ، مما أظهر جزءا من الخد ينسجم في اللون مع اليد الطرية ، فقررت استكشاف وجه صاحبته عند أول توقف للحافلة ، لأن مشكلة الوجوه تغزوني بدءا من الركاب الذين لا أرى منهم إلا قمم الرؤوس المشعرة أو الجلحاء ، و انتهاء بعجزي عن تذكر ملامح ابن العم المتوفى ، الذي أجد فيه ضرورة ملحة ، ففلسفة الوجه مهمة لنا كثيرا نحن سكان المدن ، من خلاله نحدد الصلة بيننا ، فهذا وجه زميل عمل ، وهذا وجه جاري المقابل ، أو هو وجه الطابق الخامس ،أو الثالث ، وهكذا تستطيع القول : صباح الخير جار ، أو السلام عليكم زميل ؛ وعندما تفشل في سياسة الوجوه ستبدو انعزاليا مترفعا ، والمصيبة الأكبر في القرية ، فهم لا يكتفون بتصفح الوجه ، بل يلامسون الدم و الخلايا و الصوت و الرائحة ، وهكذا يحددون لك من تصافح ومن تحتضن ومن تقبل ، وبذكر القبلات اندفعت أتمرغ في مرج الذهب المتموج أمامي ، وأسترق النظر من جاري خشية قراءته أفكاري فألحظه يكبح ضحكاته ، ويرتسم شارباه الأسودان الكثان كنقيض صارخ لخيوط الشمس المنسدلة على فسحة الخد القمرية ، فمسدت براحتي شاربي الأصهبين ، لأجد فيهما صلحا للألوان المتباعدة ، بينما نظرات ابني الجامعي تشي برغبته امتلاك شاربيّ فيقول :
- سأذهب إلى المزين و أطلب منه صباغة شعري بهذا اللون التائه ما بين الليل والنهار .
فأبتسم له و أعيده إلى محور صراعنا الذي بدأ منذ إحالتي على التقاعد وإعلاني الرغبة
في استيطان اللاذقية قرب أهلي :
- السباحة البحرية هي من صنع مزيج الألوان هذا .
فيحتج مع شقيقته على ترك دمشق :
- لن تقنعنا يا أبي ... لقد ولدنا وشببنا هنا ، ولن نستطيع العيش في مكان آخر .
- مسقط رأس والدك وجدك في اللاذقية ، وهناك ستكون قبورنا ...
- أما نحن فمن دمشق واليها ...
- ألا تقومان بواجب زيارة قبورنا في صباحات العيد ؟...
- بعد عمر طويل ...
- والسفر إلى اللاذقية مربك وطويل ...
- لا يهم الميت مكان القبر ، فلتكن القبور هنا ...
- ومراسم التشييع من يقوم بها ؟! .. أين متعة الجنازة الكبيرة ؟! من سيعزيك في غربتك ؟..
- المعزون هم المعارف ، وأصدقائي وعلاقاتي هنا ، وليست هناك ...
- يا بني يقول المثل : أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب ...
- ويقول المثل أيضا : رب أخ لم تلده أمك ... ثم لم هذا الإصرار بالحديث عن النهايات ؟! فلنتكلم عن البدايات ، فلتفكر بجمالية انتشار سلالتك في دمشق ...
وهنا يطل فخر والدي بإنجابهما لكل واحد منا في بلدة مختلفة ، ثم توزيعنا بحكم الوظيفة على مدن أخرى ، في حلب وحمص ودمشق وطرطوس و اللاذقية ، فباتت لقاءاتنا تقتصر على الاطمئنان الهاتفي ، أو مصادفة الإجازات في بيت العائلة باللاذقية ، أما الحبل السري مع القرية فقد حافظ عليه العجوزان ، وهاهما يحاولان تسليمه لنا ، وأزعجني خاطر "التسليم والاستلام " هذا لايحائه بقرب نهايتهما ، ثم هل تكفي زيارة واحدة لاستلام الراية ؟ أم أن الوالد سيجدها مناسبة ليطلبني في الأعراس أيضا ؟! لأكرر وقوفي تائها في " مركز الانطلاق" كما الآن ، مترددا بين التحرك إلى القرية مباشرة ، أو اللجوء إلى منزل العائلة في اللاذقية لقضاء هذه الليلة ، الاحتمال الذي يفقدني إيجابية : طاعة الوالد ، فحسمت الأمر ، وطلبت من سائق العربة الصغيرة إيصالي إلى القرية ، محاولا الاستفادة من العتمة للابتعاد عن استجداء معرفة الأقارب ، ورغما عن أجواء الحزن داخلني شعور من النشوة لمعرفتي الغريزية بعض الوجوه التي احتشدت حولي ، وساعدني اصطفافهم للترحيب و تقبل التعازي في التمييز الهادئ بينهم ، والتحضير لنوعية السلام المفترض ، فبعد تقبيل يد أبي ، رفعت كف عمي لتقبيلها لكنه قاومني واحتضنني لتبادل القبلات ، بينما عيناي تسترقان النظر لاستكشاف التالي ، برز وجه مألوف تماما بشاربيه الأسودين الكثين وبشرته السمراء ونظارتيه السميكتين وصلعته الواسعة ، وكأن عمي يسلمني لجاره قال :
- وصل ابن عمك من دمشق منذ لحظات ، ألم تلتقيا ؟! ..
مد الآخر كفه للمصافحة ورفع ذراعه الثانية للاحتضان ، ضممته إلى صدري وهمست خجلا : هل يبقى الأمر سرا ؟!..
أجابني ونحن نبادل الخدين : خطيئتنا متبادلة .
أمسكته من كتفيه : كم تغير المدن ملامح الوجه !!
وبلهجة من عركته الحياة تساءل أبي : والنفوس أيضا؟!
أما أنا لا أدري كيف توقعت بأن شقراء البولمان ستكون بين الحشد فتطاولت أبحث عنها ؟!..
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. المراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة خلاصة منهج اللغة الإ

.. غياب ظافر العابدين.. 7 تونسيين بقائمة الأكثر تأثيرا في السين

.. عظة الأحد - القس حبيب جرجس: كلمة تذكار في اللغة اليونانية يخ

.. روبي ونجوم الغناء يتألقون في حفل افتتاح Boom Room اول مركز ت

.. تفاصيل اللحظات الحرجة للحالة الصحية للفنان جلال الزكى.. وتصر
