الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
القضية السورية وإشكالية صراع الشرق والغرب
ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)
2014 / 6 / 16
مواضيع وابحاث سياسية
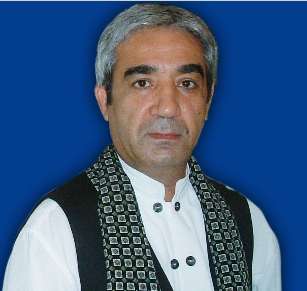
هناك بديهيتان وجوديتان وطبيعيتان تتعايشان وتتناقضان بقدر واحد. الأولى تقول، بان الشمس تشرق دوما من الشرق وأفولها في الغرب دوما! والثانية أن وجودهما متلازم بالضرورة. فمن الناحية الشكلية تتطابق صورة صعود الشمس من الشرق وغروبها في الغرب مع الصورة التاريخية لشروق المدنية والحضارة في الشرق وتكاملها الحديث في الغرب (اي غروبها أيضا، كما توصل إليه شبنجلر في كتابه "أفول أوربا"، بوصفها عملية طبيعية لنمو الثقافة وتصلبها في حضارة). أما من الناحية الفعلية، فان صعود الشرق والغرب هو مظهر من مظاهر الصيرورة التاريخية والكينونة الثقافية للأمم من جهة، وانعكاسها الأيديولوجي من جهة أخرى. وذلك لان فكرة الشرق والغرب من حيث مقوماتها الأيديولوجية هي مجرد تحويل الأبعاد الجغرافية في رؤية ثقافية، بينما الرؤية الثقافية لفكرة الشرق والغرب، هي مجرد انعكاس أيديولوجي للفكرة السياسية. وكلما يرتقي الوعي النظري إلى مصاف الرؤية الثقافية الكونية الخالصة، كلما يقترب أكثر من معايير الرؤية الإنسانية الخالصة، اي فكرة الإنسان والعقل والحيوان الناطق.
لكن الأمر يختلف حالما تصبح فكرة الشرق والغرب علاقة، ومن خلالها تتبلور مواقف وتأويلات سياسية وثقافية. لكن هذه الحالة المثيرة التي مازالت تفعل فعلها في الصراع الدولي المعاصر، هي أيضا طور من أطوار التطور الذاتي للأمم والتاريخ العالمي. كما أنها تعكس حالة الارتقاء الذاتي للمركزيات الثقافية في موقفها من النفس والآخرين. بعبارة أخرى، إن تحول فكرة الشرق والغرب إلى ثنائية متصارعة أو متعادية أو متناقضة أو عصية على الحل هي جزء من خصوصية الارتقاء الذاتي للفكرة الثقافية السياسية عند الأمم، كما أنها تعكس مستوى وحالة الوعي الذاتي للمركزيات الثقافية. ولا تخلو هذه العملية المتناقضة والمعقدة من عنف ودموية ونزوع لا عقلاني بأثر بقاء الغزيرة وفعلها في العقل الباطن للثقافة، اي ما لم تنتقل بصورة فعلية إلى مرحلة الرؤية الحقوقية الأخلاقية في تطورها التاريخي.
وعندما ننظر إلى مثال الحالة السورية والصراع حولها، فان من الصعب تجاهل الأثر الفعال والعميق للمركزية الثقافية في بلورة المواقف السياسية منها. الأمر الذي يشير إلى أن الأبعاد الثقافية للصراع هي جزء من تاريخ الدول والأمم والمصالح. فالصيغة العامة والظاهرية التي أخذت بالتبلور الواضح والجلي يقوم في صراع الشرق (الصيني – الروسي) والغرب (الاوروامريكي). ولا يكفي حدّ هذا الصراع بمعايير الرؤية الاقتصادية والمصالح العابرة فقط. وذلك لان هذه الأخيرة لها محدداتها أيضا في الأبعاد الثقافية الدفينة. فمن الناحية الشكلية لا خلاف جوهري كبير بين النظم الاقتصادية السائدة في الشرق والغرب، بمعنى إنهم جميعا يدعون ويعلنون ويمارسون اقتصاد السوق، اي الصيغة العامة لتنوع الاقتصاد الرأسمالي. بينما تختلف وتتناقض كتلة الشرق الرأسمالي مع الغرب الرأسمالي. وعندما نرجع هذه الكتلة إلى إطارها التاريخي الجغرافي الثقافي، فإننا نقف أمام اختلاف عميق في هيئة ومضمون المركزيات الثقافية الكبرى المتبلورة في كليهما على امتداد قرون من الزمن. وفي العصر الحديث تمظهرت المركزية الثقافية (الغربية) الأوربية ولاحقا الأمريكية، ثم الاوروامريكية الحديثة، بهيئة كولونيالية (سافرة ومقنعة)، بينما تمظهرت المركزيات الثقافية الكبرى (الروسية والصينية) بهيئة مراكز مضادة للكولونيالية بحيث نراها في تاريخ وأطوار روسيا البلشفية، وروسيا "الليبرالية"، وفي الصين الشيوعية و"اشتراكية الوجه الإنساني"، في موقفها من الغرب كما هو جلي في الحالة السورية.
بعبارة أخرى، لا يمكن فهم حقيقة الصراع بينهما وتفسيره بمعايير وقواعد الرؤية الجيوسياسية، والجيواقتصادية والجيوعسكرية. إذ أن فاعليتها موجودة حتى بين "القوى المتحالفة" في الشرق والغرب على السواء. إلا أن التكتل المستميت بينهما في الموقف من القضية السورية، يشير إلى فاعلية المركزية الثقافية بوصفها قوة جيوثقافية هائلة في الصراع الحالي بين الشرق والغرب. فالوعي الشرقي مشبع بتاريخ عريق، والغربي أيضا. ولكل منهما مساره ومذاقه الخاص في تحسس وفهم قيم الخير والجمال، اي المكونات الجوهرية للوجود الإنساني. فهو المسار الواقعي الوحيد القادر على إيقاف الجميع عند حدودها، لكي يأخذ العقل العلمي والحقوقي والأخلاقي دوره الفعال في إدارة الصراع والتكامل على النطاق العالمي. ومن الممكن رؤية هذه الحالة المتناقضة والدرامية أيضا على مثال العولمة المعاصرة وانعكاسها في الصراع الدائر حول سوريا. حيث نرى بعض ملامح اللاعقلانية الفاقعة في وقوف الغرب (المتمدن والليبرالي) إلى جانب اشد السلفيات تحجرا وإرهابا!
كما نعثر في هذه العولمة على استعادة جديدة لنفسية وذهنية المركز والأطراف والكولونيالية الجديدة والأقطاب وتحللها في الوقت نفسه. بمعنى إننا نرى فيها ظهور وتبلور الحدود الذاتية للإمكانيات المرتبطة بصعود"الأقطاب" المتعددة، بوصفها مركزيات ثقافية أيضا. وإذا كان الغرب (الأمريكي) بالأخص قد بلور فكرة أيديولوجية عن صراع الحضارات، فإنها تعكس ليس فقط بعض نماذج الرؤية المستقبلية للصراع، بل وتتمثل تقاليد عريقة في مواجهة الشر شكل عام والإسلامي بشكل خاص. وليس اعتباطا على سبيل المثال أن تتبلور التقاليد الفكرية والسياسية الروسية (وبالأخص ضمن تيارات السلافية والأوروآسيوية) ضمن سياق الموقف الثقافي المناهض للغرب الأوربي، كما هو جلي على سبيل المثال عند دانيليفسكي (1822-1885) في كتابه الشهير (روسيا وأوربا). بينما نرى الصين تدعو في الفترة الأخيرة لاستعادة "طريق حرير" جديد يحرر الشرق والغرب من نفسية وذهنية الهيمنة والاستحواذ. الأمر الذي يعكس طبيعة الصراع المرتبط بما ادعوه بصعود المركزيات الثقافية الكبرى.
إن الصعود الشرقي الحديث والمعاصر، بوصفه حالة تلقائية للتطور والتكامل الذاتي ليس صراعا بين الحضارات، بل استكمالا له ولكن بمعايير المستقبل. وذلك لأنه ينتج مركزيات ذاتية أو أقطاب حديثة تعمل من حيث آليتها وطاقتها على صنع التوازن الضروري من اجل صنع عالم موحد محكوم بفكرة العلم والحقوق والأخلاق.
وعندما نطبق هذه الرؤية العامة على الحالة السورية (والعربية عموما)، فإننا نقف أمام تقاليد ومراحل في المواجهة والصراع والتداخل تمثل حالات الانتقال من المواجهات التاريخية القديمة للإمبراطوريات إلى صراع مستمر ولكنه معجون بعقائد كونية (دينية وفلسفية). فقد كان وادي الرافدين (العراق والشام) بؤرة الثقافة الكونية القديمة ثم العربية الإسلامية ثم العربية الحديث (القومية). أنها بؤرة وادي الرافدين والهلال الخصيب والمشرق (الإسلامي) ثم المشرق العربي. ومن ثم فهي المنطقة الجوهرية في الفكرة العربية وتراكمها التاريخي. وضمن هذا السياق يمكن فهم السر القائم وراء تحول الشام إلى محل الصراع بين أوربا والمشرق (السامي) ثم العربي. على امتداد تاريخهما. إذ نقف أمام موجات رومانية ثم أوربية قروسطية ثم حروب صليبية ثم غزو كولونيالي. وفي مجراها كانت النتيجة واحدة وهي أن المشرق (العربي) كان على الدوام عصيا على الاستحواذ والمحاصرة. وكل من يقترب منه يحترق به أو فيه. وضمن هذه الرؤية يمكن تأمل مستقبل الصراع حول سوريا وقبلها فلسطين، بوصفها مظاهر لصراع ثقافي دفين وهائل لا ينتهي ما لم يتكامل العالم العربي بمعاييره الذاتية بوصفه قطبا عالميا جديدا كما كان من حيث الأصل والجذر والتاريخ.
فقد كان التاريخ العربي الحديث مجرد زمن لا قيمة له بالنسبة لتأصيل مقوماته الذاتية. وعلى الرغم من التضحيات الهائلة التي قدمها في مجرى قرنين الزمن، بعد أن خرج من فلك العثمانية الهلامي ودخوله فلك الكولونيالية الأوربية والأمريكية، إلا انه لم يستطع لحد الآن إرساء أسس مقوماته الذاتية، ومن ثم تطوره التلقائي وإبداع ما يناسبها من مرجعيات جامعة عن فكرة الدولة والنظام السياسي والاجتماعي والوطنية والقومية. ومن الممكن رؤية هذه الملامح الأولية في مجرى الصيرورة المعقدة والمتناقضة للثورة الحديثة (الربيع العربي). فقد أشركت الجميع في صراع عربي - عربي أيضا، اي صراع سوف ينتج بالضرورة رؤية ذاتية عن الواقع والمستقبل. ومن ثم إرساء أسس منظومة المرجعيات المتسامية. والاحتمال الأكبر لها يقوم في إرساء أسس مرجعية الإصلاح العقلاني الشامل بوصفه فكرة وفلسفة ومنهجا للبدائل. عند ذاك يمكن للعالم العربي أن يكون قوة فاعلة في المركزية الشرقية بوصفها قوة مستقبلية للتوازن والعقلانية والنزعة الإنسانية. حينذاك يتطابق المعنى الفعلي للحقيقة القائلة، بان الشمس تشرق دوما من الشرق وأفولها في الغرب، مع فكرة الدورة الحية للوجود الإنساني والتاريخ الكوني!
***
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. هل يستطيع بايدن ان يجذب الناخبين مرة اخرى؟

.. القصف الإسرائيلي يدمر بلدة كفر حمام جنوبي لبنان

.. إيران.. المرشح المحافظ سعيد جليلي يتقدم على منافسيه بعد فرز

.. بعد أدائه -الضغيف-.. مطالبات داخل الحزب الديمقراطي بانسحاب ب

.. إسرائيل تعاقب السلطة الفلسطينية وتوسع استيطانها في الضفة الغ
