الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
الشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى يكتب : أنا النهاية أروي لأبقى
عبدالله عيسى
2015 / 7 / 18الادب والفن
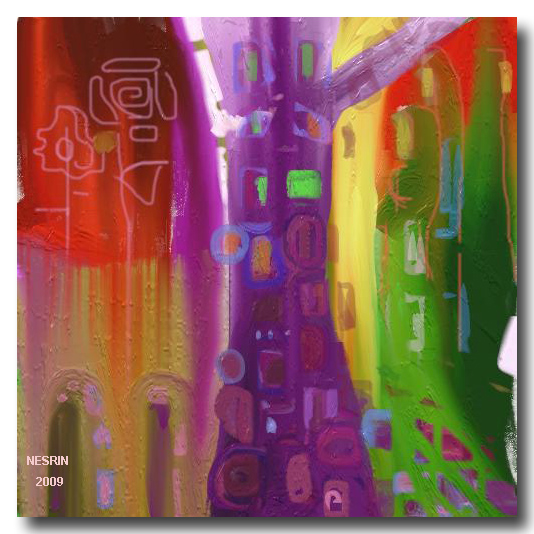
الشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى يكتب :
أنا النهاية ، أروي لأبقى
في رثاء المناضلة نهاية محمد
عبدالله عيسى *
لم نعد ، كلّنا : نحن المائلين على صناديق السلالة حيث رائحة مفاتيح بيوتاتنا القديمة في فلسطين لم تصدأ بعد وحيث ملامح السلالة في الصور لم تذبل بعد فيها ، لتحرس أجسادنا بحلم عودتنا من مجزرة طائشة أو هجرة تربك التاريخ ِو تؤرق الجغرافيا ، لم نعد ، كما كنا تماماً قبل أن يزورنا هذا الموت بكل ذاك الدمار المبين ، نرى ظلّ نهاية محمد صاعداً أدراج إقليم سوريا في قلب مخيم اليرموك ، وهي ترتب على جدرانه ، وكانت أيضاً في الطريق إليه في الحواري والأزقة التي ضاقت كالأرض كاملة على حلم الفلسطيني ، صور الشهداء وتتفقد ابتساماتهم ونظراتهم وأسماءهم واحداً واحداً : خالد نزال ، عمر القاسم ، وآخرون جميلون في مرايا الذاكرة . ولم تقل لأحد منّا أن الفسحة التي بقيت ، ككسرة سماء تطل على عتمة السجن ، بين الشهيدين تليق بها تماماً ، لنتفقد نحن ابتسامتها ونظرتها في مرايا ذاكرتنا وهي تروي لنذكر :
أنا نهاية . أصغر شقيق وشقيقتين ، لأب يشبه جدنا الكنعاني الذي وحّد الآلهة باسم الإله " إبل " لتكنى به ملائكة مثل جبرائيل واسرافيل وعزرائيل ، وشعباً مثل " اسرائيل " خرج من تلموده القديم بوصايا رب الجند مدججاً بالحقد المقدس ليقترف بنا التقتيل والتشريد ، وأمٌ ، سليلة أمنا الكنعانية تعلم حكمة شعبها للنحل كي يصنع العسل ، وللشعوب المجاورة صناعة السفن والصباغة ، ِو للبداوى فن تربية المواشي .
على أرضهما تزوجا ، ذاك العامل القويّ كسورعكا القادم من لوبيا في الجليل ، وتلك البسيطة كماء طبريا حيث عاشت .
أشبه بقطرتي مطر توحدا ، قبل أن يأتي العابرون الجدد ويفسدوا حلمهما بمنع الأمم من الانقراض بتعليمها فن غناء الميجنا والدبكة والتطريز ونشيد شعبهما الطويل كحنين بحارة فينيقيين انتسبوا لبطولة الرواية الفلسطينية .
لم أجئ إلا لأحلم كي أعود .
أنا نهاية . حملتتي أمي في بطنها ، على امتداد درب آلامها الطويل ، ككل أعضاء السلالة الفلسطينية ، مذ رمى العابرون حقائبهم على أسرّتنا التي هجرونا منها مؤولين بغريزة القتل المقدس ، من طبريا إلى بيت جبيل جنوب لبنان حيث ولدتني ، لا كما ينبغي أن تلد الأمهات . وحملتتي ، لا كما ينبغي أن يُحمل الأطفال في المهد ، من صيدا إلى الشام ، وصُرة لجوئها على ظهرها ، فيما يعتصم بجسدها الماضي إلى غده اللاجئ في بلاد غريبة أخوتي عادل واعتدال ووداد .
لم يكن لي وطن لأقصّ عليه مفردات طفولتي ، ككل أطفال الأرض ، إلا ما تسرد ذاكرة السلالة ، في مكان ما في أرضٍ ما ، كان يمكن أن يكون مَنْسياً لولا حلولنا فيه، نحن الأحياء الذين نبقى نحلم كي نعود سمّوه مخيماً ، وسمٌونا ، لنظل قابضين على جمرة الحلم بالحياة كي نعود ، لاجئين .
ولأنني ما أزال أحلم ، أروي سيرتي تلك في مرايا عودتي المنقوصة إلى وطني المنقوص ما يزال في الضفة الغربية ، بالعودة كاملة إلى وطني كاملاً من غير سوء :
جيء بي ، وأسرتي التي التحمت بعائلات فلسطينيات لاجئات من أرجاء فلسطين الممتدة ، إلى حيٌ ، أقلّ من مخيم وأوسع من مقبرة جماعية ، على مقربة من طلعة الشيخ محي الدين بن عربي ، ألماً على ألمٍ ، وفقراً على فقرٍ ، لتضيق الأرض بما اتسعت على أجسادنا المكلومة بالحنين إلى الوطن الأم وحلم العودة إليه .
أنا تلك الصبية ، بملامحي السمراء كاملة الأوصاف واسمي واضحاً كحزن نبي غريب في أهله ، ألمّ ، بذراعي ّ الذين لم يبلغا بعد الرابعة عشر ، أقراني في المدرسة ، حولي لنردد النشيد الذي كان عالياً على قاماتنا الصغيرة " تحيا الوحدة الناصرية " بين سوريا ومصر ، وكنا قد ظنناها بوحي حلمنا ، طريق عودة إلى فلسطين .
وأنا تلك التي تصطحبني أمي برفقة الأمهات الفلسطينيات الأخريات لانتقاء الهندباء والخبيزة والمشمش والجوز ، وتشيّعني للعمل مبكراً ، بعد وفاة الأب مصطفى محمد المبكرة ، في شركة الكونسروة في شارع بغداد الدمشقي ، لسدّ أفواه حوصلاتنا الجائعة ، ثم فيما بعد للالتحاق بالعمال في معمل سيرونيكس لتجميع التليفزيونات ، ولم يكن أحدها في بيتنا ، لدرء عبء نفقات تحصيلي العلمي في كلية الحقوق عمن سواي .
وأنا تلك نهاية طالبة البكالوريا في ثانوية التجهيز التي يركض ظلها برسالة من جورج حبش المتحفي في شارع بغداد ، وقد أخفيتُها في نطاقي ، إلى رفاقه المناضلين التاصريين في حركة القوميين العرب المتخفيين مثله عن أنوف المخبرين وعيون العسس في باب توما .
لم يرَ أحد ، مثلي ، ظلي ذاك مرتعشاً في مدرسة البنات الأولى في الميسات ، أعلى " المزرعة " وأسفل الشيخ " محي الدين " ، والحرب على سوريا في سوريا تدخل الأمكنة والقرى لتفسد الحياة فيها . وأنا أعلق مجلة الحائط بخطوط ممهورة بألوان العلم الفلسطيني ، وأناصر ، بالفكرة التي تعلو على جسارة الروح وحنكة الصوت كي لا يعرفه المخبرون ِو يقتادونه ألى عتمة السجون ، الفكر الوحدوي الناصري ، وأفكار ساطع الحصري وعبد الرحمن كواكبي القومية التحررية آنذاك ، والأدب السوفيتي كروايات الحرب العالمية العظمى ، والأم ، وعشرة أيام هزت العالم ، وسواها .
وكنتُ أروي كي أَذكّرَ أن الفلسطيني الذي ما يزال يدقٌ الخزان يبقى يهزّ العالم ببطولة تراجيدياه ، ويخيل لي أن على جون ريد الذي هزٌ العالم بتأملاته في شعلة ثورة أكتوبر أن يأتي إلى مخيماتنا في الشتات أو بيوتنا الصامدة بأهلها تحت الإحتلال ليؤسطر الملحمة الفلسطينية ، وأن الأمّ ، أي أم فلسطينية ، تكتب أسطورتها الخالدة ، كتلك الأم الذي أرّخ لحكايتها غوركي في روايته .
وأنا ، أسوة بجدتنا الكنعانية التي حرست بفائض صبرها وفيض حكمتها حلم شعبها ، لا أكتفي بتعليم الرياضيات في مدرسة فرادة في مخيم سبينة ، فأواصل قصٌ رؤياي على الكواكب والشمس والقمر الساجدين لبطولته ، كما لبطولات مخيمات اليرموك وخان الشيح والنيرب وجرمانا والسيدة زينب والعائدين ودرعا وشقيقاتها ، أن المرأة الفلسطينية حارسة حلم العودة والإستقلال الأبدي ، بالزغرودة والميجنا والدبكة ، أجمل ، ككل أعضاء سلالتها ، في مرايا التاريخ الإنساني من مزامير قاتل شعبها العصريّ .
وكأن ظلي لا يزال هناك في مكتب إقليم الجبهة الديمقراطية ، على مقربة من مقبرة الشهداء ، يقرأ الفاتحة و يحرس غفوتهم ، ويذرع أزقة المخيمات ، بصحبة نساء المخيمات اللواتي صرن امرأة واحدة ، نحض الرجال على البطولة ، ونحيّي على حلم العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة .
كُنتُ أروي في مراياي شيئاً ، فيصاب بئر البيت القديم بالحزن ، مثلي :
وكأنني حسبتُ أن المكان المتسع لصورتي بين الشهداء المبتسمين ، الحالمين ، أبداً مثلي ، سيبقى لي فوق جدران هذه المخيمات التي شئنا أن تصير متاحف بعد عودتنا تروي سيرتنا على الرواة والعصاة والطغاة ، قبل أن يزورها الموت والدمار ويعبثان بحلم الحياة ، وحياة الحلم بالعودة فيها .
وأنا هي ، نهاية محمد ، حاملة ، وحارسة ، حلم العودة إلى الوطن ، لم أتمهّل الأبد الذاهب بي إلى غده ، والعمر ، عمري ، المرفوع على نشيد العودة في درب آلامنا الطويل ، لأعود إلى الجزء الممكن من وطني المحتلّ .
وكأنني عدتُ ، ولم أعد .
ظلالي هناك في مخيمات اللجوء تذكّر بي هنا ، في رام الله ، وعلى مقربة من القدس ، حيث السماء قربية من قلب الرب . الحجارة التي تحتفظ ما تزال برائحة ظلال أمنا الكنعانية التي أشبهها ، لا تشير إلى أثر عابرٍ لأولئك العابرين الذين خرجوا ، بأحفادهم ، من العهد القديم ، ليمحو أسماءنا وأجسادنا المتوحدة أبداً بالمكان المقدس ، وطننا الأصلي .
وكما هناك ، في أزقة المخيمات والبيوتات التي ضاقت على ساكنيها ، حيث أحفظ أسماءهم واحداً واحداً ، وأوصاف شهدائهم واحداً واحداً ، وسيرة أحفادهم واحداً واحداً ، حفظت ، هنا ، ملامح المكان ، وانحناءات طرق البلدات التي تصل أرحام القرى برغبة إلهية ، ومواقف المواصلات العامة ، وأصوات الباعة أيضاً ، وكذا أسماء القرى المدمرة في الوطن كله، والروح البشري الفلسطيني التي ترفعه مع الصلوات لتحرس به تعاليم الرب وأجنحة الملائكة بين طائرات الأعداء العمياء ورصاص المستوطنين المدججين بغريزة القتل المقدس .
وكأن قرية زوجي في الضفة غدت العتبة التي أطل بها على الوطن ، ومن عتباتها يبدأ العالم .
وكأن الآل : الأم والأخوة والآخوات وأبنائهم وأحفادهم الذين ينوفون على المائتين أوراق مخضبة بروح الرب في غصن فرعه في السماء ، من شجرة السلالة - العائلة الفلسطينية الكبيرة والتي جذعها متوغل في الأرض - أرضنا هذه ، ليمسك العالم خشية أن يقع .
وأنا نهاية محمد تركت لكم ، فيما تركت ، لتذكروا :
قصاصة ورق رسمت عليها زهرة الدحنون
وكتبت تحتها بماء الروح :
" يداي اللتان لم تعتادا زرع الشوك أبداً سوف تبقيان ترسمان الورد وتخطان الأمل .
للورد والصفاء نذرت نفسي
وللحياة الصادقة وللمحبة تهفو روحي .
سوف تبقى الوردة رمزاً أتوق إليه في كل الأحوال و الأزمان ".
أنا نهاية محمد .
كأني سمعت أحداً منكم يغني ، أو كلكم ، تغنون لي "
مالت مالت مالت
وحق النبي مالت
سمرا يا نهاية
ردي العصبة مالت "
وها أنذا أردها .
* شاعر فلسطيني مقيم في موسكو .
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. بطل الفنون القتالية حبيب نورمحمدوف يطالب ترمب بوقف الحرب في

.. حريق في شقة الفنانة سمية الا?لفي بـ الجيزة وتعرضها للاختناق

.. منصة بحرينية عالمية لتعليم تلاوة القرآن الكريم واللغة العربي

.. -الفن ضربة حظ-... هذا ما قاله الفنان علي جاسم عن -المشاهدات

.. إصابة الفنانة سمية الألفى بحالة اختناق فى حريق شقتها بالجيزة
