الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
عن اليوم العالمي للمسرح ورسالته ... تأملات حول تقليد آن مراجعته
عبد الناصر حنفي
2016 / 7 / 22الادب والفن
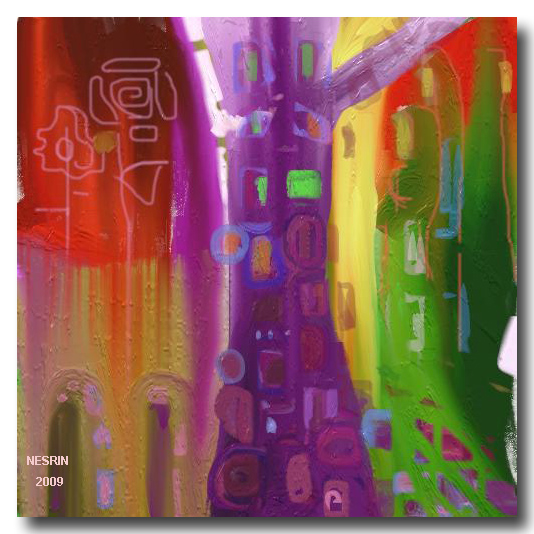
كانت رسالة اليوم العالمي للمسرح هذا العام موضع نقاش مطول مع صديق، تساءلنا لماذا يتصدر مثل هذا المشهد الاحتفالي والاحتفائي معا هذا الاستدعاء لصورة "المسرحيين اليائسين"، وهل اصبح "اليأس المسرحي" ظاهرة تفرض نفسها على التأمل العالمي؟ وهل لهذا الطرح علاقة مباشرة بوعي المجال المسرحي لذاته، وبمعضلات وجوده في الواقع: مثل ضآلة اقتصادياته في مجملها مقارنة بفنون أخرى، ومحدوديته المحلية في الزمان والمكان بواسطة أفراد بعينهم وأمام جمهور بعينه، وهل يشير هذا التأمل "الاستغاثي" إلى تضعضع ما في مقاومة المسرح "الملحمية" لتقنيات الاستنساخ الآلي الحداثية؟ وباختصار: هل نحن أمام ظاهرة تشعر بالخطر؟ أم تبدأ استسلامها له؟
فيما بعد تبين أن أحد الترجمات، أو القراءات، المرتبكة تتحمل جزءا من مسئولية إبراز موضوعة "اليأس المسرحي" في الصدارة على نحو مبالغ فيه، غير أن هذا لا يعني أن الرسالة خلت تماما من الارتباك سواء بصدد هذه التفصيلة أو غيرها، مثلما لا يعني ايضا أن تلك التساؤلات السابقة ليست اقل الحاحا وتطلبا، وهو ما دفعنا إلى الشروع في تأمل وتحليل تلك الرسالة وذلك التقليد الذي انتجها.
أولا: الرسالة:
على مدى عشرات الأعوام ترسب ما يمكن اعتباره تقاليد ذات طابع بنيوي تحدد مسارات كتابة "كلمة اليوم العالمي للمسرح"، وهي في مجملها لا تخرج عن الاحتفاء، والتبشير بالفعل المسرحي، وربما لمحة من التاريخ الشخصي للكاتب في علاقته بالمسرح والتي عادة ما تأتي ممتزجة بإشارات واضحة إلى مشاكل هذا النوع الجمالي أو أزماته أو مستقبله .. إلخ، والكلمات الأكثر حظا قد تحقق انخطافة نحو تأمل أكثر عمقا يحاول الغوص في جوهر ما هو مسرحي، أو يقتنص شيئا من ماهية علاقته بالعالم.
وفي كل الاحوال سيبدو الفاعل –أو المتكلم- هنا وكأنه في صراع مع ذاته التي عليها أن تتنحى وتتوارى إلى الخلف بقدر ما من أجل إبراز ما هو أكثر تعاليا وتطلبا في هذا السياق، أي المسرح، إذ أن تصدر الذات للمشهد أكثر مما ينبغي سيحيل عالمية الاحتفال إلى انتعاظ شخصي مغلق على نفسه، بينما تجاهلها وإلقائها بعيدا في الخلفية لن يترك لنا سوى عبارات باردة بلا حميمية. وهنا نلمح المنطقة التي يكمن فيها التوتر الدرامي الحاكم لكل الكلمات تقريبا.
وكلمة هذا العام التي كتبها المسرحي الروسي"أناتولي فاسيليف" لا تخرج عن تلك التقاليد البنيوية، حتى وإن بدت أكثر توترا وتأزما في علاقتها بكاتبها، فمجرد قراءتها بتروي ستكشف عن الطريقة "المدرسية" الساذجة التي اتبعت في تأليفها، فقد وضع الكاتب لنفسه خطاطة هيكلية مسبقة تمثلت في عدد من النقاط التي جاءت على هيئة أسئلة تتمحور في أغلبها حول "الحاجة المسرحية": هل نحتاج المسرح، وفيما نحتاجه، وماذا يعني، وما الذي يمكنه قوله لنا، وما المسرح الذي نحتاجه أو لا نحتاجه؟ .. إلخ، وتلك النقاط ستبدو وكأنها بمثابة أسيجة تمنع الكتابة، والكاتب، من الانفلات، أو الضياع في تيه الكلمات والاندفاع تجاه ما لا يراد، أو ما لا ينبغي قوله!، وبرغم ذلك، أو ربما بسببه، فمن الواضح أن الفقرات الأولى للكلمة تعاني حالة مبرحة من المعاظلة، والاقتضاب، قبل أن تطمئن الذات مع الفقرات الأخيرة وتستسلم لإلحاحها الخاص بوصفها المرجعية الحاضرة للرغبة المسرحية المعلنة.
وأول ما يتبادر للذهن هنا هو: لماذا يتوجب إخضاع مسرحي ما لتلك التجربة القاسية التي تشبه غلظة أداء "واجب مدرسي" صعب ومفاجيء؟ وأن يعاني الشعور بتأهب العالم لسماع كلماته التي لم يعثر عليها بعد، ما الفائدة من مثل هذا الوضع، سواء للمسرح أو للمسرحيين؟
وإذا ما عدنا للنظر في الكلمة ذاتها (وبعد مقارنة عدة ترجمات) فسنرى أنها تمر على قضية اليأس المسرحي في إلتفاتة عابرة، قبل أن تعود لتسجل قلقها من حالة التبدد التي ينتهي إليها الفعل المسرحي والذي ما أن ينقضي حضوره حتى يتحول إلى مجرد ذكرى لمن تشاركوه، وهو ما يتبدى عبر الدعاء أو الابتهال للجمهور ألا يترك المسرح نهبا للنسيان وقلة المشاركة، وهذا المنحى الإبتهالي في مواجهة إشكالية بنيوية تحكم وجود الظاهرة المسرحية يكاد يرسم سقف الوعي البسيط، والمغترب، المهيمن على هذه الكلمة والذي يصل بها إلى حد التخارج أو النفي للظاهرة المسرحية التي لا تستطيع مقاربتها إلا عبر ما هو "غيرها" أو خارجها، أو ما هو مجرد تفصيلة عابرة، أو تبديات حسية وأولية للظاهرة، وباختصار فالكلمة تتأسس على وعي مغترب عن ظاهرة المسرح، وتؤسس لهذا الاغتراب في نفس الوقت.
وهذا الوعي المغترب يمكن تتبعه بسهولة في الحديث عن "المسرح" بوصفه "أداة للحكي" والإخبار عن "تفاصيل العالم" أو "موضوعاته" (الحكي في النهاية مجرد تقنية مسرحية، ولكنه هنا يتم إعلاؤه بلا مبرر بحيث يصبح المسرح نفسه أحد أدواته!)، أو في التقهقر نحو التبدي الحسي السطحي للمسرح بوصفه مقصورات وشرفات مذهبة أو صناديق سوداء يعلوها الطين وتلطخها الدماء، مقابل تلك القفزة الغنوصية التي تجعل المسرح أكثر شفافية من الضوء، أو تقدمه بوصفه جوهر "النور" الذي لا يمكن لأحدنا إلا أن ينغمر و"يتعمد" داخله، وفي لحظة ما سيبدو وكأن العالم قد ابتلع ما يخص المسرح بحيث أصبحت أحداثه محض تكرار للتراجيديات الأصلية، بينما في لحظة أخرى سيبدو وكأن المسرح قد ابتلع العالم وأن كل ما يجري في الواقع هو محض تجليات للأنواع المسرحية، ومن الواضح أنه عبر هذا التماهي والتماهي المعكوس بين المسرح والعالم يصبح من الصعب تمييز ما هو مسرحي، وكذلك الأمر بالنسبة لخفض حضور "ما هو مسرحي" إلى المستوى الحسي البسيط لصناديق التمثيل والمشاهدة، أو للتفاعل الحسي المباشر للمسة والايماءة، أو إعلائه الميتافيزيقي ليصبح "جوهر النور"، أو إختزاله لأحد تقنياته –الحكي-، كل هذه الدوائر المغلقة من الخفض والتعالي والتماهي والتماهي المضاد ترسم معالم اغتراب هذه الكلمة عن المسرح، وتخارجها عنه.
وبالتأكيد فهذه ليست المرة الأولى التي يطل علينا فيها هذا الوعي المغترب عبر نصوص رسالة اليوم العالمي للمسرح، فهناك مثلا الكلمة التي كتبتها المسرحية البارزة "آريان منوشكين" والتي لا تتضمن سوى أدعية وابتهالات ذات نبرة دينية واضحة موجهة للمسرح وكأنه إله قادر بذاته على الفعل بنا والفعل لنا، وهذا الاعلاء للمسرح إلى مرتبة الآلهة من زاوية يقابله إلغاء لإنسانيته وخفض لها من زاوية أخرى، وكأنه قد أصبح خارج حدود إرادتنا وفعلنا، أي أننا أصبحنا نخصه أكثر مما يخصنا، بمعنى أننا هنا لسنا أمام حالة من الاغتراب عن المسرح فقط بقدر ما هي ايضا حالة اغتراب للذات عن فعلها؟
ولكن مهلا .. لماذا يتوجب علينا أن نحلل هذه الكلمات وكأنما كان يفترض بها أن تقدم أفكارا متماسكة عن "النوع المسرحي"، فهذه مهمة منظري المسرح، بينما كتاب هذه الكلمة هم في غالبيتهم مجرد مبدعين مسرحيين، وتعاطي الافكار النظرية المجردة، أو الملهمة، ليس بالضرورة ضمن مهاراتهم، أو حتى اهتماماتهم، وهو ما يقودنا لتساؤل آخر أكثر أهمية: لماذا يتم الاحتفاء بالمسرح في يومه العالمي عبر تعميم مثل تلك التأملات المضطربة والمغتربة؟ وما هي أهمية تلك التأملات أصلا إن لم تصبح موضوعا للنقاش والتحليل؟ ... وهو ما ينقلنا إلى الجزء التالي.
ثانيا: طقسية التقليد:
منذ عام 1962 فصاعدا اصبح يوم 27 مارس هو اليوم العالمي للمسرح، طريقة تحديد هذا اليوم كانت اعتباطية إلى حد كبير، فهو ببساطة كان تاريخ افتتاح مسرح الأمم في باريس، والموقع الالكتروني المخصص لهذا الحدث لا يقدمه إلا بوصفه موعدا لإلقاء تلك الكلمة -التي تختار المؤسسة الدولية للمسرح كاتبها كل عام- في جميع المسارح التي تلتزم طوعا بذلك. وتحديد الكاتب الأول للكلمة تم بشكل أكثر بساطة، فما دام الموعد قد ارتبط بمسرح باريسي فقد تم اختيار المسرحي الفرنسي الشهير "جان كوكتو" لأداء هذه المهمة، ولكن يبدو أن هذه البساطة السلسة قد خلقت مشاكل أكبر فيما بعد، إذ أن عملية الاختيار تلك –منذ بدايتها- لم تتأسس طبقا لقواعد واضحة، وتركت بأكملها لإرادة القائمين عليها، وبالنظر إلى عشرات المسرحيين الذين تناوبوا على كتابة هذه الكلمة فمن الصعب أن نعثر على قاعدة واضحة تضع "بيتر بروك" مثلا إلى جوار "سلطان القاسمي"، أو حتى تساوي بين "سعد الله ونوس" و"فتحية العسال"، ولذلك لن يمكننا أن نتكلم عن هذه الاختيارات بوصفها جائزة أو تتويجا لمنجز مسرحي، فهي اقرب ما تكون إلى مجرد تكريم دون مبرر معلن أحيانا، ودون مبرر مفهوم أو "مشروع" أحيانا أخرى!
لقد تم إرساء تقليد كلمة اليوم العالمي للمسرح، كمحاولة –ربما- لاستخدام واحدة من الاسلحة السحرية للمسرح، وهي الحضور الحي والآني في حيز بعينه، بحيث يتم توحيد هذا الحضور في لحظة ما على مستوى العالم بأكمله، وعبر هذه الحالة التوحيدية سيبدو وكأن المسرح يتحرر ولو للحظات من قيده المكاني ليطفو في الزمن متماثلا مع ذاته على مستوى كافة مساحات حضوره، أو كافة مساحات التمثيل والفعل المسرحي عبر العالم، وبالطبع فهذه مغامرة جريئة للغاية، وذات طابع طقسي لا تخطئه عين، وكأنها ابتهال "مؤقت" واستعادة عابرة لاندفاعات تلك الفعاليات الطقسية القديمة التي انتجت لنا المسرح في النهاية.
ولكن الفعل المسرحي هو بالأساس تطور فارق للاندفاع الطقسي، وخطوة بعيدة عنه، فهو حالة أكثر تعقيدا وتركيبا، واقل مباشرة، وأكثر شغفا بإبراز ما هو مختلف والتعاطي معه، وبعبارة أخرى يمكننا القول أن ما هو مسرحي بدأ مع الالتفات لما هو مختلف على حساب الآلية الطقسية للدمج وطمس الاختلافات. وهنا نصل إلى التناقض الذي يحكم، أو بالاحرى يفتت ويذيب، تقليد الاحتفال باليوم العالمي للمسرح عبر تلك الكلمة او الرسالة الموحدة التي تلقى على مختلف خشبات المسرح في العالم، فالاحتفال، اي احتفال، هو بحكم التعريف تأسيس للحظة فارقة، إعادة خلق، أو تأكيد، لتراتبية ما تضع ما هو محتفى به بمنأى عما هو عادي أو مبتذل، وبذلك فالاحتفال فعل طقسي في جوهره، وبالتالي فليس من الممكن الاحتفال بما هو مسرحي، وتجنب الانغماس في فعالية طقسية، أو بعبارة أخرى، فالتناقض الكامن في مثل هذا الاحتفال هو أمر لا يمكن تجاوزه، أو تجنب الوقوع فيه، فهو يبدو بمثابة الضريبة التي يتوجب على ما هو مسرحي أن يتكبدها، فمن أجل الاحتفاء بنفسه عليه أن يسمح لذاته بالتقهقر والغياب بحيث تصبح منبرا لحضور ذلك الأب الطقسي الذي سبق له أن تخلص منه وقتله ليؤسس نمط وجوده الخاص. لا يوجد هنا من يمكن أن يوجه له اللوم.
ومع ذلك يبقى السؤال الأهم على وجه الاطلاق: لماذ يختار المسرح، أو يختاروا له، أن يكون احتفاءه السنوي بذاته عبر شكل غير مسرحي، بل بالادق شكل ما قبل مسرحي، وهو "الالقاء"؟
ثالثا: المراجعة:
لو أنه من المقدر لذلك التقليد أن يعود إلى واجهة الاهتمام مرة أخرى على نحو مؤثر واكثر حيوية، فينبغي إعادة التفكير فيه بجدية أكبر.
وبداية ينبغي التفرقة على نحو كامل بين تكريم شخصية مسرحية بعينها كل عام، وبين الرسالة التي يتم تعميمها على مسارح العالم، فلا يوجد أي منطق في الربط بينهما على هذا النحو.
والتكريم ينبغي أن يتم عبر التأسيس لجائزة ذات قواعد معلنة ومعروفة وتحظى باحترام الجميع، بدلا من ترك الأمر لتسويات الكواليس والتقديرات الشخصية لمن يديرونها، أما إذا كنا نفكر في تقليد الرسالة السنوية بوصفه فرصة لتعميم تأمل بعينه حول المسرح فالأجدر أن نتعامل معه بوصفه كذلك، وهنا تكون الأولوية للبحث عن الفكرة لا الشخص، وبالتالي يمكن إجراء مسابقة عالمية قادرة على التقاط وتقديم تأمل فارق وافكار أصيلة أو مجددة حول النوع المسرحي، بدلا من تلك القطع الانشائية البليدة التي باتت "كلمة اليوم العالمي للمسرح" تدور في رحاها.
وفي كل الاحوال ... فعلى المسرحيين أن يفكروا في شكل أكثر انتماء وقربا للمسرح من تقنية "الإلقاء" الطقسية المصمتة تلك، بحيث يجعلوا احتفالهم السنوي أكثر "مسرحية".
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. ملتقى دولي في الجزاي?ر حول الموسيقى الكلاسيكية بعد تراجع مكا

.. فنانون مهاجرون يشيّدون جسورا للتواصل مع ثقافاتهم الا?صلية

.. ظافر العابدين يحتفل بعرض فيلمه ا?نف وثلاث عيون في مهرجان مال

.. بيبه عمي حماده بيبه بيبه?? فرقة فلكلوريتا مع منى الشاذلي

.. ميتا أشوفك أشوفك ياقلبي مبسوط?? انبسطوا مع فرقة فلكلوريتا
