الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
أسئلة السينما العراقية المعاصرة
بشار إبراهيم
2006 / 7 / 7الادب والفن
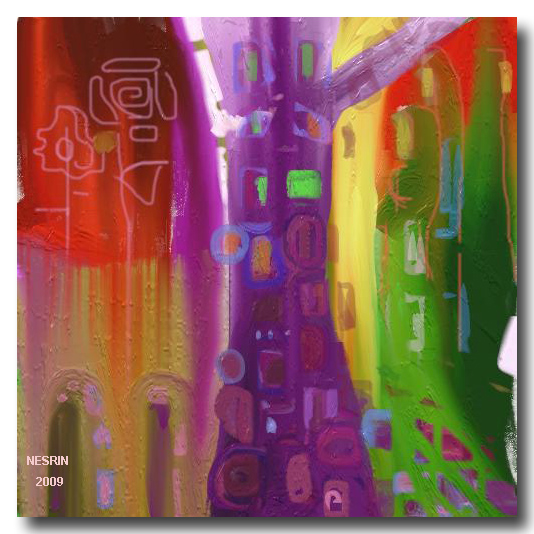
أقام مهرجان الإسماعيلية الدولي التاسع للأفلام التسجيلية والقصيرة، عام 2005، تظاهرة خاصة تحت عنوان «نماذج من السينما العراقية المعاصرة»، تمّ خلالها عرض مجموعة من الأفلام، التي تتناول الموضوع العراقي، من جوانبه المختلفة.. وفي الحقيقة لم يغب طراز هذه الأفلام عن غالبية المهرجانات المنعقدة، خلال العامين المنصرمين، بدءاً من مهرجان الفيلم العربي في روتردام، الذي منح جائزتين أوليتين لفيلمين عراقيين، في دورتيه السابقتين، على التتالي، مروراً بمهرجان الإسماعيلية، وصولاً إلى الدورة الأولى من «مهرجان بغداد الدولي للفيلم التسجيلي والقصير» في شهر كانون أول/ديسمبر 2005.
وإذ تفتح هذه المهرجانات الملفات العراقية، عبر العديد من الأفلام التي تم إنجازها، بإنتاجات متعددة، عربية وأجنبية.. وإذ تحاول هذه الأفلام رسم جوانب من صورة العراق في «مرحلة ما بعد صدام»، فإنها إنما ترتكز على الكثير من تفاصيل صورة العراق في «مرحلة صدام» نفسه، ربما بسبب اعتقاد راسخ بأن الكثير مما جرى أيام صدام، لم يتم الاطلاع عليه، ولا معرفة حقيقته على الصورة الأمثل، وبالتالي فإن الكشف عنه يؤسس إلى تحويل ما جرى في الماضي، درساً يُستفاد منه في مجال تجنب تكرار التجربة المؤلمة، أو الوقوع في ربقة الديكتاتورية، مرة أخرى!..
لقد فتح سقوط الطاغية صدام حسين، وانهيار نظامه، الباب أمام تحولات تاريخية لا بد أن يشهدها العراق في أيامه المقبلات، على المستويات كافة، سياسية، واجتماعية، واقتصادية، وثقافية فكرية، وفي مجمل صنوف الإبداع.. وبالمقدار الذي حاول به نظام الاستبداد البائد، إغلاق الخيارات التاريخية، والقبض على مصير الوطن والشعب، والتحكّم بمقدَّارتهما، وأقدارهما؛ بالمقدار نفسه، ستأتي التحولات على درجة من القوة، والوضوح، والدأب في التخلّص من كل الآثار التي تركتها «الأيام الطويلة» بكل سوادها، والسعي نحو الانفتاح على مستقبل مأمول.
وإذا كان المجال هنا، هو تناول الحديث عن السينما العراقية، التي استطاعت، خلال العامين المنصرمين، أن تكون سفيرة لـ «القضية العراقية»، مُبيّنةً بالصورة التي لا تُدحض، جوانب مما جرى، وعرضها على جمهور المشاهدين، في شتى أنحاء العالم، عبر نصوص بصرية، تفاوتت في المستوى الفني، وتنوعت في الخطاب الفكري، وما يتعلق به من رؤية سياسية، فمن الجدير القول إن السينما العراقية المعاصرة، كان عليها التخلص من كل المؤثرات السلبية، التي حاول نظام البعث زرعها في جسد السينما العراقية، التي تعود بولادتها الأولى إلى ما قبل ولادته البعث نفسه.
السينما العراقية.. توطئة تاريخية
تتفق أغلب المصادر التاريخية، التي تُسجّل بدايات السينما العربية، على أن العراق عرف أول عرض سينمائي في العام 1909، تم في مدينة بغداد، عبر البعض من هواة الدهشة والمغامرة، ممن أحضروا أشرطة سينمائية، وآلة عرض، ومنحوا متعة المشاهدة للحضور، قبل أن يقوموا بتنظيم تلك العروض، مقابل بطاقات مدفوعة الثمن.
وتذكر المصادر ذاتها، أن أول دار عرض أقيمت، كانت أيضاً في بغداد، وكانت تُعرف باسم صاحبها: «سينما بلوكي»، وذلك قبل أن يتم إنشاء عدد من دور العرض، التي تذكر المصادر منها: (عيسائي، وأوليمبيا، وسنترال سينما، والسينما العراقي، والسينما الوطني).. وكانت العروض التي تقدم في هذه الدور عبارة عن مشاهد متنوعة، حيث يُذكر أنه في العام 1911، كان يتم عرض مشاهد من جنازة إدوارد السابع في انجلترا، ومشاهد عن سباق مناطيد، ومشاهد من الطبيعة (بحر هائج)، أو بعض الأعمال المشوقة: (صيد الفهد، التفتيش عن اللؤلؤة السوداء)..
أما على مستوى التصوير، فيذكر أن بعض البعثات الأجنبية، كانت تحضر إلى العراق، للقيام بعمليات التصوير السينمائي، خاصة للأحداث الهامة، أو المواقع التاريخية، وعرضها على الجمهور العراقي.. إذ كان من المنطقي أن يحظى العراق باهتمام كبير، بسبب حيازته على موقع خاص، بسبب موقعه في السياسة الدولية، أو ما يمتلكه من مواقع، وآثار، وأوابد تاريخية..
وعلى صعيد الإنتاج السينمائي، يُذكر أن أولى المحاولات لإنتاج أفلام في العراق، بادرت إليها إحدى الشركات الأجنبية، في عام 1930، لكن المحاولة لم تكتمل، ومن ثم حدث أن شارك عدد من هواة السينما، من الفنانين العراقيين، في عدة أفلام مصرية وسورية، يُذكر منهم نزهت العراقية، التي شاركت في فيلم «العزيمة» الذي أخرجه كمال سليم.
ومع مطلع الأربعينيات، شرع بعض أصحاب الأموال، وأثرياء الحرب، في تكوين الشركات السينمائية، وكانت أولاها «شركة أفلام بغداد المحدودة»، التي أُجيزت في أواخر عام 1942، والتي لم تُوفَّق إلى النجاح في إنتاج أي فيلم. وفي عام 1946 أُنتج أول فيلم في العراق، من قبل شركة «أفلام الرشيد» العراقية المصرية المشتركة، وهو فيلم «ابن الشرق»، إخراج المصري نيازي مصطفى، ومثَّل فيه عدد كبير من الفنانين العرب، وخاصة من مصر، مثل بشارة واكيم، ومديحة يسري، ونورهان، وأمال محمد. أما من العراق فشارك في الفيلم كل من عادل عبد الوهاب، وحضيري أبو عزيز، وعزيز علي.
وعرض «ابن الشرق» خلال أيام عيد الأضحى في أواخر عام 1946، الذي شهد إنتاج الفيلم الثاني «القاهرة بغداد»، الذي أنتجته شركتان، على ما تذكره المصادر، هما شركة «أصحاب سينما الحمراء»، وشركة «اتحاد الفنيين» المصرية. ومع الفيلمين (ابن الشرق، القاهرة بغداد)، شرع بتصوير الفيلم الثالث «عليا وعصام»، الذي أخرجه الفرنسي أندريه شوتان. ومثَّل فيه كل من: إبراهيم جلال، وسليمة مراد، وجعفر السعدي، وعبد الله العزاوي، ويحيى فايق، وفوزي محسن الأمين وغيرهم.
وبعد نجاح فيلم «عليا وعصام» قام منتجه (أستوديو بغداد)، بإنتاج فيلم جديد هو «ليلى في العراق»، الذي أخرجه المصري أحمد كامل مرسي، ومثل فيه المطرب محمد سلمان من لبنان، وشارك في الفيلم من العراق إبراهيم جلال، وعفيفة إسكندر، وعبد الله العزاوي، وجعفر السعدي. وقد عرض فيلم «ليلى في العراق» في سينما روكسي خلال ديسمبر 1949. وفي العام 1953، بادر ياس علي الناصر، إلى تأسيس شركة «دنيا الفن»، وكان فيلمها الأول «فتنة وحسن»، الذي أخرجه حيدر العمر، وجرى عرضه في عام 1955.
وتأسست في العام 1960، أول مؤسسة رسمية تعني بالسينما، هي «مصلحة السينما والمسرح»، التي بدأت نشاطها بإنتاج الأفلام التسجيلية الوثائقية، إضافة إلى تقديمها التسهيلات للعاملين في القطاع الخاص، من أجل العمل السينمائي الواقع تحت السيطرة، أو الإشراف.
أما في مجال الفيلم الروائي، فإن «مصلحة السينما والمسرح»، لم تقدم على هذه الخطوة إلا بعد بضع سنوات. حيث شرع في عام 1966 بتصوير فيلم «الجابي»، من إخراج جعفر علي، وبعد عرضه تتابعت أفلام المصلحة، فكان فيلم «شايف خير» لمحمد شكري جميل، و«جسر الأحرار» لضياء البياتي. وفي عام 1973 أُنتج فيلم «الظامئون» من إخراج محمد شكري جميل، ومن ثم فيلم «الأسوار».
وفي العام 1973، صدر القرار الذي جعل مهمة استيراد وتوزيع الأفلام بيد الدولة، عبر «مديرية استيراد الأفلام» التابعة لـ «المؤسسة العامة للسينما والمسرح»، مما أنهى دور القطاع الخاص في مجال استيراد، وتوزيع الأفلام، وبقي له هامش، تحت التحكم الكامل، في مجال الإنتاج. الأمر الذي كان يعني أن الدولة احتكرت العملية السينمائية لذاتها، وتحكمت بها على النحو الذي تريد.
سينما «الأيام الطويلة»!..
منذ العام 1980، أُدخل العراق في أتون حروب متتالية، لم تنته حتى سقوط النظام، ففي الفترة ما بين العام 1980 والعام 1988، كانت حرب الخليج الأولى، فيما بين العراق وإيران، وخلال هذه الفترة عمد النظام إلى تهيئة الفرص، لإنتاج أفلام دعائية تحريضية، تمجد النظام العراقي، وتهاجم إيران، كان أبرزها فيلم «القادسية» للمخرج المصري صلاح أبو سيف، الذي حاول القيام بعملية إسقاط تاريخية، تخدم نظام صدام وحربه، من خلال استعادة بائسة لموقعة «قادسية سعد بن أبي وقاص»، ومقايستها بموقعة «قادسية صدام حسين»!.. واستعادة أكثر بؤساً لصورة «العدو الفارسي»!..
وكذلك فيلم «الأيام الطويلة» للمخرج المصري توفيق صالح، عن حياة صدام حسين نفسه، وتم تحقيقه برعاية مباشرة، وغير مباشرة، من قبل صدام حسين، مما جعل الفيلم أكثر بؤساً من الوقوف عنده، خاصة وأن جنون العظمة دفع بصدام حسين للتدخل في تفاصيل الفيلم بشكل يثير السخرية المرة. والطريف أن هذا الفيلم لم يعد مؤهلاً للعرض، بعد ما جرى لحسين كامل حسن، وشقيقه صدام، الذي قام بدور صدام حسين..
من المنطقي القول إنه لم يكن لهذه الأفلام أن تحقق أي مستوى فني، أو أي حضور في سوق العرض السينمائي العربي، لأسباب عدة منها ما هو متعلق بالشروط الصارمة، التي كان يتم خلالها إنجاز هذه الأفلام، خاصة حالة الضبط الأمني الصارم، الذي كان يصل إلى درجة الرعب الحقيقي، مما جعل هذه الأفلام عبارة عن دعاية مباشرة، لا تمتلك أدنى إحساس بالخجل!.. كما اُعتبرت لطخات سوداء في جبين تاريخ كل من المخرجين صلاح أبو سيف، وتوفيق صالح، لم يستطيعا التبرؤ منها، ولا الحصول على المغفرة!..
السينما العراقية التي أرادها صدام حسين، ونظامه البائد، سلاحاً يخدم مصالحه، كان لها أن تموت، وتندثر، حتى قبل أن يندثر هو.. فعندما يتم إخضاع نسق إبداعي لخدمة الديكتاتورية، ويرضى الإبداع بذلك، يفتقد هذا النسق أخلاقياته، ولا يستطيع الحصول على احترام أحد. هكذا كان من المنطقي أن نجد عدداً كبيراً من السينمائيين العراقيين، يسعون للفرار من بطش الطاغية، والتناثر في شتى أنحاء العالم، طالما أنهم لم يتمكَّنوا من العمل الذي ينتمي إلى القليل من قناعاتهم، ولا الانزواء والسكوت، أو الاستنكاف عن العمل فيما لا يؤمنون، ولا يقبلون به، فقد كان من أدنى ممارسات نظام البعث أن اعتبر الولاء له، أهم وأولى من الولاء للوطن، وبالتالي اعتبر أن إنجاز أفلام تخدمه، وتتبنى مقولاته، بمثابة المهمة الوطنية التي لا بد للسينمائيين من القيام بها.
ماتت السينما العراقية بين أيدي نظام الطاغوت، بعد أن أُذلَّت وأُهينت، وصار السينمائيون العراقيون لاجئين في بلدان العالم، عربية وأجنبية، واستوعبتهم المنافي، فاستقر المخرج قيس الزبيدي في ألمانيا، وقاسم حول في هولندا، ومحمد توفيق في الدانمارك، وانتشال التميمي في هولندا، وقاسم عبد في لندن، وفيصل الياسري في سوريا، ومن ثم مصر، وباز شمعون في كندا، وهادي ماهود في أستراليا، وعمر أحمد في أمريكا.. وتوارى آخرون، ومات من مات، كاظماً غيظه، منطوياً على حزنه، بل غضبه.. وهكذا فإن العراق، الذي كان يبشّر، فيما مضى، بأن يكون أحد مراكز السينما العربية، صار خرابة سينمائية!..
سينما اللحظات الحاسمة..
سقط صدام في «حفرته»، فخرج العراق من «بئر الظلمات»، التي وُضع فيها طيلة خمس وثلاثين سنة، وتنفس العراقيون الصعداء، وبدا للحظة أنهم يعودون دفعة واحدة إلى التاريخ، الذي أُخرجوا منه. قرص الكثيرون أفخاذهم ليتأكدوا أنهم ليسوا في حلم، وبالتالي لم تطل ساعات استعادة الوعي كثيراً، فكان أن أشرع سينمائيون عراقيون في بحر رحلة العودة إلى الوطن المُستعاد، وتحولت رحلات العودة، بعد مرور السنوات الطوال، إلى رحلات استكشاف، للعراق الذي كان غارقاً في ظلمات المجهول، مسوراً برجال البعث والمخابرات، والتعتيم، والقتل..
سيبدو فيلم «ست عشرة ساعة في بغداد» للمخرج طارق هاشم، واحداً من أوائل تلك المحاولات، فهذا الفيلم التي صار جاهزاً للعرض في العام 2004، ونال جائزة كبرى في مهرجان الفيلم العربي في روتردام، وهو فيلم تسجيلي طويل (مدته 58 دقيقة)، هو رصد بصري لمسيرة عودة المخرج طارق هاشم، إلى بغداد، بعد غياب عنها دام قرابة 23 سنة.
لا يريد طارق هاشم امتحان ذاكرته، بعد كل هذا الغياب، فقط، وهذا حقّ له، بل سنراه يحاول استكشاف كل التحولات التي جرت في بلده، في سنوات الغياب الطويل، سنوات القهر الذي لا نظير له، فيمضي مع الكاميرا إلى الكثير من الأمكنة والمواقع، المعهودة في بغداد، والكثير من الشخصيات التي باتت لا تخاف من الجهر بقولها، والتعبير عن مواقفها.
يصل طارق هاشم إلى بغداد، بينما لن يتمكن باز شمعون البازي، من تحقيق ذلك، فيكون فيلمه «العراق إلى أين؟» التسجيلي القصير (مدته 19 دقيقة). يأتي باز شمعون من كندا إلى الأردن بغرض العودة إلى العراق، وهو من أمضى 27 عاماً بعيداً في المنفى الكندي. عودة باز شمعون حصلت قبل 75 يوماً من أسر الجيش الأمريكي لصدام حسين، وبالتالي فإن الفيلم الذي انتهت عملياته الفنية، وصار جاهزاً للعرض عام 2004، يفصح عن التاريخ الذي تمّ فيه تصوير الفيلم، وهذا أمر لا بد منه، إذ أن تلك اللحظات ذات تأثير في مواقف الناس وآرائهم، وهو ما يجعلنا اعتبار السينما العراقية المُنجزة في ذلك الوقت، هي «سينما اللحظات الحاسمة»، فالمتغيرات في الحال العراقية هي على تسارع لحظي هام، يجعل كل صباح يأتي بجديد.
فيلم «العراق إلى أين؟» يدور في الأردن، ولا يصل إلى العراق أبداً، لكنه وعلى الرغم من ذلك يحاول رسم صورة العراق في تلك اللحظات، من خلال ما يقوله الناس المنتظرين الوصول إلى العراق. في إحدى محطات الركاب ثمة مجموعة من العراقيين، ممن لم يعودوا قادرين على عبور الحدود، منهم سائقي شاحنات، ولاجئين متعبين، ومنتظرين على قلق، وعمال لا عمل لهم، وباعة صغار.. تقابلهم الكاميرا، كما تتجوّل بين المطاعم الرخيصة، والمقاهي الشعبية، المجاورة لمحطة الانتظار..
ما بين عناء السفر، قدوماً من شتى البلدان إلى هنا، ولحظات الانتظار الملولة، للسماح بالعبور إلى العراق، القريب في مدار الحلم، والبعيد على بوابات العبور، ترصد الكاميرا حالات من الحوارات والنقاش، الذي يعلو إلى حدّ الجدال الساخن.. فلكل رأيه، ورؤيته، لواقع العراق اليوم، وحاله المستقبلية، الأمر الذي يبدو على هيئة «مؤتمر شعبي» عراقي ينعقد بعفوية، على قارعة الرصيف، يفتح الملفات الساخنة حول سنوات الحرب، والعقوبات، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والخوف من الإعدام.. هناك من يلعنون الاحتلال، كما يلعنون زمن صدام، ويشعلون سؤال مستقبل العراق..
عودة المنفي إلى السماوة..
رحلة الاستكشاف الأهم، على المستوى الفني، والمضمون الفكري، تتجلّى في فيلم «العراق موطني» للمخرج هادي ماهود، وهو فيلم تسجيلي طويل (52 دقيقة)، يمتدّ تحقيقه على مدى أكثر من سنة ونصف، يبدأها الفيلم بخبر سقوط النظام، فما يكون من المخرج العراقي هادي ماهود، المقيم في أستراليا، منذ 13 عاماً، إلا التحضير للعودة إلى العراق، وهذه العودة سوف تنتهي إلى الفيلم الذي بين أيدينا.
سنعرف أن هادي ماهود ينتمي إلى مدينة السماوة، في الجنوب العراقي، ولهذا فإنه يمنح فيلمه عنواناً فرعياً هو «عودة المنفيّ إلى السماوة». العودة إلى السماوة هي العودة إلى الوطن العراقي، الذي افتقده هادي ماهود، والانتماء إلى السماوة هو الانتماء إلى الوطن، الذي حافظ عليه هادي ماهود، حتى في مغتربه الأسترالي. وبالتالي فإن الصورة التي سيرصدها هادي ماهود في السماوة، هي جزء من صورة الوطن ذاته.
يتميز فيلم «العراق موطني» بأنه يرصد، وبصورة تكاد تكون استثنائية، مدينة عراقية بعيدة عن مدينة بغداد، التي أخذت مركز الاهتمام من السينما العراقية المعاصرة، والأفلام التي أنتجت عن العراق، عربية أو أجنبية.
من أستراليا إلى السماوة تمتد الرحلة. وفي السماوة سيجد المخرج هادي ماهود العديد من الشخصيات الطريفة، التي تصلح لأن تكون مرتكزات درامية يقوم عليها فيلمه، أولها شخصية «مجيد» المجذوب الذي يكاد يصل إلى حدّ الجنون، والعاقل الذي يصل إلى حدّ أن يكون صوت الضمير. «مجيد» مجنون المدينة وحكيمها يتناول التفاصيل التي كانت في عهد صدام، بكل قسوتها ووجعها، كما يلتقط أطراف الفساد الراهن، بسبب الفوضى التي تعم المكان.
أما الصبي «أحمد»، الفتى اليافع، والذي فقد مهنته كعامل بناء، بعد أن سُرقت معدات معمل الإسمنت، ليتحول إلى مهنة بيع الرصاص، يقود المخرج إلى تفاصيل المدينة وأسرارها، مثل: غرف تعذيب دائرة الأمن العامة، وسجون قطاعات التحالف في المدينة، التي لا يتوفر فيها أدنى حد من الخدمات.
سيتعرض الفيلم لموضوع السجناء العراقيين، وطبيعة الحياة في السماوة، والتفجيرات التي تستهدف دوريات الشرطة، والجنائز وطقوس التعزية الشيعية، والمدافن الجماعية، وعمل الجيش الياباني، وواقع البنية التحتية في المدينة، ومواقف المواطنين العراقيين السياسية، وشكل الحياة في هذه المدينة، ذات الطبيعة المحافظة.
خلال تصوير يحدث تفجير سيارة مفخخة، فيرى المخرج في الحدث فرصة لا بد من تسجيلها، وتوثيقها، بتصويرها، الأمر الذي يجعله يدفع ثمناً موجعاً، بتعرضه للضرب الموجع، من قبل رجال الشرطة، والاعتداء الواسع من قبل الناس المفجوعين بالانفجار، محطمين كاميرته، وتاركين الآثار الدامية على جسده..
فيلم «العراق موطني»، ينتهي إلى ما يشبه رسالة انتماء من قبل المخرج هادي ماهود، إذ نراه يرفض مغادرة العراق، مرة أخرى، ويقرر الانتماء النهائي للوطن، ويربط نفسه بزواج من فتاة عراقية، ليبقى إلى الأبد في وطنه، ويقطع علاقته مع المنفى. وفي هذا الإطار يرسم صورة جميلة ومشرقة لمستقبل العراق، بدءاً من النشيد العربي الشهير «موطني»، وصولاً إلى الكشف عن التحولات التي باتت مدينته تشهدها، من حيث قدرة الناس على التعبير عن استنكارهم لموقف مجلس المدينة، تجاه هذه المسألة الحياتية اليومية، أو تلك. أو من حيث تبلور مظاهر التحديث، بدخول الكمبيوتر، والإنترنت، واستعمال الفتيات له.
اللغة..
لن يعود المخرج سمير زيدان إلى العراق، من أجل تحقيق فيلمه «اللغة»، الروائي القصير (مدته 5 دقائق)، بل سيبقى في منفاه الأوروبي، ليتناول من هناك حكاية دالة ومعبرة، من خلال حياة المنفيين العراقيين في بلدان الاغتراب، وإشكالية التواصل عبر اللغة.
الكثير من العراقيين، في المنافي التي استطالت بها السنون، وجدوا أنفسهم يتزوجون، وينجبون أطفالاً، لم يعرفوا غير بلدان المنفى موئلاً، مما جعل لغة البلد الأجنبية هي أداة التواصل بين الأب وأطفاله، في حياة المنفى، ولكنها لن تستطيع أن تكون أداة تواصل بين هؤلاء الأطفال والأهل في العراق..
الحكاية تجري على نحو بسيط ظاهرياً، عميق دلالة وتعبيراً، إذ تأتي مكالمة من العراق، تتلقاها الابنة العراقية، الصبية «ماجدة»، التي وُلدت وعاشت في النرويج، والتي لا تعرف اللغة العربية، فتحار الابنة أمام المكالمة العربية، التي لا تفهم منها شيئاً..
يهتدي الأب إلى وسيلة طريفة في التخاطب، إذ يعزف على شبابته مقاماً عراقياً معروفاً، تقول كلماته: «يللي نسيتنا.. إمتى تذكرونا»؟.. فما يكون من الابنة، وبعد أن أتقنت العزف، في موعد الاتصال التالي، إلا أن تعزف المقطوعة، مستعيضة بالموسيقى عن الكلمات. الموسيقى التي تستطيع التعبير عن الكثير من الأحاسيس، والمشاعر، والانفعالات..
فيلم «اللغة»، وبالمقدار الذي يبدو فيه بسيطاً، سلساً، فإنه يأتي متقناً فنياً، دالاً وعميقاً، حافلاً بالرموز، والتعبيرات الفنية، قادراً على قول الكثير بصدد العراقيين المنفيين، وتواصلهم مع الوطن المفتقد.
العلكة المجنونة..
يعتبر فيلم «العلكة المجنونة» للمخرج عمار سعيد، واحداً من الأفلام العراقية القليلة التي تم تحقيقها في العراق، فهذا الفيلم التسجيلي القصير (مدته 29 دقيقة)، من إنتاج الهيئة الوطنية العراقية للاتصالات والإعلام، يتناول واقع العمل الصحفي في العراق، في المرحلة الجديدة، في ظلال وجود القوات الأجنبية، والتفجيرات اليومية، التي تشهدها المناطق العراقية.
يبدأ الفيلم ببطله «يحيى» الصحفي الشاب الذي يعمل في إحدى الصحف المحلية، ويعيش ضغوطاً هائلة، بفعل التغطية الصحفية التي يقوم بها. يتساءل هذا الصحفي الشاب عما يجب أن يقوم به في وضع بلده، وكيف يكون صحفياً موضوعياً وغير متحيز؟.. ويتساءل عن سرّ هذا الواقع الإعلامي، الذي يحفل بوسائل الإعلام (هناك ما يزيد على 180 صحيفة، و20 قناة تلفزيونية)، وعن الطريقة التي يجب أن يتخذ فيها قراراته وسط الأجواء الخانقة، والحرية الجريحة، متحملاً مسئولية اختياره ليقول لنفسه: «أنا ضائع مع حريتي المفقودة».
لقد كان هذا الصحفي، من قبل، يحصل على الخبر من وزارة الإعلام العراقية، وينشره كما هو، أما اليوم فهناك حرية ممنوحة، وغير مضمونة، ومنقوصة، بفعل واقع العراق، وكثرة الأطراف، وتداخل مصالحها داخل العراق!..
ومن جهة أخرى يتعرض الفيلم، عبر مجموعة مقابلات مع صحفيين عرب وأجانب وعراقيين، لواقع عمل الإعلاميين الصعب، وسط تحدي الموت، أو الخطف، الذي يقابلهم في كل تحركهم، لا سيما أن أكثر من 60 صحفياً، قتلوا في العراق، نتيجة لتغطيتهم الأحداث فيه.
سنوات الرماد.. سنوات الدمار
بعد سنوات أمضاها المخرج محمد توفيق، في سينما الثورة الفلسطينية، وجد نفسه في الدانمارك، يمتلك فسحة من التأمل، يعود عبرها إلى الموضوع العراقي، فينجز ثلاثة من أفلامه، هي: «شاعر القصبة» 2001، «تحديات ساعي البريد» 2003، «صائد الأضواء» 2004، تتناول موضوعات ذات علاقة بثنائية العراقي والمنفى، عبر «الاستعادة للموضوع العراقي»، وليس «العودة للعراق»، على الأقل لأنه بعد مرور سنتين على سقوط الطاغية، يمكننا الانتباه إلى أن الكثير من السينمائيين العراقيين لم يعودوا إلى العراق، لا يقلل من شأن هذه الحقيقة الزيارات المتفرقة، التي قام بها البعض إلى موطنهم، ومن ثم الاستمرار في الإقامة في المنفى!..
لقد جاءت بعض العودات المؤقتة (الزيارات)، في سبيل إعادة اكتشاف المكان الذي تركوه شوطاً من الزمن، غالباً ما يكون لمدة تستطيل أكثر من نصف العمر، أو من أجل تحقيق بعض التجارب السينمائية، دون أن يمثل الأمر عودة نهائية إلى الوطن.. ومن هنا فمن اللائق القول إن ما يحصل، حتى اللحظة، في تجربة السينمائيين العراقيين، هو استعادة للموضوع العراقي، بعد غياب طال، وبعد انشغال غالبية السينمائيين العراقيين بموضوعات شتى..
في هكذا إطار، ينجز المخرج محمد توفيق فيلمه الجديد «سنوات الرماد»، عام 2005، التسجيلي القصير (مدته 14 دقيقة)، وفيه محاولة فنية ذكية يقوم من خلالها المخرج بقراءة تجربة العراق المريرة منذ العام 1975، وحتى اللحظة الراهنة، من خلال سيرة رجل عراقي، عاش تجارب وطنه بكل مآسيها، ومواجعها. هكذا تتكثَّف تجربة العراق في سيرة رجل، وتنفرد سيرة رجل، حتى تكاد تغطي حكاية شعب ووطن.
يعود محمد توفيق، بعد غياب طويل، إلى بلدته «تللعفر» ويقتطف منها قصة فرد، ليقول لنا بطريقة إبداعية، هذه حكايته، وحكايتي، وحكايتنا، في العراق الذي فرضت عليه الأقدار الدامية أن يعيش «سنوات الرماد»، وربما ليس من السذاجة القول: إن إعادة ترتيب حروفي بسيط لعنوان الفيلم يجعل منها «سنوات الدمار» أيضاً..
استكشافات سينمائية عربية، لوطن لم يكن بعيداً، أبداً..
لم تتوقف الأفلام التي تناولت الموضوع العراقي، على المخرجين العراقيين، فقط، بل كان من أوائل المساهمين في إطارها، مجموعة من المخرجين العرب، الذين قاموا برحلات استكشاف للعراق، في مرحلة «ما بعد صدام»، فكان فيلم «طريق لغروب أقل»، للمخرج اللبناني باسم فياض، وهو الفيلم التسجيلي الطويل (مدته 50 دقيقة)، أحد أهم الأفلام التي رصدت العراق في مرحلة على غاية من الدقة، إنها لحظة انكشاف العراق على الممكن، ممكن رؤيته واستعراضه من الشمال إلى الجنوب.
سيأتي المخرج باسم فياض بمرافقة مجموعته الفنية إلى الشمال العراقي، ويبدأ رحلة استكشاف معرفية، تدقق في صورة العراق، وتكويناته. والملفت أن المخرج سوف يكتشف الصورتين، كليهما، وعلى السواء. صورة العراق الذي كان تحت قبضة نظام الطاغية، بلداً مترعاً بالقتل والتدمير، والعنف اللامحدود. وصورة العراق المتخلص من صدام وموبقاته.. العراق الناهض إلى مستقبل يليق به..
ينتمي فيلم الافتتاح، «طريق لغروب أقل» للمخرج اللبناني الشاب باسم فياض، إلى طائفة الأفلام العربية التي تم إنجازها بعد سقوط نظام صدام حسين، في نيسان/أبريل 2003. والفيلم هو رحلة استكشاف للعراق، في مرحلته الجديدة، حيث يذهب المخرج اللبناني باسم فياض، مع مجموعة من المساعدين، والعاملين في فيلمه، إلى الشمال العراقي، من أجل البدء في رحلته من الشمال نحو الجنوب، على أمل اللقاء في بغداد، بمخرج عراقي (هو عدي رشيد) اقترح عليه عبر الانترنيت القيام بهذه الجولة لرؤية العراق عن كثب، والتعرُّف على واقعه، وامتحان القدرة على فهم ما يدور في هذا البلد، الذي أضحى هدف وسائل الإعلام كافة، فكان أن زادت من غموض صورته، وضبابيتها!..
رحلة الاستكشاف هذه، تتحوّل إلى محاولة إضاءة لصورة العراق، بما فيها من غموض والتباس وتناقضات!.. وبالتالي فالفيلم هو محاولة تلمُّس، فاحصة، بعين متبصرة تريد الكشف عما يعتمل في هذا البلد من آلام، وفظائع، سبَّبها نظام فاشي، قاهر، انهار بعد أن ترك آثاره المدمرة، على كل شيء..
الفيلم جميل ومعبر، ومشغول بحرفية لافتة، من قبل مخرج يدرك أهمية الصورة، وبنائها، وقدرة التشكيل البصري في التعبير عن حالات الحزن والألم، كما عن حالات الفرح والاستبشار، على الرغم من كل ما جرى، ولذلك فهو يضيء شمعة الأمل للمحزونين والمنكوبين..
ولم يبتعد فيلم «سيدي الرئيس القائد» للمخرج اللبناني جاد أبي خليل، وهو الفيلم تسجيلي طويل (مدته 50 دقيقة)، عن الإطار ذاته، وإن كان هذا الفيلم قد أخذ لنفسه اتجاهاً مختلفاً، تم التعبير عنه من خلال مجموعة الرجال الذين خدموا صدام وأعوانه، ولم يفلتوا من بطشه، أو بطش إجرام ولديه. وهو ما يمكن قوله عن فيلم آخر شاهدناه بعنوان «الصنم»..
وماذا بعد؟..
سقط صدام حسين في حفرته، غير مأسوفاً عليه، وانتهى نظام الظلم والاستبداد، إلى غير رجعة، كما يتمنى الجميع. وقبلهما سقطت كل الترهات التي كان يقوم بها بعض صغار النفوس، فما عاد للشعر والقصة والرواية والمسرح والسينما إلا المساهمة في افتتاح المرحلة الجديدة!..
والجديد يقتضي، بالطبع، تأسيس تقاليد جديدة، ووضع رؤى جديدة، تتوافق مع المرحلة الجديدة، ومهماتها، وإمكانيات التعبير في إطارها.. الأمر الذي يعني الانتهاء من حالة الارتجال الفردية، والرؤى الذاتية الخاصة، والعمل على دخول السينما في الفاعلية المحلية الوطنية، العراقية، والحركة السينمائية العربية والعالمية، والتفاعل مع ثقافات العصر، وتشجيع السينمائيين على الحوار، وتبادل الأفكار، في إطار العمل الجاد من أجل بناء العراق الجديد، على أسس العدالة والحرية والديمقراطية والمساواة.
السينمائيون العراقيون أثبتوا، وبمبادراتهم الذاتية أنهم يستطيعون تحقيق الكثير، وبالتالي ينبغي على المؤسسات الوطنية العراقية العمل على منحهم المزيد من الفرص الإبداعية لتحقيق أعمالهم، والتمكن من عرضها، محلياً وعربياً وإقليمياً.. فما استطاعت السينما العراقية قوله، لم يقدر عليه الكثير من الكلام.. مهما بلغ من الفصاحة..
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. #كريم_عبدالعزيز فظيع في التمثيل.. #دينا_الشربيني: نفسي أمثل

.. بعد فوز فيلمها بمهرجان مالمو المخرجة شيرين مجدي دياب صعوبة ع

.. كلمة أخيرة - لقاء خاص مع الفنانة دينا الشربيني وحوار عن مشو

.. كلمة أخيرة - كواليس مشهد رقص دينا الشربيني في مسلسل كامل الع

.. دينا الشربيني: السينما دلوقتي مش بتكتب للنساء.. بيكون عندنا
