الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
نهاية عصر الديموقراطية الليبرالية الغربية
علي سيريني
2023 / 4 / 20العولمة وتطورات العالم المعاصر
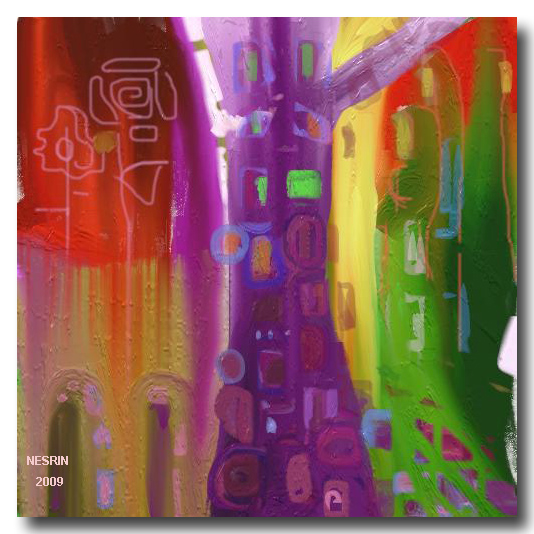
منذ بدء الحملات الإستعمارية التي بدأت في القرن السادس عشر، حمل الأوروبييون "رسائل حضارية" إلى الشعوب التي اعتبروها بدائية، مفادها أن الأوروبيين هم "مركز الحضارة" و "أصحاب رسالة الخلاص الوحيدة" و "التقدم والرقي لا يمكن إنجازهما إلا بإتباع الغرب وقيمه". شكلت المسيحية، في القرن السادس عشر وإلى القرن التاسع عشر، دافعا وغطاءا رئيسيا في الحملات الإستعمارية التي بدأها الإسبان ثم البرتغال، وتبعهم الهولندييون والفرنسييون والإنجليز والألمان. فحين دخلت القوات الإسبانية (مملكة قشتالة)، بقيادة هيرنان كورتيس (1485-1547)، العالم الجديد المكتشف قريبا وسمي بأمريكا، كان على متن السفن قسيسون ورهبان مهمتهم إدخال السكان الأصليين في أمريكا إلى المسيحية.
في القرن التاسع عشر، كانت الحملات الإستعمارية مازالت تحمل معها تباشير المسيحية، لكن وجهها الطافح كان قد تحول إلى واجهة تبدي نفسها بما توصل إليه الغرب من أفكار فلسفية ونظم سياسية تدعي التطور والتقدم، ناهيك عن التفوق الصناعي والتكنلوجي، خصوصا صناعة السفن والأسلحة و تطور وسائل الإنتاج في أعقاب الثورة الصناعية ببريطانيا في منتصف القرن الثامن عشر. بعد الثورة البلشفية في روسيا (1917) وترسيخ الفروقات الحضارية بين الغرب و بين الروس، ومن ورائهم الدول الآسيوية مثل الصين، انقسم العالم على كافة الأصعدة الحضارية بين غرب ديموقراطي ليبرالي و شرقين أحدهما عالمثالثي (العالم الإسلامي والعربي)، وشرق أوروبي بقيادة الروس وهو ما عرف بالإتحاد السوفيتي أو المنظومة الإشتراكية (العالم الثاني). هذا التقسيم تبلور منذ عام 1917 واستمر إلى عام 1989، على أعتاب مرحلة جديدة وهي إنهيار الإتحاد السوفيتي وسقوط جدار برلين. منذ بداية التقسيم بين الغرب والشرق الأوروبي الإشتراكي، ظلت التنظيرات الفلسفية تتسع وتتعمق بإتجاه "مسلّمة" تفوق الغرب الأوروبي-الأمريكي حضاريا، وهو ما يعني أن النظم الغربية الديموقراطية-الليبرالية هي الأصلح والأفضل من الطروحات الإشتراكية الماركسية-اللينينية-الماوية وتفرعاتها. وهذه التنظيرات لم تكن تترسخ في السياسات الغربية والثقافية والفنية، بسبب التفوق المادي الغربي فحسب، بل كان هناك تأكيد راسخ في الذهن الغربي الرسمي والأكاديمي والشعبي، أن الغرب تفوق على الشرق فلسفيا وفكريا وآيديولوجيا، بحيث أمسى التنائي حالة دائمة لا رجعة فيها.
في عام 1989، عبّر فرانسيس فوكوياما عن اللحظة التأريخية المؤاتية للغرب، للإستدلال على هذا الترسيخ التنظيري، فأعلن أن الديموقراطية الليبرالية هي نهاية التأريخ وأنها أسمى نظام أو فلسفة حياة يقدر الإنسان على إنجازها، وليس هناك ما يفوقها من فكر أو طرح، الآن أو مستقبلا. بدأت فكرة نهاية التأريخ (وهي مفهوم فلسفي) مع الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط (1724-1804) الذي استنبط فكرة نهاية التأريخ من الفلسفة الأخلاقية التي اقتبس جلّها من الفيلسوف الديني الألماني أليكساندر بومغارتن (1714-1762). مفاد هذه الفلسفة هو أن الإنسان مسؤول أمام نفسه وأمام الناس في أخلاقياته وتصرفاته التي تتجه إلى نقطة مرجوة، وهي الوصول إلى ذروة ليست بعدها ذروة أخرى. وهذه الذروة هي التي تفسر مسيرة الإنسانية، أنها تناضل من أجل بلوغ أسمى فكرة يمارسها الإنسان لتنظيم حياته التي لابد أن تحقق النقطة المرجوة وهي الحرية كما ذهب كانط. أضاف الفيلسوف الألماني الآخر جورج فريدريك هيغل (1770-1831) العرفان المتبادل بين البشر كعتبة تلي الحرية. بيد أن كارل ماركس (1818-1883) الذي وافق على الثنائية المتلازمة لكانط وهيغل حول الحرية والعرفان المتبادل، أضاف منحى جديدا في فهم نهاية التأريخ، وهو أن الصراع عبر التأريخ هو صراع إقتصادي بين الطبقات (السادة والعبيد)، وسينتهي بإقامة الدولة العمالية التي تطبق الإشتراكية التي ستكون نهاية التأريخ. من هنا، يشرح ماركس أن الحرية التي قصدها كانط والعرفان المتبادل الذي أضافه هيغل سيتحققان حال إقامة الإشتراكية التي تقضي على الطبقية في المجتمع. في الواقع، كان تفسير ماركس فذا وعميقا في شرح كيفية الوصول إلى الذروة التي أصْطُلِحَ عليها بنهاية التأريخ. غير أن ماركس نفسه لم يستطع أن يفصّل في كيفية تطور رغبات الإنسان وسطوها على أي نظام حكم مهما كان صارما وعادلا، وهذا ما أرداه أن يرسم صورة طوباوية للنظام السياسي، اكتفى في تفسيره بمنئى عن عمق مطلوب وهو مضمار تعمقت فيه المدارس الفلسفية الأوروبية والأمريكية في القرن العشرين، لا سيما المدرسة الفلسفية التحليلية الأمريكية ولاحقا المدرسة البراغماتية. وفي المقابل، وحيث كانت الرأسمالية تتعاظم في الغرب عبر وسائل الإنتاج والتطور الصناعي والتكنلوجي، وحيث كانت ظواهر المجتمعات الليبرالية توحي بمفاهيم الحرية والديموقراطية، تم التعامل مع إشتراكية ماركس كشبح يحوم فوق الغرب. واشتدت ضراوة هذا التعامل بشكل مرَضي مع إشتداد الحرب الباردة والصراع السوفيتي-الغربي، إلى حد وصف الأحزاب الشيوعية واليسارية في الكثير من دول الغرب بالخونة، أو حصان طروادة السوفيتي. لذلك، فسقوط جدار برلين، وإنهيار الإتحاد السوفيتي ما كانا مدعاة لإحتفال الغرب بسقوط عدو آيديولوجي فحسب، بل بسقوط فلسفة مناوئة كانت تستهدف صميم النظام السياسي الغربي المؤسس على رأسمالية شديدة الغور في الطبقية، والإحتكار، والتنافس الذي حوّل أكثرية الناس إلى روبوتات الإنتاج والعمل لصالح أقليات مستولية على مناحي المجتمع والنظام والحياة.
مع تعاظم شبكات الرأسمال الغربي، المحتكر طبعا لصالح عوائل وشركات معدودة، تطورت طرق زيادة الإنتاج بغية أرباح خيالية لصالح الشركات الكبرى التي تخطت حدود الدولة القومية، لتؤسس لنفسها أذرعا إقتصادية ومالية خارج حدودها. هذه الشركات الإنتاجية، أصبحت بمرور الزمن تابعة للشركات القابضة الكبرى، وهي التي دخلت مفاصل السلطة والدولة والقضاء والإعلام والسياسة والتعليم (خصوصا الجامعي). ومن هنا بدأت هذه الشركات الكبرى تعيد الحسابات والنظر في تكوينات المجتمع وروابطه وأركانه وعلائقه المتشابكة. وبدأت إعادة رسم وبناء المجتمع وفق قيم جديدة ومناحي مستحدثة وعلاقات متنوعة لا تأبه بالموروث الديني والثقافي في العصور الماضية، بل أصبحت طرق الإنتاج وتراكم الثروة في يد الأقليات المهيمنة هي المحك في تقرير رسم وبناء المجتمع وفق قواعد وسبل مبتكرة. لنضرب مثالين مختلفين، لفهم كيفية تبلور المجتمع الغربي الرأسمالي (الليبرالي الديموقراطي). المثال الأول، هو إدخال النساء في مجال العمل والإنتاح بوتيرة صاعدة، وكان الهدف من وراء ذلك زيادة الإنتاج والثروة لصالح الشركات المتعددة. لكن اللافت هنا هو أن التنظيرات الفلسفية والفكرية رافقت هذا التبلور (إدخال النساء في مجال العمل والإنتاج)، وبدأت تتعمق في مفهوم حرية النساء وإستقلالهن المالي والمادي الذي يطوّر ويحسّن وضعهن المعيشي والإجتماعي. وهكذا، وفي خضم هذه التطورات ظهرت سمة جديدة في العالم الغربي وهي أن النساء في المجتمعات الديموقراطية الليبرالية أكثر تحررا وأكثر رقيا من النساء في المجتمعات الأخرى. وفي ثنايا هذه التغيرات، تطورت في الخفاء أفكار مثل حرية ممارسة العلاقات الجنسية ونبذ الأسرة والإنجذاب وراء حياة البذخ واللهو والمتعة، دون قيود وضوابط مجتمعية ودينية وما إلى ذلك. هذا التطور بدوره كان مرتبطا بمؤسسات مالية وإنتاجية هدفها الربح وجمع الثروة مثل شركات إنتاج الكحول، والأفلام والأدوات الجنسية، و النوادي الليلية والفنادق وما إلى ذلك، حيث لعبت النساء في هذا المضمار دور اليد العاملة في إنتاج الثروة لصالح الشركات المالية الكبرى.
المثال الثاني هو الإعلام. في بلادنا الإسلامية والعربية، ظل الناس لعقود طويلة تؤمن بأن الإعلام الغربي هو إعلام حر يعكس قيم الحرية! في الحقيقة هذا وهم كبير. فالإعلام في الغرب، على سبيل المثال في أمريكا، تابع لشركات كبرى معدودة على أصابع اليد الواحدة. وهذه الشركات الكبرى المالية والإقتصادية، مرتبطة مباشرة بالأقليات المهيمنة على القرار السياسي والعسكري. والإعلام الغربي ليس واحة مفتوحة للناس للإطلال من خلالها، للتعبير عن أنفسهم وأفكارهم. فما يظهر في الإعلام، وكأنه يوحي بوجود الحرية للأفراد، مدروس بعناية و منظم بشكل متقن ومُدار لصالح سياسات طافحة وسائدة. وهذا الإعلام، يوجه بشكل مستمر، تفكير وسلوك الناس نحو الأهداف المبتغاة والتي تتبلور وتتجدد حسب المصالح والتطورات. والسمة البارزة لهذا الإعلام هي تفكيك العلاقات الأسرية، وعزل الأفراد عن بعضهم، وعزل الفرد عن المجتمع في كل ما يمت بصلة إلى العلاقات الحيوية، والأهم من ذلك، إغتيال حس المسؤولية في نفوس الأفراد تجاه القضايا الكبرى والخطيرة التي تمس صميم المجتمع ومستقبله. وفي المقابل، يضخ الإعلام الغربي طاقة كبيرة لتوجيه الأفراد نحو التسلية مثل الألعاب الرياضية والأفلام والمسلسلات، وتحوبل هذه التسلية إلى قضايا جدية تهيمن على عقول الناس وخصوصا الجيل الناشئ.
في ما يخص النساء، نعم شهد الغرب تطورات هامة على صعيد تطوير مظاهر الإطلالة النسائية، وتحسين كمي لوضعهن المالي وتطوير مهاراتهن المطلوبة للعمل والإنتاج. ولكن نمت في هذا الواقع معضلات متعددة ومتشابكة ضربت وجود النساء في الصميم، مثل ارتفاع معدلات الأمراض السايكولوجية، إزدياد نسبة الطلاق، الوحدة والعزلة الشعورية، الإقصاء بسبب التقدم في العمر، التشريد، التعرض للإغتصاب والتحرش بهن بمعدلات خيالية وإرتفاع نسبة الإنتحار. وفي الخفاء، وبوتيرة صاعدة، انتشر الفساد في مفاصل الدولة والمجتمع، بسبب الدور الذي شهدته نساء كثر في مجال توظيفهن والمقربين منهن، عبر إستغلال علاقات جنسية مع أرباب العمل أو المدراء والمسؤولين. أما في ما يخص الإعلام، فعلى أقل تقدير، ومنذ عام 1990، لاحظت شعوب العالم أن الإعلام الغربي يمارس الخداع والتضليل بشكل صارخ ومكشوف. فالدعايات الكاذبة التي روجت في العالم مثل قتل الجيش العراقي لأطفال الحاضنات في مستشفيات الكويت، وأسلحة الدمار الشامل في العراق، وإسقاط النظام العراقي في عام 2003 من أجل بناء الديموقراطية في العراق، وقبل ذلك، أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وأحداث أخرى كثيرة أثبتت أن الإعلام الغربي لا صلة له بما يقال عن الحرية وقيم اليبرالية والديموقراطية التي تؤكد على حرية الأفراد وحقهم عن التعبير.
النقد هنا لليبرالية والديموقراطية الغربية ليس نقدا للتطبيقات فقط، بل هو نقد في صميم الفلسفة والفكرة الليبرالية الغربية. فعلى أقل تقدير، حتى اللحظة الراهنة، أثبتت الليبرالية الغربية أنها تمثل نظام الإحتكار والطبقية والظلم والخداع. وهذا النظام لا فكاك له من تراكمات التأريخ منذ القرن السادس عشر وإلى اليوم، مرورا بالمحطات المهمة في خلال قرون الغرب الإستعماري الذي دفع بعوائل وشركات معينة نحو صدارة القوة والسلطة والهيمنة على شتى الأصعدة. فإذا كانت الليبرالية الديموقراطية تطرح كفكرة مجردة قابلة لإحتمال حدوثها (يصطلح عليه بممكن الحدوث)، فحينئذ تكون هذه المنظومة الفكرية مجرد أوهام طوباوية، حالها حال أي فكرة أو فلسفة اخرى لم يشهدها الواقع. أما إذا كانت المراهنة على الواقع، فإن ما حدث في الغرب، على الأقل، منذ بزوغ القرن العشرين ليس سوى تدمير حقيقي لمفهوم الحرية والعرفان المتبادل عالميا. أما الحديث في الإنتخابات (للإشارة إلى الديموقراطية)، فإن الشركات الكبرى في الغرب هي التي توجه سير الإنتخابات وجوهر الأحزاب وسياساتها. والإنتخابات على أي حال نظام تفويض وليس نظام حكم الشعب كما يقال، لأن الناس تصوت للذين لا تعرفهم، ولا تحاسبهم بعد أن يصوتوا لهم، ليذهبوا إلى برلمانات تقرر الشركات الكبرى سياساتها بمنئى عن الناس ومصالحهم، إلا في الإبقاء على أشد ضروارات البقاء على قيد الحياة. والإنتخابات ليست ذات شأن، ففي أفغانستان، والعراق والسودان ولبنان ودول أفريقيا تحدث الإنتخابات، وهي دول فاشلة وفق نظرة الغرب. لذلك لا تضيف الإنتخابات أي مزية فلسفية للديموقراطية الليبرالية الغربية كفكرة جرى تنظير كثير لها أنها نهاية التأريخ. المجتمعات الغربية اليوم تعيش مثل باقي المجتمعات الأخرى في العالم محكومة من قبل أقليات متسلطة، مع فارق أنها تعيش في أحوال إقتصادية ومالية وخدمية أفضل من غيرها، ما عدا دول الخليج العربي واليابان وكوريا الجنوبية. ولكن مآلات الحرب الروسية الأوكرانية وتعاظم قوة الصين الإقتصادية والعسكرية، ووجود الأسلحة النووية لدى دول غير غربية، وتفوق دول آسيوية في مجال الكومبيوتر والتكنلوجيا والذكاء الإصطناعي، سيعيد ترتيبات العالم في غد قريب، وهو ما يعني أن الديموقراطية الليبرالية الغربية ليست نهاية التأريخ، ولم تستطع إنجاز هذه الذروة المرجوة فلسفيا. كل ما هو مطلوب هو وقوع حادثة شبيهة بسقوط جدار برلين في أيامنا، لتؤذن الحادثة بنهاية وهم الديموقراطية الليبرالية كنهاية للتأريخ. الحرب الروسية الأوكرانية مازالت المرشح الأقوى لتشكل هذا الآذان الذي سيرفع قريبا.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. فولفو تطلق سيارتها الكهربائية اي اكس 30 الجديدة | عالم السرع

.. مصر ..خشية من عملية في رفح وتوسط من أجل هدنة محتملة • فرانس

.. مظاهرات أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية تطالب الحكومة بإتم

.. رصيف بحري لإيصال المساعدات لسكان قطاع غزة | #غرفة_الأخبار

.. استشهاد عائلة كاملة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في الحي الس
