الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
السرد والمقام في كتاب (العبرة الشافية والفكرة الوافية)
قيس كاظم الجنابي
2023 / 8 / 10الادب والفن
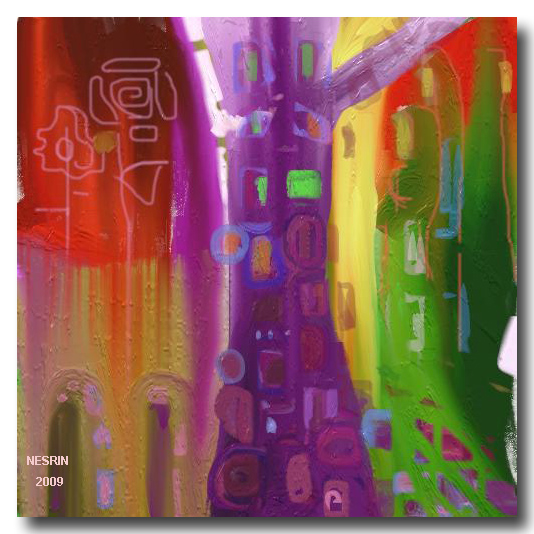
-1-
يمكن أن نعد كتاب(العبرة الشافية والفكرة الوافية) لمهذب الدين البصري(نهاية القرن 11 الهجري) كتاباً في الموعظ ،وهو في(مئة جوهرة) أو قطعة نثرية عالية السبك والانتقاء،وصفت بأنها (مقطوعات حكمية مسجعة ومقفاةٍ)، واضافة التقفية الى السجع يعني انطباق ضوابط قافية الشعر عليها مع ضوبط النثر.
بدأت هذه الجواهر بتوطئة بعد البسملة بالتوكل على الله في نوع من التنويه يبدأه بقوله:" واستنصره واتكل عليه،مُذ تكلّلت التوكلُ،فزجت بالحظ الجسيم ،أي فوز فوق هذا، ذلك الفوز العظيم".
فبدا التوكل تنويهاً الى فرضية الدعاء، وأهمية الدعاء والوعظ وأهمية الوعظ للفوز العظيم(أي المغفرة والجنة) وان مقام المؤلف يترسخ وجوده من خلال العلاقة بين المؤلف/ الواعظ وبين الباري سبحانه وتعالى،والسرد هنا منتقى ومركب ومصنف ومنسق ليكون عالي الجودة ،قوي النبرة، متقن السبك.
وانهى الكاتب كتابه نهاية تقليدية، وقد نتساءل: لماذا يميل الواعظ الى تعقيد النص الوعظي، وتحميل سرده حملاً ثقيلاً صعب الفهم،وصعب التلقي، من حيث السجع والتقفية وغير ذلك؟
على العموم فان العصور المتأخرة شهدت تعقيداً في الكلام ونسجه ،والبحث عن فنون مبتكرة عديدة، ولعل بعضها جاء بفعل مؤثرات خارجية ،ولكن جوهرها من الصلابة والتعقيد ما يجعل القارئ ينعم النظر ويديم البحث في الوصول الى الحقيقة، لقد كان مهذب الدين البصري يعيش في بيئة معقدة ، بيئة عربية محاطة بثقافات شرقية فارسية وتركية وهندية، قام فيها برحلة الى بلاد فارس لاسباب دينية وثقافية، وفي الغالب تكون كتابات مثل المهذب معقدة لنها تحاكي القرآن والحديث والنصوص الدينية العالية النظم.
-2-
بدأ نصه الأول(الجوهر الأول) بقوله:" عاف الهوى بلبّهِ، طاف الهُدى بحبّه، فمذ درى بما رأى ،خاف مقام ربّه".فاللغة تحاكي لغة القرآن والحديث النبوي الشريف ،المحمّل برؤى وأفكار وألفاظ تحيل الى آيات قرآنية ترتبط بالمقام ،مثل(خاف مقام ربه)؛ وهنا نشعر بانه يحيل موضوعنا الىأهمية المقام في هذا الكتاب السردي، كما يحيل الى بناء المقامة العربية القديمة ولغتها المعقدة،وان كان البناء الاطاري الذي اتصف بهكتاب(ألف ليلة وليلة) يبدو حاضراً، بصورة مضمرة، فالليالي تأطرت بحكاية شهرزاد قبل زواجها من الملك شهريار مع حكاية اختها دنيا زاد، فلما تزوجت راحت تسرد حكاياتها المتتالية، ويشكل السجع والجمل المتقنة الرصينة التي تحتكم الى نوع من الرفض من خلال استخدام أداة النفي لا، حيث يقول:" يكرع الموت، ولا يسمع الموت يطير طبّراً، ويطير طرّاً".
وحين يشعر بزخم النثر، يستعين بالشعر، وغالباً ما تكون بداياته متوهجة ،ونهاياته رخية صامتة، متصالحة مع النفس ،فهو ينهي الجوهر الأول بقوله:" لا يحب الله ربّي،كلّ مختال فخور". وينهي الثاني بقوله:" إنّ من سنخّ الغنى منه يُغني عبده كل شيء عنده"؛وهكذا هو يبدو متألقاً في البدء، كما يفعل في استهلاله للجوهر الثالث:" طُوبى له قد صحّ إيمانه،وصحّح الكون مع المؤقنين فكيف لا طوبى وطوبى له".
فالبداية مرهونة ومرتبطة بكلام مفترض ،يجعل البداية متأثرة بها، كما في قوله في الجوهر الرابع:" سُحقاً له من جاهل ،تبّت يدا أبي لهب،أصلاً كأنه لم يأته، كل أمره بما كسب. فقوله(سُحقاً) هو كلمة منصوبة بفعل محذوف ، بصفتها مفعولاً مطلقاً، مما يعني تعلق الكلام بما قبله وبما بعده، كما يحصل في المقامة ،وهو يحاكي القرآن ويضمن نصوصه، ويربط جواهره كما تربط حبات المسبحة.
-2-
لقد كتب الحريري خمسين مقامة، بما يوحي لنا بأن وجود خمسين جوهر أو قطعة نثرية مركزة تعبير عن وجود فن نثري مركز، يحاكي النص القرآني أو سجع الكهان في النثر الجاهلي، ويقترب من المقامات الحريرية عداً وتوجهاً، واذا كانت البدايات معقدة فان النهايات المتمثلة بالعصور المتاخرة تكون مرهونة بها، وفي هذه الجوهرة، تتشظى الحكاية وتتشتت مع رغبة المؤلف/الكاتب في ان يكون النص غاية وليس وسيلة لبث الأفكار؛ فغاية المؤلف هو التعالي بالنص الإنساني/الواقعي لأن يكون نصاً إلهياً. وعموماً فإن هذه النصوص في الأول والأخير هي محاولة لاثبات قوة منتج النص لها، واثباتها هي أيضاً من خلال تميزها عن غيرها، أي أن تكون خارج السائد والمألوف، والمتداول، وهذا ما يفترض توفرها في النص الممانع،أو الصعب الافتضاض للإبقاء على عذرية الكلمات والأفكار، وكأنّ النص يحاكي الجسد الانثوي المحاط بالنجاسة.
ومنأمثلة عذرية النص الجوهر (17) حيث يقول:" جهل الورى لقد جرى، في الكلّ من اوصاله، فهم هنا ترى الهوى يخرج من خلاله، فيا من يتقلّب الريشة في الفيافي".
نلاحظ كثرة الجناس، او الإيقاع الداخلي في الجمل وخارجها، مثل(الورى، جرى)،و(أوصاله، خلاله)،و(ترى، الهوى)،و(يتقلّب، تقلّب)،و(المنافي،الفيافي)؛ بما يفقد الكلام بهجة التلقي، ويدفع القارئ الى ولوج الاسجاع المتتالية، وذلك منعاً للآخرين من محاكاة هذا النص،أونسج الحكاية على منواله؛ وهذا نابع من بحثه عن طريقة لمنح الجوهرة قدسية تشبه الجواهر والمعادن والاحجار الكريمة،التي تختن الماسة الكبيرة، بين عدد من الجواهر والاحجار الثمينة الغالية الثمن.
-3-
يبدو أن دراج عنوان ثانوي بعد ذكر عدد الجواهر ،هو أنها(مقطوعات حِكمية مُسّجعة ومقفاة)؛ هو إحالة الى ما ذكره صاحب كتاب (المفصل في تراجم الاعلام) لغرض الكشف عن هوية الكاتب النادر الذي لا يشبهه كتاب. وقد أراد له مصنفه ان يكون فريداً في نثره، يتجاوز به مدرسة الجاحظ وأبي حيان ،مدرسة المقامات العربية منذ بديع الزمان والحريري وباقي الركب حتى آخر المقاميين الذين ركبوا كل صعب وغريب ونادر وفريد؛ وهكذا فالكاتب يحاول الاستمرار في تذويب مصادره حتى تبدو العبارات منسجمة ومتناسقة تماماً؛ وهذا بحد ذاته هو نوع من الصبر والجلد، في الاكثار من المؤثرات القادرة على استيعاب ثراء النثر العربي في تزويده بالصور والاحالات التي تمثل عصر الكاتب وزمن كتابته،وهذا ما اتصف به الادب العربي خلال حكم الاعاجم، من مختلفالقوميات كالفرس والترك وغيرهم، حيث عاشت اللغة العربية غربتها بعيداً عن التعليم المنهجي، وبقيت في داخل المساجد وبعض الكتاتيب؛ فيقرأ الكاتب ما هو غريب ليحاكيه وينتج ما يوازيه.
وع كل ذلك فان الكاتب يلجأ الى العبارات القصيرة والجمل السلسة كقوله في نهاية(الجوهر الثامن عشر):" وأهب الخير للورى،فالق الحبّ والنوى، وأنت بالحال عالمٌ، خالق الحُب والنوى. أو قوله في مستهل (الجوهر الثالث والاربعون:" يملي لكم ويُمهل،حقاً فليس يُهمل.
ففي الأول يبدو النص مشبعاً بالصور القرآنية حول علاقة الحَب بالنوى، من النباتات بمقابل الحُب والنوى في شأن الشوق حيث تتردد الكلمات المسجوعة بين(الورى والنوى)،أي بين الناس والحب وكذلك معجزة الخلق الإلهي للحب والنوى،وإخراج النبات منهما. أما الثاني فجاء الفعل (يهمل) بمواجهة الفعل(يهمل) من حيث السجع والجناس والمفارقة الكلامية بين الإهمال والامهال، وهذا نوع من الصياغة التي تعبر خير تعبير عن كون هذا الجوهر يعبر عن ماوراء السرد، من خلال علاقته بالقرآن الكريم وكونه نصاً أدبياً شارحا له بصورة غير مباشرة، فهو يتحدث عن كلام محفوظ في كتاب يحاول إعادة انتاجه ونثره، وإعادة صياغته، ومقام المخاطَب هو مقام محفوف بالمخاطر، لأنه بين نصوص كثيرة ترتبط بالحكم الإلهي بمعاقبة المذنبين، في نوع من التحريض على العبادة والتحذير من العصيان، وهذا ينبع من خلفية ثقافية عالية، ولكنها محصورة في اتجاه معين أسلوبياً؛والكلام هنا هو كلام مشرع ،وقادر على صنع الحياة بطريقة مختلفة.
وهي مرتبطة حالها حال مقامات بديع الزمان ارتباطاً وثيقاً، من خلال طبيعة الأسلوب، فهي خمسون (جوهرة) ومقامات البديع خمسون مقامة، ولها ببناء التنضيد الذي سرت على وفقه الليالي العربية والمقامات العربية؛ فكانت هذه البنية تستند الى تتابع الحكايات/النصوص/ الجواهر اشبه بتتابع القصص القصيرة ، فكل جوهرة مستقلة عن غيرها ولكنها متصلة بالنظام العام والأفكار العامة من خلال مناخ الموضوع واسلوبه ومضمونه.
واذا كان بعض كُتّاب المقامات كتب فقط خمسين مقامة، فان المهذب البصري كتب خمسين جوهرة، سردها متشابه ولكن بتحولات واضحة تجمع بين صناعة الأسلوب ،وصعوبة التداول ،وإصرار الكاتب على عرض قدراته اللغوية والأدبية؛ ففي الجوهر الخمسون يقول منذ البدء:
" قد قال فما يكون أمري، قُلت التقوى فنعم الامر، هذا الأقصى فإنّ هذا ، ما لم تستطع عليه صبراً، خير الزاد التقوى، وشر المهاد الشقوى، من ارتقى إليها علِمَ،ومن إتقى بها سَلِم".
لقد بدأ الكاتب بحرف التحقيق (قد) للتعبير عن ثقته بنفسه ، ثم استخدم الفعل الماضي ، ثم استمر في سرده موظفاً السجع، والجناس ،ومقتبساً من القرآن الكريم؛وذلك باستخدام السجع المزدوج ،كما بين(امري وأمرِ) وبين (التقوى واشقوى)،وبين( الزاد والمهاد)،وبين(ارتقى واتقى)،وبين(علم وسلم)؛ بحيث تتوالى الجمل الواحدة بعد الأخرى ،لكي يكون في الجملة الواحدة عنصران أو كلمتان توظفان لغرض(السجع). وهذا السجع يخلق نوعاً من التعدد في الالفاظ والجمل، ونوعاً من الحوار المضمر ، في مثل(خير الزاد التقوى، شر المهاد الشقوى)، فالجملة الأولى تتكون من ثلاث مفردات /كلمات لكل واحدة مسجوعة مع غيرها،ومتطابقة طباقاً بلاغياً من حيث مضمونها، كما في الطباق بين( شر، خير)؛ مع مود نوع من الجناس المسجع بينهما ،وكذلك بين(المهاد والزاد)؛ فالاول مجنس ومسجع مع الثاني، فاحدهما يكمل الاخر ،فالاول للغداء والثاني للسكن والراحة، وكذلك الحال في الطباق بين(التقوى والشكوى) ، وكذلك السجع بينهما؛ وهذه الآلية تسري على الكثير من الجمل والتشبيهات بحيث تتوالد الأفكار الواحدة من الأخرى بطريقة حوارية .
لا نستطيع الفصل بين الكاتب والراوي، كما يحصل في المقامة،ولا بين الكاتب والبطل، فالكل مندمج في شخصية الكاتب، ولكن إشارة الكاتب الى الآخر، القريب منه بقوله:" قد قال فما يكون امري، قلت التقوى فنعم أمر".جعلنا نشعر بوجود شخصية الراوي/ الكاتب بجانب البطل الذي أشار اليه بالفعل (قال)، ثم أجباه الراوي بالفعل(قلت)؛ وهذا يعني ان روح المقامة متأصلة في هذع الجواهر،وهو ما يتكرر في هذا الجوهر، حين يقول:" وتغدو الظلم بالعجل،وتبدو الثُلم بالخجل، فاذا قُمت من مضحك الى مرجعك، قام بك بتهجهجه منهجك".
فقوله (قمت، قام) توحي بوجود شخص حاضر يخاطبه، بالفعل(قمت)،وهناك شخص غائب يخاطبه بـ(قام)؛ وهه الحوارية الزمنية والمقامية والسردية تقوم بين الماضي والحاضر وتستند الى حوارية مضمرة، فالراوي هو الممثل الذاتي للكاتب على الورق، يبدو جديّاً،ومراوغاً يعيش على التلاعب بالألفاظ،أو من صنع خيال الكاتب.(كتابنا: المقامات العربية )
وأحياناً يلجأ الى الخطاب،أو أسلوب (فعل الخطاب)، كما في قوله في (الجوهر الواحد والخمسين) :"لا تخوضوا تُحفظوا، ذلِكم شر لكم، فاصمتوا، ثم انصتوا، ذلكم خي لكم، صمتاً أيُّها الناطق صمتاً ،ومقتاً أيها الناهق مقتاً".
فقد بدأ مع أداة النهي(لا)، ثم تلاها بالفعل المضارع الخاضع الى سلطة المتحدث الذي يوجه الخطاب بطريقة الآمر الناهي، ثم يردف الفعل بما يغني عن دوره في الكلام عبر استخدام المصدر الذي يؤدي دور الفعل بما يقلل من التكرار اللفظي،ويجسد التكرار المعنوي؛ فالفعل(صمتوا) كره بالفعول المطلق(صمتاً) مرتين، ثم يستخدم (مقتاً) و(تعساً)و(تعساً)و(سحقاً) بالطريقة ذاتها، فالتكرار راسخ في النص،ولكنه يتفلت بطرق شتى.
-4-
وفي(الجوهر الستون) تتضح علاقة الجوهر بالمقامة، حينما يستهله بقوله:" في كل مقاماته، لا ييحذر من ربّه، واهاً لمراماته، لا يسأل عن ذنبه،فويل للمجرم وزحمة،ونيل للمحرم، يكرُّ على الكبيرة فيركبها،ولا يتزحزح".
ثم يستخدم ضمير المتكلمين (نا) في بداية (الجوهر الحادي والستون) فيقول:" بعضنا أرحام بعض حقنا والحق فرض،ما قرأتم قول ربي، بعضهم أولى ببعض".( ) فان(نا) في (بعضنا) تشير الى ضمير المتكلمين ،والكاتب واحد منهم، وكذلك في (حقنا)،ثم يتوجه الى مستمعيه مخاطباً (ما قراتم) وهنا تتداخل الضمائر بين(أنا) و(أنت)؛ وهكذا هو المبدأ الحواري الذي يبحث عنه المؤلف لربط الكلام بينه وبين المتلقي، الحاضر او الغائب، كقوله في (الجوهر الرابع والستون):" المرء من حيث هذا اللسان،شقي بذيّ سعيد مجيد"، ولكنه ينتهي بالمخاطب الى القول له:" فاتركوا ما ليس يعني واذكروا الله كثيراً".
فان توالي الاسجاع والتقفية النثرية التي تشبه بعض الأحيان، ما ورد في القرآن الكريم، أو في اسجاع الكهان يعني وجود حركة اتصال وحوارات وتقابلات وما أشبه ذلك ؛ وكل هذه المحاولات الايقاعية لها أهداف أخرى غير الجانب الشكلي وايثار الصنعة، منها ترصين وحة الكلام وتصعيد بلاغة القول ،ووربط المقدمات بالنهايات، بصورة منطقية وسلسة، تتغير فيها الاسجاع من حرف او من كلمة الى حرف آخر وكلمة أخرى ،وهو الذي يلمح الى الأساليب الجديدة التي ظهرت في عصره، أو قبله بقليل، مثل العنعنة و(فن السلسلة)، كما في (الجوهر الرابع والسبعون) حيث يقول:" واغفل زنده العلم من كوّة العنعنة والسلسلة فينكب في هوة العّنت والبلبلة،،فاعل يا أبا الملال،إنّ التقليد امّ الضلال وتوأم الاضلال. فهو بالرغم من ميله الى الصنعة يعيب على غير الانحراف فيها.
وهو يكثر من السجع في وسط(الجوهر) بطريقة مثيرة، كما في (الجوهر السابع والسبعون) حين يقول:" ولا تغتر بغرورها فقراحها نهبورٌ ومارحها عاثور، ورحتها زحمةٌ ومنحتها مِنحة، وخيرها شرٌّ ومَيرها ضرٌّ، وطولها هولٌ وقولها بولٌ، فلا تسمع مقالها ،ولا ترفع قلقالها..
حيث السجع بين (قراحها ومراحها)،وبين(النهبور وعاثور)، بشكل متوالٍ، الأول بين (قراحها ومراحها). والثاني بين( نهبور وعاثور)؛ وهذا على سبيل المثال، فهو دائم الاستخدام لمثل هذه الأساليب لتعزيز قوة النص ، لخلق موحدة موضوعية وموسيقية خاصة لها علاقة بالوحدة العضوية بشكل عام؛ مما يعبر عن تشبع الكاتب بالنص الديني كالخطب والادعية والحديث،وقد يكون السجع المتتالي ، مثل استهلاله في (الجوهر الثامن والسبعون)، حيث يقول:" الى متى يطمع،والنصح لا ينفع، فمن هنا يجمع، ومن هنا يرفع، هذا له يدفع وذا له يصفع،كلٌّ له خصم خصيم من ذا الذي يشفع"..
فقد استخدم التجنيس بين(يطمع، ينفع ، يجمع، يرفع، يدفع، يصفع)، في حرف العين البعيد المخرج، والذي جعله الخليل بن أحمد الفراهيدي(ت 175هـ) مقياساً لمعجمه الصوتي(العين).
وهذه النصوص، هي نصوص وعظية ،وغالباً ما تكون الاستهلالات/ البدايات فيها محبوكة، ومختارة بعناية فائقة، كقوله في بداية (الجوهر السابع والتسعون):" مجدكم من مجدنا،وجدكم من وجدنا، لطفنا قد عمّكم ، رحمة من عندنا، سعادة لانسان بأكبريه إيمانه واحسانه ،وشرفه بأصغريه جنانه ولسانه".
فالجناس بين (مجدكم ، مجدنا، وجدنا)، والسجع بين ( مجدكم، جدكم)،ثم انتقل من السجع الى التفصيل مع الاول، له صلة ايقاعية مع الثاني، أي بين(ايمانهن احسانه)،وبين (جنانه ،لسانه)؛ وهذا في العادة سياق مرت به المقامات العربة وخصوصاً في أثناء تطورها وتفاقم الصنعة فيها.
ومن الناحية الموضوعية ، فان الكاتب انتهى الكتاب بعد تدوين مطالعة السيد عبد الباقي الموسوي(ت1346هـ) له، حيث اختتم آخرها بالصلاة على النبي وآله، حيث قال:" نحمد من سرنا،بنور سرّالزمن،روح أرواحنا، اذهب عنا الحزن، والشكر لوليه وأهله،والصّلوة على نبيه وآله. وهكذا انتهى الكلام ،أما الابيات التي وصعها من دون سياق؛ فهي من وضع القراء أو النساخ وغير ذلك،والله أعلم.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. وائل شوقي.. الفنان المصري -العبقري- يبهر جمهور بينالي فينيسي

.. ستايل توك مع شيرين حمدي - لقاء مع الفنانة علا رشدي وحديث خاص

.. -ليست حرب بل إبادة-.. فنان مصري يشارك شهادة جراح أمريكي عاد

.. طلاق الفنانة نيللي كريم من لاعب الإسكواش هشام عاشور

.. الفنانة جميلة عوض تحتفل بزفافها على المونتير أحمد حافظ
