الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
لعبة المرايا.. في زمن الهوامش
حسين جرود
2023 / 11 / 18الادب والفن
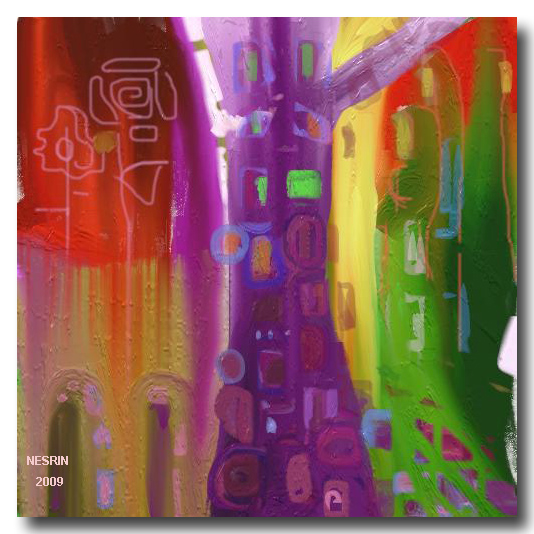
ما الشعر؟ إنه مجاز، بصرف النظر عن شكل القصيدة، حتى بات ممكناً الآن استخدام جميع تقنيات الكتابة فيه، فلا شيء ممنوع، وحتى الفشل أو النجاح نسبي! ولنذهب قليلاً في رحلة مع المجازات، والشعر السوري.
عانى المذهب السريالي الذي ظهر في أوروبا في عشرينيات القرن الماضي خيبات كثيرة في الشعر -على النقيض من الرسم والسينما- ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى الرؤيا، أو ما وراء الواقع، وفضَّل ذلك على الاهتمام –أو حتى الاكتراث- بشكل النص. وكي لا نذهب بعيداً فقد ظهرت كتابات جبران خليل جبران التي أمدَّت الشعر العربي واللغة العربية بطاقات جديدة قبل ذلك كلِّه وكانت الكتابات الرومانسية والرمزية منتشرة في الشعر والنثر العربيين في النصف الأول من القرن العشرين، والسريالية بحدِّ ذاتها ليست أكثر من تجلٍ أخير للرومانسية والرمزية، أو تلويحة وداع.
تحدَّث شعراء الستينات العرب –مثل أدونيس- عن الصوفية والسريالية، كما تحدثوا عن الكثافة والتوهُّج والمجانية، ولكنهم كتبوا أيضاً رؤيتهم الإيديولوجية الموجودة لديهم مسبقاً، مما شوَّش على التجربة، حتى أقصاها لصالح الإيديولوجي وحده عند من جاؤوا في السبعينيات. فبتنا منذ نكسة حزيران 1967 تقريباً أمام شعر سياسي مباشر، أو تكلُّس شعراء الحداثة الذين أصبحوا شكلاً ثقافياً فارغاً، لا يعيش في الهواء الطلق، والقارئ في واد وهُم في واد. وحتى اليوم، ما زالت أيام الستينيات زمناً جميلاً لا يتكرَّر في المخيِّلة العربية.
بعد ذلك، ظهرت مغامرات جريئة لسليم بركات، ورياض الصالح الحسين، ومنذر مصري، وغيرهم في السبعينيات والثمانينيات... حتى جاء شعراء التسعينيات وأرادوا تصحيح الخلل الموجود في الحداثة نظرياً ونقدياً وتجريبياً.
حاول شعراء التسعينيات الانقلاب على شعر الحداثة بإبعاده عن الإيديولوجيا وذلك نتيجة انطلاقهم من زمن موت السرديات الكبرى، فكتبوا شعر اللا معنى وانتظروا الرؤيا والإشراق التي انتظرها شعراء الحداثة، وتواصلوا وتنازعوا مع البياض ودرجة الصفر وما وراء الواقع.
لكن، أليس شعر الرؤيا بهذه الطريقة انتظاراً لوحي ما وتجميداً للحظة الإبداع وعدِّها مقدَّسة، ومن ثم عانَوا من عدم الفهم الذي عانته تجارب الحداثة الأولى دون وجود قاموس إيديولوجي يساعد على التفسير.
الكتابة الأدبية -في المحصلة- أسلوب يتطوَّر وإن كان هذا يجري معهم بنحو طبيعي، ولكنهم كانوا ينتظرون لحظة ما تعبِّر عن ذاتهم باستمرار لكتابة نصوص أخرى ككتب سماوية تنسخ بعضها، دون أن يعرفوا إن كان القراء -أو المأوِّلِون- سيقبلونها أصلاً.
خرج عن هذا شعراء التفاصيل الذين كانوا يبحثون عن الزجاج في الرمل، ويقفون موقف الناقد من كتاباتهم، واستطاعوا كسب القارئ عبر الشعر الشفوي أو شعر التفاصيل اليومية، وبات السؤال فقط: هل هذا شعر؟
إذن، بين تقديم الرمل كاملاً أو الزجاج استمرت تجربة التسعينيات التي كانت الأضخم من حيث الكم في سوريا، حتى أتى زمن أصبح فيه النص سلعة مطلوبة دوماً، ثم سلعة غير مطلوبة، ثم أصبح الهواء المجاني المتاح، وتلك قصة أخرى بدأت مع ثورة السوريين، أو زيادة عدد المواقع الإلكترونية ووسائل النشر.
في تلك الفترة، لمع اسم شاعرين على الجدران واللافتات وحائط فيسبوك وجدران غرف المثقفين، هما محمود درويش ورياض الصالح الحسين، وهما من مدرستين مختلفتين كلياً. ولا يمكن إنكار تأثر الجزء الأكبر من هذا الجيل بشعراء التفاصيل والشعر الشفوي لدى محمد الماغوط، وإن اختلفت تقنيات الكتابة عن الماضي، والأهم اختلاف اللغة التي غدت أبسط. في حين قلَّ تأثير أدونيس في بداية الثورة، لأسباب سياسية أو ببساطة معرفية.
منذ عقود كانت الحرب مشتعلة بين قصيدة التفعيلة التي تريد الاحتفاظ بشاعر وحيد للقبيلة يضمن استمرار النظام، وقصيدة النثر الديمقراطية، أو لنقل بين الشعر السياسي وقصيدة النثر. حققت قصيدة التفعيلة ما أرادت، ولديها على الأقل محمود درويش وأمل دنقل (نجما مرحلة عربية كاملة)، ولكنها فشلت في ولادة شاعر «كبير» بعد درويش، ربما لأنه لم تعد توجد قضايا كبرى، أو قبيلة أصلاً. أما قصيدة النثر فتستمر في تحويل الجميع إلى شعراء، مشكِّلةً أمواجاً جديدة متلاحقة تضيع في الرمال العربية، مرة تقِّلد محمود درويش ومرة تقلِّد رياض الصالح الحسين، وكأن هذا استسهال للنجاح باتباع أشهر وصفات الطبخ، مع وجود سؤال: هل يمكن أن نحلم بقصيدة رؤيا؟ وماذا تعني هذه الكلمة بعد كل ما حدث؟
في بداية تجربتهم، كان نزار قباني وأدونيس مشبَعين بالثقافة العربية والشعر العربي وحتى الذكورية العربية وفكرة الشاعر العظيم الوحيد، فلم يخرجوا عن النظام تماماً، وكانوا شعبويين (نزار) أو شعراء أحزاب (أدونيس) كما في العصور العربية السحيقة الأموية والعباسية، بينما كان الماغوط هو أبو نُواس المتمرِّد، الذي لا يوجد ما يجبره على «محبة ما لا يحب وكراهية ما لا يكره»، وكلما جاء شاعر جديد ليتابع طريق الماغوط ينحو نحو الهوامش أكثر، حتى يمكن القول أن قصيدته أتت أُكَلَها منذ التسعينيات، وكتبها مئات السوريين، ثم وُلدت من جديد في السنوات الأخيرة.
ما المشكلة في أن يصبح الجميع شعراء؟ في العصر العباسي كان الأمر كذلك؛ كل من سمع بعض القصائد يكون قادرًا على نظم الشعر، وكانت الكلاسيكية الجديدة في كل مكان. لكن بينما كانت البراعة منذ العصر العباسي تقاس بتعقيد الصنعة وتجاوز الشعر العربي الناصع المألوف لهم، تقاس البراعة في شعر التفاصيل منذ الماغوط نفسه (في مرحلته الثانية) بالوصول إلى المتلقي بعد أن أهملته موجة الحداثة الأولى، فتركها وأهملها بدوره. لذا بعد سنوات قد تصبح "صباح الخير" شعرًا، وبالفعل يوجد مجموعة شعرية لشاعر مصري معروف بعنوان: صباح الخير تقريباً.
التاريخ يعيد نفسه في المرة الأولى كمأساة وفي المرة الثانية كمهزلة. فإذا كانت الستينيات بداية المأساة هل نعيش استمرارها، أم ما يحدث الآن مرحلة جديدة؟ وهل لهذه المرحلة سمات أصلاً؟ قد يُقال إننا وصلنا إلى المهزلة.
إن ما يمنعنا حالياً من أن نصبح شعراء هو وجود القرَّاء، لا قلَّتهم كما يُظن. وكي لا نركِّز على شعراء الحداثة الأوائل الذين استحبُّوا دور المثقف الدون كيشوت الذي لا يأبه بالقراء، ولديه حلم ومشروع وهذا المهم، حتى لو كان هذا الحلم جنوناً لا معنى له، لنذهب إلى مكان آخر.
الشاعر الجاهلي في ظهوره الأول -قبل تكريسه إعلامياً للقبيلة وضيفاً على الأسواق- لم يكن يأبه بقارئ، وصنع شيئاً من لا شيء، وكل إبداع هو لحظة خلق وافتراق، ولكن الكتابة لا تنطلق من ترتيب معين لكلمات لغة متعالية، بل تنطلق من اللا شيء من فراغ ما نعيشه، وتنتظر قارئاً ما، وهذا ما يجعلنا نبتعد عن شعراء الرؤيا عموماً، لا سيما أن اهتمامهم باللغة والشكل يناقض أساساً قصيدة الرؤيا الدادائية أو الألعاب السريالية، فقصائدهم قصائد رؤيا مصطنعة أيضاً، تقدم رؤية جاهزة في الستينيات، أو اللا معنى في التسعينيات.
لقد اخترنا طريقاً آخر، فالقارئ يستحق أن نتغير من أجله طالما أن الأساليب جميعها صناعية، وليكن الإبداع إيجاد الأسلوب الذي يحقق الوجهين: الوجه التاريخي (الظروف السياسية والاجتماعية وحالة اللغة والتذوق والأساليب في عصر ما)، والوجه المجازي الرؤيوي الشخصي، وهو ما قد يُسمى الصفر الوجودي بدلاً عن درجة الصفر البنيوية التي كانوا يسعون لها في نصوصهم، فالحياة الإنسانية هشَّة جداً، ومتهاوية، ولذا وجد الشعر.
نحن نرى ما نريد، متى نريد، وكل لحظة نعيشها لها رؤياها، ومنها لحظات مقدَّسة لدينا، أو أثَّرت فينا رغماً عنا، ولكننا نجد أنفسنا مضطرين إلى كتابة تلك اللحظات أو الهواجس بطريقة أخرى دوماً، ليفهمنا القارئ أولاً، ولنفهم أنفسنا أيضاً بوصفنا قرَّاءً، فالكتابة أداة من أدوات التفكير، وكل لحظة نعيشها يمكن قراءتها بأشكال مختلفة في أوقات مختلفة.
بعد ولادة الشعر العربي العفوية، غدا الشاعر الجاهلي شاعراً للقبيلة، وفي العصور اللاحقة غدا شاعر الأمويين أو معارضيهم، وبعدها غدا شاعر من يحتاج تلك الوسيلة الإعلامية من خليفة أو أمير أو وزير... كانت هذه الحالة هي المتن، ما يجعل المهتمين بالأدب الاجتماعي يسألون: ألم يكن هناك أدب آخر؟
نعم، كان هناك هامش في شعر الصعاليك مثلاً في عصر الجاهلية، وفي شعر التصوف في العصور المتأخرة أيضاً، وحتى في القصائد الكبرى لكبار الشعراء الرسميين، فالشعر العربي كله كان متنفساً لحضارة مادية، وإن غرق بدوره في ماديتها، وهنا نعود لأفكار أدونيس.
في زمن الحداثة كان المتن والهامش يسيران جنباً إلى جنب في البداية، فقصيدة الماغوط كانت سياسية، وشعر التفعيلة ذو الوظيفة الإعلامية عند أدونيس كان رؤيوياً، وتحس مع أدونيس أن الحداثة كلمة لا معنى لها تقريباً، فهي شيء متوفَّر في أي كتابة جيدة، ولكن هذه نقطة جيدة ومريحة. ثم استمر جيل الحداثة والأجيال اللاحقة بالبحث عن الشعر دون أن يستطيعوا الهروب من الإعلام والسياسة، أو يواجهون الإهمال الذي أحاق بشعراء التسعينيات، الذين بحثوا عن شعر صافٍ في المكان الخطأ.
إذن، كان لدينا قصيدة جاهزة مقشَّرة، صنعها الماغوط ورياض الصالح الحسين ولقمان ديركي وشعراء التفاصيل في التسعينيات، وقصيدة تفعيلة مكتملة صنعها السياب ودرويش... وتجارب فردية مكرَّسة لأدونيس وأنسي الحاج وسليم بركات وبعض شعراء الثمانينيات.
الفن سلعة مطلوبة، ولا يمكن أن نصرَّ على سلعة كاسدة، ولا يمكن أيضاً أن نقبل بأن تغدو كتاباتنا مستهلكة. لكن، ما قيمة كل هذه الوداعات للرؤيا؟ أليس من الأولى أن نبدأ الكتابة وكفى؟ وقبل ذلك، أي قارئ نقصد؟ ألم يدعونا كونديرا إلى انتقاء قرائنا؟
ما يُكتب اليوم هو شعر الصعاليك الجدد الذين بدؤوا الكتابة في عصر المهزلة، وبدلاً من حادي العيس الجاهلي لدينا حادي الفيس بوك الافتراضي، الذي يمزج أشكالاً أدبية مختلفة، ويكتب كما يريد، ولا يميز الشذرة من الومضة، أو القصيدة من الخاطرة... ما الذي يبقى إذن في كل مرة؟ شغب «س» من الشعراء، ثم شغبه من جديد، وهكذا. إنه اللعب الحر دون منطلق أو مستقر وقد يكون أجدى لتحريك مياه اللغة من كل تلك التشنجات القديمة.
طبعاً، قد ندعو الشاعر لاتباع صوته، وتطوير أسلوبه، ولكن ليعبر عن ماذا؟ ذاته أم تمرُّده؟ وهل هناك فرق؟ هل نكتب شعراً أم نثراً؟ ما الفرق بينهما يا ترى؟ هل نحن فلاسفة أم عشَّاق؟ ننقل أخباراً أم نتخيَّل أحداثاً؟ خفَّفنا التوهُّج، وأضفنا إلى الكثافة بعض الثرثرة، وإلى المجانية المعنى ونقيضه وتعدُّد مستويات القراءة.
بعيدون عن جدية شعراء الستينيات، وتشنُّج شعراء السبعينيات، ورهبنة شعراء التسعينيات، نرمي النص ببساطة، بل الكتاب كله، عندما لا يعجب القراء، والشعر لدينا ليس قضية بل تحصيل حاصل، وقصيدة النثر كتابة وبحث عن الأسلوب فقط.
لم تعد قصيدة النثر جزراً منفصلة كما كانت في أواخر القرن الماضي، حين لم يعلم شعراء التسعينيات المصريون بتجارب السوريين، والعكس صحيح. وهذه النقطة وحدها كافية لنسف محاولات تطبيق أي تنظير شعري عربي على هذه اللحظة التي باتت فيها رواية من أمريكا اللاتينية أو اليابان تؤثر أكثر من الشعر السوري كله، وأتمنى أن نتجاوز هذا.
الإبداع يأتي من اللا شيء، ولكنه يتجَّه نحو قارئ. نعرف أن الرؤيا مستحيلة، ولكن اللعب بالكلمات ممكن. إنها لعبة المرايا، التي لم يعد لها مكان سوى الهوامش.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. الفلسطينيين بيستعملوا المياه خمس مرات ! فيلم حقيقي -إعادة تد

.. تفتح الشباك ترجع 100 سنة لورا?? فيلم قرابين من مشروع رشيد مش

.. 22 فيلم من داخل غزة?? بالفن رشيد مشهراوي وصل الصوت??

.. فيلم كارتون لأطفال غزة معجزة صنعت تحت القصف??

.. فنانة تشكيلية فلسطينية قصفولها المرسم??
