الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
سؤال يحتاج الى اجابة من كل من يمتلكها
ابراهيم علاء الدين
2008 / 12 / 24دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
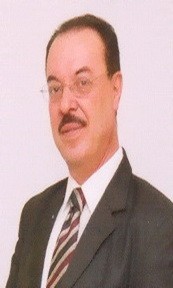
يستخدم الكثير من الكتاب والادباء والسياسيون عبارة " زمن الموت العربي" في وصفهم للحالة التي تمر بها البلاد العربية في الوقت الحالي، وهي عبارة تحمل في مضمونها احتجاج صارخ على الاوضاع الراهنة، وغالبا ما تأتي في سياق كتابات تحريضية ذات طابع عاطفي خطابي حماسي، تحاول ان تستحث "الأمة" على التمرد والثورة وتغيير الوضع القائم، وهي في غاياتها نبيلة وذات اهداف سامية.
وقد سمعت الشاعر سميح القاسم في حديث على الجزيرة يقول ان الزمن الحالي هو الاسوأ في تاريخ الامة العربية، ومثل القاسم هناك في كل عصر من اعتقد ان عصره هو الاسوأ بالتاريخ، فهل يعني هذا ان السوء يتزايد في كل حقبة عن الاخرى، وان الموت يتفاقم ، وان الامة الميتة هي كالجثة يوما بعد اخر تتماهى بالتراب، بفعل العوامل الطبيعية.؟ ام ان التخليل والوصف هو الخاطيء وبناء عليه يتم توصيف واختيار اساليب خاطئة لمواجهة ازمة الموت ، وهل اصلا يمكن احياء ميت ؟؟
ويلاحظ ان الكثير ممن يتصدون للحالة الراهنة ممن يستخدمون هذه العبارة او العبارات المشابهة لها لا يعتنون كثيرا بتحديد متى حدث الموت، هل بدأ مع احتلال فلسطين عام 48، مثلا، ام مع الاحتلال العثماني خمسمائة سنة، ام مع سقوط الدولة العثمانية وبدء مرحلة الاستعمار الحديث؟، ام قبل كل هذه الاحداث؟.
ابن خلدون المولود في مايو من عام 1332 ميلادي، وهو العالم الموسوعي متعدد المعارف والعلوم، والرائد المجدد في كثير من العلوم والفنون، و المؤسس الأول لعلم الاجتماع، وإمام ومجدد في علم التاريخ، وأحد العلماء الراسخين في علم الحديث، وأحد فقهاء المالكية المعدودين، ومجدد في مجال الدراسات التربوية، وعلم النفس التربوي والتعليمي، يقول في مقدمته الشهيرة، "ان زمن الموت العربي بدأ في نهاية القرن الثامن الميلادي، فقد انقلبت أحوال المغرب الذي نحن شاهدوه و تبدلت بالجملة و اعتاض من أجيال البربر أهله على القدم، بما طرأ فيه من لدن المائة الخامسة من أجيال العرب بما كسروهم و غلبوهم وانتزعوا منهم عامة الأوطان وشاركوهم فيما بقي من البلدان لملكهم هذا إلى ما نزل بالعمران شرقاً وغرباً في منتصف هذه المائة الثامنة من الطاعون الجارف الذي تحيف الأمم و ذهب بأهل الجيل و طوى كثيراً من محاسن العمران ومحاها، وجاء للدول على حين هرمها وبلوغ الغاية من مداها فقلص من ظلالها وغل من حدها وأوهن من سلطانها وتداعت إلى التلاشي والاضمحلال أموالها و انتقض عمران الأرض بانتقاض البشر فخربت الأمصار والمصانع ودرست السبل و المعالم و خلت الديار و المنازل وضعفت الدول والقبائل وتبدل الساكن.
وكأني بالمشرق قد نزل به مثل ما نزل بالمغرب لكن على نسبته و مقدار عمرانه و كأنما نادى لسان الكون في العالم بالخمول والانقباض فبادر بالإجابة و الله وارث الأرض و من عليها وإذا تبدلت الأحوال جملة فكأنما تبدل الخلق من أصله و تحول العالم بأسره و كأنه خلق جديد ونشأة مستأنفة و عالم محدث".
وفي المشرق تورد المؤلفات التاريخية وهي عديدة صورة مقاربة لتلك التي وصفها ابن خلدون للمغرب فيقول المؤرخون مثل السيوطي والذهبي والطبري وابن الاثير وغيرهم انه في عهد المتوكل بالله وهو الخليفة العاشر في الدولة العباسية (232 الى 257 هجرية – 847 الى 871م) بدأت مظاهر في الانهيار الفعلي للدولة الاسلامية، ونهاية مرحلة ازدهار الدولة الاسلامية، على الرغم من محاولته اصلاح الفساد العام والشامل الذي حاق بالدولة خلال فترات حكم الخلفاء الاربعة الذين سبقوه الامين والمامون والمعتصم بالله والواثق بالله، حيث عزل الكثير من الولاة، وصادر املاكهم وعزل قاضي القضاة وعزل عامله على المعونة، الا ان جهوده ضاعت هباء، حيث تعرضت البلاد في او سنة من حكمه الى سلسلة من الزلازل دمر احدها دمشق وقتل الالاف من البشر، ثم ضرب انطاكية فهدمها، ودمر زلزال رابع الجزيرة العراقية، فيما قضى زلزال خامس على نحو 50 الفا في مدينة الموصل ودمر المدينة.
ثم هبت ريح سموم اكلت الاخصر واليابس واهلكت الزرع والضرع في بغداد والكوفة والبصرة، وقتلت الافا من الناس واستمرت خمسين يوما توقفت خلالها حركة الحياة.
وفي السنة العاشرة من حكمه دمرت سلسة من الزلازل شديدة القوة مدينة تونس وضواحيها، كما دمرت الري وخراسان ونيسابور وطبرستان واصفهان ، وانشقت الجبال وانهارت وتشققت الارض، واصيبت الحياة كلها بالشلل التام والموت الزؤام والبؤس والدمار.
وبالاضافة الى ذلك فقد جرى في عهد المتوكل تحول خطير حين استبدل الفرس بالاتراك لمعاونته في شؤون الحكم فاستلبوا القيادة وتحكموا بكافة شؤون الدولة وفي النهاية قتلوا المتوكل بالسم، ليتحكموا بعد ذلك بمعظم خلفاء بني العباس الذين دام ملكهم 500 سنة تقريبا، وانتهى فعليا سنة 1258 بالغزو المغولي بقيادة هولاكو الذي دمر بغداد وقتل المستعصم بالله اخر خلفاء بني العباس في بغداد.
ووفق الرواية التاريخية لمعظم المؤرخين فان الدولة العربية الخالصة لم تكن الا في زمن الدولة الاموية، حيث ان الدولة العباسية كانت حتى الفترة الاولى من حكم هارون الرشيد خاضعة للنفوذ الفارسي من خلال البرامكه، ورغم انه قضى عليهم الا ان النفوذ الفارسي استمر حتى قام المتوكل بالقضاء على نفوذهم ليبدأ نفوذ الاتراك ويستمر حتى سقوط كل الممالك العربية بيد الاتراك وانتقال الخلافة الاسلامية لهم في منتصف القرن السادس عشر.
ومع ذلك وبالرغم من هيمنة الفرس على الدولة العباسية قبل ان يبدأ نجمها بالافول في عهد المتوكل فان العصر الاموي وبدايات العصر العباسي شهدت اعلى مراحل الازدهار والتوسع والقوة وبلغت اوجها في عهد الرشيد. ثم بدات بالتراجع.
ولم تكن القوة العسكرية وحدها سببا لهذا الازدهار، كونه اصلا لا يمكن انشاء قوة عسكرية قاهرة اذا لم يكن هناك دولة تمتلك مقومات اقتصادية كبرى، وقدرات علمية متميزة، وكفاءات بشرية وموارد مالية عالية، وانظمة ادارية معاصرة.
وهكذا كان حال الدولة الاسلامية في عصر الازدهار الذي استمر زهاء 250 عاما ، فقد حققت الدولة كل هذا الازدهار وهذا المجد عندما كان حكامها يولون العلم والعلوم والعلماء (ليس المقصود بهم علماء الدين وانما هؤلاء من طائفة العلماء) العناية والرعاية والاهتمام، والتشديد على اهمية المعرفة ، مما جعل الدولة الاسلامية المركز الاول على مستوى العالم في ميادين الثقافة والعلوم والفكر والفلسفة والطب والتعليم بكل فروعه، والفضل في كل ذلك يرجع الى الامويين وفي مقدمتهم معاوية بن ابي سفيان مؤسس الدولة العربية النقية الوحيدة في التاريخ والتي عاشت نحو مائة عام ودمرت على ايدي العباسيين.
وقد رسخ الامويون اسباب المعرفة واسسوا الكثير من دور العلم وجلبوا العلماء الى دمشق من انحاء الامبر اطورية الممتدة ووضعوا اول عملة اسلامية، واسسوا اول اسطول بحري، وشيدوا المعالم واعلوا العمران وازدهرت الحواضر كدمشق والقدس وحلب وفيما بعد في الاندلس، وانشأوا المدن الجديدة ، واسسوا المستشفيات والمكتبات ودور العلم والعبادة والقصور.
وفي العصر العباسي شيدت بغداد وسامراء والكثير من المدن والحواضر، وشيد بيت الحكمة في بغداد ليكون قبلة سعى اليه العلماء وكل طالب علم من المسلمين وغير .
وسادت في تلك الفترة النزعة الانسانية والعقلانية لدى المفكرين الاسلاميين خلال بحثهم عن المعرفة ، ودعموا التسامح الديني مما خلق شبكة من العلاقات متعددة الثقافات مما جذب المفكرين الى الاسهام بنشر المعرفة من المسلمين والمسيحيين واليهود، لتنتج تلك الفترة ابداعا فلسفيا عظيما وامتد هذا الابداع حتى نهاية القرن الثالث عشر الميلادي.
وسط هذا المناخ الذي يبجل العلم والعقل اقيمت اول جامعة في العالم بالقيروان سنة 859 م ، وافتتح اول مستشفى مجاني في بغداد في عهد الرشيد، وتم افتتاح اول مسشفى في مصر عام 872م لتنتشر بعدها في كل انحاء الامبراطورية.
وبحلول القرن العاشر كان في قرطبة 700 مسجد و 60 الف قصر و 70 مكتبة، كانت تحوي أكبرها 600 الف كتاب. وكان يتم نشر ما مجموعه 60 الف دراسة و قصيدة و مؤلفة كل سنة، وكان يوجد في مكتبة القاهرة ما يقارب مليونين كتاب. وفي مكتبة طرابلس في لبنان أكثر من 3 ملايين كتاب.
ومن المظاهر الأخرى للعصر الذهبي للإسلام وجود عدد كبير من العلماء المسلمين الذين كانوا يلقبوا ب (الحكماء)، قام كل منهم بالمساهمة في مجموعة متنوعة من الحقول الدينية و العلمية والتعليمية، وكان يتمتع هؤلاء بمعرفة واسعة و عريضة في مختلف المجالات و الحقول و لم يكونوا متخصصين في مجال واحد. من امثال (البيروني و الجاهز و الكندي و الرازي و ابن سيناء و الإدريسي و ابن باجة و عمر الخيام و ابن زهر و ابن طفيل و ابن رشد و علي بن حزم الأندلسي و غيرهم ).
بالاضافة الى ازدهار التجارة والزراعة والصناعة والحرف وعمت مظاهر الحضارة والقوة والمنعة في كل الميادين.
اذن فان الازدهار الحضاري قام على العلم والعقل وعلى اكتاف العلماء والمفكرين، وهذا ليس استثناء فكل حضارات الدنيا قامت على هذا الاساس.
وكل هذه الحضارة العظيمية بدات بالانهيار والزوال بعد ان عصفت باركان الامبرطورية الصراعات الداخلية على السلطة والعرش، وعادت الاخلاق الهمجية لتسيطر على الطبقات العليا المتصارعة، فانزوى العلماء وانحط العلم، وعم الجهل ، وعادت العصبيات من كل الانواع للظهور، وتمزقت الدولة الى ممالك وامارات واسر حاكمة، وعمت الثورات والانتفاضات والعصيان والتمرد الارجاء، واصبحت الدولة بمعنى السلطة ورمزها الخليفة لا حيلة لها ولا قوة، وخصص الخليفة جل جهده للدفاع عن عرشه وكرسيه، وفي سياق مصالحه سير الجيوش لقمع الثورات والانتفاضات والعصيان، وقتل الكثير من الخلفاء بالسم وبغيره، (وسوف نخصص بحثا خاصا لعرض حالة الوضع السياسي الداخلي للدولة الاسلامية لنعرض للفتن والمؤامرات والثورات وحالات التمرد والعصيان).
من هنا بدأ زمن الموت العربي ولهذه الاسباب. اي منذ نهايات القرن الثامن الميلادي تقريبا.
وقد يتسائل البعض لماذا اعطي كل هذا الاهتمام لتحديد زمن الموت العربي، او بعبارة اكثر دقة زمن انهيار الدولة العربية الاسلامية، وما علاقة تحديد التاريخ بمحاولات التصدي للواقع الراهن والعمل على الخروج منه؟.
وللاجابة على هذا السؤال اقول انه على ما يبدو ان معظم الناس على اختلاف مستوياتهم يظنوا ان حالة النكوص والتراجع والتخلف هي حديثة العهد، وان الاستعمار هو المسؤول عنها، ولا يدركوا ان هذه الحالة هي بسبب عوامل بنيوية شاملة ، لا تتم مواجهتها الا بتفكيك المنظومة الفكرية السائدة واحلال منظومة جديدة تماما ..
كما ان تحديد تاريخ "حدوث الموت" له اهمية بالغة في معرفة كيفية مواجهة الواقع الراهن، وتقييم كافة الاطروحات الفكرية والسياسية، والاجتماعية والمسلكية وادوات ووسائل المواجهة، وذلك لان تحديد التاريخ لا بد وان يفرض على معرفة عناصر الازدهار والقوة، ثم معرفة عناصر الانهيار والزوال، ثم دراسة مجمل ما قام به المجتمع منذ ذلك الوقت من محاولات لاعادة الحياة للدولة التي انهارت، وهنا تكمن اهمية الزمن فاذا كان قصيرا يكون هناك من المبررات الكثير لتبرير الفشل، ويقال ان التجارب ما زالت يانعة وغير ناضجة الامر الذي يتطلب المزيد من العمل بنفس الادوات والوسائل والطريقة والبرامج والسياسات ولأجل نفس الغايات والاهداف، لكن اذا كانت الفترة طويلة كما هي حالة البلاد العربية وتمتد الى 1200 عام ، فان ذلك يستدعي دراسة عميقة لاسباب فشل اعادة بناء الدولة منذ ذلك التاريخ، ولا بد وان يخرج الباحث او الدارس الى حقيقية مؤكدة تقول ان كافة الاطروحات الفكرية والسياسية، والاجتماعية، والمسلكية، وادوات ووسائل المواجهة كانت فاشلة، والدليل على ذلك انها لم تستطع اعادة بناء الدولة، رغم ان المقومات لم تتغير فأغلبية السكان ينتمون الى عرق واحد ويتحدثون لغة واحدة ودين واحد وثقافة وثراثا واحدا.
اذن هذا يفرض على المفكرين والساسة والمثقفين والعلماء ان يضعوا اطروحات فكرية وسياسية واجتماعية ومسلكية وادوات ووسائل جديدة. هذا ابسط الاستنتاجات التي يمكن ان يصل اليها الباحث.
فهل من يستخدمون عبارة "زمن الموت العربي" في سياق التحريض على التغيير، ومن يرفعوا شعارات التغيير ومنخرطون في معمعان الحركة النضالية بكل مسمياتها، وضعوا مثل تلك الاطروحات والمناهج القادرة على التغيير.؟؟ اشك في ذلك ..
فطالما ان الثقافة الشعبية السائدة في العالم العربي هي ثقافة التواكل من الناحية الدينية، وثقافة عاطفية من الناحية النفسية، تبرز بشدة في حالات الفرح فتنتشي الحماسة، او حالات الحزن فيعم الاحباط، ثقافة سلفية قد تمتد الى اعماق التاريخ، واساطير القصص، ثقافة تجد الاوهام فيها موقعا مريحا. ويجد التضليل مسارات مفتوحة على مصراعيها لانتاج الوهم.
ولطالما هذه الثقافة هي السائدة في الاوساط الشعبية، فان المنطق يقول ان النخب الفكرية والثقافية والسياسية مقصرة في احسن الاحوال وعاجزة في الاعم عن تغيير هذه الثقافة وتبديلها والاتيان بثقافة يمكن من خلالها تغيير الواقع.
أي ان النخب عاجزة عن صياغة الاطروحات والبرامج والمناهج والاساليب لتحقيق التغيير الذي لا يمكن له ان يتحقق الا من خلال الفعل الجمعي للشعب، بعد ان برهن التاريخ على فشل تجربة الانقلابات او المؤامرات ، والاعمال الفردية مهما كانت جرأتها .
فالتاريخ والواقع والتجربة البشرية ومنها تجربة اهل المنطقة تقول ان المقصود بالتخلف هو تراجع العمران والتحضر والمدنية والعلوم والصناعة والتجارة والزراعة. ويترتب ذلك على تخلف نظم الحكم والادارة وتغيب العدالة والمساواة وحرية التعبير، وسيادة الاستبداد، والظلم، والفساد والواسطة والمحسوبية والرشوة.
ولمواجهة ذلك يجب الاقرار من النخب ان الاساس في احداث التغيير هو الوعي وانتشار المعرفة، وان واجبهم ايصالها الى الجماهير، وبقدر نجاحهم في ذلك يفرضوا على الادارات الحاكمة الحكم الرشيد، وعندها تجد الحضارة سبلا لتحققها.
وقد يقول قائل "الم تمارس النخب هذا الدور في كل العصور، ولم يحقق نتائج؟".
واجيب بالقول انه من حيث الشكل مورس وما زال يمارس، لكن باي منهج وما هي برامجه ؟ وما هي وسائله؟ وما هي المنطلقات الفكرية التي قامت عليها؟
فكل ما مورس سابقا انطلق من منطلقين اما منطلق ديني او منطلق قومي، وكلاهما اعتمدت دعوته على الثقافة السلفية، والعاطفة الدينية والقومية، فهذا يريد اقامة الدولة الاسلامية ، وذاك يريد اقامة نفس الدولة مع تعظيم او اسبقية كلمة العربية على الاسلامية، مع فارق اخر ان الاول حدود دولته الاسلامية اوسع من حدود الوطن العربي، فيما الاخر لا يرى ضرورة لان تشمل الدولة غير العرب. وعلى اساس خطاب عاطفي اعلامي لا يرى الا ما هو مضيء بتاريخ المنطقة وهو محدود وقليل بالمقارنة مع ما ساده من ظلام وبؤس وقهر واستبداد.
ومنذ 1200 سنة منذ زلازل المتوكل على الله، ورياح السموم، ما زالت جهود ابناء المنطقة النخبة منها والعوام تدور في هذا النسق، لتحقيق ذات الهدف، وباستخدام نفس الادوات والوسائل وبنفس المنهج الفكري والثقافي . وقد فشلت كافة المحاولات للطرفين.
وهناك تجربة لا بد من الاشارة اليها وهي تجربة الشيوعيين او اليسار عموما، فبالرغم من تميزها الفكري عن التجارب الاسلامية والقومية، الا انها اتسمت بذات السمات من حيث انها وقفت عاجزة عن التصدي بقوة وجرأة للموروثات التي تكتسي طبيعة قدسية. سواء منها المستمد من الاساطير والشعوذة والوهم ، او من الموروث الشعبي من قيم وعادات واعراف، بل يمكنني القول ان النخبة الشيوعية واليسارية هي ذاتها لم تتخلص من هذه الموروثات. فكيف يمكن لامة ان تنهض وهي تحمل في اعماقها بذور فناء حضارتها..؟
فكان نتيجة جهودها وتضحياتها لا تكاد تذكر.
اعود لاكرر ما اصبح يشبه اللازمة في معظم المقالات ان الخروج من حالة التخلف المأساوية التي يعيش فيها شعوب العرب، تتطلب اقصى درجات البذل والعطاء والتضحية والعمل المتواصل ليلا نهارا لتغيير القيم والاعراف والمفاهيم السائدة بالمجتمع، وان يحل مكانها القيم التي تمجد العلم والبحث والابداع والاختراع، والعمل ، والثقافة والفنون، والانتاج ، وتمجيد كل المنظومة الاخلاقية التي تحث على العدالة والمساواة والديمقراطية وحرية التعبير والمعتقد، وتكافح كل اشكال التمييز، وتعمل على تقويض اسس الثقافة العنفية، ونشر ثقافة المجتمع السلمي، والنضال والكفاح والمقاومة السلمية، في وجه ثقافة الارهاب والعنف والاقصاء.
وليبني كل شعب دولته الوطنية ، وكلما نجحت الشعوب العربية في بناء وتعزيز وارتقاء دولتها الوطنية كلما حتمت عليها المصالح ان تلتقي باشكال من الاتحاد او التعاون مع غيرها من من الدول، فالمصالح هي التي توحد وهي التي تفرق وتمزق، اما الدعوات العاطفية والحماسية دينية كانت او قومية، فلن تحقق ايا من طموحات شعوب المنطقة.
فمتى تتبارى نخب هذه الشعوب في نشر الوعي الحضاري المعاصر..؟؟ سؤال يحتاج الى اجابة من كل من يمتلكها .
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. المدرجات تُمطر كؤوس بيرة في يورو ألمانيا.. مدرب النمسا يُحرج

.. لبنان يعيش واقعين.. الحرب في الجنوب وحياة طبيعية لا تخلو من

.. السهم الأحمر.. سلاح حماس الجديد لمواجهة دبابات إسرائيل #الق

.. تصريح روسي مقلق.. خطر وقوع صدام نووي أصبح مرتفعا! | #منصات

.. حلف شمال الأطلسي.. أمين عام جديد للناتو في مرحلة حرجة | #الت
