الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
العنف والمقدس (2)
سامي فريدي
2009 / 3 / 31العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
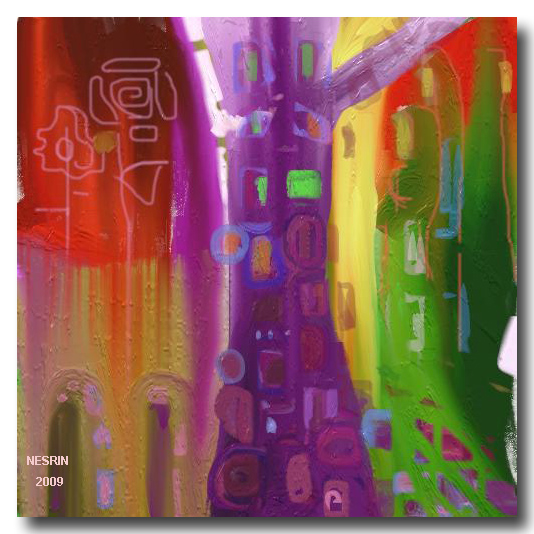
- المصادر النظرية لأعمال العنف في العراق-
شكلت أحداث العنف الأهلي في العراق في أعقاب الغزو الأمريكي ظاهرة غير عادية، كانت بالنسبة لكثيرين صدمة فكرية ونفسية غير متوقعة. لا أعتقد أن عدم قدرة المثقفين العراقيين والعرب على استباق صورة ما حدث بالنوع والدرجة يعتبر نوعا من العجز الفكري أو عدم فهم الظاهرة الاجتماعية في العراق، أو قصور سياسيا بشكل من الأشكال. لذلك ظهرت تأويلات وتفاسير سريعة ومختلفة لتلك الظاهرة مثلت رد فعل نفسيا مباشرا لاجابة أسئلة راهنية طارئة، ويمكن تصنيف تلك التفسيرات في شقين رئيسين:-
- وصف الشخصية العراقية بالعنف والتمرد واستقراء ذلك في جملة التاريخ القديم لأرض الرافدين منذ بادئ ذي بدء، كان أبرزها كتاب نشرته جريدة الزمان مسلسَلا حاول تحميل الفرد العراقي وزر الحروب والغزوات وحوادث الأغتيال ودسائس قصور الحكم في عملية اسقاط منافية لمنطق العقل وبالشكل أحادي القراءة بما يخدم الموقف العربي الرسمي ويبرر الدكتاتورية. فكانت الشخصية العراقية والانسان العراقي ضحية للطعن والقدح والامتهان والانتقاص.
- تحميل وزر العنف لأفراد وجماعات دخيلة عبر الحدود، وهو يمثل موقف جهات عراقية سيما عقب تشكل قوى الشرطة العراقية والقاء القبض على أفراد من جنسيات بلاد عربية ومسلمة.
ولا يمكن للباحث الأخذ بأي من الرأيين الصادرين من ردود أفعال عاطفية سطحية، دون تصدي علماء النفس والاجتماع لدراسة الظاهرة بروح علمية موضوعية، أو تشخيص جملة نقاط مساعدة، يمكن اعتمادها أضواء رئيسة في التصدي للموضوع.
فالموقف التجريحي المهين للانسان العراقي يتجاهل الخصائص الابداعية والحضارية لانسان الرافدين، وانبثاق أولى إشعاعات الفكر والدين والفلسفة من هذه المنطقة، كما يتجاهل جملة من مرجعيات الفكر وحمالات الازدهار لكل مما يسمى بالعروبة والاسلام، اللتين تفتقتا وتطورتا بفضل إنسان الرافدين وخلفيته الثقافية التعددية الزاخرة. وبالتالي فليس من المنطق أن يجاهر الموقفان العروبي و الاسلامي بمهاجمة الخصائص الجينية أو الخواص النفسية للفرد العراقي، الذي لا يخرج - بهذه السهولة- من خانة العرب والمسلمين. ناهيك عما عكسته تلك الاراء من واقع العجز الذاتي والرغبة في التشظي وتجزئة قضايا الانسان والمنطقة والتاريخ. فما يمكن أن يصح على بلد ليس بعيدا عن واقع بلد مجاور وخواصه، ضمن خريطة التبادل والتداخل الاجتماعي والثقافي في الشرق الأوسط.
أما الموقف المقابل بالقاء تبعات الأحداث على المتسللين من بلدان الجوار، فلا يمكن أن يشكل مجمل الصورة اطلاقا ناهيك عن عدم حذفه مسؤولية الأهلين الذي يوفرون المأوى والرعاية الكاملة لتخريب بلدهم وتقتيل أبناء جلدتهم ومواطنيهم. الحقيقة.. أن الثقة والاعتداد بالانسان والمجتمع العراقي كانت أكبر بكثير قبل الغزو مما حدث بعده. لقد اهتزت الصورة، وكانت الصدمة الفكرية والنفسية من أحداث السلب والنهب والعنف الأهلي أكبر مما شكله الغزو العسكري الأمريكي بحد ذاته. فحادث مثل الغزو قد يكون طارئا من الخارج واضحا للعيان، أما ما يتعلق بالشخصية المحلية فهو ضمانة البلد ورأسمالها الدائم. وقد اهتزت الصورة، بكثير من الأسف!.
*
بايجاز شديد، أن الظروف غير العادية في أرض النهرين لا تنفصل عن جملة الظواهر غير الاعتيادية الناجمة عنها. ان أصعب الصعوبة هو المطالبة بشيء طبيعي في ظرف غير طبيعي. وهنا لا يجوز استغفال دراسة تاريخ الاضطراب العراقي المحتدم في العصر الحديث، وما حدث ليس غير انفجار الاحتقان، وانكشاف المتناقضات. تلك المتناقضات التي تفضح مدلولاتها الاساسية الكامنة وراءها. لقد أريد لبلد الرافدين منذ معركة القادسية الأولى أن يكون حصان رهان الأمة الخارجة من عمق الصحراء، ورسخت الأحداث التالية هذا المنحى، بدء بانتقال عاصمة الدولة من مكة إلى الكوفة، واضعة البلاد وأهلها ساحة لتصفيات عرقية وطائفية لا تنتهي. ويمكن تأشير ثلاثة عوامل عامة لتلك الأحداث وبايجاز شديد..
1- أسباب ذاتية موضوعية..
2- أسباب سياسية..
3- أسباب دينية..
أولاً:- تنقسم الأسباب الذاتية والموضوعية إلى ثلاثة أبواب..
1- التعددية الأثنية للمجتمع العراقي واستمرار النعرات العشائرية والطائفية التي لم يظهر جهد جاد من قبل الحكومات المتعاقبة منذ تأسيس الدولة العراقية على معالجتها وإذابتها في نسيج مواطنة وطنية ولحمة شعب منسجم مع بعضه. وقد تركزت أحداث العنف في مركز العاصمة ومراكز المدن الرئيسة مثل الموصل والبصرة، مما شكل مركز صراع الأطراف المتهافتين للسيطرة على المركز وبغاية الاقتراب والتأثير في سلطة القرار مستقبلاً. لقد شكلت أحداث العنف عبئا ثقيلا على أهالي العاصمة الأصليين، كما أهالي المراكز الرئيسية الأخرى. ان الحركة الدمغرافية الداخلية وانتقالات السكان داخل العراق كانت في حركة دائبة طموحة في سياق تحسين المستوى المعيشي وتطوير أنماط السكن والحياة من القرية إلى المدينة ومن الأطراف إلى المراكز ومن المراكز نحو العاصمة الرئيسة، وهاجسا مشتركا لكثير من السكان. لعبت فيها العوامل السياسية وتحسن أوضاع التعليم والظروف الاقتصادية دورا مشجعا. وكانت الحكومة أصدرت قراراَ في سبعينيات القرن الماضي بوقف الانتقال بين المحافظات العراقية وتغيير السكن الأصلي. ان زوال النظام يوفر فرصة تاريخية - لا تعوض- لتحقيق مكاسب مادية طموحة في إطار سباق اقتصادي طبقي ملحوظ في حركة المجتمع العراقي. قد تتفاوت الأسباب من عائلة لأخرى وفرد لغيره، لكن النتيجة هي ضمن الحركة العامة التي شكلت مشهد الفوضى والعنف الداخلي.
2- شهدت المدن العراقية والعاصمة تحديدا حركة سريعة في الثمانينيات والتسعينيات لما أطلق عليه "ظاهرة ترييف المدن" وذلك جراء هجرة فلاحية واسعة من القرى نحو المدن، ومن المدن نحو بغداد. وكان السبب المباشر لهذه الظاهرة التحسن الكبير في الوضع الاقتصادي للفلاحين وذلك لعاملين رئيسين..
أ- الحوافز المادية الممنوحة للفلاحين ضمن تطبيقات تحسين الواقع الزراعي والمجلس الأعلى للزراعة التي خصصت لكل فلاح نقابي حق الحصول على ماكنة زراعة وسيارة نقل بما ينسجم مع نوع المشروع، وقد كانت آثار تلك الحوافز عكسية، دفعت الفلاحين لهجرة الأرض والعمل في النقل ومجالات أخرى، أسهل وأسرع أيرادا من العمل الزراعي الشاق على مدار العام. (آثار طفرة النفط على ترييف المجتمع، عقب هجرة الفلاحين لقراهم ونزوحهم لإلى المدن).
ب- ظروف حرب الثمانينات التي شملت فئات واسعة من المواطنين، كبّدت الأهلين خسائر بشرية كانت تعويضاتها المادية مصدر إثراء فئات معينة سيما ممن كان لهم أكثر من فقيد في الحرب. وقد أغرت تلك الحوافز المادية المتضمنة لمنحة مادية وأرض وسيارة مع أفضلية في المعاملات ومراجعات دوائر الدولة بالتحول من حال لحال. تمثل في تغيير العنوان الحرفي أو المهني من فلاح إلى كاسب أو موظف ومن كاسب أو موظف إلى تاجر، استتبعه طموح اجتماعي وسكني في خريطة التحول الطبقي أو البرجوازي في المجتمع.
3- شكلت لعبة الازاحات الطبقية والأثنية جزء من سياسة النظام السابق دون اعتبار للتفاوت الثقافي والحضاري بين السكان. ويمكن الاشارة إلى أن حزب النظام كان أكثر ميلا للاعتماد على المتعلمين محدودي الثقافة من المثقفين والأكادميين، وطيلة مدة حكمه لم يكن في قيادته العليا من حصل على شهادة جامعية عليا، غير اسمين أحدهما يكون وزيرا للصحة أو التعليم العالي. وفي إطار تبعيث أجهزة ومؤسسات الدولة من درجة مدير ومسؤول قسم فما فوق، يمكن تصور المستوى الثقافي العام لطبقة المسؤولين في المجتمع والدولة، بكل ما ينعمون به من أمتيازات واستثناءات وحوافز. وكل ذلك مما ينعكس بالتالي على صورة المشهد العام للمجتمع، ويجعل طبقة المثقفين والأكادميين تحت رحمتهم.
2- أسباب سياسية..
طيلة ما ينيف على ثلاثة عقود من حكم الدكتاتورية وقعت ممارسات عديدة ومختلفة من الاستبداد والاعتداء على حقوق الانسان والمواطنة، يمكن تلخيصها في عناوين رئيسة..
- حوادث التهجير خارج الحدود..
- تصفيات سياسية .. كانت أكبر حملتين فيها أوائل الثمانينات وأوائل التسعينيات.
- اعتقالات متواصلة للمشكوك في ولائهم، وأشهرها عقب انتفاضة مارس 1991.
- تصفيات عرقية ضد الكرد.
- حملات أعدام متعددة في صفوف التجار والعسكر.
ان أكثر هذه الممارسات شعبية هو ما جرى ضدّ سكان الجنوب والكرد، حيث تعدّت درجات العقوبة الاعدام الجماعي أو العائلي إلى مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة بما فيها السكن والأرض، فأنتجت فئة من السكان غير القادرة على إعالة نفسها أو الحصول على مأوى ولقمة عيش. كان بين من تبقى من عوائل التصفيات أطفال وأحداث قاصرين.وهي مخلفات ثقيلة كانت تنتظر حلولا ناجعة أو مرضية بعد طول عهد. لكن زوال النظام لم يعد عليها بأقل القليل مما انتظرت.
3- أسباب دينية..
شكلت الحركات الدينية جانبا من معارضة النظام السابق، والتي دخلت البلاد مع قوات الغزو وأصبح لها نشاط علني، أبرز اتجاهات هذا النشاط ..
- استهداف بقايا النظام السابق ومواقعه..
- استهداف القوات الأجنبية الغازية (كفار /صليبيين)..
- تصفيات محلية داخلية..
ان خطورة هذه المجموعة مقارنة بغيرها، تكمن في صفة (المقدس) التي تصف بها مبرراتها ومنطلقاتها العنفية، من جهة، وصفة الالزام التي تفرض بها أوامرها على أتباعها كواجب جيني أو فرض. وعدم الاستجابة لها يمثل قصورا في الواجب الديني الذي يستتبعه عقاب آني من قبل الشيوخ أو آجل يوم القيامة.
أما الوجه الأخر لخطورة هذه المجموعة، فهو انخراط جماعات كثيرة من خارج الحدود تطوعت لممارسة الجهاد الفرضي (المقدس) إلى جانب جماعات الداخل وفي إطار وحدة جيوبولتيكية وعقائدية، ساهمت فيها شبكة من منظمات وحركات عابرة للحدود وبدعم وتنسيق من بعض بلدان الجوار. بل ان اصطباغ المرحلة بالمدّ الديني جعل منظمات سياسية قومية ومحلية تتخذ أو تستغل لبوس الدين وشعاراته ومناهجه لأغراض تكتيكية وتعبوية.
*
دوامة عنف خمسية..
شكلت السنوات الخمس عقب الغزو (2003- 2008) مرحلة من أصعب مراحل الفوضى غير المسبوقة بالنوع والدرجة والأمد من عمر المجتمع العراقي. مما يضاف إلى سلّة الحروب والحصار ثالثاً. وعند النظر إليها اليوم، فأنما ذلك يتم من منظور المآسي والتضحيات المضافة في تاريخ المجتمع العراقي، ناهيك عن آثارها وانعكاساتها في البنية الدمغرافية والثقافية.
على صعيد المصطلح تخذت تلك الأحداث إسمين بارزين.. هما..
- إرهاب..
- مقاومة..
وكلّ منهما يكتنفه الغموض والضبابية والفوضى، على الجانبين، جانب المصدر للعنف والمتلقي، كما على الصعيد الاعلامي. لكن سيرورة الأحداث واتجاه النار يكشف عن استهدافها الأهلين أولاً، وهو ما تكشف عنه أرقام الخسائر الفظيعة، أما ادعاء المقاومة ضد الاحتلال فيجد تفنيده في أرقام خسائر العدو المتواضعة بالمقارنة. تلك الأرقام التي لا يمكن اعتبارها إزاء العدد الكبير لمدّعي المقاومة والجهاد المقدس.
ان الصورة الخارجية لعنف السنوات الماضية يكشف عن درجة من التنظيم والتعاون لجهات متعددة عبر الحدود. كما أنه يسجل نقلة في تعاون أكثر من جهة أو حركة رغم اختلافها العقائدي فيما بينها وعدم تقاربها التنظيمي. ففي حديث لأحد الجزائريين يعترف بكون حركته طلبت من (الزرقاوي) في العراق اختطاف أفراد من جنسية محددة لاستخدامه ورقة ضغط لأطلاق سراح أحد المعتقلين في الجزائر. وهي درجة من التنظيم والتنسيق تحتاج آليات نقل وتوصيل سريعة ودرجات سرية بالغة وأمينة، لا يمكن استحضارها بدون مؤسسات رسمية لبلدان ذات علاقة خلف الكواليس. وهذا الأمر يسجل سابقة جديدة أيضا، أعني تعاون دول مع مآفيات وجماعات عنف عبر الحدود. وبالشكل الذي يقتضي تقديم تسهيلات أمنية وفنية وعسكرية جيوبوليتيكية كافية في الخدمة (المنافية للقانون الدولي للمنظمة الدولية التي تكون دول دعم العنف عضوا فيها، وبالتالي خرقا لميثاقها).
ترى كيف تنظر الدول الحاضنة أو الداعمة للعنف إلى نفسها؟.. وكيف تنظر إلى المنظمة الدولية وتعهداتها في الحفاظ على الأمن والسلم العالمي؟.. ماذا تنتظر من الدولة ضحية العنف؟.. وهل يعقل عدم انكشاف هذه الدول وأنشطتها للسلطات الأمريكية؟..
الغريب في الأمر ذلك الأدب البالغ للغاية للتحذيرات الأمريكية الموجهة لبعض البلدان، رغم نشاط أصابعها في غير بلد وغير قضية مخالفة للقانون الدولي. هذه الاحداث غير المتوقعة واشتراك جهات دولية ورسمية فيها بهذا الشكل، يضيف إلى قائمة تعقيدات الوضع العراقي تعقيدات كثيرة، ليس على صعيد الراهن، وانما مستقبل سياسات الحكومة العراقية، وكيفية تحديد موقفها ممن طعنوها من الخلف، فيما يفترض وقوفهم معها في وقت الأزمة، وأكبر من هذا وذاك، ما هو موقف العروبة والاسلام من كل ذلك؟..
*
لا عنف بلا إعلام..
هل كان يمكن للعنف أن يحدث بدون وسائل إعلام حاضنة وراعية وموجهة له؟..
كيف يمكن تقييم أو تصنيف وسائل إعلام واتصال محددة قصرت نفسها على أحداث العنف وما وراءه، ما وجه الحياد أو البراءة فيها؟.. لا أعتقد أن المؤسسات الدولية والراصدين الدوليين على هذه الدرجة من السذاجة، كما لا أعتقد أن هذه الوسائل على هكذا درجة من الذكاء؟..
للأسف.. وهو أسف يدخل في مجال الثقافي والحضاري والانساني قبل كلّ شيء، باعتبار أن الصحافة كانت أداة فعالة لنشر الثقافة والحضارة والتمدن والوعي الانساني ذات يوم..
كان لوسائل اعلام عربية دور غير مشرّف في عملية قتل الشعب العراقي وتخريب الحاضرة العراقية.. وبعضها كان يقوت نفسه من مال العراق ودم العراق، فوجد في لحم العراق تجارة رابحة له، في وقت النظام وفي وقت الغزو على السواء. وقد تعددت وسائل الاعلام بين صحافية وفضائية وألكترونية، بما لا يترك وسيلة دون أخرى.. لقد استخدمت صور ارساليات الراديو في الحرب العالمية الثانية وما بعدها لبث شفرات عسكرية ورسائل حركية موجهة، فكيف هو الحال مع وسائل الاعلام الحالية الأكثر تطورا بالصوت والصورة..
لقد تشكلت قنوات فضائية عربية ذات زوايا إرسال عالمية تغطي أكبر مساحة من سطح الأرض، ومواقع ألكترونية عديدة عقب أحداث سبتمبر، أبرزها قناة الجزيرة في قطر قبل الغزو الأمريكي لأفغانستان، وقناة الحرة قبل غزو العراق. والمادة الرئيسية هي التغطية السريعة والشاملة لأحداث الغزو والاضطراب الطارئة. وبلغة الاعلام، القيام بتوجية حركة الرأي العام عبر أساليب التوجيه النفسي والفكري للمستهلك. بل أن نجاح هذه القناة وتلك وحجم استقبالها الجماهيري، يرتبط بمستوى الخراب النفسي والتشرذم والتخلف الفكري الذي يسود حياة العرب اليوم. ومن غير دراسة أثر ودور وسائل الأعلام المميزة، تلك، لا يمكن استكناه أسباب كثير من المظاهر المستعصية اليوم.
الحاصل.. أن الأحداث السالفة أثبتت بما لا يقبل الشك، عدم وجود صحافة عربية معتبَرة، علمية حيادية وموضوعية، في خضم الضياع والفوضى الراهنة.. وإذا كان هذا حال الصحافة والفضائيات، فما حال الدول عربية أو اسلامية أو مجاورة؟..
*
لا عنف بلا مقدس
في كتابه (الانسان والمقدّس)* يرى روجي كايوا في الاحتفالات الطقوسية صورة الحرب، حالة إفراط وتجاوز تبذر فيها مخزونات تراكمت على امتداد سنين، تنتهك فيها القوانين الأشدّ قداسة. جريمة الأمس تصبح من قبيل الأوامر والتعليمات، وحالة من النشوة والتهوّس تتملك الجميع فتتعطل السلطات المدنية في صالح ممثلي العالم الآخر، عالم العظمة والقوة.
ويشخص ظاهرة "الذوبان في الديني" و " الطاعة اللامشروطة لأوامره" بحيث يبدو الدين صنوا للقوة والرهبة والعظمة. فصلاة الجماعة مثلها مثل الاحتفال والحرب (التعداد العسكري) معايشة لما يتجاوز الذات، وحالة نسيان الفردية التي تنتهي لها. القشعريرة التي تنتاب البعض وهو يستمع لترتيل القرآن ليست بعيدة عن تلك التي تنتاب الجندي أمام النشيد الوطني ومختلف تقنيات الشحن. حالة المشاركة في صلاة جماهعية، والتي شاعت كثيرا بشكل غير مسبوق، تفعل باتجاهين، اولاً: ترسيخ الكراهية ونزعة الانتقام ضد الآخر. وثانيا: استثارة الحماسة ورفع معدل الثقة والاعتداد بالذات، حين تنتظم صفوف صلاة طويلة ومتعددة. ان تنظيم اسلوب الوقوف للصلاة انما هو نفس اسلوب تنظيم صفوف الكردوس العسكري في التعداد والدرس. وقد تكررت أحداث عنف متعددة عقب الخروج من صلاة الجمعة للاقتصاص من (الكفار) وأعداء (الاسلام).
*
لقد شكلت هزيمة 1967 هزيمة للوعي العربي، دفعت البعض للتشبث ومراجعة حساباته، الهزيمة القومية حفزت الوعي الديني، وجاءت الثورة الاسلامية في ايران لتوقد جذوة الشعور الكامن، مما صبغ المرحلة التالية بصبغته، واستطاعت جمع مختلف أطياف فسيفساء الاسلام في إطاره. قد تختلف القراءات، ولكن الموضوع الديني يسجل حضوره في غير مكان ، ويتصدر واجهات حوارية وسلوكية ناهيك عن آثارها المباشرة داخل العائلة العربية في غير بلد. وهنا كان للفضائيات والصحافة دور طيب في نقل الخدمة والدعاية. ويمكن تأشير ثلاث خصائص للمرحلة..
- تراجع دور المثقف والعلمانية..
- رواج التسطح الثقافي وأنصاف المثقفين..
- تصدر العنف في الواجهات الاجتماعية والسياسية..
ان لكل حركة أو ظاهرة معينا تصدر عنه وتقوت منه، فما هو المعين الذي تستقي منه حركات العنف مدادها..
هل كان لتلك الحركات الازدهار والرواج والنجاح بدون مصادر نظرية ومالية وعسكرية..
لم يبخل شيوخ جامعة الأزهر باجتهاداتهم القيمة لشرعنة العنف، ما ساعد لجنة الافتاء في الرياض لمنافستها، ولولا اندلاق ألسنة العنف في جامعة عين شمس وغيرها وتخلخل الجدار الأمني السعودي ما انكمش الشيوخ عن الترويج للعنف المقدس..
فما هي المصادر التي استند اليها أولئك الشيوخ في فتاوي العنف وفرضه..
هل كان لكل ذلك العنف ان يندلق لولا توفر مصادر نظرية ملزمة..؟..
لماذا يجوز استخدام تلك النصوص ضد الآخر (الخارج) ولا يجوز تعميمها على الكل بضمنها (الداخل)؟.. إلى أي حد يمكن تسويغ الانتقائية في الفكر والتطبيق والسياسة؟..
*
عنف و عولمة..
لعبت ظروف الهجرة وتقدم وسائل الاتصال الفضائي والالكتروني دورا مساعدا في عولمة العنف ونقله عبر القارات.. سواء على صعيد التبشير والاستقطاب أم العمليات اللاحقة له..
وقد شهدت عواصم ومطارات معينة خلال أحداث العراق نشاطا مكوكيا ساخنا في حركة نقل غير رسمي، فاستقبلت لندن أمواجا من البشر من جهات متعددة، في طريقهم إلى الشرق الأوسط، وفي عملية (Feedback) مدهشة عادت لاستقبال أعداد من العائدين ومنحتهم تأشيرة لجوء. كما لعبت دمشق ذات الدور في حركة السياحة العنفية من وإلى داخل العراق. وهكذا تكاملت منظومة نقل جيوبولتيكية لخدمة مشروع الدعم اللوجستي المساعد للغزو العسكري المباشر. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت حاجتها لتجنيد أعداد من المتحدثين بلغة البلاد لدعم قواتها ولم تذهب خالية الوفاض. لندن وحواضر غربية أخرى تمثل مراكز آمنة لاحتضان أعداد من الجلادين وأعداد من الضحايا ممن كتب له الخروج من هناك. وثمة.. ان أعمق مشهد في التراجيديا العراقية هو السريالزم، اجتماع الأضداد، أو الأخوة الأعداء.
*
لندن
في العشرين من مارس 2009
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• الانسان والمقدس – تأليف مشترك- منشورات العربية محمد علي الحامي للنشر والتوزيع- تونس- صفاقس- ط1- 1994- والتضمين من ص79.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
التعليقات
1 - المقدس
هاوزين الخياط
(
2009 / 3 / 31 - 13:59
)
المقدس والدين وجهان للعملة واحدة الله هو العنف ومصدره واحد
.. المحكمة العليا الإسرائيلية تبدأ النظر في تجنيد -اليهود المتش

.. الشرطة الإسرائيلية تعتدي على اليهود الحريديم بعد خروجهم في ت

.. 86-Ali-Imran

.. 87-Ali-Imran

.. 93-Ali-Imran
