الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
الاسلام والعلمانية
عبد الاله إصباح
2010 / 4 / 3العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
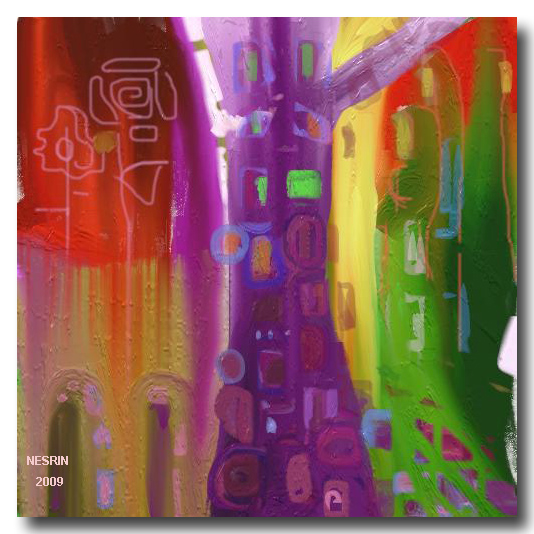
تندرج العلاقة بين الإسلام والعلمانية ضمن الإشكاليات التي واجهها ويواجهها الفكر العربي الحديث والمعاصر، باعتبارها إحدى القضايا الرئيسية التي تجعل الإسلام يواجه ذاته من منطلق إخضاع ثوابته لسؤال النقد ومقتضيات التحليل والتفكيك. ولذلك فالإسلام هنا بقدر ما هو ذات جماعية تواجه تحدي المتغيرات والتطورات، بقدر ما هو أيضا موضوع لأسئلة هذه المتغيرات والتطورات ذاتها. غير أن الإسلام كذات جماعية لا تعني بالضرورة وحدة في الفهم والرؤية. فهذه الذات أخفت وتخفي في وحدتها الظاهرية انقساما وتعددا استعصى على كل إرادة في التوحيد القسري منذ وفاة الرسول على الأقل إلى يومنا هذا، وهكذا تعددت أجوبة الإسلام دوما اتجاه المتغيرات والتطورات على الرغم من السعي الدائم إلى تهميش أو إقصاء مجموعة من هذه الأجوبة لصالح جواب واحد مرتبط بالجهة التي تحقق الانتصار في ميدان الصراع وتحتكر تمثيل الإسلام والنطق باسمه وباسم حقيقته، وهو ما ترتب عنه تضييق نطاق التنوع إلى حد قتل الإبداع لفائدة التقليد والإتباع. ولذلك فإن طرح إشكال الإسلام والعلمانية، يستهدف كسر دائرة الجمود التي عاقت وتعيق انبثاق أسئلة جديدة، وتروم النظر إلى الإسلام من زاوية الحاجة إلى تأهيل ذاتنا الجماعية لتكون قادرة على التلاؤم مع مقتضيات ومنطق عصرنا الراهن، دون تنابذ أو تنافر. وهذا يعني جعل الإسلام يطرح على ذاته الأسئلة الضرورية الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في النظر إلى الذات والآخر، نقلة تتجاوز الاستكانة إلى ما أصبح يشكل بديهيات بفعل عدم التعود على التفكير من منظور مخالف. لقد استمر النظر إلى الذات مرتهنا إلى زاوية نظر واحدة أصبحت معها الحقيقة ذات بعد واحد ووحيد. صحيح أنه على طول التاريخ الإسلامي، كانت هناك محاولات جادة لإرساء منطلقات مخالفة في التفكير، غير أن مآلها كان هو الانزواء، حتى كأنها لم توجد لعدم ممارستها أي تأثير في آليات إنتاج الخطاب السائد حول حقيقة الذات وحقيقة الآخر. ولقد ازداد مجال التنميط والتقليد في إنتاج الخطاب الإسلامي بالموازاة مع التدهور العام الذي أخد يصيب جسد الإمبراطورية الإسلامية، ولما بلغ هذا التدهور أوجه انغلقت آلية إنتاج الفكر لتصبح مجرد تكرار وترديد لما أنتجه السلف، والدوران في فلكه، مما ضخم في حجم الحواشي حول مثن هو في الأصل ضحل وفقير. استمر النظر إذن إلى الذات بوثيرة من الزهو والاطمئنان، إلى أن اصطدمت بواقع جديد تمثل في التحول الثوري الذي طرأ على الآخر، وجعله قادرا على اقتحام قلاع هذه الذات وزلزلة كيانها، بفعل قوته ومنجزاته العلمية والحضارية. لقد استفاقت الذات إذن مبهورة ومصدومة من هول ما اكتشفته من حجم التغير والتحولات التي عرفها هذا الآخر، فوقفت على حقيقتها المرعبة كذات بقيت محنطة في قوالب الثبات والجمود. وفي هذه اللحظة التاريخية، لحظة إدراك الفارق بين الأنا والآخر، بدأ إنتاج أسئلة جديدة انصبت أول ما انصبت على تحديد معنى الذات ومعنى الآخر. وهكذا انصرف التفكير في الذات إلى تحديد خصائصها وثوابتها، وكذا علائقها بمجموعة من المفاهيم والتصورات والقضايا التي ارتبطت بطبيعة الدولة والمجتمع، واستدعت سجالا ونقاشا في الأوساط الفكرية والثقافية من قبيل حرية المرأة، الديمقراطية، العلمانية، التقدم... وغيرها من القضايا والإشكالات. ولاشك أن موضوع العلمانية هو الذي يحظى بنظرة خاصة مرتبطة بمجموع ما يوحي به ويحيل إليه. ولذلك اتسم النقاش حوله بالحدة والتوتر، وكثيرا ما أدى إلى نوع من التشنج في العلاقة بين أطراف النخبة. ولا غرابة في ذلك، ما دام هذا المفهوم يحيل إلى كثافة حضور الآخر إلى درجة إحساس جزء ممن يمثل الذات بأنه مستهدف في كيانه وجوهره كلما استدعي هذا المفهوم إلى دائرة السجال والمطارحة الفكرية. والحق أن مفهوم العلمانية يطرح أمام الذات الإسلامية مجموعة من التحديات ذات العلاقة بتحديد مرجعية كيان الدولة الإسلامية، بمعنى هل هذا الكيان استمد مقومات قيامه فعلا من النص القرآني، أم أن هذه المقومات ارتبطت بشروط سياق لحظة تاريخية هي التي تحكمت في تعيين وتحديد تلك المقومات. لا شك أن جوهر هذه الأسئلة يضع على المحك طبيعة وحقيقة حقبة تاريخية بكاملها اعتبرت دوما على ارتباط وثيق بحقيقة وجوهر الإسلام، وهاهي مع سؤال العلمانية تجد نفسها أضحت موضوعا لمجموعة من الإستفهامات التي تزحزح وضعها المرجعي. استفهامات انصبت على تعيين حدود علاقة هذه المرحلة بالإسلام من خلال سؤال جوهري، مؤداه: هل الإسلام دين أم دولة؟ أم أنه يجمع في ذاته بين الأمرين معا ؟. ولا شك أن التنظير لما يسمى الخلافة الإسلامية ارتكز على إثبات جانب الدولة في الإسلام، وضخم من حضور هذا الجانب، حتى أضحى التلازم بين الدولة والدعوة فيه أمرا محسوما وغير قابل للنقاش، بل أصبح نقاشه محرما يعرض كل من تجرأ على ذلك إلى خطر التكفير والوصف بالردة والخروج عن الملة. وليس من الصعب إدراك الغاية من إضفاء الطابع الإسلامي على جميع الدول والإمارات التي تعاقدت على الحكم طيلة الفترة التاريخية الممتدة من الخلفاء الراشدين إلى انهيار الإمبراطورية العثمانية. ذلك أن الاستناد إلى الإسلام تحول إلى آلية أساسية في الفكر السياسي المرتبط بهذه الفترة. وإذا كان من الطبيعي أن نمط الحكم في جميع هذه الدول لم يكن ديمقراطيا اعتبارا للشروط التاريخية للمرحلة التي تجعل الديمقراطية تندرج ضمن اللامفكر فيه، فإن طابع الاستبداد وسمة التيوقراطية كمعززة لهذا الطابع، أصبحت تجد لها سندا دوما في الارتباط بالإسلام. وقد تعزز هذا الربط بفعل تراكم مجموعة من الإنتاجات المرتبطة بتراث الآداب السلطانية، وهي إنتاجات استهدفت الدفاع عن الطابع التيوقراطي الاستبدادي لنمط الدولة الإسلامية. وكان أول ما اصطدمت به العلمانية هو ثقل حضور هذه الأدبيات في العقل السياسي العربي، الأمر الذي استدعى إنجاز حفريات معرفية أساسية لإزاحة ما تراكم من طبقات هذا التراث الاستبدادي على العقل العربي.
ومن هنا يتسم الدور الذي تقوم به العلمانية بطابعين أساسين، إيديولوجي ومعرفي. الطابع الاديولوجي يتجلى في التبشير بنمط جديد للدولة، هو الدولة الديمقراطية التي ينتفي فيها الطابع التيوقراطي الاستبدادي الذي لزم ما يسمى بالدولة الإسلامية. أما الطابع المعرفي، وإن كان لا ينفصل عن الطابع الأول الإيديولوجي، فإنه اتصف بسعيه تجديد البحث في تاريخ الإسلام انطلاقا من أسئلة جديدة، منطلقها مناهج البحث التاريخي التي لا تستكين إلى ما تحول بفعل الهيمنة الاديولوجية إلى حقيقة وبداهة غير قابلة للنقاش والمراجعة.
وهكذا تم إخضاع شخصيات وأحداث تاريخية لمقتضيات البحث العلمي التاريخي، وتم تسليط أضواء كاشفة على زوايا معتمة فيها، انكشفت على حقائق جديدة أو مغايرة تزيح ما ارتبط بها من طابع القداسة، لأنها ظهرت بفعل ذلك البحث على حقيقتها التي لا تعلو على القوانين المتحكمة في البشر سواء كأفراد أو كجماعات، خاصة في لحظات انقسامهم وصراعهم على النفوذ والسلطة. وكان الانكباب على دراسة حروب الردة والفتنة الكبرى يستهدف بالضبط إبراز ما تحكم فيها من دوافع سياسية تم تغليفها بطابع ديني لإخفاء تلك الدوافع، ولجعل التعبئة فيها تتم على أساس الدين، بينما كان الصراع السياسي هو محركها الأول والأساسي.
لقد أخذت العلمانية على عاتقها كاتجاه فكري، أن تحدد في هذه الأحداث الشروط والعوامل التي أدت إلى أن يصطبغ الصراع السياسي دوما بالصبغة الدينية، الأمر الذي جعل الدين يكتسي حضورا وازنا في الجهاز الإيديولوجي للدول المتعاقبة، وفي البنية المتحكمة في إنتاج الفكر السياسي لهذه المرحلة. لقد أظهرت العلمانية أن التلازم بين الديني والسياسي في الإسلام، تحكمت فيه شروط وملابسات تاريخية، وهو تلازم ليس بالضرورة مطابق لجوهر الإسلام، خاصة وأن النص القرآني لم يرد فيه ما ينص على ضرورة هذا التلازم، وبالضبط في الجانب المتعلق بطبيعة الدولة ونمطها. وهذا معناه أن الإسلام لم يكن في الأصل نظرية سياسية، وأن السياسة وهواجس السلطة ارتبطت به وأقحم في خضمها بعد وفاة الرسول، أي عند الشروع الفعلي في تأسيس دولة الخلافة. ولقد تكفل منظرو هذه الدولة فيما بعد ببناء "نظرية سياسية" ادعت ارتكازها على الإسلام وثوابته، وأدت وظيفة التبرير الإيديولوجي لهذه الدولة.
على أن جهد العلمانية لم يقتصر فقط على نقد وتحليل الشروط التي أدت إلى اصطباغ الإسلام بالصبغة السياسية، بل انصرف نظرها أيضا إلى فترة تبلور الدعوة الإسلامية في عهد الرسول، بتسليط الضوء على طبيعة الصراعات التي خاضتها هذه الدعوة والآليات التي وظفتها لتكريس خطابها ومجابهة الخطابات السائدة آنذاك. ورغم حساسية هذه المرحلة وثقل وزنها الرمزي في الوعي الجمعي للمسلمين، فقد أخذت العلمانية على عاتقها تحمل مسؤولية مقتضيات البحث العلمي في هذا المجال، وما يترتب عنه من تضحيات جسام هي الثمن الضروري الذي لا بد أن يؤديه كل باحث طرح أسئلة العقل على مرحلة زاخرة بالقداسة. وهنا تتجاوز العلمانية مجرد كونها فصلا بين المجال الديني والمجال السياسي، لتصبح مرتبطة بسؤال مصدر المعرفة، أي تتجلى في العمق كموقف إبستيمولوجي قبل كل شيء، يربط المعرفة بمصدر وحيد هو العقل أولا وأخيرا. واستنادا على هذا العقل، أصبح مفهوم الإسلام ذاته موضع تساؤل من جديد يرمي إلى مراجعة ما تراكم بصدده من مفاهيم وتصورات وإخضاعها لمنظور الملاءمة والراهنية. بل إن النص القرآني أصبح هو أيضا موضوعا للتحليل والتفكيك وإعادة البناء، بطرح مجموعة من الأسئلة المتعلقة بمفهومه كوحي، وربط هذا المفهوم بالشرط الثقافي العام الذي وسم مرحلة تأسسه، فضلا عن طرح أسئلة أخرى متعلقة بترتيب آياته بناء على مجموعة من المعايير كوحدة موضوع الآيات وتسلسلها التاريخي، وغير ذلك من الاعتبارات.
ومن البديهي القول بأن العلمانية وهي تتوسل مقاربة جديدة للإسلام ولنصه التأسيسي، تحدث صدمة قوية في الوعي الجمعي، ولكنها صدمة ضرورية لابد منها لكي يتعود هذا الوعي على تقبل أسئلة جديدة، تجعله في مواجهة ذاته التي استكانت إلى بديهيات أصبحت تشكل عائقا معرفيا أمام انبثاق حقائق ومعارف أخرى مواكبة لتطورات ومستجدات العصر.
والواقع أنه لا سبيل إلى اندراجنا فيما هو كوني، إلا عندما يؤسس الإسلام علاقته بالمنجز الفكري والعلمي والحضاري للآخر، على أنه طموح ينبغي السعي إليه لكي يصبح جزءا من هويتنا الجماعية منسجمة تمام الانسجام مع كياننا كذات دون تشنج أو توتر يجعلنا على الهامش في هذه الحضارة وهذا العالم.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. 134-An-Nisa

.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلزم اليهود المتدينين بأداء الخدم

.. عبد الباسط حمودة: ثورة 30 يونيو هدية من الله للخلاص من كابوس

.. اليهود المتشددون يشعلون إسرائيل ونتنياهو يهرب للجبهة الشمالي

.. بعد قرار المحكمة العليا تجنيد الحريديم .. يهودي متشدد: إذا س
