الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
الاسلام و علوم الاجتماع : محاولة في الدفاع عن العلم ضد -المنظور الثقافي الاسلامي- عند الدكتور محمود الذوادي (2)
بيرم ناجي
2012 / 7 / 27العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
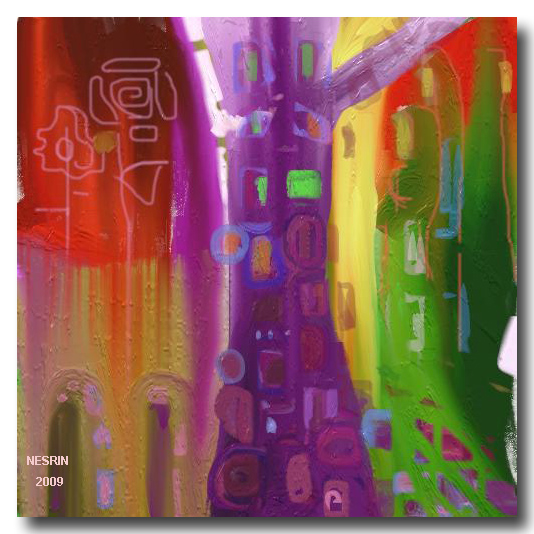
الفصل الثاني؛ حول مقال "في أبجدية الرموز الثقافية من أجل تفسير أدق للقضايا الهامة"
1: حول" مشروعية البحث في الرموز الثقافية":
عندما نشر الدكتور محمود الذوادي بحثه " في أبجدية الرموز الثقافية، من أجل تفسير أدق للقضايا الهامة" في مجلة " الآداب"، بدأ بفقرة عنونها: " في مشروعية البحث في الرموز الثقافية". وعرفنا أنه بدأ البحث حول " الرموز الثقافية" بداية 1990. ثم أضاف أنه وجد نفسه يبحث " عما يسميه عديد العلماء اليوم الرجوع إلى أساسيات الأشياء" ( م2 ؛ الآداب ، ص8).
وترتبط هذه الفكرة بما كتبه أيضا في ندائه المنشور في " عالم الفكر"، فهي تحتوي على عبارة "الرجوع" التي لها علاقة مع " تأصيل" علم الاجتماع، كما أنها ترتبط بفكرة " البحث العلمي الأساسي" الذي يكتشف " العامل الأساسي " الذي يعتقد الدكتور أنه بواسطته يقدم " باراديغما جديدا" في علم الاجتماع.
يفترض، إذن أن يبدأ الدكتور في تقديم تعريفات واضحة " للرموز الثقافية" انطلاقا من أرضية علم الاجتماع تحديدا، والعلوم الإنسانية والاجتماعية عموما. يفترض أن يعرفنا بمعنى الثقافة ومعنى الرمز حتى نبدأ معه فعليا في معرفة " أبجدية الرموز الثقافية" ونفهم معه " تفسيره الأدق للقضايا الهامة".
كتب الدكتور ما يلي: " الرموز الثقافية أو الثقافة أو المنظومة الثقافية ( اللغة والفكر والدين والمعرفة والقيم والأعراف الثقافية والقوانين والأساطير) هي أكبر صفة مميزة للجنس البشري عن سواه من الأجناس الحية الأخرى، وهي أيضا العناصر الحاسمة التي أهلت الجنس البشري وحده للفوز بمقاليد السيادة والخلافة في هذا الكون" (الاداب ص8).
إذن، نحن أمام تعريف للرموز الثقافية فيه مكونات " الرموز" وأهميتها ووصف لها بأنها عنصر حاسم. و هذا التعريف أقرب إلى الجرد الوصفي منه إلى التعريف العلمي لأنه يكاد يكتفي بعرض مكونات الثقافة، وعندما يضيف إلى الجرد عبارات "العناصر الحاسمة" و"الخلافة" يتحول الى تعريف ديني لها و لا يصبح تعريفا سوسيولوجيا.
إن التعريف ـ الجرد، إضافة إلى طابعه الوصفي، سرعان ما يطرح مشاكل علمية عندما نهمل أحدى مكونات الظاهرة الثقافية أما التعريف العلمي السوسيو ـ انتروبولوجي فحتى لو نسي عنصرا من العناصر يكون قادرا على استيعابه. إن تعريف تايلور مثلا لا يذكر اللغة لكنه يمكن أن يحويه لأنه يضيف إلى العناصر التي ذكرها عبارة « جميع الامكانات و العادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان كعضو في مجتمع معين".
من ناحية أخرى، يستدعي هذا " التعريف" الملاحظات التالية؛
أولا: لا يفرق الدكتور بين عبارات " الرموز الثقافية" و " الثقافة" والمنظومة الثقافية" في جملته " الرموز الثقافية أو الثقافة أو المنظومة الثقافية هي أكبر صفة مميزة للجنس البشري"، في حين كان لا بد من مزيد من التدقيق، إذ ليست كل هذه المصطلحات متساوية، فمصطلح " الثقافة" العام، لا يساوي مصطلح " الرموز الثقافية" الذي يشير إلى الجانب الرمزي في الثقافة، دون أن يحويها كاملة، فهنالك من الثقافة ما هو غير رمزي، سواء أخذنا الثقافة بمعناها العام جدا، أى بمعنى الحضارة، أو حتى إذا ضيّقنا تعريفها بشدة " ثقافوية".
فإذا كان تعريفنا للثقافة معادلا للحضارة تقريبا، فمن البديهي أن من عناصرها ما هو غير رمزي حسب "المعنى الرموزى" عند الدكتور، مثل التقنية...( م29) و هذا لا ينفي تحول بعض التقنيات إلى رموز مثل الميزان كرمز للعدالة...( م30).
وحتى إذا ضيقنا تعريف الثقافة إلى ما هو فكري، مثلما يبدو أن الدكتور يريد، فإنه من الضروري مثلا التفريق، من ناحية أولى، بين العلامة والإشارة والرمز، وبالتالي تجنب التعميم القائل بأن " الثقافة تساوي الرموز الثقافية" رغم أهمية الجانب الرمزي في الثقافة. ( م 04 ، ص ص139ـ142) .
من ناحية ثانية و عند دراسة اللغة مثلا لا بد من التفريق، كما دعانا بيار بورد يو الذي يقول الدكتور أنه يتفق معه حول علم الاجتماع النقدي ، بين الجوانب المعرفية و التواصلية و الرمزية في اللغة .
كذلك، لا بد من التدقيق في المساواة بين عبارتي " الثقافة" من ناحية و " المنظومة الثقافية" التي تعني بدقة شديدة الجانب المنظم، النسقي في الثقافة، أي الثقافة نسقا. هذا إذا فهمنا عبارة منظومة بمعنى نسق أو نظام.
إن معنى " المنظومة الثقافية" يشير إلى الوجه أو البعد " المنظوم" للثقافة وليس " الثقافة" بمعناها العام. كما أن مصطلح "النظام الثقافي" لا يعني بالضرورة وجود علاقات بين كل عناصر الثقافة، ليس فقط كما قد تدل عليه عبارة "المنظومة الشمسية " مثلا، بل حتى عبارة "النظام الاجتماعي " وهذا بسبب شدة حضور العامل الذاتي في تمثل الثقافة كنظام. (م4، ـصص142ـ143) هذا طبعا إذا عرفنا النظام انطلاقا من "نظرية التعقيد" التي يدعونا الدكتور إلى تبنيها و كذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار خصوصية النظام الثقافي بوصفه أشد المنظومات تعقيدا ربما.
ثانيا: يأخذ الدكتور بهذا التعريف موقف الذين يفصلون على ما يبدو بين الثقافة والحضارة. وهذا ممكن طبعا من الناحية النظرية، على شرط الالتزام فعليا في التحليل، وهو ما لن يفعله الدكتور كما سنبين لاحقا، وعلى شرط عدم الوقوع في نزعة ثقافوية، كرد فعل على " الاقتصادوية" أو " النزعة البيولوجية". ولكن كتب الدكتور في هامش الصفحة الحادية عشرة، في مقال " أبجدية الرموز"، إنه يفضل؛ " استعمال كلمة " الثقافات " بدل " الحضارات" في تحليل مسألة الحوار أو الصدام بين الأمم والمجتمعات: إذ إن الثقافات هي المؤسسة للحضارات وتجلياتها، بما فيها القدرة على الحوار والصّدام مع الآخر" (ص11). في حين أنه يدعى تبني تعريف تايلورالذي لا يفرق بين الحضارة والثقافة.
ثالثا: حتى داخل الثقافة، بمعناها الضيق ( منتجات الفكر)، يتجاهل التعريف الذي قدمه الدكتور عنصرا هاما هو الفن ، أو الفنون عموما.
فإذا كان الدكتور يقصي " العمل" مثلا من تعريف الثقافة، لأنه يميزها عن الحضارة، فكيف يتجاهل الفن ضمن " الرموز الثقافية". وقد لاحظنا إقصاء الفن حتى في مقال " نداء من أجل تأصيل علم الاجتماع" في مجلة " عالم الفكر" رغم استشهاد الدكتور بأم كلثوم و الشابي..
رابعا: عندما يقول الدكتور أن الثقافة ( الرموز الثقافية، المنظومة الثقافية) هي " أكبر صفة مميزة للجنس البشري" يتأكد لنا التصور " الثقافوي" عنده. فعلم الاجتماع و الانثربولوجيا، عندما يؤكدان أن الإنسان يتميز بالثقافة، يعنيان بالثقافة وقتها مصطلح الحضارة بمعناه العام وليس الثقافة بمعناها الضيق الفكري فقط.
وعندما يضيق الدكتور تعريفه للثقافة ثم يقول إن الثقافة ، الضيقة المعنى هذه ، هي ميزة الإنسان ، فإنه يتجاهل مثلا، العمل ودوره في تميز الإنسان، إضافة إلى كل عناصر الاجتماع البشري الأخرى وكذلك دور الخصائص البيوفيزيولوجية في تميزه.
خامسا: عندما يحدد الدكتور الإنسان بميزة " الرموز الثقافية" بمعناها الضيق الذي ذكره، فإنه يبتعد عن الفكرة الأساسية التي توجّه علم الاجتماع باعتبار الإنسان كائنا " اجتماعيا" أو " مدنيا بطبعه" حسب التعبير الخلدوني. ففي الهامش الأول الذي ذكرناه في الصفحة الحادية عشرة من "الآداب"، يذكر الدكتور مصطلحات " الثقافات" و " الحضارات" وكذلك " الحوار أو الصدام بين الأمم والمجتمعات"، ولكنه لا يحدد الإنسان بكونه كائنا اجتماعيا، بل بكونه كائنا " رموزيا"، وكان بامكانه أن يعرفه ككائن اجتماعي تاريخي على " معنى " "الظاهرة الاجتماعية الكلية" التي سبق أن دعانا إلى قبولها.
سادسا: يقدم الدكتور الكائن الإنساني على أنه يتميز بالرموز الثقافية، التي هي " عناصر حاسمة" في الفوز بمقاليد السلطة والخلافة" (ص8) بمعناها الديني، أي خلافة الله على الأرض. وهنا يدمج الدكتور علم الاجتماع بتصوره الخاص عن الدين بشكل قد يضر الدين و، بالتأكيد يضر، بالعلم في نفس الوقت .
بهذا التصور، و من الناحية الدينية، لا قيمة لعملية "التسوية الإلهية" لآدم من قبل الله ولا لعملية " تعليم البيان"...في الفوز بالخلافة. إن الدكتور يطبق السببية الأحادية حتى على أفعال الله دون أي دليل لا علمي ولا ديني على ذلك .
إن المشكل مع الدكتور يعود بالتالي إلى عدم توضيحه لما يسميه " أبجدية الرموز الثقافية " ، و يتأكد الأمر عندما نقرأ ما يلي ؛ " بالنظر المتعمق إلى جوهر طبيعة الرموز الثقافية عند الجنس البشري تبين أنها تتسم بلمسات غير مادية / متعالية/ ميتافيزيقية تجعلها تختلف عن صفات مكونات الجسم البشري و عالم المادة " ( ص8).
هكذا إذن، بما أن الرموز مخالفة للمادة و للجسم فالرمز لا يمكن أن يكون ماديا و لا جسميا، بشريا و./ أو غير بشري.
من ناحية أخرى، يبدو أن العالم بالنسبة إلى الدكتور هو مادة و جسم و روح / رموز و لا مجال للحديث عن الممارسات أو الأ فعال البشرية.
بهذه الصورة، نفهم لماذا يكتفي الدكتور في كل تعريفاته " للرموز الثقافية" بالقول إنها " اللغة و الفكر و الدين و المعرفة و القيم و الأعراف الثقافية و القوانين و الأساطير " ( ص 8) .
إن للدكتور تعريفا ثقافويا للرموز، فهي عنده " رموز ثقافية" بالمعنى الفكري لعبارة ثقافة و ليست رموزا اجتماعية عامة أو ثقافية بالمعنى الانتروبولوجي العام أي حضارية.
و إذا عدنا الآن إلى التعريف الأكثر أبجدية للرمو ز نقرأ ما يلي على سبيل المثال؛
" ان الطريقة الأكثر بساطة في تعريف الرمز هي القول انه " شيء ما يحتل مكان شيء آخر" أو القول كذلك انه " شيء ما يحل محل شيء آخر و يستدعيه" ( ...) إن الرمز يتطلب ثلاثة عناصر ـ1ـ دال ، وهو الشيء الذي يحل محل شيء آخر، أي الرمز نفسه بالمعنى الدقيق و الملموس للكلمة. ـ2ـ و مدلول، وهو الشيء الذي يحل الدال مكانه. ـ3ـ الدلالة، وهي العلاقة ما بين الدال و المدلول، علاقة ينبغي لها أن تدرك و تفسر على الأقل من قبل الشخص أو الأشخاص الذين يتوجه الرمز اليهم . ( ...) و هذا ما يستدعي حينئذ ضرورة وجود عنصر رابع للرمزية، وهو وجود اصطلاح محدد للعلاقة بين الدال و المدلول.." (غي روشيه، م 4 ، ص 107)
إن غي روشيه يدرس مسألة الرمز ضمن علاقته بالفعل الاجتماعي وليس بالفعل الثقافي ـ الفكري الضيق. و بهذا المعنى تتعامل العلوم الإنسانية مع مسألة الرمز داخل إطار الحقل الاجتماعي العام و ليس داخل الحقل الثقافي بمعناه الفكري الضيق.
بهذه الطريقة نفهم الطابع الأبجدي للقول بأن الرموز ليست بالضرورة ميتافيزيقية.
إن تمثال الجندي المجهول رمز للتضحية في سبيل الوطن و ان العلم رمز للوطن و هما مادتان جامدتان.
إن الحمامة رمز للسلام و الأسد رمز للقوة و النظام و هما جسدان لحيوانين.
إن الشوارب قد تكون رمزا للرجولة و هي من الجسد البشري.
إن العنقاء رمز للانبعاث و الصمود و هي كائن خيالي من صنع المخيال العربي.
إن الرموز بهذا المعنى الأبجدي العام يرفضها الدكتور الذوادي لأنها تتعارض مع تصوراته الميتافيزيقية الإسلامية المزعومة التي يلح فيها على المماهاة بين مصطلح الثقافة في علم الاجتماع و التصور الديني عن الروح.
إن الرموز تصبح ميتافيزيقية على عكس المادة و الجسد. إنها ليست رموزا اجتماعية مرتبطة بالفعل الاجتماعي الذي هو بالتأكيد " غارق كليا و باستمرار في الرمزية و انه يعمد إلى الرموز بطرق متعددة و هو كذلك مدفوع و مصوغ في آن معا، من قبل مختلف أنواع الرموز " ( غ روشيه ، م4 ، ص106-107)
إن الفرق بين "علم الاجتماع الغربي " و" علم الاجتماع الإسلامي" واضح هنا بل و له دلالات رمزية كبيرة أيضا ، مع الأسف الشديد .
2ـ في تعريف الإنسان و حول" المعالم الخمسة للرموز الثقافية":
كتب الدكتور أن " الملاحظة البسيطة " تفيد أن أفراد الجنس البشري يتميزون وينفردون بخاصيتين هما:
- بطء النمو والنضج البيولوجي.
- طول مدى الحياة مقارنة بـ" الأغلبية الساحقة للأجناس الأخرى" (ص8).
وهذا صحيح نسبيا، وقد وردت بعض هذه الأفكار في عدة دراسات حديثة لتنضاف إلى أفكار أخرى كان ابن خلدون قدمها حول " العجز عن تلبية القوت" وحول " الضعف الجسدي" و " الحاجة إلى الحماية" وكذلك ما تمّ تقديمه حول احتمال " توحش الإنسان" في صورة عزله عن المجتمع منذ طفولته الأولى، هذا طبعا عندما يحالفه الحظ في الحياة. ( م 31 )
إن فكرة طول طفولة الجنس البشري مثلا، تحدث عنها ديزموند موريس في كتابه " القرد العاري؛ (.م32) ليدلل بها على اجتماعية الإنسان وليفسر بها مثلا، سبب ظهور التقسيم الجنسي للعمل بين الرجل والمرأة، بل وحتى سبب " تحرر الأيدي" البشرية من وظيفة المشي نظرا لاستعمالها في حمل الطفل البشري ـ طويل الطفولة ـ وحمايته ، خاصة عند النساء .
المهم، نريد أن ننبه إلى أن هذه المسألة ليست مجرد " ملاحظة بسيطة" قام بها الدكتور.
إن هذه الفكرة هي نتيجة لملاحظات علمية مقارنة قام بها علماء الحيوان والإنسان، هذا أولا.
أما ثانيا، وهذا هو الأهم، فإن فكرة " طول طفولة الإنسان" مثلا، التي تحدّث عنها صاحب كتاب " القرد العاري" تختلف نسبيا عن فكرة طول حياته العامة. ان عبارة " الأغلبية الساحقة" التي يذكرها الدكتور لا تحل المشكل لأن بعض الحيوانات من البرمائيات، و خاصة السلاحف تعيش أكثر من الإنسان. لكن نترك الدكتور يوضح الفكرة أكثر.
يكتب الدكتور ما يلي: " ولتفسير ذلك يتطلب الأمر طرح فرضية واقعية ثم التحقق من مدى مشروعية مصداقيتها. وأول فرضية واقعية تتبادر إلى الذهن في هذا الصدد هي أن الرموز الثقافية تشكل العامل الحاسم في كل من بطء النمو البيولوجي والفيزيولوجي، وإطالة مدى الحياة عند أفراد الجنس البشري" (ص8).
وماذا يقول حول " التحقق من هذه الفرضية؟
يجيب إن الرموز هي فعلا العامل الحاسم لأن " الكائن البشري" هو كائن ثقافي بالطبع"(ص8) و لأنه حسب الدكتور: " يتضح أن إطالة مدى حياة الإنسان هي التي تعطي الفرصة لكسب رهان النمو والنضج في أثمن ما يملكه البشر وفي أكثر ما يميزهم عن الأجناس الأخرى ويشعرهم بإنسانيهم ألا وهي الرموز الثقافية" (ص8).
إن الطريقة التي طرح بها الدكتور " فرضيته"، موهما إيانا أنها تمت بعد " ملاحظة بسيطة" ( هي غير ذلك فعليا)، ثم الطريقة التي حسم بها الأمر لا تفصح،على الأقل ضمن المقال الذي بين أيدينا، أن الدكتور " تحقق من فرضيته" عبر تجارب علمية، بل عبر مسلّمة. و النتيجة أن " المسلمّة" هي التي" بسطت الملاحظة " ثم اختزلت عملية " التحقق" في نشاط ذهني أعادنا إلى المربع الأول نفسه، الذي يقول: " الإنسان ثقا في بطبعه".
من ناحية أخرى، يفسر الدكتور سبب طول الطفولة وطول مدى الحياة بعملية " الإطالة"، و ينسب ذلك إلى " الرموز الثقافية" كعامل حاسم وهذا أقرب إلى الطوطولوجيا منه إلى العلم. ومن حقنا أن نسأله مثلا ، ما دور العمل في إطالة عمر الإنسان؟
وما دور السمات البيولوجية – الفزيولوجية نفسها، كعامل طبيعي، في هذا الطول؟ هذا من ناحية علمية .
لكننا نسأل الدكتور أيضا أن ينزل لنا المسألة دينيا؛ هل أن طول حياة الإنسان ناتج عن كون الله نفخ فيه من روحه فقط أم لأسباب إلهية أخرى أيضا؟
اذا كان الأمر، كما ذكر، فليقدم لنا الدليل التفسيري عليه، و بما أن للسلاحف أرواح أيضا، وفق التصور الديني، فهل تعيش أطول منا بسبب خصوصية في "النفخة الأولى" أيضا؟
من ناحية أخرى، نفترض أن الدكتور يؤمن معنا بأن الرموز الثقافية تطورت عند البشر كلما تقدموا في التاريخ، و بالتالي فان أمد حياتهم ماانفك يطول هو الآخر، لكن في هذه الحالة، كيف يفسر لنا الدكتور ما يحتويه المخيال العربي الإسلامي حول شدة التعمير و الحياة عند القدامى التي تذكرها أدبيات القصص الإسلامي ؟ ( م33 )
يبدو لنا أن الدكتور وضع نفسه في ورطة مع العلم والدين في نفس الوقت، فالعلم يقول إن أمل الحياة عند الإنسان ماانفك يتزايد بينما التصور الديني يقول أن القدامى كانوا يعيشون أطول منا، ونترك للدكتور "حرية الاختيار".
إذن، عوض دراسة هذه الظاهرة، كغيرها من الظواهر، على أنها نتيجة تفاعلات متعددة ذات طابع مركب و معقد، يتسرع الدكتور الذوادي في تأكيد صحة فرضياته ! فتصبح الرموز هي السبب الحاسم، الأساسي لطول مدى الحياة.
إضافة إلى هذا، يقول الدكتور ما يلي:
" ويمكن القول بأن تميز المخ البشري با حتضان منظومة الرموز الثقافية أثر في هندسة جينات و بيولوجيا الإنسان، والمتمثلة في بطء نموه البيولوجي" (ص8) ويعتقد أن هذا، يعزّز مصداقية قوله بأن الإنسان " كائن ثقافي بالطبع".
لكن، ماذا يقصد الدكتور بأن المخ البشري يتميز " باحتضان منظومة الرموز الثقافية"؟
في الحقيقة، عند هذه النقطة، نصل إلى أول مهمة كان على الدكتور الذوادي أن ينجزها لنا، لو أنه اتبع منهجا عاديا وصريحا في عرض أفكاره.
ان "السؤال المهم" هنا هو التالي: هل الإنسان هو كائن رامز أم لا ؟
أي، هل هو الذي" يصنع" رموزه، ( كما تقول كل العلوم الإنسانية والاجتماعية)، بوصفه كائنا بيو ـ فزيولوجيا واجتماعيا تاريخيا في نفس الوقت، أم أنه، مجرد " حاضنة" لرموز هي " روح رموزية" منفوخة فيه من الخارج؟
يبدو أن " المخ البشري" عند الدكتور الذوادي هو فقط " مستودع" رموز " ميتافيزيقية"، " لا محسوسة"، " ما ورائية " ، مودعة داخله من خارج " خفي" .
يعترف الدكتور بهذا الأمر بكل وضوح في مقال أصدره في مجلة "الحياة الثقافية" ، حول الذكاء الإنساني و الاصطناعي " قائلا ؛
" و من المنظور القرآ ني ،فان هذه الفردية (في التميز بالرموزـ نحن ) هي النتيجة المباشرة للقرار المقدس وليس للتطور (...) باعتبار أن نصوص القرآن تعتبر الذكاء و التفكير معطى الاهيا مقدسا و ليس كسبا بناء على قوله تعالى " وعلم آدم الأسماء كلها" ... ( م34 ، ص 17 وص32).
بل انه، في عرض لكتاب ادغار موران " في المنهج" ، يلوي رقبة واحد من أعظم من كتب علميا حول الانسان في القرن العشرين ، في صفوف علماء الاجتماع ، و يقول، دون أي احترام للمؤلف
" و بالتعبير القرآني ، فعالم الأفكار هو نتيجة للنفخة الإلهية(...) في الإنسان.(...) فاختلاف طبيعة عالم الثقافة و الأفكار (...) يرجع إلى جذوره الماورائية المتعالية التي تختلف عن كينونة الإنسان العضوية ، ( الطين بالتعبير القرآني ) ".( م35، ص18) و كأن ادغار موران أصبح اسلاميا بفضل الدكتور الذوادي.
إننا لا نستوعب تماما كيف يدعونا الدكتور في " نداء لتأصيل علم الاجتماع" إلى القبول بتعريف تايلور للثقافة الذي يقول أنها كل معقد و يكتسبه الإنسان بوصفه عضوا في مجتمع ثم يدعونا كذلك إلى الإيمان "بالتصور القرآني" القائل أن الثقافة ليست كسبا ولا هي اجتماعية ولا ناتجة عن التطور بل عن "النفخة الالهية" ؟
من ناحية أخرى نرجو أن يكتفي الدكتور بهذا الاكتشاف المعادي للعلم في أبسط أبجدياته القائلة أن الإنسان يفكر بدماغه الذي هو ليس مجرد "حاضنة" ، ولا يضيف لنا اكتشافا دينيا جديدا يقول فيه ، بسبب التناظر الذي يقيمه بين الروح بالمعنى الديني و "الروح الرموزية الثقافية" ، أنه اكتشف لنا موقع الروح في الجسد ، بمعناها الديني، ،في الدماغ أيضا .
من ناحية ثالثة نسأل الدكتور أن يجيبنا عما يلي؛
أولا ؛ لماذا لم يتذكر" و علمه الأسماء كلها" إلا الآن ولا يعتبر تلك العملية " كسبا" أوليا لآدم الأول؟
ثانيا؛ ماذا نفعل في الوطن العربي بنظرية التطور، هل نكفرها ؟ هل نمنع تدريسها في مدارسنا و جامعاتنا؟
إننا ندعو الدكتور إلى جولة قديمة جدا في الفكر العربي، ليلاحظ كيف كا ن أجدادنا العقلانيون يفسرون " الرموز الثقافية"، فيكاد يرفض بعضهم نظرية "التوقيف الالهي" في اللغة، وليقارن بعد ذلك سوسيولوجياه ببعض أعلام " ثقافتها العربية الإسلامية" القدامى. ( م36.)
إننا ندعوه إلى العودة إلى أبي عثمان الجاحظ أو الفارابي أو ابن جني أو غيرهم من العلماء وخاصة من المعتزلة، كالقاضي عبد الجبار، الذين يؤكد بعضهم، مثلا، (ولكن كما سمحت به ظروف و أفكار عصرهم)، على أن " اللغة مواضعة واصطلاح" أو" محاكاة للطبيعة"... وأن تعدد اللغات ناتج عن اختلاف الشعوب وتاريخها، وتداخل اللغات ناتج عن تتاقف الثقافات ...الخ. ( م37)
كما ندعو الدكتور إلى التخلي عن القراءات الحرفية و الظاهرية للنص الديني إذا كان لا يريد أن يبقي المسلمين في قطيعة مخجلة مع العلوم الحديثة و يسير على خطى العلماء و المفكرين العرب القدامى الذين تجرأ وا و خاضوا في كل المواضيع بروح تتجاوز أحيانا كثيرة بعض علماء اليوم.
حول اللمسات الميتافيزيقية للرموز الثقافية ( اللمسة الخامسة)
يعيد الدكتور ذكر خصائص " الرموز" التي استعرضها في " نداء من أجل تأصيل علم الاجتماع" وهي:
أ- انعدام الوزن والحجم في الرموز
ب- سهولة و سرعة الانتقال
ج- القدرة على البقاء إلى درجة الخلود
د- القوة الماورائية الهائلة للرموز مقارنة بـ" المعطيات المادية"
ولكنه يضيف إليها خاصية خامسة يمكن أن نسميها: " عدم النقصان"
يقول: " لا تتأثر الرموز الثقافية بعملية النقصان عندما يعطي منها للآخرين، كما هو الأمر في عناصر عالم المادة إذا منحنا الآخرين شيئا من معرفتنا وقيمنا الثقافية ولغتنا فإن ذلك لا ينقص شيئا من رموزنا الثقافية هذه " (صص 8-9: الآداب).
وعندما تحدث عن " عالم المادة" قال لنا:
" فإعطاء الآخرين خمسين دينارا من رأس مالنا وقنطارا من قمحنا وعمارة من عماراتنا ينقص مما هو عندنا من ممتلكات مادية" (صص8 – 9 ).
نكتفي بما قلناه سابقا، في الجزء الأول، حول " الخصائص الأربعة" الأولى للرموز الثقافية ونهتم بهذه الخاصية الخامسة.
يبدو أن الدكتور الذوادي أراد أن يقول لنا الآتي؛ عالم المادة و الجسم محسوس ومادي له صفات الوزن والحجم وبالتالي، إذا منحنا منه يحدث عليه نقصان كمي، أما عالم الرموز فهو ميتافيزيقي، غير مادي، وبالتالي، إذا منحنا منه شيئا لا يصيبه النقصان.
إن الدكتور يقوم بعملية خلط بين نوعين من التفاعل البشري؛ تبادل الأشياء من ناحية و تبادل الأفعال من ناحية ثانية.
وعندما يقول إن الرموز الثقافية تختلف عن الجسد و عن المادة يقف عند المقارنة بين ألأشياء و ينسى الأفعال و الممارسات الإنسانية التي يمكنه تطبيق فكرة " عدم النقصان " عليها كلها تقريبا.
اننا نطرح عليه الأسئلة التالية مثلا ؛
عندما نمارس الجنس هل نصاب بنقصان جنسي ؟
عندما ننجزعملا صناعيا هل نصاب بنقصان مهاري في العمل ؟
عندما نشارك في عملية انتخابية... هل ينقصنا شيء من القدرة الانتخابية أو السياسية عموما؟
ألا يفيدنا بورديو في هذه الحالة( مع تعسف نسبي ربما )، عبر مفهومي الهابيتوس / الممارسة تحديدا، بحيث نعرف أن ما استدخل في الجسد من معارف فكرية و مهارات جسدية و عملية يصبح من مكوناته الموشومة عليه إلى درجة تؤدي إلى خاصية "عدم القابلية للنقصان" ؟
لكن في هذه الحالة ألا تصبح أغلب الممارسات ( الجنسية و المهنية والسياسية...) ميتافيزيقية كما يعتقد الدكتور ؟
حتى لا يذهب الدكتور بعيدا في هذا الاتجاه نذكره بما يلي؛
أولا: قلنا سابقا، أن بعض الفنون بطبيعتها غير منفصلة عن المادة، مثل النحت والسينما والرسم... فماذا لو سألنا الدكتور: هل أن إعطاء الآخرين خمسين تمثالا من تماثيلنا ولوحة من لوحاتنا وقطعة قماش من تصاميمنا ينقص ما عندنا أم لا؟
ثانيا: يقول الدكتور الذوادي إن " عالم المادة" وحده يصيبه النقصان، وكأن " عالم المادة" نفسه خال تماما من أي بعد رمزي. خاصة إذا ذكرنا " عالم المادة" الذي يعنيه الدكتور- خمسين دينارا وقنطارا وعمارة" وهو عالم مجتمع socialisé بواسطة العدد ( خمسين وواحد) وبواسطة الوزن و العملة ( القنطار و الدينار) ومرمز بها.
طيب، و ما رأي الدكتور في التصور الإسلامي الذي يقول إن " إخراج الزكاة والصدقة لا ينقص من المال بل يزيده و يضاعفه" ؟
و هل تدمير عمارتي " مركز التجارة العالمي" من قبل القاعدة لا يقصد تحديدا البعد الرمزي لهاتين العمارتين ؟
وهل يفتقد الميزان / القنطار دائما لأي بعد رمزي ؟ ألا توجد رموز ذات علاقة بالوزن في ثقافتنا مثل الريشة الرامزة إلى الخفة و الملح الرامز إلى الثقل ؟
و هل العملة مجرد مادة لا رمزية فيها دائما ؟ ألا يرمز المسلمون إلى الثروة بمال قارون ؟ و ألم يصبح الدولار رمزا للثروة بفعل السيطرة المالية للولايات المتحدة ؟
إن مجال الحياة الاجتماعية متشابك بدوره مع الرموز كما تؤكد ذلك كل الدراسات الانثربولوجية والسوسيولوجية وهذا قد يدفع الدكتور، بهذه الرؤية التي له عن الرموز، إلى تحويل كل حياتنا إلى بعد ميتافيزيقي، طالما أنه مصرّ على تقسيم " ابستمولوجي" بين المتعالي الميتا فيزيقي والمادي النيوتني، دون ذكر واضح للاجتماعي والتواصلي و الاتصالي.
و على ذكر العملة: ما رأي الدكتور في ما يلي:
1- العملة الإلكترونية لها نفس سرعة حركة أية " رموز" من رموزه الميتافيزيقية.
2- العملة الإلكترونية لا وزن ولا حجم لها، بمقاييس الدكتور نفسه
3- العملة الإلكترونية يمكن أن تستعمل في التقرب من الله والتضرع له عبر دفعها كصدقة أو زكاة الكترونيا.
ـ 4 العملة الإلكترونية ، بل والعملة عموما، مثل الكلمة أو الصورة ، يمكنها تخليد شخص ما حسب تصور الدكتور نفسه عن الخلود.
5- العملة الالكترونية لا يصيبها النقصان إذا دفعت كصدقة أو زكاة.بل يضاعفها الله حسب التصور الإسلامي الذي يدعونا الدكتور إلى قبوله.
فهل العملة مادية أم رموزية؟
لو أدرك الدكتور أن الرمزي لا يناقض المادي دائما لحلت المشكلة.إلا أن تصوره الثنائي الديني، و ليس التعقيدي، لا يمكنه من هذا الإدراك مع الأسف.
ثالثا: يقدم الدكتور مسألة " انعدام النقصان" الرمزي هذه ضمن تصور لا اجتماعي تقريبا. فهو، في مجتمع يتميز بنظام علاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية متشابكة، لا يذكر إلا مظهرا واحدا جزئيا جدا من هذه العلاقات وهو: " أن يعطي أحدنا رموزه للآخر" وهو يصور المسألة بصورة أحادية تماما من زاويتين:
الأولى: التركيز على الشخص الذي يعطي.
الثانية: التركيز على عملية الإعطاء أ و المنح.
وبهذه الصفة لا يضع الدكتور العملية التي يصفها ضمن تبادل رمزي ( أو مادي) بين طرفين، كما هو غالب في الحياة الاجتماعية، بل ضمن عملية أحادية المظهر سواء من حيث الاتجاه- واحد يعطي – أو من حيث المحتوى- الذي يظهر وكأنه هدية أو هبة.
إننا لسنا في إطار عملية تبادل اجتماعي فيه أخذ وعطاء، فيه تفاعل رمزي بين طرفين أو أكثر، ناهيك عن التبادل الاقتصادي.
إن هذه الطريقة التي وضع داخلها الدكتور فكرته هي التي سجنته ضمن تصور ميتافيزيقي عن الرموز الثقافية ولو أعدنا صياغة المسألة ضمن العلاقات الاجتماعية الحقيقية لوجدنا الأمر مختلفا تماما. فلنفعل ذلك إذن.
رابعا: إن عملية المنح التي يذكرها الدكتور، لا علاقة لها حتى بمفهوم " الهبة" عند مارسيل موس. فالهبة عملية تبادل اجتماعي رمزي فيها فعل المنح والإعطاء وفيها ترقب أو حصول تبادل هبات أو ما يعوضها تقريبا.
أما إذا خرجنا إلى " التبادل الرمزي" الحديث، في مجتمعنا المعاصر، فمن الواجب التذكير مثلا بدراسات بورديو حول تحويل رأس المال الرمزي إلى رأسي مال اقتصادي " مادي" أو العكس. و بالتالي فإن عملية " منح الآخرين شيئا من معرفتنا وقيمنا الثقافية ولغتنا" ينتظر منها، أو ينتج عنها غالبا، إما قبولا ( يقابل المنح) لشيء من معرفة وقيم ولغة الآخرين، أو أموالهم وعماراتهم...( أي عبر الحوار أو التجارة مثلا).
خامسا: إن العملية تتنزل، إذن، ضمن التبادل الرمزي والاجتماعي عموما وليست أبدا مجرد عملية " اعطاء "، فهل يعني الدكتور أن الرموز لا يصيبها النقصان فقط عند " المنح" أم داخل التبادل عموما؟
ثم هل أن " عدم النقصان" يعني أيضا " عدم الزيادة " في الرموز بحيث تصبح الصورة واضحة، ترتبط بانعدام الوزن والحجم، و تقريبا، الكمية؟
وهل عندما لا نعطي من رموزنا لا يصيبها النقصان أيضا؟ ( أي عندما لا نكلم أحدا ولا نعطيه من معارفنا أو قيمنا ) .
إن أهم ما في المسألة هو التالي: الدكتور يريد أن يقنعنا أن الرموز الثقافية كائنات " غير مادية" وأنها " ما ورائية" و " لا محسوسة" و فاقدة للوزن والحجم، وطبعا، إذا طبق عليها فيزياء نيوتن قد يكون معه الحق. ولكن، هل مثل هذه البديهيات هي التي تسمى عنده " أساسيات الأشياء"؟
إن تبادل الرموز الثقافية "لا " يتم و لا يدرس بالأساس ضمن " الحقل الفيزيائي" بمعناه الضيق بل ضمن " الحقل الرمزي" حسب عبارة بيار بورديو و هذا طبعا ضمن علوم الإنسان .
والتبادل الرمزي له خصوصية مقارنة حتى بالتبادل الاقتصادي، وانتقال الرموز في " ا لمكان" أو (حركتها)، أو إعطاؤها، منحها، كلها عمليات لا تحلل بقوانين نيوتن بالدرجة الأولى بل بعلوم الاتصال والتواصل، و لكن بالجوانب الفيزيائية و البيو ـ نورولوجية الضرورية للعلاقات البشرية أيضا.
سادسا: إذا أعطى أحدنا رموزا خاطئة (معرفيا) أو غير واضحة، فإنه قد يناقش فيها من قبل غيره، ( إذا وافقنا الدكتور على دراسة الظاهرة ضمن التبادل طبعا)، وبالتالي فقد يبين لنا الآخر خطأنا مثلا، وبهذا تصاب رموزنا في نفس الوقت بالنقصان ( تنقص منها الأخطاء) وبالزيادة أو التصحيح، فنعرف أشياء جديدة و إضافية.
سابعا: عندما يعطينا الدكتور من "رموزه" يعتقد أن رموزه لا تصاب بالنقصان، ولكن إذا أخذنا عنك جزءا من رموزك يا دكتور، ألا تنقص رموزك بوصفها رموزا خاصة بك وتتحول إلى رموز جماعية نشاركك في امتلاكها، إنها تكف عن كونها رموزك الخاصة، وبالتالي فإذا تعممت رموزك الخصوصية وانتشرت بين الناس أصابها نقصان من حيث هي رموزك الخاصة. ألا يعبر النقاد الأدبيون عن هذه الوضعية بقولهم إن " النص الذي يصدر للقارىء لا يبقى ملكا لكاتبه"، رمزيا بالطبع، وليس من حيث حقوق التأليف والنشر.
ثامنا: كيف يفسر لنا الدكتور ظاهرة النسيان؟ أليست " نقصانا رموزيا" ؟ وكيف يفسر لنا كون لغات تولد وأخرى تموت وأفكار ومعتقدات وديانات وعادات وتقاليد تموت وأخرى جديدة تولد، ألا يعبر ذلك عن " نقصان" أحيانا و"زيادة" أحيانا أخرى، ضمن التبادل، أو التفاعل الرمزي عند الإنسان الفرد أو المجتمع؟
إن النقصان أو الزيادة في " رصيد الرموز الثقافية" لا يدرس فيزيائيا بل رمزيا. فلا داعي لمحاولة إضفاء صفة " الميتافيزيقا" على الرموز الثقافية عبر حشر صفات المادة الفيزيائية وقوانين حركنها النيوتنية.
إن هذه العملية تضر بعلم الاجتماع من حيث تدّعي أنها تبحث له وضمنه عن " أساسيات الأشياء".
إننا نستغرب تماما أن يقدم عالم اجتماع " بحثا علميا أساسيا" يريد أن يقترح بواسطته " باراديغما جديدا" في علم الاجتماع والعلوم الإنسانية عموما يحتوي على مثل هذه الأفكار.
إن الدكتور يتبرع لنا في بحثه حول " تأصيل علم الاجتماع العربي" بأربعة "خصائص ميتافيزيقية" ثم يضيف لنا في مقاله " في أبجدية الرموز الثقافية" عنصرا خامسا. ولا نفهم لماذا اكتفى بهذه " المعالم الخمسة للرموز الثقافية" إذ كان بإمكانه أن يعطينا عشرات المعالم الأخرى لرموزه لو لم يكتف بمقارنة الرموز بالمادة الفيزيائية ووسّع اهتمامه ليشمل كل أشكال المادة الأخرى.
كان بإمكانه أن يقول لنا أيضا، الرموز الثقافية اللغوية لا لون ولا رائحة لها، ولا ذرات ولا جزيئات فيها، ولا خلايا ولا جينات ولا صبغيات عندها، ولا فصيل دم ولا أعضاء تناسلية عندها ولا عمودا فقريا ولا شعرا و لا عيونا ولا آذانا ولا أيادي أو سيقان لديها.
نرجو ألا يكون ترك لنا مثل هذه الاكتشافات لمقالات ودراسات لاحقة.
ما هذه الرموز الثقافية العجيبة التي يقترحها علينا الدكتور؟
يبدو أن ربطه بين مصطلح " الروح الرموزية الثقافية" و مصطلح الروح بالمفهوم الديني هو الذي أوقعه في هذه " الأساسيات".
فبما أن الروح، بالمعنى الديني، تقدم على أنها " متعالية" و " ميتافيزيقية" يستنتج الدكتور، وفق ابستمولوجيته القرآنية المزعومة، أن " الرموز الثقافية" أيضا ميتافيزيقية ومتعالية، ويبدو أنها، هي الأخرى خالدة، تفارق الجسد عند الموت وتخرج من "حاضنتها"، الدماغ، لترجع إلى ملكوت السماء.
إن الدكتور الذي يزعم تصويب أفكار المفسرين المسلمين وعلماء الاجتماع في نفس الوقت يذهب بعيدا في المماثلة بين " الروح" في المعنى الديني و " الروح الرموزية الثقافية" ، إلى درجة قد توقعه في مشاكل دينية و علمية خطيرة جدا كان من الممكن تجنبها تماما لو أنه فرق بين فعلي الإيمان الديني والبحث العلمي..
ان سيد قطب، الذي نعتقد أن الدكتور قد يكون أخذ عنه بعض أفكاره و انطلق منها، دون ذكره، يتعرض أيضا لمسألة الرموز هذه ، مثلا ، في تفسيره للآيات(30ـ39) من سورة البقرة قائلا
"..ها نحن أولاء نشهد طرفا من ذلك السر الإلهي العظيم الذي أودعه الله هذا الكائن البشري، وهو يسلمه مقاليد الخلافة ، سر القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات . سر القدرة على تسمية الأشخاص و الأشياء بأسماء يجعلها ـ وهي ألفاظ منطوقة ـ رموزا لتلك الأشخاص و الأشياء المحسوسة (...) فأما الملائكة فلا حاجة لهم بهذه الخاصية..." ثم يضيف متسائلا حول مخاطبة الله الملائكة "..كيف قال الله تعالى لهم؟ و كيف أجابوه ؟ (...) هذا وأمثاله في القرآن الكريم غيب من الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه (...) و من ثم لم يعد للعقل البشري أن يخوض فيه ، لأنه لا يملك الوسيلة للوصول الى شيء من أمره .وكل جهد يبذل في هذه المحاولة هو جهد ضائع ، ذاهب سدى ،بلا ثمرة و لا جدوى ..."( م38 ، ص 57 و59)
على الأقل ، نجد هنا تعريفا واضحا للرمز و فصلا نسبيا بين الإيمان والعقل ، رغم أنه يقع في حدود ضيقة حول ما تم في الملأ الأعلى و مع الملائكة ، ، أما عند الدكتور فلا شيء يفلت على قدرته على الخلط بين " الدين والعلم والفلسفة "!.انه صاحب " علم لدني صوفي" على ما يبدو !
3ــ حول: " أمثلة ميدانية":
تطبيقا " للأبجديات" يقدم الدكتور أمثلة ميدانية يختبر فيها " باراديغمه الجديد"، فلنفحصها معه
أ- التبعية:
يقول " الكتابات حول مسألة التبعية ركّزت اهتمامها على خطر التبعية الاقتصادية وهمّشت خطر التبعية الثقافية على المجتمعات النامية. ويبرز هذا التوجه الفكري خاصة عند المفكرين الماركسيين، وما مدرسة " نظرية التبعية" التي نادى بها جوندر فرانك وأتباعه إلا أشهر مثال على ذلك"(ص9).
كنا نعتقد أن الدكتور الذي ينادي باعتماد " التعقيد" وبتجاوز " الحتمية الضيقة" ويكرر كثيرا، عبارة " هذا الكل المعقد"، سيقول لنا إنه على علم الاجتماع العربي أن لا يكتفي بمجرد " ردة فعل" على الماركسية، ويفهم التبعية على أساس أنها ظاهرة معقدة هي الأ خرى .
لكن، وبما أنه لا يؤمن فعلا " بالتحليل المعقد"، يقول لنا ما يلي: " أما منظورنا للرموز الثقافية فهو يرى أن تبعية مجتمعات العالم الثالث للمجتمعات الغربية على مستوى المنظومة الثقافية أكثر خطورة من التبعية الاقتصادية لأنها تضّر بأعز ما يملكه الجنس البشري وما يميزه عن سواه من الأجناس الأخرى"(ص9).
إذن، إننا بصدد عملية قلب للماركسية الاورثوذوكسية لا غير، فعوض التبعية الاقتصادية سنركز، مرة أخرى، بصفة أحادية الجانب، على وجه واحد من التبعية، هو التبعية الثقافية هذه المرة! هذا من ناحية.
من ناحية أخرى، عندما يقدّم الدكتور تصوره مناقضا الماركسية، يتحدث عن تبعية " مجتمعات" العالم الثالث لـ" المجتمعات الغربية".
وهذه الطريقة في التحليل تهمل، ما كان انتبه إليه الماركسيون، أن ظاهرة التبعية هي ظاهرة مرتبطة بانقسام " مجتمعات العالم الثالث والمجتمعات الغربية"، نفسها، إلى طبقات وفئات اجتماعية تمارس الاستعمار والإمبريالية من ناحية، وطبقات وفئات اجتماعية مسئولة عن التبعية بدرجة أولى من ناحية ثانية.
من ناحية ثالثة، نعتقد أن الدكتور، عندما ينقد الماركسية، يبالغ في تعميمه، باستعمال مثال واحد هو مثال " مدرسة التبعية".
إن التعريف" الماركسي اللينيني" للأمة، على الأقل، الذي قدّمه جوزيف ستالين، وهو الذي كان أكثر انتشارا في العالم، يقول إن " الأمة هي جماعة بشرية مستقرة، تكونت تاريخيا، على قاعدة وحدة الأرض ووحدة اللغة ووحدة الحياة الاقتصادية ووحدة التكوين النفسي المترجم في وحدة الثقافة". ( م39 ، ص33)
إن هذا التعريف، جعل عددا من الماركسيين يطرح مسألة الاضطهاد القومي على أنه، في نفس الوقت اضطهاد قومي، ترابي ( احتلال الأرض القومية) ولغوي و نفسي ثقافي واقتصادي و سياسي، رغم تركيزهم المبالغ فيه أحيانا كثيرة على الاضطهاد الاقتصادي ومبالغتهم في أهمية صراع الطبقات حتى ضمن مرحلة التحرر الوطني...
في المقابل، يقدم لنا الدكتور، ردة فعل ثقافية ضد " الاقتصادوية"، ويعطينا مفهوما عن الهوية الوطنية وظيفيا تماما.
يقول: " المنظومة الثقافية هي بيت القصيد في تحديد هوية الجنس البشري، وبالتالي في تحديد هوية المجتمعات البشرية" (ص9).
وبما أنه يقدم لنا " المنظومة الثقافية " كجوهر متناسق، مشترك بين أفراد الأمة، خارج عن الزمان والمكان وعن الصراعات الداخلية، فإن " الهوية" تصبح معرّفة تعريفا " ميتافيزيقيا" تماما. إذن، مقابل الاقتصاد يقترح الدكتور الثقافة، ومقابل الصراع يقترح الوحدة.
هناك مبالغة في اتجاه، وهنا مبالغة في اتجاه آخر
أين " التعقيد"؟ لا أحد يعرف.
و يا ليت الدكتور وقف عند " المنظومة الثقافية" "ككل معقد" في تعريف الهوية وفي تعريف التبعية الثقافية، إنه يذهب بعيدا فيقول:
" تشير الملاحظات في دنيا التثاقف بين الأمم والمجتمعات إلى أن عنصري اللغة والدين يلعبان دورا حاسما في تحديد مدى خطر التبعية الثقافية" (ص9).
إذن، نرجع مرة أخرى إلى " الدور الحاسم"، حتى داخل الثقافة نفسها، بعد أن رأينا دور الثقافة الحاسم داخل المجتمع، " الكل المعقد" هو أيضا.
إن " التبعية العلمية" التي طالما دعانا الدكتور إلى إنهائها و " تأصيل" علمنا الاجتماعي العربي، هذه التبعية، ليس لها " دور حاسم"، لأن العلم ليس " جوهريا" في الثقافة العربية الإسلامية ولا الفن ولا أي شيء آخر على ما يبدو.
بعد هذه " المقدمة النظرية" ينتقل الدكتور إلى عملية " تصنيف علمي" لظاهرة التبعية فيقول:
" فتثاقف مجتمعات الوطن العربي مع الغرب في القرنين التاسع عشر والعشرين أفرز نوعين من التبعية الثقافية. فمن جهة، نجح الاستعمار الفرنسي- المعروف بتركيزه على الجانب اللغوي والثقافي- في بث لغته وثقافتها في بلاد المغرب العربي ومن جهة أخرى، كان الاستعمار الإنجليزي أقل اهتماما بجوانب الاستعمار اللغوي والثقافي لبلاد المشرق العربي التي سقطت تحت هيمنته فلم يبلغ تعلم وانتشار واستعمال اللغة الإنجليزية في مجتمعات المشرق العربي الدرجة التي بلغتها اللغة الفرنسية في مجتمعات المغرب العربي" (ص10).
تطرح هذه العملية التصنيفية جملة من المسائل أهمها التالية :
أولا: يقسّم الدكتور " نوعين" من التبعية عموما والتبعية الثقافية تحديدا اعتمادا على فكرة أن الاستعمار الفرنسي " معروف بتركيزه على الجانب اللغوي والثقافي" على عكس الاستعمار الإنجليزي.
ثانيا: يصنف " نوعين" من التبعية الثقافية على أسس " كمية" ثقافية تتحدث عن " الاهتمام الأقل" وعن " الدرجة".
ثالثا: يصادر الدكتور على التاريخ فيقول أن الاستعمار الفرنسي " نجح" في بث لغته وثقافتها في بلاد المغرب العربي".
كان على الدكتور أن ينسب هذه الأفكار الثلاث قليلا، حتى يتجاوز الثنائيات المبالغ فيها، والتي هي شائعة فعلا، حتى يقدم لنا رؤية علمية للمسألة.
فأولا: إن الفكرة القائلة بان الاستعمار الفرنسي، على عكس الإنجليزي، " معروف بتركيز اهتمامه على " الجانب اللغوي والثقافي"، هي فكرة قد تكون استعمارية فرنسية الأصل، أراد بها الفرنسيون، إعطاء خصوصية " حضارية وتمدينية " لاستعما رهم. و كأنهم، عندما يستعمرون، لا يبحثون عن نهب خيرات الشعوب واضطهادها سياسيا...بل من أجل نشر اللغة و الثقافة الفرنسيتين فقط ! أو أساسا ! ـ فعبارة " التركيز على الجانب اللغوي والثقافي" تعني " عدم التركيز على الجوانب الاقتصادية والسياسية" مثلا، وكأن الاستعمار الفرنسي يسمح بالتالي بالاستقلال والتقدم الاقتصادي، و لو جزئيا، بينما لا يفعل ذلك الاستعمار الإنجليزي...
وثانيا: كان على الدكتور ربما أن يصنف اعتمادا على مصطلح آخر غير " نوعين" من التبعية، كأن يستعمل بكل بساطة عبارة " درجتين" من التبعية الثقافية باعتبار أنه عندما يتحدث عن " النوعين" يكتفي بالقول: " أقل اهتماما" و " الدرجة".
وثالثا: كان على الدكتور ألاّ يستسهل عبارة " نجح" الاستعمار الفرنسي، وكأن المسألة انتهت وتوقف التاريخ عند هذا المعطى. وكان عليه أن يدقق " درجة" النجاح تلك " أكثر من مجرد القول بوجود " ظاهرة الكتاب الفرنكفونيين" مثلا، رغم ما لهذه المسألة وغيرها من رمزية فعلية.
من ناحية أخرى، عندما يقدّم لنا الدكتور مقارنة بين واقع التبعية الثقافية للبلدان العربية التي خضعت للاستعمار الفرنسي وبين المستعمرات الإنجليزية، كان عليه أن يذكرنا بعوامل الزمن (مدة الاستعمار) وشكل الاستعمار ( استعمار فرنسا للجزائر كان يريد أن يكون استيطانيا) وبخصوصيات محلية أخرى.
كما أنه كان على الدكتور أن ينتبه إلى أن ضعف تواجد الكلمات الإنجليزية النسبي في اللغة المحكية في المشرق العربي لا يخفي حضور الكلمات التركية والفارسية مثلا، وهذا له أسباب تاريخية، وجغرافية في علاقة المشرق العربي بالفرس والأتراك.
إن هذه الملاحظات حول المشرق والمغرب هدفها، كما نريد، هو تجنب " انحرافين" هيمنا على أذهان عدد كبير من العرب وهما:
أولا: ادعاء بعض المغاربة أنهم عقلانيون مقارنة بالمشارقة غير العقلانيين وتسويغ ذلك بوجود مدرستين، واحدة رشدية ( ابن رشد) والأخرى يتزعمها ابن تيمية أو بغيرها من المبررات.و بالانفتاح على الثقافة الغربية .
ثانيا: إدعاء بعض المشارقة أنهم عروبيون وإسلاميون أكثر من المغاربة واتهامهم للمغاربة، مجانا وبصورة تعميمية مبالغ فيها، بنقص في عروبتهم وإسلامهم...
إن الدكتور الذوادي لا ينتبه إلى هذا الأمر الخطير، الذي هو مجاف للحقيقة معرفيا وضار سياسيا، على الأقل بالنسبة إلى من يدّعون الدعوة إلى الوحدة العربية. إنه، أكثر من ذلك، يقع تقريبا في فخ بعض شيوخ الشرق الأصوليين الذين دعا بعضهم إلى " إعادة فتح تونس إسلاميا ".
و حتى لا نتجنى على الدكتور ندقق فيما كتبه: قبل تعرضه للمثال التونسي، قدّم لنا الدكتور هذه الفكرة:
" رموز الغازي الثقافية ذات أمد بقاء طويل، من جهة، وذات حضور شبه ميتافيزيقي، من جهة أخرى، في المجتمعات المتأثرة كثيرا على الخصوص بالانتشار الواسع لتلك الرموز الثقافية. أي أن الحضور المادي، مثلا، للمستعمر الفرنسي في مجتمعات المغرب العربي لم يعد ضروريا لاستمرار تأثير اللغة الفرنسية وثقافتها في تلك المجتمعات"(ص10).
هكذا إذن، الفهم " السوسيولوجي" للتبعية أو لا يكون. بما أن الرموز الثقافية " خالدة" و " ميتافيزيقية". فحتى عند عدم توفر " الحضور المادي للمستعمر" يستمر " تأثير اللغة الفرنسية وثقافتها".
إن تأثير لغة المستعمر وثقافته يبقى طبعا حتى بعد " غيابه المادي"، فليس هذا هو موطن احتجاجنا على الدكتور.
احتجاجنا هو على ربطه هذه الظاهرة بالحضور المادي" الانطولوجي وليس بالعلاقات الاجتماعية التاريخية القابلة للتحليل السوسيولوجي.
إن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين المغرب العربي وفرنسا لا تزال موجودة وقوية جدا في إطار " التبعية" التي أعقبت الاستعمار " الحضور المادي"، ولذلك هنالك " استمرار تأثير اللغة الفرنسية وثقافتها"، إضافة إلى أسباب أخرى طبعا.
بعبارة أخرى، " الحضور المادي" هو حضور علائقي، كان موجودا في شكل استعمار مباشر وأصبح موجودا في شكل تبعية.
لا داعي إذن للبقاء عند مستوى تحليل " ميتافيزيقي" لهذه الظاهرة.
لابد من خلط المادي " بالميتافيزيقي" لاكتشاف " تعقد" ظاهرة التبعية الثقافية وتحليلها سوسيولوجيا.
في الواقع يقوم الدكتور بهذا جزئيا، بل ويدعي أنه يعتمد بيار بورديو في تحليل الظاهرة انطلاقا من مقولة " إعادة الإنتاج" ( انظر ص: 11، آخر فقرة في العنصر الأول).
ولندقق الأمر معه إذن، ولكن قبل ذلك نطلب من الدكتور أن يفكر في تعويضه " الحضور المادي" للمستعمر، بالنخب السياسية والفكرية والشرائح الاجتماعية المتعلمة" التي تنوبه في البلدان المغاربية.
أ ليس لها هي أيضا " حضور مادي" ؟
في الحقيقة، إن " سوسيولوجيا الدكتور مدوّخة فعلا"
مرة يقول لنا إن استمرار الرموز الثقافية للمستعمر في البقاء في دول المغرب العربي راجعة أساسا لخصائص هذه الرموز: " طول البقاء" و " الحضور شبه الميتافيزيقي". و مرة أخرى يقول لنا إن " الحضور المادي" للمستعمر، " لم يعد ضروريا لاستمرار تأثير اللغة الفرنسية وثقافتها في تلك المجتمعات، إذ تنوب عنه النخب السياسية والفكرية والشرائح الاجتماعية المتعلمة" (ص10)
إنه مرة يقول لنا، أن خصائص الرموز الجوهرية ليست في حاجة " للحضور المادي" للمستعمر ومرة أخرى يقول إن بقاء تلك الرموز مهمة " نائب مادي" حاضر داخل مجتمعاتنا ! فما هو " العامل الحاسم" في بقائها يا ترى؟
عزاؤنا في كل هذا الخلط هو اكتشاف الدكتور للفاعلين الاجتماعيين والثقافيين والسياسيين أخيرا، ( النخب السياسية والفكرية).
أخيرا، يقرّ الدكتور أن بقاء أو عدم بقاء رموز ثقافية ما يعود إلى الفاعل الاجتماعي و هذا، على الأقل، مكسب لعلم الاجتماع.
لكن، يبدو أننا لن نتفاءل كثيرا. فمباشرة بعد هذا، وعندما يبدأ التحليل للمثال التونسي تظهر مشاكل جديدة، ولكنها سوسيولوجية هذه المرة.
*******
- التبعية: المثال التونسي:
يقسّم الدكتور تحليله للتبعية الثقافية في تونس إلى نقاط مبوبة كما يلي: وصف " حال المجتمع التونسي" ثم يقدم ملاحظتين لتدعيم وصفه وبعد ذلك يقدّم عاملين لتفسير الظاهرة ليستنتج في آخر الفقرة أن ذلك " عبارة عن عملية إعادة إنتاج (Reproduction) حسب عبارة بيا ر بورديو ( ص11).
كتب الدكتور واصفا حالنا كما يلي:
" ينطبق هذا كثيرا على حال المجتمع التونسي الحديث. فالنخب السياسية والفكرية والمسؤولون ذ وو المراكز الحساسة وأغلبية الشرائح الاجتماعية المتعلمة لفترة ما بعد الاستقلال هي فئات يغلب عليها التعا طف مع لغة وثقافة و ا يديولوجيا المستعمر الفرنسي، أو الغرب عموما، أكثر من تعاطفها مع اللغة العربية وثقافتها ورؤيتها للحياة.و هذا ما أطلقنا عليه " ظاهرة التخلف الآخر" (ص10).
ثم يواصل قائلا: " والحال أن علاقة التونسيين المتعلمين بلغتهم الوطنية ليست بخير بعدما يقرب من نصف قرن من الاستقلال. فهم لا يستعملونها بالكامل شفويا أو كتابيا، ولا يعارضون استعمال لغة أجنبية بينهم، ولا يبدون اعتزازا باللغة العربية أو عليها، ولا يوجد لديهم شعور عفوي قوي إزاء أولوية استعمالها بينه، ولا حس لمراقبة استعمال الكلمات والجمل الفرنسية، وأخيرا فالتونسيون المتعلمون اليوم يندر أن يعّرفوا بتلقائية هويتهم بلغتهم الوطنية ( اللغة العربية)، كما يفعل مثلا الألمان والإيطاليون والفرنسيون والأسبان" (ص 10-11).
و كذلك: " تفيد كل المؤشرات اليوم إلى وجود موقف جماعي سلبي لدى الأغلبية الساحقة من التونسيين المتعلمين بالنسبة إلى علاقتهم مع اللغة العربية" (ص11).
إذن الدكتور الذوادي يصّب غضبه على النخب السياسية والفكرية والإدارية ( المسؤولون ذوو المراكز الحساسة) وعلى " أغلبية الشرائح الاجتماعية المتعلمة لفترة ما بعد الاستقلال، وإذا عرفنا أن " الشرائح المتعلمة" في تونس توجد ضمن كل الطبقات والشرائح الاجتماعية ( عمال، فلاحون، فئات متوسطة، صناعيون، وتجار) فإن الغضب يطال الجميع تقريبا. وهو ما تؤكده عبارة " وحديث معظم الفئات التونسية الأخرى" (ص10) التي ذكرها الدكتور عند تعرضه لغياب مصطلح " الاستقلال اللغوي والثقافي".
أما ما هو أخطر، فهو أن الدكتور لا يتحدث عن عدم وعي هذه الفئات بالمسألة بل عن غياب
" التعاطف" و" الاعتزاز" و " الغيرة" و " الشعور العفوي القوي" و"الحس" و " التلقائية".
إن هذا التوصيف الكارثي لوضع اللغة العربية في تونس، بقطع النظر عن النوايا، هو توصيف مجاف للمنهج العلمي السوسيولوجي من ناحية، وللواقع التاريخي من ناحية أخرى.
بداية، لا بد من الاعتراف أن هنالك مشكلا لغويا في تونس، فنحن لن ندافع عن الرؤية المقابلة لما قاله الدكتور بصفة عامة، لكن التوصيف الذي قدّمه يستحق النقد بصرامة.
أولا: من الناحية العلمية النظرية، نعتقد أن الدكتور يتناول " النخب" الفكرية والسياسية والإدارية وغيرها، وكأنها نخب متجانسة تماما وكلها على نفس الموقف دون أن ينتبه إلى أن هذه النخب منقسمة على بعضها البعض ومتناقضة ومتصارعة أحيانا حتى في مسألة الثقافة.
وعندما يتناول الدكتور تلك النخب، يفهم منه أن المؤسسات ( حيث تعمل النخب) السياسية والتعليمية والإدارية، هي تقريبا " أجهزة" ( حسب تعبير ألتوسير) " لإعادة إنتاج"، " لغة وثقافة و ايديولوجيا المستعمر، أو الغرب عموما؟" وليست " حقولا" ( حسب تعبير يباربورديو، الذي يقول الدكتور أنه يوافقه)، و " الحقول" تتميز عن " الأجهزة"، حسب بورديو في أنها ذات استقلال نسبي وأنها مسرح " لعب" وصراع ومجال لرهانات مختلفة.. ( م27 ، ص ص 69 ـ71).
لذلك فإن " إعادة الإنتاج" التي يتحدث عنها الدكتور، يجب تنسيبها بطريقة " توليدية" على الأقل، إذا وقفتا عند بورديو.
من ناحية أخرى، منهجية، عند توصيف "حال المجتمع التونسي" و مبالغته الشديدة، حسب اعتقادنا، في الحديث عن غياب التعاطف والاعتزاز والغيرة والشعور العفوي القوي والحس والتلقائية، في التعامل مع اللغة العربية والثقافة العربية، لم يقدم لنا الدكتور هذا الوصف استنادا إلى أبحاث ميدانية دقيقة ذات مصداقية علمية، على الأقل على حدّ علمنا، بل على ما يبدو على أساس تأمل ذاتي وبهدف شدّ الانتباه لأطروحاته.
إن الدكتور لا يعطينا أية معلومة عن دراساته الميدانية، ولا عن طرقه الخاصة التي مكّنته من معرفة درجة وجود أو غياب التعاطف والغيرة والاعتزاز عند التونسيين بلغتهم وثقافتهم العربيتين.
إننا نعتقد أن تحليل الدكتور للمثال التونسي عن التبعية الثقافية هو مثال سيء عمّا يجب أن يكون عليه علم الاجتماع الثقافي نظريا ومنهجيا. ونرى أنه مخترق بالكامل برأي الإسلاميين خاصة أولئك الذين يكادون يشككون في عروبة الشعب التونسي وإسلامه، وخاصة نخبه السياسية والعلمية و الإدارية والشرائح المتعلمة فيه. و إننا نعتقد أن هذا الموقف هو ردة فعل عن عمق مشكل التبعية في تونس لكنه ردّ فعلي عاطفي، حسي، عفوي قوي، وليس علمي.
وإذا ربطنا هذا التوصيف بمفهوم الدكتور عن الهوية فإنه يصبح تشكيكا تاما في عروبة كل التونسيين المتعلمين وإسلامهم فعلا.
فهو يقول عن الهوية، والعصبية الثقافية: " إن ما نعنيه بالعصبية الثقافية هو اشتراك الأفراد والجماعات والمجتمعات في رموز ثقافية متجانسة ومتشابهة يدفعهم إلى التقارب والتضامن بعضهم مع بعض بطريقة تلقائية يغلب عليها الحماس العاطفي في المساندة والدفاع عن الذين يشتركون معهم في تلك الرموز الثقافية" ( م 1 ، ص 58).
يبدو، بهذه الصفة، أن التونسيين هم، حسب الدكتور، خارج " العصبية الثقافية" العربية الإسلامية.
ثانيا: يكتفي الدكتور، عند تقديمه وصفه لحالتنا، بملاحظتين " تعززان" قوله كما يعتقد:
- " غياب شبه كامل منذ الاستقلال ( 1956) لمصطلح " التحرر / الاستقلال اللغوي الثقافي" من قاموس السياسيين، ومن نقاش المفكرين والعلماء والمسؤولين التونسيين، وحديث معظم الفئات التونسية الأخرى"( ص10)
- " غياب كامل بعد الاستقلال لحملات وطنية توعوية لصالح اللغة العربية ( اللغة الوطنية)" (ص10).
إننا نعتقد أن في هاتين الملاحظتين تجنيا كاملا على التاريخ التونسي المعاصر.
أولا على الدكتور الذوادي أن يرجع إلى برامج كل الأحزاب السياسية التونسية وسيرى أنها جميعا تتحدث عن التعريب. وبإمكانه على الأقل ألا يظلم قسما من تلك النخب، التي رفعت أيضا شعار " الثقافة الوطنية" عاليا منذ الاستقلال.
كل التنظيمات اليسارية والقومية، إضافة إلى الإسلامية، رفعت شعارات التعريب والثقافة الوطنية، وحتى بعض اليساريين الذين رفعوا في مرحلة ما شعار " اللغة التونسية"، كانوا يفعلون ذلك انطلاقا من تصور ما عن الوطنية وليس انطلاقا من تبعية للغرب بالضرورة.
حتى النخب الحاكمة ( وهي التي قد يعنيها الدكتور في المقام الأول)، رفعت شعار تونسة الثقافة أحيانا وتعريبها أحيانا أخرى. وإذا كانت هذه النخب الحاكمة تتحمل المسؤولية الأساسية فيما نحن عليه، فذلك لا يعني أن عالم الاجتماع، بهدف نقدها، يزّور الوقائع أو يتجاهلها.
إن الحركة الوطنية التي وصلت إلى الحكم بعد الاستقلال، لم تنجز كما يجب عملية التعريب والدفاع عن الثقافة الوطنية، لكن ذلك لا يعني تناسي محاولاتها الإصلاحية، المحدودة، والتي لم " تفك الارتباط" فعليا " بالغرب"، ولا يعني معاملة تلك الحركة بكاملها وكأنها كتلة متجانسة في موقفها من التعريب والثقافة الوطنية. ( م 40)
ان موقفا من هذا النوع سيكون عدميا تجاه بعض أهم أعلام ثقافتنا و على رأسهم الكاتب محمود المسعدي
الذي كان من وزراء التربية الأوائل في تونس و لا يمكن أن يزايد عليه أحد في الدفاع عن العربية.
من ناحية أخرى، إن الدراسات العلمية التونسية حول التعريب موجودة، ومن الغريب أن دكتورا في علم الاجتماع يتجاهل ( أو يجهل) أعمال اللسانيين وعلماء التربية حول أهمية التعريب باعتباره شرطا للتحرر اللغوي والثقافي. ويكفي أن نذكر الدكتور بأعمال الدكتور أحمد شبشوب و عبد السلام المسدي و الطيب البكوش و عبد القادر المهيري و صالح القرمادي....
إنه من غير المعقول تماما أن يقدّم لنا الدكتور الذوادي نفسه وكأنه أول باحث تونسي يستعمل مصطلح " التحرر/ الاستقلال اللغوي الثقافي".
إن علم الاجتماع في تونس، فتح عينيه منذ البداية على أعمال الدكاترة عبد الوهاب بوحدبية والطاهر لبيب و عبد القادر الزغل و خليل الزميتي و رضا بوكراع و غيرهم كثر. وكل هؤلاء كانوا أنصارا للعربية لغة وثقافة حتى لو اضطر بعضهم إلى الكتابة بالفرنسية لاعتبارات معينة، ( مثلا عند إعداد أطروحات في فرنسا).وهنالك أساتذة اهتموا بالمسألة مباشرة لا يذكرهم الدكتور رغم أنهم زملاؤه في نفس قسم علم الاجتماع . ( م 41 )
وأخيرا، يقول الدكتور أن التونسيين يحتفلون سنويا بعيدي الجلاء العسكري و الفلاحي للاستعمار الفرنسي من الأراضي التونسية، ( في حين)، لا يكاد يذكر الجلاء اللغوي الثقافي، ناهيك عن المناداة به بصوت عال، خاصة من طرف النخب وأصحاب القرار" (ص10)
ونحن نرى أنه لا غرابة في الأمر، ربما ، لأننا ندرك يا دكتور أن الجلاء العسكري و الزراعي هو جلاء " للوجود المادي للمستعمر"، أما " الوجود الرموزي للمستعمر" فلا ينطبق عليه مصطلح " الجلاء" أو لنقل أن النخب التونسية استثقلت مصطلح " الجلاء اللغوي والثقافي" لأنه ذو خصوصية كبيرة مقارنة بالجلاء العسكري والزراعي .
ربما يعود الأمر لكلمة " جلاء" بوصفها رمزا لغويا لا يرمز بدقة ( مثلما هو الأمر في الميدان العسكري والزراعي)، إلى ما يجب أن يتم في الميدان " الرموزي الثقافي" ولا إلى الطريقة التي يتمّ عبرها.
لهذا، اختار التونسيون، عبارة " التعريب" و " الثقافة الوطنية" عوض " الجلاء اللغوي والثقافي".
من ناحية أخرى ، يفترض في التونسي أن يحتفل بإنجاز حققه وليس بأمر لم يحققه بعد مثل
" الجلاء اللغوي و الثقافي " و بالتالي يصبح عدم احتفال التونسيين به دليلا على وعيهم بعدم تحققه.
ثانيا: عندما يقول الدكتور أنه بعد الاستقلال كان هنالك " غياب كامل" لحملات وطنية توعوية لصالح اللغة العربية ( اللغة الوطنية)" فهو لا يجانب الحقيقة بصورة عامة. ولكن، هل " الحملات الوطنية التوعوية" هي ما تحتاجه اللغة العربية في تونس؟
إن الدكتور يقدّم المسألة وكأنها مقاومة لوباء أو أية مسألة مشابهة تستحق من حين لآخر " حملات وطنية توعوية"، إنه يحول ، دون أن يشعر، مسألة الاستقلال اللغوي والثقافي إلى مسألة كاريكاتورية تقريبا.
قد تكون مثل هذه الحملات ضرورية، ولكن المهم هو أمر آخر على المستوى التعليمي وعلى مستوى حركة الترجمة وعلى مستوى الإعلام عموما..
إن المطلوب " سياسة لغوية وثقافية" جديدة تماما، تكون مرتبطة بسياسات اقتصادية واجتماعية جديدة وبعلاقات جديدة مع الدول العربية والشعب العربي وليس " رفع شعارات" والقيام " بحملات وطنية توعوية" فقط!
إن علم الاجتماع اللغوي والثقافي، عندما يدرس حالة التبعية اللغوية والثقافية، يربط الظاهرة بأبعاد المجتمع التابع وعلاقاته بالمركز ( إذا أردنا استعمال عبارات سمير أمين)، في إطار ما يدعي الدكتور أنه يدعو إليه من " تحليل معقد" و هو لا يركز على " الخصائص الجوهرية للرموز الثقافية" للمستعمر كسبب لاستمرار تلك الرموز " الخالدة" في المجتمعات التابعة.
كما أن علم الاجتماع الثقافي، في إطار وظيفته النقدية، لا يستطيع أن يقف عند التذكير ببعض أبيات تلهب الحماسة الوطنية كما يفعل الدكتور مع شاعرنا أبي القاسم الشابي، إنه يذكر أيضا، وشعريا ، بما قاله المتنبي حول علاقة الرأي بشجاعة الشجعان " فهو أول، وهي في المقام الثاني".
ومن حسن الحظ، أن الدكتور عندما يذكر العوامل التي أدّت إلى الحالة التي عليها اللغة والثقافة العربيتان في تونس، يرجع إلى جادة السوسيولوجيا نسبيا ويقول بوجود " عاملين أساسيين"
" تأثير الاستعمار الفرنسي في إقصاء اللغة العربية" من ناحية و " التونسيون المزدوجو اللغة والثقافة، أو المفرنسون، الذين أخذوا زمام الأمور في تسيير شؤون البلاد بعد الاستقلال من ناحية ثانية "(ص11).
وكان عليه ألا يرى العامل الثاني " الفاعل الاجتماعي" فقط بوصفه فاعلا " مفرنسا" أي " فاعلا رموزيا، بل، ربما، بوصفه فاعلا تابعا، في" مركب" مظاهر التبعية المختلفة.
إن المسألة لا تكمن في ثنائية " الفاعل المفرنس" ضد " الفاعل المعرّب أو المتونس" لغويا وثقافيا فقط. إنها مسألة صراع بين الفاعل الوطني المتعدد الأبعاد، المركب، المعقد، والفاعل التابع من جميع جوانبه تقريبا، وقد لا يتطلب الأمر مجرد " سلسلة من الإصلاحات" بل سياسة ثقافية ولغوية جديدة تماما.
****
ب- الازدواجية اللغوية والثقا فية:
مقارنة بتحليله لظاهرة " التبعية" يختصر الدكتور الذوادي كلامه عن " الازدواجية اللغوية والثقافية" إلى حد كبير، فهو لم يكتب في مقاله " في أبجدية الرموز الثقافية" سوى عامود وبضعة أسطر فقط.
كما أنه لم يعرف لنا معنى " الازدواجية اللغوية والثقافية" ولا أي مصطلح آخر، مثل " التعددية اللغوية والثقافية" أو " الأحادية اللغوية والثقافية" ولم يقل لنا لماذا اختار مصطلح " الازدواجية" عوض " الثنائية اللغوية والثقافية"....
إن هذا الاختصار الشديد قد تبرره اعتبارات تقنية عند كتابة مقال لمجلة، لكن على شرط ألا يضر ذلك بالوضوح المعرفي المطلوب في مثل هذه المسائل.
إن تحليل ظاهرة " الازدواجية اللغوية والثقافية" لا يمكن أن يستقيم دون البدء بظاهرة التعددية اللغوية والثقافية وأشكالها الخاصة، لأن التعدد اللغوي الثقافي ينتج الازدواج اللغوي الثقافي.
يطلق مصطلح التعددية اللغوية مثلا، على نوعين من الوضعيات عادة.
أولا: وضعية وجود لغتين متباينتين أو أكثر داخل مجتمع متعدد ( عربية – بربرية).
ثانيا: وضعية وجود لغة أجنبية مع لغة محلية ( فرنسية – عربية مثلا)
أما مصطلح الثنائية اللغوية أو الازدواجية اللغوية فيطلق عادة عند " استعمال منظومتين أو أكثر، من جانب المتكلمين في متحد واحد والثنائية اللغوية ليست سوى حالة قصوى من التعددية اللغوية" ( م42 ، ص115)
ويطرح مصطلح الازدواجية اللغوية إذن بشرط مزج لغتين في " متّحد واحد" يستعمل من قبل المتكلمين.
وينطبق هذا المصطلح، ليس فقط على استعمال لغتين مختلفتين تماما، بل يطبقه علماء الاجتماع اللغوي أيضا على ظاهرة الازدواج بين الفصحى والعامية عند بعض الشعوب.
وفي المغرب العربي، الذي يركّز عليه الدكتور متناسيا المشرق ( الذي يبدو أنه لا ازدواجية فيه)، توجد ثلاثة أصناف كبرى من الازدواجية اللغوية.
ازدواجية عربية – فرنسية ( بربرية – فرنسية)
ازدواجية عربية – بربرية
ازدواجية فصحى – عامية
إن ما يهم الدكتور الذوادي هو طبعا الازدواجية الفرنسية – العربية، لكن الوقوف عند هذا الحد من التحليل يجعل هذا الأخير منقوصا، لأنه على البحث العلمي أن ينتبه لأمرين؛
أولا: هل أن الازدواجية اللغوية الموجودة بين الفرنسية – العربية، هي ازدواجية الفرنسية مع العربية الفصحى، أم ازدواجية الفرنسية مع اللهجة العامية التي يستعملها المتكلمون يوميا؟
ثانيا: على البحث الاجتماعي اللغوي أن يبحث عند الازدواج اللغوي ضمن متحد العامية، عن كيفية تعامل اللسان العامي المغاربي مع اللغة الفرنسية، هل هو يذوب فيها تماما ( أو كثيرا)، أم أنه، في تونس مثلا، يخضعها لمنطقه الخاص نسبيا عبر إحداث عمليات تحويل صوتية ونحوية على المعجم الفرنسي الذي يستعمله بحيث يحاول ( ولكن بصعوبة شديدة بسبب ثنائية الفصحى / العامية مثلا)، هضم ما يأخذه عن الفرنسية صوتيا ونحويا، ضمن ما يسمى بنحو العامية التونسية.
ولو دقّق الدكتور الذوادي في هذه الأمور للطف قليلا من هجومه على كل نخب الشعب التونسي وفئاته ونسّب استنتاجاته العلمية قليلا.
هل يعني هذا أن الازدواجية اللغوية غير موجودة؟
قطعا هي موجودة ، هنالك عائلات تونسية تكاد تتخاطب بين أفرادها باللغة الفرنسية تقريبا.
هنالك فئات متعلمة تونسية تتخاطب فيما بينها تقريبا بالفرنسية، خاصة عندما يكون موضوع الخطاب علميا مثلا.
هنالك من يعتبر أن الفرنسية وحدها يجب أن تكون لغة تدريس العلوم.
هنالك من يعتبر أن اللغة والثقافة العربيتين تجمّدتا، ( خاصة اللغة)، وأنه لا يمكن اللحاق سريعا بالمعرفة العالمية إذا ركزنا جهودنا على الترجمة وتعريب التعليم في الوقت الحاضر.
هنالك حالات أخرى عديدة جدا من المواقف حول هذه المسائل، لكن، مع كل هذا، لا يعتبر التحليل الكارثي للظاهرة هو الحل الذي سيجعل الناس يستيقظون من حالة انعدام " الحس" و " الاعتزاز" بلغتهم وثقافتهم.
هنالك ازدواج لغوي ثلاثي المظهر، من ناحية هنالك تداخل معجمي بين الفرنسية والعامية. ومن ناحية أخرى، هنالك نوع من التقسيم الاستعمالي بين الفرنسية ( في المواضيع العلمية) والعامية في الشؤون اليومية ومن ناحية ثالثة هنالك فئات تتكلم الفرنسية تقريبا حتى في حياتها اليومية، وأخرى تتكلم العامية التونسية، التي يوجد فيها تداخل لغوي نسبي.
وهذا الازدواج مرتبط بثنائية أخرى هي ثنائية العربية الفصحى مع العامية التونسية، و"ضعف نسبي"، في تونس، " للغة الوسطى" ، التي يفترض أن يدعمها الإعلام الوطني خاصة، وكذلك بعض الفنون مثل الغناء و المشرح وغيرهما . المشكل إذن عام. وقد أحسن الدكتور، عند طرح الحلول ،عندما نبّه إلى ضرورة تجنب بعض الأفكار مثل ربط رهان التنمية بالمحافظة على ازدواجية لغوية وثقافية.
لكن في المقابل، لم يرفض الدكتور " الازدواجية " اللغوية والثقافية بكل أصنافها (ص11)
بل اقترح علينا ما يلي:
" في المقابل ترحّب رؤيتنا إلى الرموز الثقافية بالازدواجية اللغوية والثقافية التي تحافظ فيها اللغة الوطنية وثقافتها على الأولوية والصدارة في قلوب وعقول وسلوكات مواطني ومؤسسات المجتمعات النامية، كما هو الأمر في " المجتمعات المتقدمة". ذلك أن تعلّم اللغات الأجنبية وثقافتها في هذه المجتمعات يمثل فقط وسيلة انفتاح على الآخر. لا يربك ولا ينسف مناعة اللغة الوطنية وثقافتها. ولا يخلق أعراض مركّب النقص والتحقير للذات بين المواطنين"(ص11)
إن هذا الحل الذي يقدمه، يخلط بين حالة " الازدواجية اللغوية و الثقافية" وبين " تعلم اللغات الأجنبية وثقافتها" هذا أولا.
وثانيا يبدو لنا أن مثال الكيبيك في كندا، ربما يكون قد أثّر على الدكتور و قد يعنيه عندما يتحدث عن " المجتمعات المتقدمة" ( والتي لا نعرف لماذا يضعها بين هلالين مزدوجين).
إن القبول بازدواجية لغوية وثقافية من نوع خاص، " تحافظ فيها اللغة الوطنية وثقافتها على الأولوية والصدارة" قد يفتح الباب لعملية قياس اجتماعي سيء بين مجتمعات مختلفة تماما وتتطلب حلولا مختلفة تماما.
يمكن فهم قبول مواطن في كيبيك في كندا بنوع من الازدواجية اللغوية والثقافية بشرط المحافظة على أولوية الفرنسية – الكبيكية ، فالمجتمع هنالك متعدد اللغات ( فرنسية- إنجليزية- مع لغات ولهجات السكان المحليين)، أما الوضعية في المغرب العربي فمختلفة، قد يكون المطروح فيها المطالبة صراحة بأحادية لغوية ( تجاه الفرنسية وليس تجاه البربرية أو تجاه اللهجات العامية) وثقافية مع القبول طبعا بـ" تعلم اللغات الأجنبية وثقافتها".
إن تونس ليست مقاطعة الكيبك وإن الازدواج اللغوي المرتبط بتعددية لغوية داخلية في دولة متعددة اللغات والقوميات ككندا. يختلف تماما عن الازدواجية اللغوية بين لغة المستعمر ( بكسر الميم) ولغة المستعمَر ( أو لهجته المحلية).
ج- حول " حوار وصدام الثقافات":
يبدأ الدكتور بعد كتابة العنوان الفرعي المذكور أعلاه بتذكيرنا عبر هامش في أسفل الصفحة يقول فيه: " نفضل استعمال كلمة " الثقافات" بدل " الحضارات" في تحليل مسألة الحوار أو الصّدام بين الأمم والمجتمعات، إذ أن الثقافات هي المؤسسة للحضارات وتجلياتها، بما في ذلك القدرة على الحوار والصدام مع الآخر"(ص11).
يقول الدكتور إنه يفضل استعمال كلمة "ثقافات" بدل " حضارات" "في تحليل مسألة الحوار أو الصدام بين الأمم والمجتمعات" ونسأله، لماذا لم يجعل من عنوان دراسته الفرعي " حوار وصدام المجتمعات و الأمم" ويريحنا؟
إن عالم الاجتماع الذي يدعو، كما يوهمنا الدكتور إلى تناول الظاهرة الاجتماعية " كظاهرة اجتماعية كلية"، عادة ما يحلل الصراعات أو الحوارات العالمية بين المجتمعات أو الأمم، أي بين فاعلين اجتماعيين كليين، وذلك باعتماد منهج " التعقيد" الذي يدرس تظافر العوامل المؤدية إلى الحوار أو الصراع، اقتصادية وسياسية وثقافية وغيرها.
وإذا أراد عالم الاجتماع أن يدقق في الموضوع فإنه، إذا كان يعترف بوجود صراع حتى داخل كل مجتمع على حدة ، يبحث في أطراف الحوار أو الصراع العالمي، ليس بين مجتمعات بكاملها، بل بين فئات أو طبقات أو نخب داخل تلك المجتمعات بحد ذاتها، هذا إذا لم يكن ينظر إلى تلك الأمم والمجتمعات على أنها كتل متجانسة كما يفعل الوظيفيون و العضويون و النسقيون المتطرفون.
لكن، يبدو أننا نطلب المستحيل من الدكتور لأن له نظرة أخرى مخالفة تماما. يقول: " فالاشتراك والتشابه بين التجمعات البشرية في الرموز الثقافية ( أعز شيء يملكه الجنس البشري) يعزّز بالتأكيد من الاستعداد والتحمس والقدرة على الحوار والتفاعل بين تلك المجتمعات"(ص11-12).
إن رؤية الدكتور للرموز الثقافية قادته مباشرة إلى " الاشتراك والتشابه بين التجمعات البشرية" ولم تقده إلى " أعز شيء يملكه "الجنس البشري" مع الأسف وهذا الأمر لا يطرح فقط مشكلا " سياسيا" بل وكذلك علميا.
علميا، ورغم اعتراف الدكتور بأن " الرموز الثقافية" هي " أعز شيء يملكه الجنس البشري" ، لم يذكر كلمة واحدة حول الطابع الكوني للرموز الثقافية الذي طالما أكّد عليه الاثروبولوجيون، مع اعترافهم بوجود أشكال خاصة، قومية، من هذه الرموز الكونية. اكتفى بالذهاب مباشرة نحو " التجمعات البشرية" التي هي تجمعات فرعية وجزئية ضمن " الظاهرة البشرية الكلية".
سياسيا عندما يذكر الدكتور " الاستعداد والتحمس والقدرة على الحوار والتفاعل بين تلك التجمعات " يتناسى نوعا آخر من " الاستعداد والتحمس والقدرة على الحوار ليس بوصفها " تجمعات بشرية" بل بوصفها جنسا بشريا.
منذ البداية، إذن يجرد الدكتور أعضاء " التجمعات البشرية" من أعزّ ما يملكونه كبشر، كأعضاء في الجنس البشري و يكتفي بأعز ما يملكونه كتجمعات فقط.
إذن، ما يهم الدكتور في تمييز الإنسان عن غيره من الكائنات، ليس ما يميزه كإنسان،كنوع، بل كعضو في " تجمعات بشرية" قومية ودينية بالأساس.
إن الأحادية في النظر إلى هذين المظهرين تؤدي، في كلتا الحالتين ( تغليب الإنساني العام أو تغليب خصوصيات التجمعات البشرية)، إلى خطر علمي وسياسي في نفس الوقت. والدكتور يختار الأحادية " التجمعاتية" على حساب وحدة الجنس البشري، وبالطبع، سيكون من الخطأ اختيار الوحدة البشرية، دون النظر إلى تنوعها أيضا.
بعد هذا، يدقق لنا الدكتور تصوره ويقول: " واللغة هي أهم عناصر المنظومة الثقافية لفتح أبواب الحوار والتواصل بين الأفراد والمجموعات البشرية" ( ص12) لأنه يعتقد كما رأينا سابقا أن اللغة هي أهم عنصر من الرموز الثقافية عموما، لكن من الغريب، بعد ذلك أن ينتقل الدكتور في تحليله نحو بعد آخر تماما.
يقول مواصلا: "ومن ثم يمكن القول بأن حوار الثقافات بين العالم الإسلامي والعالم الغربي يتطلب من الطرفين معرفة لغات بعضهم البعض"( ص12).
وكان عليه، لو كان متناسقا في تحليله أن يقول بأن حوار الثقافات بين العالم العربي ( وليس الإسلامي) والعالم الفرنسي / الفرانكفوني أو الإنجليزي /الأنغلوفوني
فبما أن اللغة هي أهم عنصر ضمن " أعز ما يملكه الجنس البشري" يفترض في تحليل متماسك، أن يصنف المجتمعات، أو " التجمعات البشرية" كما سماها، حسب " الاشتراك أو التشابه" اللغوي بالدرجة الأولى، وأن يدرس حوارها أو صدامها حول محور التصنيف اللغوي وليس حول أي محور آخر. وعند مواصلة التحليل، يذكر لنا الدكتور مثالا حول الولايات المتحدة طبعا.
يقول: " وهذا مفقود عند الطرف الغربي نخبويا و شعبيا، وينطبق هذا أكثر ما ينطبق على المجتمع الأمريكي، لا في جهله لغات العالم الإسلامي فحسب، بل أيضا في عدم معرفته اللغات الأجنبية بصفة عامة. وعلى العكس من ذلك، فإن لنخب العالم الإسلامي معرفة واسعة ومتمكنة بلغات المجتمعات الغربية المتقدمة"( ص12).
إننا لا نشك كثيرا في هذا التوصيف، لكن ما نلاحظه هو إجراء الدكتور مقابلة بين " المجتمع الأمريكي" وبين " نخب العالم الإسلامي" وهذه المقابلة ليست دقيقة. إما أن نقارن مجتمعا بمجتمع أو نخبا بنخب. وإذا كانت المقارنة، حتى بين " النخب الإسلامية" و" النخبة الأمريكية" تدل على " تفوق" إسلامي، لا بد من الاحتراز من هذا " التفوق" لأنه " تفوق حاجة وضعف" وليس بالضرورة تفوق " الاستعداد والتحمس والقدرة على الحوار والتفاعل".
لكن الدكتور يصّر على أن واقع النخب الإسلامية اللغوي وواقع شعوبها « يعزز عند المجتمعات الإسلامية هاجس التفتح والحوار مع المجتمعات الغربية، وخاصة الأكثر
تقدما " ( ص12)، على عكس الواقع في المجتمعات الغربية.
إن معرفة لغات الشعوب الأخرى هو طبعا عامل يساعد على التثاقف، ولكن لا يجب تعميم الأمر في اتجاه " الحوار والتفاعل" دائما. إننا قد نسعى لمعرفة لغة شعب آخر من باب " إعرف عدوك". إن اللغة حمالة معان، وهي وإن لم تكن يوما محايدة، (اذ هي وسيلة معرفة وتواصل وترميز عند الجنس البشري" وعند " التجمعات البشرية" كما يقول بورديو الذي يدعي الدكتور انه يوافقه في علم اجتماعه النقدي و يمارس مثله " حرفة عالم الاجتماع" ( م43.) تفعل فعلها في العلاقات، حوارا أو صداما، ارتباطا بمعطيات في الغالب " خارجة " عنها تقريبا، مثل المصالح والحاجات والمواقف والقيم والأهداف وغيرها.
إنه من القصور في التحليل العلمي أن نعتبر " الواقع اللغوي" عند النخبة أو عند الشعوب " عاملا حاسما" في " الاستعداد للحوار أو الصدام". وهذا مع الأسف هو ما يكاد يفعله الدكتور.
يقول: " في ضوء هذه المعطيات، لا يمكن الحديث عن المساواة في رغبة الطرفين الغربي و الإسلامي في الحوار" ( ص12).
لكن بعد المعطيات " اللغوية" فقط، يضيف: " فالهيمنة الغربية الحالية، وتاريخ الغرب الاستعماري للشعوب الإسلامية، تضعف كثيرا من استعداد وقدرة تلك المجتمعات على الحوار التلقائي والمتحمس والواعد مع المجتمعات الإسلامية" (ص12).
إذن، واقع الهيمنة الحالية و التاريخ الاستعماري وجهل " سواد المجتمعات الغربية" كلها تساهم في " الصدام"، لكن كما عوّدنا الدكتور لا بدّ من البحث عن " العامل الحاسم".
يقول لنا إن ما يزيد الطين بلّة هو أن هيمنة الغرب العالمية ومصالحه الكبيرة والمتنوعة في العالم العربي الإسلامي" (ص12)، تدفع ليس فقط لإضعاف الحوار بل " تشجع الغرب على الهجوم" (ص12)، وأكبر دليل على ذلك " السياسة الخارجية الأمريكية الصدامية لإدارة بوش الصغير"(ص12).
وماهو "العامل الحاسم"؟
يقول الدكتور: " وتأتي المنظومة الثقافية لإدارته بمثابة عامل حاسم في الصدام لا مع هذا العالم فحسب ( يقصد الإسلامي) بل مع المجموعة الدولية قاطبة" (ص12).
إن تتبع تحليل الدكتور يوصل إلى نتائج غريبة فعلا، في البداية يقول لنا إن " الواقع اللغوي" يجعل الحوار غير ممكن، وبعد ذلك يضيف عوامل التاريخ والهيمنة والمصالح ليقول إنها تدفع باتجاه " الهجوم" لكن حتى يرجعنا إلى " العامل الحاسم" يقوم بدورة تجعله يتنكر لتحليله الخاص.
ويقول لنا إن المنظومة الثقافية لإدارة جورج بوش الابن هي العامل الحاسم في الصدام مع العالم العربي الإسلامي، بل والمجموعة الدولية قاطبة.
إذن " إدارة" جورج بوش وليس " العالم الغربي" ولا حتى " المجتمع الأمريكي" نفسه هم أصحاب المصلحة وأصحاب " المنظومة الثقافية" الجزئية التي تدفع باتجاه الصدام الهجومي ضد العالم قاطبة.
إن الثنائية الأولى التي انطلق منها الدكتور: عالم غربي/ عالم إسلامي، ثم الثانية: المجتمع الأمريكي/ العالم الإسلامي تتحول إلى ثنائية إدارة بوش/ العالم قاطبة.
وإن الثنائية الأولى بين الغرب المسيحي/ والعالم الإسلامي ورموزهما الثقافية تتحول إلى ثنائية رموزية ثقافية لإدارة بوش/ العالم الإسلامي.
كان على الدكتور أيضا القيام بخطوة أخرى باتجاه تفكيك العالم الإسلامي تحليليا من خلال تنوع مصالحه وتاريخه ورموزه الثقافية المختلفة حتى يعبر لنا عن الواقع المتعدد والمتناقض عندنا أيضا. لكن، يبدو أن هذه المهمة صعبة جدا على مفهوم " العصبية الثقافية".
هنالك من هم من العرب المسلمين ( وليس لعلم الاجتماع أن يكفرهم) من يلعبون دور الفئات/ الطبقات والنخب التي " تنوب" عن إدارة جورج بوش و"منظومة رموزها الثقافية".
المسألة إذن، ليست صراع أو حوار حضارات أو ثقافات أو مجتمعات بأكملها أو أمم، إنها صراع/ أو حوار فئات وطبقات ونخب تدافع وتعبّر عن مصالح وأهداف خاصة.
إن " الرموز الثقافية" الغربية أو الأمريكية تنجب بوش مثلما تنجب نقيضه، تنجب بوش ويمينه المسيحي المتطرف والمتحالف مع الصهيونية مثلما تنجب مارتن لوتر كينغ و ظاهرة لاهوت التحرير و مثلما تنجب نعوم تشومسكي.
كما أن الرموز الثقافية الإسلامية تنجب الشيء ونقيضه أيضا، في الفكر والسياسة على حدّ السواء. وأمثلة الخلفاء الذين قتلوا المفكرين والشعراء والمتصوفة والفقهاء لا تحصى ولا تعدّ.
كفى " السوسيولوجيا" تكرار الثنائيات السرمدية من نوع " المخيال الغربي ( منظومته الثقافية) أصبح منذ ذلك التاريخ (غزو العرب المسلمين لأسبانيا)، ( نعم غزو ـ ص12)، متوجسا وخائفا وعدائيا" (ص12) و نقيضه ولكن شبيهه العربي الإسلامي، "خسارة الأندلس أدّت إلى تكوّن مخيال عربي- إسلامي حاقد " على الأسبان وعلى الغرب بصفة عامة".
إن هذه الثنائيات لا تقود إلا إلى تصور كارثي يعبر عنه الدكتور كما يلي: " وعليه، فإن المنظومة الثقافية السلبية إزاء " الآخر" عند مخيالي الطرفين ( الغرب والعرب المسلمين) مرشحة لأن تستمر إلى أجل غير مسمى. ذلك أن الرموز الثقافية ذات مدى حياة طويل قد يصل إلى الأبدية ومن ثم فإن المعطيات المبنية أعلاه لا تسمح بالتفاؤل للحديث عن توفر الشروط اللازمة لحوار حقيقي متكافئ فعلا بين الغرب والعالم العربي الإسلامي، إذ الطرف الغربي هو الأقل تأهلا اليوم للدخول بطيب نية ونزاهة وتحمس في مثل ذلك الحوار"(ص12).إنها الكارثة الآتية و السبب حسب الدكتور " النية والنزاهة والحماس" المفقودين تارة عند "مخيالي الطرفين" و طورا عند " الطرف الغربي" فقط .
المصادر و المراجع و الملاحظات
29 انظر: بودون، ريمون و بوريكو، فرانسوا، المعجم النقدي لعلم الاجتماع، تعريب سليم حدّاد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى: 1986، مواد: الرمزية الاجتماعية – الثقافوية والثقافة.
- *و كذلك
Encyclopédie Universalis, Dictionnaire de sociologie, Universalis- Albin Michel, Paris, 1998 : culture, contre culture...
-30- CHEVALIER, Jean et GHEERBRANT, Alain, Dictionnaire des symboles, R LAFFONT/ Jupiter, Paris, 1982, وخاصة مقدمة ج شوفالييه.
* ENCYCLOPEDIE UNIVERSALIS, symbole, symbolique, de Dominique jameux et Angele kremer-marietti.
31- MALSON. Lucien, Les enfants Sauvages, Ed 10/18, Paris, 1964.
32- موريس، ديزموند ، القرد العاري، دراسة للتطور العضوي والجنسي والاجتماعي للإنسان، تعريب ميشيل أزرق، مراجعة محمد قجة ، دار الحوار، اللاذقية- سوريا، الطبعة الثانية، 1995.
33- ابن كثير، اسماعيل ، قصص الأنبياء ، ووزارة الشؤون الدينية ، الجزائر، د ت .
34 - الذوادي، محمود، في طبيعة الذكاء الإنساني والذكاء الاصطناعي، تعريب سامية الفوناس، الحياة الثقافية، تونس، العدد 77، سبتمبر 1996.
35- الذوادي، محمود، كتاب المنهج لإدغار موران، الحياة الثقافية، تونس، عدد 81، جانفي 1997.
36- المسدّي ، عبد السلام، التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب، الطبعة الثانية، 1986.
37- المهيري ، عبد القادر، صمود حمادي و المسدي عبد السلام، النظرية اللسانية والشعرية في التراث العربي من خلال النصوص، الدار التونسية للنشر، الطبعة الأولى، 1988.
38- قطب، سيد، في ظلال القرآن، المجلد الأول، دار الشروق، القاهرة - بيروت، الطبعة الخامسة عشر، 1988.
39
, Staline Joseph, Le Marxisme et la question nationale et coloniale, Ed Norman Bethume, Paris.
ـ هنالك ترجمة عربية لكتاب ستالين " الماركسية و المسألة القومية " صادرة عن دار دمشق سوريا لبنان
40- أنظر مثلا * بن سلامة ، البشير، اللغة العربية و مشاكل الكتابة ، تقديم محمد مزالي ، الدار التونسية للنشر، 1986.
* الجمالي ، محمد فاضل (العراقي الأصل) ، دفاعا عن العربية، تقديم الأستاذ الشاذلي القليبي ، مؤسسات بن عبد الله ، تونس، 1996.
41- انظر مثلا:
* عبد المولى، محمود؛ مقدمات وأبحاث، الدار العربية للكتاب، 1982.
* وناس، المنصف ؛ الدولة والمسألة الثقافية في المغرب العربي، سراس للنشر، 1995.
42- قارمادي،جولييت ، اللسانة الاجتماعية ، تعريب خليل أحمد خليل ، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الأولى 1990.
43- بورديو، بيير، حرفة عالم الاجتماع، تعريب نظير جاهل ، دار الحقيقة، ومؤسسة باباي ، بيروت، الطبعة الأولى 1993.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. تستهدف زراعة مليون فدان قمح تعرف على مبادرة أزرع للهيئة ال

.. فوق السلطة 387 – نجوى كرم تدّعي أن المسيح زارها وصوفيون يتوس

.. الميدانية | المقاومة الإسلامية في البحرين تنضمّ إلى جبهات ال

.. قطب الصوفية الأبرز.. جولة في رحاب السيد البدوي بطنطا

.. عدنان البرش.. وفاة الطبيب الفلسطيني الأشهر في سجن إسرائيلي
