الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
الاسلام و علوم الاجتماع : محاولة في الدفاع عن العلم ضد -المنظور الثقافي الاسلامي- عند الدكتور محمود الذوادي (3)
بيرم ناجي
2012 / 7 / 27العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
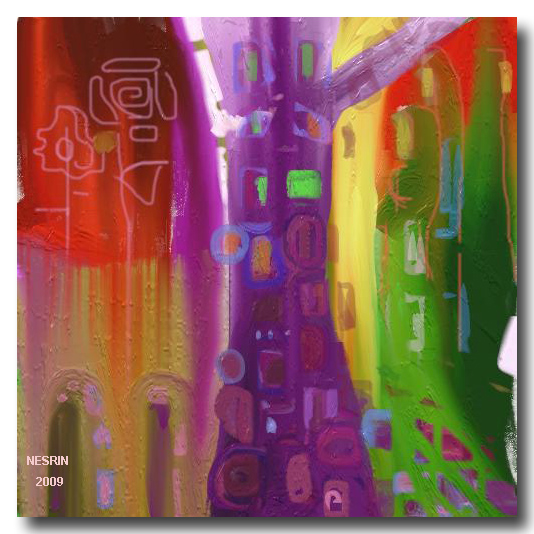
الفصل الثالث :ملاحظات نقدية حول كتاب: " التخلّف الآخر..."
يبدو أن " سوسيولوجيا الرّموز الثقافية " عند الدّكتور محمود الذوّادي لا تشكل تراجعا عن أبجديات كل من علم الاجتماع والعمران الخلدوني العربي فحسب ، كما ذكرنا في المقدّمة ، بل وكذلك حتّى عن أعمال سبق أن نشرها الدّكتور.
لتوضيح هذه الفكرة من ناحية، وللعودة إلى بعض النقاط التي سبق أن رأيناها، رجعنا إلى كتاب أصدره الدكتور سنة 2002 في تونس، تحت عنوان: " التخلّف الآخر (عولمة أزمة الهويّات الثقافية في الوطن العربي والعالم الثالث) " (م44 ) ، كما رجعنا إلى بعض المقالات الأخرى التي نشرها، والتي سنذكرها لاحقا كلما رجعنا إليها.
إن تراجع الدّكتور عن أفكاره السّابقة يقع ضمن المرحلة الفكريّة الجديدة التي وصل إليها في أبحاثه، انطلاقا من 1990 خاصّة. فقد قسّم هو نفسه مراحل تطوّر مشروعه العلمي إلى ثلاث مراحل، ارتباطا ببحثه فيما سمّاه "التخلّف الآخر".
- المرحلة الأولى : 1975- 1982، ركز فيها على جوانب لغوّية وثقافية وعلاقتها بشخصية التونسي وهوّيته الثقافية.
- المرحلة الثانية : 1982- 1990، وفيها ولد مصطلح التخلّف الآخر... وتطوّر من الجانب اللغوي الثقافي إلى المرحلة " النفسية-الثقافية" في إطار مزج بين علم النفس الاجتماعي وعلم اجتماع الثقافة تقريبا.
- المرحلة الثالثة : 1990-2001، ويمكن أن نمدّدها إلى التاريخ الحالي، وهي التي قال عنها الدّكتور :" لقد ركزنا جهودنا البحثية على إماطة اللثام عن الجوانب الميتافيزيقّية للرّموز الثقافية". (ص6-7)
*****
كان الجزء الأول من هذا العمل قد ارتبط بالنداء الذي وجهه الدّكتور في مجلّة "عالم الفكر" من أجل " تأصيل علم الاجتماع العربي..." و كذلك بالمقال الذي نشره في مجلة الآداب" حول "أبجدية الرّموز الثقافية..." فهو بذلك يعالج بعضا من آخر ما وصل إليه الدكتور في مساره العلمي، أي في مرحلته الحالية.
لكن من أجل استكمال الصّورة حول عمله، رأينا أنه من الواجب العودة إلى أهم ما نشره سابقا لتحقيق ثلاثة أهداف في نفس الوقت:
الأول ؛ مقارنة، ولو مختصرة جدّا، بين أفكار الدّكتور الحالية وأفكاره القديمة التي نشرها قبل "المرحلة الميتافيزيقية".
الثاني ؛ تلمّس تطوّر مفاهيمه السّوسيولوجية وبالتالي تسجيل التحوّلات التي حدثت عليها
الثالث؛ إلقاء الضّوء على التناقضات الدّاخلية في خطابه حتى داخل المرحلة الأخيرة نفسها.
إن هذه العملية ستساعدنا، من ناحية على إعطاء الدّكتور حقّه كاملا في الإيجابيات التي احتوتها أبحاثه القديمة، والتي أهملناها في الجزء الأول من هذا العمل.
و من ناحية أخرى ستساعدنا على تلمّس بعض التطوّرات التاريخية والنظرية الجزئيّة داخل المرحلة الجديدة من تفكيره.
و في هذا الجزء من عملنا، لن نـتبع مسارا خطيّا في الكتابة بل سنختار تقسيم المواضيع حسب بعض النقاط التي نرى أنها الأهم من غيرها.
1. حول "الثقافة" و"الرموز الثقافية "و" لمساتها الميتافيزيقية".
رأينا، في ما سبق من هذا العمل، كيف أن الدّكتور يقدم لنا تعريف الثقافة مساويا لتعريفه "الرموز الثقافية" وكذلك المنظومة الثقافية" ثم بينا أن استشهاده بتعريف ادوارد تايلور لم يكن يعني فعليا انه يتبناه وذلك لأن الدّكتور، في"المرحلة الميتافيزيقية" أصبح يضع حدودا واضحة بين "المادة" و"الروح" في الإنسان، بين "الجزء المادي من كينونته" و"جزء الرّوح الرموزيّة الثقافية" التي يربطها بالنفخة الإلهية الأولى.
كما رأينا، عند تحليل عناصر الرّموز الثقافية، كيف أن الدّكتور لا يذكر الفنون مثلا رغم أنه سنة 1998 قدم عرضا لكتاب مالك شبل "المخيال العربي الإسلامي " وفيه ذكر " مخيال عالم الجمال عند العرب المسلمين، بما في ذلك الفنون المعمارية المدنية و الدينية و العسكرية و في الخط العربي و الموسيقى و الغناء ..." ( م45 ،ص114) ، ولكن، من حسن الحظّ أننا عثرنا أخيرا على الفنّ في كتاب " التخلّف الأخر" وذلك عندما كتب يقول ان :" الرموز الثقافية تتمثل في المقام الأول في اللّغة والعقائد و منظموتي المعرفة والعلم والأعراف والقيم والمعايير الثقافية والقانونية أو الشريعة الدّينية والأخلاق والفنون." (ص 33)
ولكن من سوء الحظّ أن هذا التعريف يحمل عبارة " والقانون أو الشريعة الدّينية" وهي "أو" الوحيدة فيه، ولا نفهم لماذا استعمل الدّكتور حرف العطف ،"الواو"ّ، بين كل العناصر، لكنه عندما ذكر القانون تبعه ب "أو" هذه، وهي عادة ما ترد في صيغة التعويض. و كأنه يقول لنا، إما القانون، ربما في بعض المجتمعات، أو الشريعة الدّينية، في بعض المجتمعات الأخرى.
وإذا كان هذا الفهم هو الصحيح، فيبدو أننّا بصدد مشكلة جديدة في تعريف "الرموز الثقافية" تضع جدارا صينيا بين القانون "الوضعي" و"الشريعة الدينية"، كما لو أن هنالك ثقافات لا توجد بها سوى" قوانين" وأخرى لا توجد بها سوى "شريعة دينية" !
ونحن نعتقد أن هذا الأمر مخالف لكل مبادئ علم الاجتماع القانوني الذي يدّل على تمازج وازدواج التشريع "المدني" "الوضعي" و"الشريعة الدّينية" في كل المجتمعات تقريبا.
أما إذا كان الدّكتور، بهذه ال"أو"، يريد أن يحيلنا إلى ضرورة اعتماد العرب المسلمين على " الشريعة الدّينية" عوض القانون الوضعي، فذلك أمر آخر!
من حسن الحظ أيضا، أن الدكتور، في مناسبة أخرى لتعريف الرّموز الثقافية، يضيف عنصر "الأسطورة".
يقول : "... ما نسميه بعالم الرّموز الثقافية : اللّغة، العقائد، الفكر، المعرفة، العلم، القيم والأعراف والتقاليد الثقافية، الأساطير." (ص 07)
لكن مع الأسف أيضا، في مقام آخر، يعيد الدّكتور تعريفه للرّموز قائلا:"..الرّموز الثقافية : الكلمة والفكر والعقيدة والعلم والمعرفة والقيم والمعايير الثقافية والصّوت والصّورة."( ص 29)
وفي التعريف الأوّل، يكتفي الدّكتور بذكر الأسطورة، ولحسن الحظّ، دون موقف قيمي منها، فهو لم يذكرنا بـ "أساطير الأولين" واكتفى بذكرها بحياد معرفي انثربوسوسيولوجي.
لكن في التعريف الثاني يبدو أن الدّكتور يخلط بين الكلمة وبين اللّغة! وهو خلط غير مقبول تماما في علم الّلسانيات وعلم اجتماع اللّغة. كما أنه يدخل عناصر الصّوت والصّورة في الرّموز الثقافية، ناسيا أنهما قد يوجدان عند الجماد والحيوان على السّواء.
فالصوت، عندما يقدّم مخالفا لعبارة "الكلمة" التي وردت في أول التعريف، ومضافا إليها، يصبح أيّ صوت، سواء كان " صوت الرّيح أو الرّعد " أو أصوات الحيوانات.
أما الصّورة، فلا نعتقد أن الدّكتور ينفي أن للجبال والبحار صورا أيضا، مثلما للحيوانات و النبات، وأن الحيوانات تكوّن صورا عن محيطها أيضا، على الأقل الحيوانات التي لها حاسة البصر. أما إذا يعني بذلك، في إطار حديثه عن ثورة الاتصال الحديثة، العمل السّمعي والسّمعي البصري كنشاط تواصلي واتّصالي إنساني، فعليه تدقيق المصطلحات. فلا يعقل أنّ مشروع " بحث علمي أساسي" تقدّم فيه تعريفات لأهم" ما يميز الإنسان من رموز ثقافية" يقّدم بهذه الطريقة !
بقطع النّظر عن العناصر المكوّنة " للرموز الثقافية"، نلاحظ، كما ذهبنا إلى ذلك في الجزء الأول من هذا البحث، أن الدّكتور، في المرحلة الميتافيزيقية، يكتفي بتعريف الثقافة بجوانبها الفكريّة تقريبا. فهو كما قلنا، لا يوافق فعليا على التعريف التايلوري لها حتى رغم ادّعائه بذلك، خاصة في أعمال سابقة عن "المرحلة الميتافيزيقية".
صحيح أن الدّكتور ذكر في مناسبات عديدة أنه يتبنى التعريف الانثربولوجي للثقافة عندما كتب سنة 1986 " نستعمل كلمة الثقافة culture في معناها الانثربولوجي العام لتايلر E taylor وهو مرادف عنده لمصطلح حضارة Civilisation , ونحن نستعملهما كمرادفين." (ص 49)
و كذلك عندما كتب سنة 1983أن اللّغة والعقائد هي " المكوّنات غير المادّية لظاهرة الثقافة. أمّا عناصر الثقافة المادّية فتتمثل في كل الأشياء التي يصنعها الإنسان كالمسكن والأدوات والملابس...وغيرها " (ص 113).
و كذلك عندما تحدّث عن مصطلح " الموارد الثقافية " ذكر أنها " الموارد الثقافية غير المادّية كما سبق شرحها..."( ص 119). وهو يعني بذلك وقتها، أن هنالك موارد ثقافية مادّية أيضا.
لكن، عند التدقيق في أفكاره، خاصّة في المرحلة التي بدأت في سنة 1990، أي ما سمّيناه نحن " المرحلة الميتافيزيقية" في تفكيره، نلاحظ أنه يعني بالثقافة، والرّموز الثقافية، عالم الأفكار واللّغة ليميزها عن الحضارة، كما سبق أن رأينا في نقطة : "حول حوار وصراع الثقافات" وفي كل أطروحاته الأخرى حول "الرّموز الثقافية"
من ناحية أخرى كان من الممكن للدّكتور أن يميّز بين الثقافة عموما والجانب الرّمزي فيها، لكنه لم يفعل. فهو، على طول الكتاب "التخلّف الأخر..." أيضا، لم يعرّف معنى " الرّمز" و"الرّموزي" تماما !.
انّه يكتفي بسرد العناصر المكوّنة للثقافة، أو ما يسميه هو بالرّموز الثقافية. ثم يذكرنا من حين لآخر بأنّ اللّغة هي أهم تلك الرّموز بلغة "عضوية" تماما قد تخلق مشاكل في التحليل.
يقول مثلا : "اللّغة هي أمّ الرّموز الثقافية جميعا (... وهي) في شكلها المنطوق والمكتوب أهمّ تلك الرّموز الثقافية جميعا... وهي العمود الفقري بالنسبة لظاهرة عالم الرّموز..." (ص 33)
و نرجو ألا يستنتج الدكتور من فكرة "الأمومة اللغوية" هذه أن اللغة سابقة عن التفكير البشري وهو ما قد تعنيه قراءته "القرآنية" للخلق لو أردنا دفع التحليل إلى أقصاه .
بعد ذلك يذكّرنا ( ص52 )، أنه يوافق في أفكاره C.Geertz، وكان بامكانه طبعا أن يذكّرنا بغيره من الفلافسة والعلماء الذين سبقوا غيرتز في هذا الأمر و يختلفون مع الدكتور بسبب ربطهم الرموز بكل مظاهر الحضارة و خاصة ارنست كاسيرير (في كتابه الشهير ؛ "فلسفة الأشكال الرمزية" ) .
لكنه، في المقابل، يذكّرنا أيضا، بأنّ "الوطن العربي" ظاهرة فريدة (أنظر لاحقا العنصر الخاصّ بهذه المسألة) من نوعها في مجال عالم الرّموز الثقافية، من حيث أهمية العامل الدّيني و وزنه ، وذلك ليهيئنا، لاحقا، كما رأينا في الجزء الأول من هذا البحث، إلى استعمال مصطلح " الثقافة الإسلامية العربية " بدلا من ّ الثقافة العربية الإسلامية " ناهيك عن " الثقافة العربيّة " التي تحتوي أيضا "الثقافة العربية المسيحية " و" العربية الإحيائيّة " و"العربيّة الملحدة والعلمانيّة" .. إلخ.
انّ " أمّ الرموز " و" أهمها " و "عمودها الفقري " تكفّ عن كونها مقياس التعريف والتصنيف الاجتماعي عندما يتعلّق الأمر بالعرب المسلمين !
***
رأينا سابقا، عندما تعرّضنا إلى " نداء من أجل تأصيل علم الاجتماع... " في مجلة " عالم الفكر " و خاصّة في مقال " أبجدية الرّموز الثقافية..." الذي نشر في مجلّة الآداب، ما سمّاه الدكتور " المعالم الخمسة للرّموز الثقافية ". ولن نعود إلى نقاش مضمون هذه " المعالم " الآن، لكن نودّ فقط الإشارة الى ما يلي:
• أوّلا : إن الدّكتور، عندما عرض علينا هذه " المعالم الخمسة للرّموز " قدّمها لنا بصورة ضبابية، فقد كتب ما يلي حول : المعالم الخمسة للرّموز الثقافية " :بالنظر المتعّمق إلى جوهر طبيعة الرّموز الثقافية عند الجنس البشري تبين أنّها" تتّسم بلمسات غير مادّية/متعالية/ميتافيزيقية تجعلها تختلف عن صفات مكوّنات الجسم البشري وعالم المادّة " (م 2 ، الآداب ص8)
وبهذا التقديم، لا نعرف بدقة ما إذا كان الأمر متعلّقا " بمجرد " لمسات" أم : "بجوهر طبيعة " وصفات و مكوّنات " الرّموز الثقافيّة". إن هذا التردّد والغموض، حسب رأينا، نابع من تمزّق/ تـأليف الدّكتور بين " علم الاجتماع والفلسفة والدّين " كما قال هو نفسه. ونحن نعتقد أن الدّكتور يميل أكثر باتجاه تحويل تلك " اللمسات " إلى خصائص جوهريّة في " طبيعة " و " صفات مكوّنات " الرّموز "، مقابل صفات مكوّنات "الجسم البشري وعالم المادّة".
إن الدّكتور يقوم بعمليّة تحويل لمركز اهتمام علم الاجتماع، من تقديم وبحث " الجوانب الرّمزية للثقافة الاجتماعية "، مثلما تفعل ذلك اللّسانيات و الانتربولوجيا وعلم الاجتماع الثقافي، إلى تركيز على " الجوانب الميتافيزيقيّة للرّموز " نفسها ! وهو بهذه الصّفة يخرج البحث العلمي السّوسيولوجي من دراسته الرّمزية الاجتماعية في السلوك البشري إلى دراسة الميتافيزيقا الخفيّة في تلك الرّموز نفسها، إلى درجة نزع صفة الاجتماعية عنها، عبر ربطها بالنفخة الإلهية وتشبيهها بالكائنات الماورائية وتحديدا بالرّوح، والى درجة تشبيه الإنسان بالإله أحيانا، أو بآدم الأول أو بالمسيح أحيانا أخرى كما سبق أن رأينا.
• ثانيا : ذكرنا سابقا، في معرض تعليقنا على " المعالم الخمسة..." أن الدّكتور كان بامكانه تقديم عشرات المعالم لرموزه، عند مقارنتها " بالمادة " أو بالجسم البشري " وقلنا أنّه بامكانه القول أنّ الرّموز ليست لها رائحة أو دماغ أو أعضاء تناسلية...الخ.
وفعلا، عثرنا في كتابه "ّ التخلّف الأخر " على هذا الأمر، يقول : " إن خصوصيّة عالم الرّموز الثقافية تتجلّى ملامحها عند مقارنتها بعناصر أخرى هي من صلب كينونة الإنسان. فجسم الإنسان ورائحته هما جزء من تلك الكينونة. وكذلك الشأن بالنسبة للكلمة المنطوقة، المكتوبة والصّوت." ( التخلّف الأخر ص30)
ويربط الدّكتور ذلك في الصفحة الموالية بثورة الاتصالات فيقول : " وبينما عجزت أرفع الأجهزة التكنولوجيّة التواصليّة ل(على) نقل رائحة أجسامنا فيتمكّن من شمّها الآخرون حتى على مسافات غير شاسعة، نجحت تكنولوجيا التواصل حتى في أبسط مراحل تطوّرها (المذياع والهاتف) في إرسال الكلمة والصّوت.." (ص31)
ويستنتج أن الأمر راجع، ليس إلى اختلاف وخصوصّية نقل وتنقل الصّوت والرّائحة والصّورة، بل الى الطّابع الميتافيزيقي للصّوت والصّورة نفسيهما.
انّ الدّكتور لا يقول لنا إن الأمر راجع إلى اختلاف بين حاسّة الشّم والرائحة (و الغازات) من ناحية، وبين حاستي السّمع والبصر، وسرعة انتقال الصوت والصّورة (الضّوء) مقارنة بالغاز ، بل بين المادّة من ناحية و اللا مادّة من ناحية أخرى! أو لنقل، بين عناصر مادّية ليست لها لمسات ميتافيزيقية وأخرى لها تلك اللّمسات. ولكن، نسي الدكتور أن الصّورة التي يتحدّث عنها هي صورة الجسد، وأن الصّوت في (اللّغة) الذي يتحدّث عنه هو صوت الجسد. وبالتالي، كان عليه أن يقول لنا، ليس فقط ان اللّغة لها لمسة ميتافيزيقية بل إن الجسد البشري بكامله له لمسات ميتافيزيقية ! فعلى الأقل، بهذه الطريقة يصبح وفيا لتعريفه الإنسان ثنائيا عبر الجسد والرّوح!
إن دعوة الدّكتور قرّاءه إلى عدم الاكتفاء بالتركيز على تكنولوجيا الاتصالات لتفسير ثورة المعلومات، والى ضرورة اهتمامهم أيضا بمحتوى عملية الاتصال وخصوصيّة الصّوت والصّورة، هذه الدّعوة مقبولة طبعا، ولكن على شرط ألا ندعوهم لاستنتاج " لمسات ميتافيزيقية " للصّوت و الصّورة، القابلين، أكثر من غيرهما، من الأساس، للانتقال بسرعة داخل علاقات البشر، بسبب خصوصيّة فيزيائية حسّية من ناحية، تختلف عن الغاز أو الغذاء مثلا، وخصوصيّة حواسّ السّمع والبصر، مقارنة بحواس اللّمس والتذوّق والشّم من ناحية أخرى.
وفي كل الأحوال، طالما أن انتقال الصّوت والصّورة، يحتاج إلى أجهزة اتصال، في إطار علاقات الاتصال، فذلك يدّل على ضعف قدرتهما التلقائية على الانتشار أيضا، هذا طبعا إذا بقينا في حدود الصّوت والصّورة الإنسانيين. إن المسألة ليست ميتافيزيقيّة إطلاقا، بالعكس تماما، إنها شديدة الفيزيائيّة من هذا الجانب.
انّ حاسّة الشمّ ضعيفة عند الإنسان، كما أن قدرته على اللّمس مشروطة بوجود شئ يلمسه وقدرته على التذوّق مرتبطة بفعل التذّوق عنده و بالشيء الذي يتذوقه ، هذا إذا بقينا عند تحليل حسي ، لكن ذلك لا يعني أن البصر والسمع عنده يدخلانه في عالم الصوت و الصورة " اللا محسوس ".
• ثالثا : عندما تعّرض الدّكتور لما يسميه " اللّمسات الميتافيزيقية للرّموز"، قدّم لنا، في كتاب " التخلّف الأخر..." إعادة لفكرة " التضرّع للآلهة بواسطة اللّغة " واعتبرها دليلا على طابع اللّغة الميتافيزيقي. كما قدّم لنا تعريفا للرموز الدّينية على أنها " ذات طبيعة روحية ميتافيزيقيّة ".
من ناحية أولى : لا يمكن اعتماد الفكرة الأولى، حول التضرّع للآلهة بواسطة اللّغة، على أنها دليل على لمسات اللّغة الميتافيزيقيّة لسبب بسيط جدّا هو أنه لو كان الأمر كذلك لأصبحت كل مظاهر الحياة لها لمسات ميتافيزيقيّة.
إن الإنسان يقتل غيره تضرّعا( الجهاد)، ويعطي الزكاة تضرّعا للّه، ويأكل أشياء ويتمنع عن أكل أشياء أخرى تضرّعا، ويمارس العمل والجنس والرّياضة تضرّعا للآلهة. بهذا المنطق الحضارة كلّها تصبح ميتافيزيقا أو ذات "لمسات ميتا فيزيقية".
كتب الدّكتور : " فاللّغة، كمثال، ليست أداة تواصل مع الآخر فقط في هذا العالم الحسّي المحكوم بقيود الزّمان والمكان ففي الدّيانات التي عرفتها البشرية عبر تاريخها الطّويل استعمل الإنسان اللّغة في تضرّعاته وابتهالاته إلى الإله، فاللّغة هي أحد الرّموز الثقافية الرّئيسية التي يلوذ بها الكائن الإنساني للاتصال بالعالم السّرمدي." ( التخلّف الأخر؛ ص 14)
ونحن نسأل، فقط، ألا يقدّم الناس القرابين والأضاحي لآلهتهم، ألا يدفعون الزّكاة والصّدقة من أجل " الاتصال بالعالم السّرمدي ؟؟ "
هل تحوّل الدّين عند الدّكتور إلى مجرد " عالم روحي سرمدي " مفارق تماما للحياة ؟
نعم، هذا مع الأسف هو ما يعبّر عنه عندما كتب :
"... انّ الرّموز الدّينية ذات طبيعة روحية ميتافيزيقيّة." (ص25)
إن الدّين أصبح عند الدّكتور مفارقا لأية علاقة " تواصل مع الآخر...في هذا العالم الحسّي المحكوم بقيود الزّمان والمكان. " من ناحية، وهو، في العلاقة " بالعالم السّرمدي" يصبح علاقة روحيّة ميتافيزيقيّة أقرب إلى" التصوّف" منها إلى أي صورة أخرى عن الدين ،بما في ذلك الإسلام (حسب قراءات أخرى) الذي يدافع عنه الدّكتور ويدعونا إلى الانطلاق من " ابستمولوجيته" !
كما أن الدكتور ينسى أن بعض الديانات، المسماة ديانات " لا أخلاقية "، لا آلهة فيها مثل الرومانية القديمة و البوذية الأولى والهندوسية الأولى (م 46) ، فهل لغة معتنقي هذه الأديان، و كذلك لغة الملاحدة و العلمانيين"، رموزية " أم لا ؟
وهل "التضرع لإله مادي كالصنم ميتافيزيقا أم لا؟ فماذا عن لغة عبدتها، هل تنقصها لمسة من "اللمسات الميتافيزيقية" ؟
ألا يخلط الدكتور بين" اللمسات الميتافيزيقية" المزعومة في "طبيعة اللغة" نفسها وبين استعمال اللغة في التفكير الميتافيزيقي ؟
لو أن الدّكتور عرّف لنا معنى الرّموز، باعتبارها، فقط بعدا من أبعاد اللغة مثلا( أو الثقافة ) ، بمعناها الفكري، إضافة إلى بعد بها المعرفي والتواصلي، كما يفعل اللسانيون وعلماء النقد الأدبي والجماليات وغيرهم، لكان من الممكن أن ننسب حكمنا في ما يكتبه. لكنه يذهب إلى المساواة بين عبارات "ثقافة " و "رموز ثقافية "و "لغة" و " رموز لغوية" . وبذلك فهو يساوي بين الدّين والرّموز الدّينية أيضا.
إن العلماء الذين حلّلوا الرّموز بمعناها العام جدّا، مع الاهتمام بالفارق بين العلامة والإشارة والرّمز، اعتبروا الحضارة عموما، مركبة من منظومات رمزّية حاضرة حتى في جانبها الاقتصادي و القرابي والسّياسي، إضافة إلى جانبها الفكري طبعا، و مع تمييز (و لكن دون تناقض ) كبير بين العلمي والرّمزي.
هؤلاء ، مثل كلود ليفي شتراوس، أو جيلباردوران أو غيرهما. لا يعتبرون اللّغة ميتافيزيقيّة ولا يعتبرون الدّين أو الرّموز الدّينية " ذات طبيعة روحيّة ميتافيزيقيّة " رغم اعتراف علماء الاجتماع و الانتروبولوجيا بنوع خاص من الرّموز الاجتماعية، المتعالية ( روشي ، م4، صص121ـ123)
هنالك فارق كبير، من منظور علوم الإنسان بين الطّبيعة الميتافيزيقيّة أو المتعالية للرّموز، والمحتوى المتعالي للرّموز الدّينية، التي هي اجتماعيّة، رغم كونيّتها، وتاريخيّة رغم ثباتها النسبي، مقارنة برّموز أخرى ربّما، (مع العلم أنه إذا اعتبرنا الرّموز الرياضية المنطقية رموزا، فلها على ما يبدو قدرة على الثبات مثل الرّموز الدّينية و لها " أزلية وخلود" كبيرين أيضا) .
إن الرّموز الدّينية اجتماعية الأصل و هي مجتمعية، ولكنها أيضا إنسانية، فكثير من الرّموز تتمتع بالجانب الكوني، وهي أيضا ثابتة نسبّيا، ولكنّها تاريخيّة، تتحرك ولو ببطء، مع الفعل الدّيني تحديدا و البشري عموما ، و رغم هالة التقديس التي تتمتع بها بوصفها رموزا متعالية، ، فهي ليست لا أزليّة ولا خالدة .
إذن ، عندما يلوم الدّكتور الذوّادي علماء الاجتماع و الانتربولوجيا على كونهم لم يكتشفوا قبله " البعد الميتافيزيقي للرّموز" فيبدو أن الحقّ معهم، لأنهم بقوا ضمن المنهج العلمي وضمن ما سماه الدّكتور سابقا : " الرّؤية المركزية للعلم".
أكثر من ذلك، نحن نعتقد أن الدّكتور نفسه متردّد بعض الشئ في تصوّره الجديد الذي دشنه في المرحلة الميتافيزيقيّة " من تطوّر مشروعه العلمي.
يقول الدّكتور في المقدّمة التي كتبها، سنة 2002، لكتابه " التخلّف الأخر..." ما يلي
"...فاللّغة مادّة اجتماعيّة تحيا وتنمو وتنهض إذا كانت علاقتها بتسيير كل شؤون حياة المجتمع علاقة عضوّية و حميمية. ويصيبها، من جهة أخرى، الهزال والغربة، وربّما الاندثار في مجتمعها إذا وقع تهميشها أو إقصاؤها عن إدارة كل شؤونه."( ( التخلّف الأخر ، ص05)
هذا تعريف سوسيولوجي بامتياز ونتمنّى أن لا يتراجع عنه، رغم أن أهم محتويات الكتاب الجديدة (في التسعينات...) وما بعدها، لا تؤشّر بالخير.
إنّه تعريف سوسيولوجي، رغم أنّه "مادّي اجتماعي" ! و بالإمكان طبعا تلطيفه ليصبح تعريفا اجتماعيا تاريخيا، كما يجب أن يكون، حرصا على إبراز خصوصية الظاهرة الإنسانية، مقارنة بالمادية الطبيعية التاريخيّة التي لها خصوصياتها.
لعل تعريف اللّغة كظاهرة اجتماعية تاريخيّة، أصوب من تعريفها كمادة اجتماعيّة ، أو كذلك كجوهر روحي ميتافيزيقي في نفس الوقت. لكن وكما كتب الدكتور رضا بوكراع "بما أن اللغة في المرحلة التي يمر بها المجتمع العربي ترتبط بصفة وثيقة بقضية القومية العربية كمفهوم سياسي و بقضية التراث كمفهوم حضاري يهيكل الذاتية الجماعية أمام التحديات الإمبريالية فان الممارس للألسنية في ميدان اللغة العربية لا بد من أن يصطدم واعيا كان أو لا واعيا بالاختيارات الإيديولوجية " ( م47 ،ص409)
و هذا مع الأسف هو ما نعتقد أن الدكتور قد سقط فيه، إذ يبدو لنا أن الهم الإيديولوجي الديني حاضر بشدة في كل أعماله الأخيرة.
2. في تعريف الإنسان :
قلنا في الجزء الأول من هذا العمل أن أفكار الدّكتور موجّهة بشكل كبير نحو مناقضة الوضعيّة، ولكن، بالدّرجة الأولى، نحو مواجهة ماركس والمادّية التاريخيّة. ونعتقد، أنه، بعد الرّجوع إلى كتاب "التخلّف الأخر..."، ستتأكد هذه الفكرة بصفة مباشرة.
نختار من العدد الكبير من الفقرات المتعلّقة بالموضوع ما يلي : "...وهنا تتضح بالتحديد، في رأينا، الجانب الإيديولوجي للمقولة المادّية التاريخيّة التي تتبنّاها النّظم الشيوعيّة والاشتراكية في فهمها للإنسان. فهذه النّظم تعتقد أنّ الإنسان هو في المقام الأول كائن مادّي اقتصادي بالطبع وان ماعدا ذلك من الطبيعة البشريّة فهو إمّا ثانوي من حيث الأهمية أو هو باطل من الأساس. وهذا التصوّر المادّي للكائن الإنساني أدّى إلى تهميش أو الإلغاء الكامل لدور عالم الرّموز الثقافية في التأثير في تشكيل السّلوك البشري عند المفكرّين الماركسيين المادين المتصلّبين. وهي رؤية تقلب الأمور رأسا على عقب بالنسبة لمقولتنا الرّئيسية في هذا الفصل. إنّ الكائن البشري عندنا هو كائن رموزي ثقافي بالطبع. أي أن دور ما سمّيناه بعالم الرّموز الثّقافية من حيث فهم الإنسان والمؤثرات على سلوكه دور رئيسي يتمتّع بثقل لا يكاد يضاهيه، في نهاية الأمر، أي عنصر آخر مؤثر على السّلوك البشري. " ( ص37/38)
قبل الدّخول في مناقشة هذه الفقرة، نذّكر أن الدّكتور دعانا في "النداء..." إلى اعتماد التعقيد منهجا وإلى تجنّب " الأحادية التّفسيرية النّيوتونية". وقد سبق أن قلنا أن دعوته تلك يبادر هو نفسه بالتنكر لها. ونعتقد أن الفقرة التي ذكرناها للتّو أكدت وأيّدت ما ذهبنا إليه.
إنّ التعريف السابق لما يسمّيه الدّكتور " طبيعة الإنسان " هو مجرّد عمليّة قلب لفكر ماركس، الذي يتّهمه الدّكتور أنه أحادي ومادّي التفسير. بل إن اللّغة نفسها التي اعتمدها الدّكتور هي لغة ماركس، مقلوبة لا غير
- من ناحية أولى يصف الدّكتور فكرة المادية التاريخيّة عن الإنسان بأنها " ايديولوجيا"، بمعنى مخالفة للعلم مثلما فعل ماركس وانجلز في " الايديولوجيا الألمانية".
- من ناحية ثانية : يقول إنّ رؤية ماركس " تقلب الأمور رأسا على عقب " وهي نفس العبارة التي استعملها ماركس ضدّ هيغل بالضّبط.
- من ناحية ثالثة : يعتمد الدّكتور عبارتي " دور رئيسي" و "في نهاية الأمر" الشهيرتين عند ماركس وأنجلز.
و المحصّلة، عوض التعريف الماركسي للإنسان بكونه " مادّيا اقتصاديا بالطبع " يقدّم لنا الدّكتور تعريفه، فالإنسان عنده هو " كائن رموزي ثقافي بالطبع"!
نفضل ألا ننبس ببنت شفة حول هذا، بل ونترك الدّكتور يحكم على نفسه.
كتب الدّكتور، قبل أن يصل إلى " مرحلته الميتافيزيقيّة "، حول قسم من علم الاجتماع ما يلي :
"...فالتنظير السوسيولوجي الذي لا ينطلق من الواقع الكبير (أي الشامل لكل عناصر الظاهرة الاجتماعية) سواء أكان ذلك لتحيّز إيديولوجي حضاري أو لضيق رؤية المنظور المادّي مثلا في دراسة الظّاهرة كما ورد أعلاه (يقصد وقتها ظاهرة التخلّف والتبعية)، لا ينتظر منه أساسا إغناء المادّة الاجتماعية التنظيريّة بتعاريف ومفاهيم وفروض ونظريات مفيدة لدفع مسيرة البحت في هذا المجال بخطى حثيثة إلى الأمام..." ( التخلّف الأخر ص64.)
وبعد ذلك بقليل واصل قائلا:
"...إنّ التركيز على عنصر أو مركّب معيّن، من ناحية، وإهمال أو التّقليل، من ناحية ثانية، من أهمية عنصر آخر، رغم أنّه لا يتجزّأ من طبيعة الظّاهرة المدروسة لا يمكن أن يؤدّي إلا إلى مفاهيم وفروض ونظرّيات قاصرة ومشلولة. " ( ص65 )
كان هذا سنة 1986، عندما كانت للدّكتور "ميولات" نفسية – ثقافية ! ولم يصل بعد إلى " المرحلة الميتافيزيقيّة" كما قلنا.
يفترض في الدّكتور الذي يدعونا منذ 1986 إلى اعتماد مقاربة كلّية لظواهر" الواقع الكبير...كل عناصر الظّاهرة الاجتماعية"، تأخذ بعين الاعتبار التحليل التعقيدي، التركيبي للظواهر ألا نجد عنده تعريفا للإنسان مثل الذي بقي عنده حتى 2005، وهو : الإنسان كائن رموزي ثقافي بالطبع ! ولكن الدّكتور، عندما أصدر كتابه سنة 2002، وكان قد دخل في مرحلته الميتافيزيقيّة منذ 12 سنة، يقدّم لنا مع الأسف الشئ ونقيضه في نفس الوقت !
في الواقع، ليت المشكلة بقيت عند هذا الحدّ، إنّها تتعمّق أكثر بالطبع عندما ندرك أن " الكائن الرّموزي الثقافي" عند الدّكتور لا يعني" الكائن الثقافي" في علم الاجتماع الثقافي، مثلا في مدارس " التفاعلية الرّمزية" أو " الاثنوميتودولوجيا " أو غيرهما من المدارس.
إنّ " الكائن الرّموزي الثقافي " عند الدّكتور كائن "ميتا-اجتماعي" تقريبا لأن " عالم الرموز الثقافية " عنده ذو مصدر ما ورائي خاصّ بالدّكتور، إنّه " النفخة الإلهية الأولى"، التي يختلف فيها حتى مع المفسّرين الدينيين المسلمين القدامى والمحدثين.
يقول الدّكتور :"...فكلّ ذلك يرجع إلى "...فإذا سويته ونفخت فيه من روحي..." ( سورة الحجر، آية 29 )، ثم يضيف في الهامش الحادي والأربعين تعليقا يقول فيه :" لقد تصفّحت العديد من تفاسير القرآن ولم نجد فيها إشارة إلى الرّموز الثقافية كأهمّ جزء من تلك النّفخة الإلهية في آدم "، وبعد ذلك يواصل الدّكتور استشهاده قائلا :" فاجتمعت بذلك الظّروف في نظر القرآن (...) عند هذا الكائن العاقل لكي يكون المترشّح الوحيد للخلافة " إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنّه كان ظلوما وجهولا. " ص 37-36))
كما نرى إذن، الدّكتور يختلف في تعريفه للإنسان، ليس فقط مع ماركس ومع كلّ العلماء الآخرين، الذين تجاهلوا العالم الما ورائي واستـنكفوا من دراسته": ص 36) ) بل وكذلك مع المفسّرين المسلمين الذين كانوا يقولون إن آدم متميز عن الكائنات الأخرى بأربعة عناصر، مثلما وضّحنا ذلك سابقا، وهي :
- الصّنع من التراب " بالأيادي" الإلهية .
- النفخ من الرّوح الإلهية.
- تعليم الأسماء كلها.
- أمر اللّه بقيّة الملائكة بالسجود له.
فحتى من المنظور الإسلامي" الأكثر انتشارا " ، لا يتميّز الإنسان بالنفخة الإلهية الأولى فقط أو أساسا، بل بأربعة عناصر، بل ويمكن إضافة أخرى عليها، عند تحليل آدم الأرضي، بعد نزوله وعدم البقاء عند تحليل آدم الأوّل .فعلى الأقل التفاسير التي يرفضها الدكتور لا تعتمد عاملا واحدا مميزا ، إنها " تعقيدية" أكثر من سوسيولوجياه مع الأسف الشديد .
لكن، في المقابل، يصرّ الدّكتور على أنّ " الرّموز الثقافيّة ّ هي ّ أهمّ جزء من تلك النفخة الإلهية في آدم " ولسنا نعرف ما هي " أدلّته التفسيرية" في ذلك، ناهيك عن أدلة علمية أنثروبوسوسيولوجية. إنّها مسلّمة الدّكتور الأولى، التي يبدو أنه وصل إليها عبر الحدس "الكانطي الصّوفي" الفريد من نوعه عنده. و الذي يختلف فيه حتى عن أغلب التفاسير الإسلامية ، ناهيك عن علم الاجتماع!
إذن، الإنسان عند الدّكتور ليس كائنا " أحاديّ البعد "، (حسب العبارة الشهيرة التي عنون بها هربرت ماركوز كتابه الشهير)، بمعني أحادية البعد الاجتماعي، بل أحادي البعد الما ورائي الفريد جدّا !
أكثر من ذلك، إن هذا البعد الما ورائي، عند الدكتور، لا يمكّن من تعريف الإنسان وتمييزه عن الحيوان فقط، بل من تشبيهه باللّه، بالإله أيضا.
يقول :" إنّ تمتّع الإنسان دون سواه بالحريّة والقدرة على الاختيار ميزة تربط الكائن البشري بعالم الميتافيزيقيا. فالإله في معظم الدّيانات والعقائد يختصّ بتلك الخصال. فالإنسان هو الوحيد الذي يشترك بصورة نسبية مع الإله في تلك الخصال. "( ص36)
والغريب في الأمر، أن الدّكتور، عندما أوّل سابقا مسألة " الكائن العاقل" الذي هو الإنسان، المرشح الوحيد لخلافة اللّه على الأرض، لم يجد من القرآن آية تساعده على ذلك إلا واحدة محتواها يدلّ على الصلاة فقط ، حسب بعض المفسرين ، ويعني عكس ما يراه الدكتور تماما. فاللّه حسب تلك الآية عرض " الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنّه كان ظلوما وجهولا."
لكن الدّكتور، كما وضّحنا ذلك في الجزء الأول من هذا العمل، لا يهمّه على ما يبدو أن يدقّق بما يستشهد من فقرات يقتبسها من العلماء أو من القرآن على حدّ السّواء !
إنه ماض في تسطير " بحث علمي أساسي" يتضمّن " طرحا جديدا " لهوّية الإنسان، يختلف عن العلماء في الطبيعة والاجتماع، وعن المفسّرين المسلمين. وانطلاقا من الرّموز ولمساتها أو بعدها الميتافيزيقي يقول : " ومنه تتجسّم ، بطرح الجانب الميتافيزيقي القديم (الروح) لهوية الإنسان في ثوب جديد يظلّ رغم جدته ذا وشائج صلبة مع عالم الماورائيات و اللامحسوسات..." (ص 34) الثوب الجديد" للرّوح هو " الروح الرّموزية الثقافية للإنسان " التي هي " الجزء من كينونة الإنسان الأكثر مركزية وعمقا في تكوين ذاتية الأفراد والجماعات "ص 39). ) وهي " جوهر الإنسان ص 08) ) و "عمق الإنسان ذاته" ص 18).)...الخ.
إذن، يعيد علينا الدّكتور الذوّادي الثنائية الدّينية (جسد وروح) في ثوب جديد، (وهو جديد فعلا كما رأينا) هو ثنائية الجسد و"الروح الرّموزية ".ويعيد علينا بالتالي فكرة خلود الرّوح مقابل زوال المادّة...الخ.
طبعا، كل هذا من حق الدّكتور، حتى لو كان مغايرا لكل العلماء من ناحية والمفسّرين الدّينيين من ناحية ثانية. لكن، من حقنا أيضا أنّ نقول له إن تصّورك لا علاقة له بعلم الاجتماع، ونترك للمفسّرين أن يقولوا رأيهم الدّيني، على أمل ألا يكفّروه في هذا الزمن العربي الإسلامي الرّديء.
لقد قلنا ، منذ المدخل الأول للجزء الأول من العمل، أن الدّكتور لا يتراجع فقط عن علم الاجتماع الحديث والمعاصر، بل حتى عن علم العمران الخلدوني، وحتى عن أفكاره الشخصية القديمة.
وهذا دليل على ما قلناه في ما يخص تعريف الإنسان:
كتب الدّكتور سنة 1986: " ثالثا : الإنسان حيوان ثقافي : (...) الإنسان ككائن ليس اجتماعيا بالطّبع فقط وإنما هو أيضا ثقافيّ بالطبع كما أشرنا في الفصلين السّابقين فهو يستعمل عددا وافرا من الرّموز الثقافية التي تتصدّرها الرّموز اللغويّة من حيث الأهمية فبدون هذه الرّموز الثقافية تصبح اجتماعية الإنسان التي تحدّث عنها كثير من الفلاسفة والمفكّرين الاجتماعيين مثل ابن خلدون، محدودة المعنى(...) إنّ الصّمت عن أهميّة الجانب الرّموزي الثقافي من الإنسان هو تجاهل لطبيعة الإنسان نفسها..." ( ص 52)
كما نلاحظ، هنالك خلط غريب هنا، يبدو أنه راجع للتعديلات التي أحدثها الدّكتور على المقال الذي أخذنا منه الاقتباس عند نشره في كتاب " كتاب التخلّف الأخر..."
هنالك عبارات غريبة عن بعضها تماما.
- من ناحية أولى : الإنسان حيوان ثقافي، ونحن نعرف أن مثل هذه العبارات لها علاقة بداروين أو بالتأويلات التطوّرية الأخرى، ولا علاقة لها بالقرآن الذي يقول الدّكتور أنه يدافع عن "رؤيته
الابستمولوجيّة " ونحن نترك للدكتور أن يحلّ معضلة الخلط في جهازه المفاهيمي !.
- من ناحية ثانية هنالك رفض للفكرة الخلدونية، والاجتماعية عموما، القائلة بأن الإنسان "اجتماعي بطبعه"، تحت حجّة إضافة عنصر آخر، هو "الثقافي "، في حين أن عبارة " الاجتماع الإنساني " عند ابن خلدون تعتبر الفكر والثقافة من أبعادها الدّاخلية التي تدمجها، كما رأينا سابقا.
- من ناحية ثالثة : هنالك مساواة بين عبارتي "ثقافي" و "رموزي ثقافي" وهذا كما بيّناه غير سليم، على الأقل حسب منظور الدّكتور.
- رابعا : عوض الحديث عن "طبع" أو "طبيعة" مركّبة، اقتصادية، اجتماعية، سياسية وثقافية، للإنسان، يختار الدّكتور تصوّرا أحاديا فيه دور أساسي لا تاريخي ، جوهري،...إلخ، تحتله " الرموز الثقافيّة" فتصبح طبيعة الإنسان انه : "حيوان ثقافي بالطّبع"
3. في بعض مسائل العلم عموما وعلم الاجتماع تحديدا :
قبل بلوغه " المرحلة الميتافيزيقيّة " مع التسعينات من القرن الماضي، كان بالإمكان تصنيف أعمال الدّكتور محمود الذوّادي ضمن الطّيف العام للتيارات ذات المنحى النفسي الثقافي المرتبطة خاصّة بالمدارس الأنجلو سكسونية في علمي الاجتماع والنفس الاجتماعي وكذلك الانثربولوجيا الثقافية.
أما عربيا فهو لا يعترف بأي نسب سوى للعمران الخلدوني والغريب في الأمر أن الدكتور يقترح علينا بحثا في علم الاجتماع العربي دون التعرض تماما لبعض أعلامه العرب المعاصرين في ميدان علم الاجتماع الثقافي مثل برهان غليون و خليل أحمد خليل و هشام شرابي و السيد ياسين و غيرهم .
أمّا على " المستوى المغاربي ، فيقول الدّكتور عن نفسه أن أعماله لها " علاقة حميمة بكتابات كلّ من فرانتز فانون Frantz Fanon والبار ميمي Albert Memmi حول إنسان العالم الثالث المستعمر والمقهور وتصوّره التحقيري لنفسه في تلك الظّروف. ونعتقد أنّنا نستعمل في هذا الكتاب (التخلّف الآخر : توضيح منّا) إطارا فكريّا Paradigme -من العلوم الاجتماعية- أوسع من منظورهما النفسي لتحليل وضع أفراد المجتمعات النّامية الواقعة تحت الهيمنة الاستعماريّة بوجهيها القديم والحديث. ( ص 05 )
ولكن، هل الأمر كذلك الآن، في المرحلة الجديدة الميتافيزيقيّة ؟
إنّنا نعتقد أن أعمال الدّكتور في المرحلة الأخيرة تحوّلت باتّجاه ميتاسوسيولوجي تقريبا.
إن نقطة التحّول تمثل حسب اعتقادنا في تطوّرين أساسين، في موضوع علم الاجتماع وفي المنهج المتبع على حدّ السّواء.
في المراحل السّابقة من فكر الدّكتور، كان الاهتمام عنده منصبّا على دراسة ظواهر ثقافية في البداية، ثم نفسية ثقافية في المرحلة الثانية (1982-1990).
أمّا في المرحلة الثالثة (…1990) فكما يعترف هو نفسه " لقد ركّزنا جهودنا البحثية على إماطة اللّثام عن الجوانب الميتافيزيقيّة للرّموز الثقافيّة." ( ص 07)
وفي هذه المرحلة، حسب اعتقادنا، وقع تحوّل كبير في بناء الموضوع العلمي السوسيولوجي عند الدّكتور.
إنّه لا يبني موضوعا اجتماعيا بالأساس، بل، بحجة ضرورة الرّبط بين الدّين والفلسفة وعلم الاجتماع، و"تجاوز الوضعية" كما رأينا في الجزء الأول، أصبح الدّكتور يبني موضوعا ميتافيزيقيّا، أي أنه، مثل المتصّوف | شبه النّقدي الكانطي ـ على ما يبدو- يبحث عمّا هو ما ورائي، غير محسوس، متعال، ما قبلي...
يقول : " إنّ الرّموز الثقافية، كما تصطلح على تسميتها العلوم الاجتماعية الحديثة، تحمل في كينونتها بصمات ميتافيزيقيّة بصورة طبيعيّة أو فطرية (...) اللّمسات الميتافيزيقيّة الخفّية الكامنة في الطّبيعة الأصليّة لعالم الرّموز الثقافيةّ. فجانب تواجد العنصر الماورائي (اللاّمحسوس) في الرّموز الثقافيّة هو اذن من نوع التواجد القبلي بالتعبير الفلسفي. أي اتصاف عالم الرّموز الثقافيّة بلمسات ميتافيزيقيّة يعتبر من المسلمّات التي تتمتّع بكثير من المصداقيّة..." (ص 33 )
- إذن، نقطة الانطلاق الأساسية في فكر الدّكتور هي "مسلّمة" حول الطبيعة الفطريّة الما قبلية للرّموز الثقافيّة بوصفها ما ورائية لا محسوسة وخفيّة.
لقد ناقشنا سابقا هذه " المسلّمة "، فما يهمنا الآن هو موضعها في البناء النظري " لسوسيولوجيا ميتافيزيقيا الرّموز " لا غير.
- بعد هذه " المسلّمة "، يقول لنا الدّكتور أن علماء الاجتماع، بسبب " الطبيعة الابستمولوجية التي يشكو منها العالم الوضعيّ المعاصر في إحداث طلاق لا رجعة فيه بين عالم المحسوس والعالم الما ورائي مهما كانت طبيعة هذا الأخير " ( ص 36 )
- هؤلاء العلماء " استنكفوا" عن دراسة " الجوانب الميتافيزيقيّة " في الرّموز الثقافيّة لأنّه خيّل إليهم أنها عبارة عن أشياء ميتافيزيقيّة يختص بدراستها الفلاسفة لا العلماء ! (ص 36)
أمّا بالنسبة إليه، فإن تمتع الإنسان " دون سواه بالحرّية والقدرة على الاختيار ميزة تربط الكائن البشري بعالم الميتافيزيقيا " ( ص 36 ) وبالتالي لابدّ لعالم الاجتماع من دراسة " عالم الميتافيزيقيا هذا لحضوره داخل " الرّموز الثقافيّة " عبر " لمسات " أو "بصمات " أو " معالم " سبق وأن ناقشناها.
من ناحية أخرى، عندما يقدّم الدّكتور عمله للقارئ، يقول إنّه يتماشى مع ما يدعو له بيار بورديو، في حين أننا نعرف أن طريقة بورديو المنهجية " الموضعة المشاركة "، جعلته، مثلا، يكتب كتابه الضّخم " في التمييز... " (م 48 ) أساسا ضدّ التصّور الكانطي في النّظرية الجمالية كما يدّل على ذلك الجزء الثاني من عنوان الكتاب " نقد اجتماعي للحكم"
وقد جاء في مقال كتبه فليب كابن، (في عدد مجلة "Sciences Humaines " الذي خصّص لعمل بيار بورديو إثر وفاته)، حول كتاب " في التميز..." ما يلي :
"التمييز عملية إدانة للإستيطيقا الكانطيّة، لكنه أكثر من ذلك. إنها تبين ’’تنميط الحياة‘‘. بالنسبة لبيار بورديو، وراء فكرة الحكم الاعتباطي للفرد الحرّ والمتفوّق، هنالك إيديولوجيا الموهبة التي تحجب المحدّدات الاجتماعية للذّوق وتحافظ على علاقات الهيمنة. إنّ هذه المعايير قوّية بدرجة كبيرة إلى درجة استبطانها بواسطة "الهابيتوس" ،عندنا عالم من الحسّ المشترك، عالم اجتماعي يبدو لنا بديهيّا" (م49، ص27)
ما الأمر إذن، مع الميتافيزيقيا ؟
نعتقد ، أن الدّكتور لم يتعامل مع الميتافيزيقيا بصفتها " ميتافيزيقا اجتماعية " لابدّ من البحث في "المحدّدات الاجتماعية " لعمليّة تكوّنها، بل قبل بها كمسلّمة أولى في بحثه.
إنّه لا يبحث في العوامل الاجتماعية التي تولّد ظهور الميتافيزيقيا. إننا نعتقد، مثل الدّكتور الذوّادي، أنّه لابد من الاهتمام بدراسة الميتافيزيقيا، لكن، خلافا له، نعتقد أنّ علم الاجتماع لا يمكنه أن يدرس الأمور الميتافيزيقيّة، إلا بوصفها من منتجات المجتمع، أي منتجات الإنسان الاجتماعي الذي له القدرة على التجريد والتّرميز إلى درجة تسمح له بإنتاج " رموز ميتافيزيقيّة " حول "الكائنات الما ورائية" وتبادلها.
إنّ علم الاجتماع لا يمكنه أن يدرس علميّا، ما يسمّى " برموز التّعالي "، إلا انطلاقا من فكرة أن " الإنسان كائن رامز، خالق لرموزه" أمّا إذا قلبنا العلاقة، ليتحول الإنسان إلى ’’مجرد حافظة‘‘ لرموز مصدرها اللّه أو أية قوة ماورائية أخرى، فإن الأمر يخرج عن مجال البحث العلمي ليدخل مجال الإيمان الدّيني. وهذا الإيمان، غير قابل للإجماع العلميّ بالضرورة ، وهو عند الدّكتور، يختلف حتى عن إيمان كل المفسّرين المسلمين بسبب فكرته عن " النفخة الإلهية الأولى " !
إنّه من غير الممكن علميّا البرهنة على أنّ مصدر "الرموز الثقافيّة هو النّفخة الإلهية الأولى". فحتى التّفاسير الدّينية ،أو بعضها على الأقل ، تقول بأن " النفخة الإلهية " كوّنت " الرّوح" في آدم المصنوع من الصلصال. أمّا المعرفة التي تلقاها أدم فناتجة عن فعل " التّعليم " الإلهي. هذا بخصوص آدم الأول، وتعلمه الأسماء.
أنّ التفاسير الدّينية تفرق بين عمليات " الخلق والتسوية" المرتبطة بالصنع من "الحمإ المسنون " والنفخ من الرّوح، وبين عملية " التعلم " التي هي عملية "منفصلة بذاتها ". كما أن بعض اللسانيين المسلمين الأوائل ، عندما تعرضوا إلى موضوع اللغة مثلا ، قالوا إن الأصل الإلهي للغة يرتبط بلغة آدم في الملأ الأعلى التي يجهلها البشر و حاولوا تحليل اللغات التي يعرفونها تحليلا علميا أبدع بعضهم فيه إلى درجة أن " إخوان الصفا" يضيقون في تأويل آيات الخلق إلى درجة اعتبار التدخل الإلهي في الميدان اللغوي مقتصرا على" الهام آدم القدرة على الكلام لا غير" كما بين ذلك الدكتور عبد السلام المسدي.
كما انه من غير الممكن علميّا على الدّكتور أن يبرهن لنا من أين أتى بفكرة أن " الرّموز الثقافيّة " هي " العنصر المركزي في النفخة الإلهية" وهو لم يقل لنا ما هي بقية " العناصر اللامركزية" في تلك النّفخة !
إنّ الأمر الوحيد الذي يستطيع الدّفاع عنه هو دعوتنا للإيمان معه "بالحقيقة " التي وصل إليها على ما يبدو، عبر " حدس " أو " نور قذفه اللّه في صدره "، وهذا من حقه الصوفي طبعا، ولكن رجاءا ليس باسم علم الاجتماع.
إنّ "ايديولوجيا الموهبة " عند الدّكتور ترتبط هنا بأوسع معاني " الهبة الإلهية " وليس بالموهبة الفنيّة التي تحدّثنا عنها حول علم الجمال الكانطي عند بورديو.
لكن بين هذه وتلك، هنالك فكرة " الفرد الحرّ والمتفوق " المعممّة عند الدكتور على الإنسان المتميز " بالحرية والقدرة على الاختيار " عموما .كما انه مع هذه الايديولوجيا الجديدة أيضا، تحجب "المحددّات الاجتماعية" للقدرات " الرّموزية الثقافيّة " لتتحول إلى موهبة إلهية.
فماذا عن"عالم الحسّ المشترك " الذي " يبدو بديهيّا " حسب فيليب كابن؟
يقول الدّكتور انه " ليس من المبالغة في شئ القول بأن عالم الرّموز الثقافية ينطوي على كثير من اللّمسات الميتافيزيقيّة (الماورائية) (...) فالاتّصال بالآخر بالكلمة وبالصّوت والصّورة في لمح البصر رغم حواجز البعد والجبال والبحار والمحيطات هو، من جهة المنطق الحسّي الصّرف، واقعة تنتمي إلى عالم المستحيلات أو عالم الجنوح الخيالي للإنسان. فمثل هذه الوقائع لا يقرّها المنطق التقليدي للإنسان. إذ هي في نظره وقائع مقصورة على العالم العلوي : الإله والأرواح (...) انبهار الخاصّة والعامّة من النّاس انصب أساسا على تكنولوجيا الرّموز والمعلومات (...) فالعلماء المختصّون في ميادين الاتصال والمعلومات لا يزال يغلب عليهم موقف الصّمت. خصوصا ما أسميناه بالجوانب الميتافيزيقيّة لعالم الرّموز الثقافية (...)التي تستنفر من إقرارها والتعامل معها الرّوح العلمية الوضعية لأغلبية العلماء والباحثين المعاصرين". ( التخلّف الأخر... ص30 )
هل يقطع الدّكتور، مثل ما تقتضيه الروح العلميّة، مع عالم الحسّ المشترك المكون حول ثورة الاتصالات ؟
لا نعتقد ذلك، بل إنّه لم يصل حتى إلى مرتبة الحسّ المشترك الذي فيه " انبهار الخاصة و العامّة من الناس" منصب على تكنولوجيا الرّموز والمعلومات " وليس على " الجوانب الميتافيزيقيّة لعالم الرّموز الثقافيّة ".
في الواقع، نعتقد أن ما يميّز الدّكتور ليس " الانبهار"، بل محاولة استغلال ذلك الانبهار عند الخاصّة والعامّة لتمرير أفكار حول الرّموز الثقافية " تستنفر من إقرارها والتعامل معها الرّوح العلمية الوضعيّة لأغلبية العلماء والباحثين المعاصرين "
إن تكرار الدّكتور لمسألة " الصّمت الطويل " و "الإستنفار " من " اللّمسات الميتافيزيقيّة " ومحاولة ربط ذلك دائما بكلمة " الوضعيّة " لا ينفع حسب رأينا. فلا يجب أن نستعمل صفة الوضعيّة كفزّاعة مخيفة كلما تعلق الأمر بمثل الأفكار التي يقدّمها الدّكتور لنا. في مثل هذه الحالات، يبدو أنّه من الأفضل أن يكون الإنسان وضعيّا، حتى لو كان ذلك من باب " الدفاع عن الشيطان " كما قلنا سابقا !
إنّ الوضعية كانت مرحلة مهمّة جدّا في تاريخ العلوم، لأنها ساعدت بالتحديد على القطع الابستمولوجي مع كل النّظريات ما قبل العلميّة، رغم عيوبها المعرفية التي لابدّ من فهمها في سياقها التاريخي. لكن، في المقابل، إذا أصبح نقد الوضعية دعوة ، ليس إلى التجاوز الإيجابي بل ، إلى العودة إلى ما قبل العلمي أو ما وراء العلمي، فعندها، من أخفّ الأضرار أن يكون الإنسان وضعيّا.
*******
نرجع الآن إلى مسالة المنهجية العلميّة وبصورة مباشرة.
يقول الدّكتور :" إنّ الإطار الذي طرحنا ضمنه الرّموز الثقافيّة بالتحليل والنقاش يفصح بوضوح على الصّعوبة التي لابدّ أن يواجهها علماء الاجتماع الوضعيّون بخصوص تصّورهم وفهمهم للتأثيرات الواسعة التي تمارسها الرّموز الثقافيّة على حركيّة سلوكات الأفراد والمجموعات البشرّية. فعلم الاجتماع الحديث قد تبنّى عموما موقف الرّفض من فكرة استعمال ما يمكن أن نطلق عليه بالمنهجية الذّاتية subjective Méthodologie . فهذه الأخيرة تسمح لعالم الاجتماع بالاقتراب أكثر من الجانب الإنساني لصاحب السّلوك و الابتعاد نوعا ما عن البنى الاجتماعية المحيطة به.
إنّ مجهودنا المتواضع في هذا الفصل و المتمحور على استعمال مفهوم الرّوح الثقافيّة الرّمزية قد برهن بما فيه الكفاية على أن الوقت قد حان بالنسبة لعلم الاجتماع لكي يدمج ويتبنّى بالكامل في منظوراته التحليليّة الجوانب الذّاتية والميتافيزيقيّة للرّموز الثقافية في أي دراسة تسعى إلى كسب رهان المصداقية بخصوص فهم وتفسير كل من سلوك الفرد والجماعة. فدراسة علماء الاجتماع و الانثروبولوجيا للرّموز الثقافيّة تظل دائما قاصرة بدون فهم واستيعاب داخلي لها. فالحاجة بحق ماسّة إلى ابتكار وإرساء نوع من علم الاجتماع الفهمي يكون كفؤا للتّعامل مع المستويات المعقدة التي تحفل بها الرّموز الثقافيّة الإنسانية" ( ص47)
يقدم لنا الدّكتور إذن، وبصورة "واضحة" منهجيّته العلّميّة التي سمّاها " المنهجيّة الذاتية"، من ناحية في مقابل " علماء الاجتماع الوضعيين "، ومن ناحية ثانية ك "نوع من علم الاجتماع الفهمي" فقط وليس "كعلم اجتماع فهمي" فيبري.
ولكن ما هي ملامح هذه "المنهجية الذّاتية " ؟
- الدّعوة إلى الاقتراب أكثر من الجانب الإنساني والابتعاد نوعا ما عن البنى المحيطة به.
- الدّعوة إلى إدماج وإلى " تبنّي" "...الجوانب الذّاتية والميتافيزيقيّة... للرّموز
" بالكامل"
- الدّعوة إلى " فهم واستيعاب داخلي " للرّموز الثقافيّة.
- الهدف من هذا هو " فهم وتفسير كلّ من سلوك الفرد والجماعة "
أ. الدّعوة إلى الاقتراب من الجانب الإنساني والابتعاد عن البنى المحيطة بالإنسان.
في أخر الفقرة السابقة، يعترف الدّكتور بوجود " مستويات معقّدة" للرّموز الثقافيّة الإنسانية. لكنه في المقابل يدعونا إلى " الاقتراب أكثر من الجانب الإنساني لصاحب السّلوك والابتعاد نوعا ما عن البنى الاجتماعية المحيطة به"، فهل يعني ذلك أنّ البنى الاجتماعية المحيطة به "خارجة" عن الجانب الإنساني ؟
إنّها باعتراف الدّكتور "بنى اجتماعية "، وهو يعترف بوجود " مستويات معقّدة " للرّموز، فلماذا لا يدعونا للمعادلة بين تحليل البنى وتحليل " الجانب الإنساني " في نفس الوقت ؟
وهل يتحقّق "الجانب الإنساني" خارج البنى من الأساس ؟
وهل توجد بنى "خارج" الجانب الإنساني و"محيطة" به فعلا ؟
ألا تدعو النظرّيات السوسيولوجيّة الحديثة ، و التعقيدية بالضّبط ، إلى تجاوز ثنائية الدّاخل/الخارج، من خلال فهم جدلية التخارج/ التموضع والتداخل/ التذ يّت في الظّاهرة الاجتماعية ؟
أليس هذا مجرّد ردّ فعل على الوضعية وعلى البنيويّة... وغيرها، ولكن باتّجاه ذاتوي مبالغ فيه يعيد نفس تصورات المدارس القديمة في علم الاجتماع، ولكن بقلبها فقط ؟
ب. الدّعوة إلى إدماج وتبنّي...الجوانب الذّاتية والميتافيزيقيّة للرّموز بالكامل :
أولا : لماذا إدماج ثم تبنّي بالكامل ؟
أما أن ندمج عنصرا جديدا في التحليل، إضافة إلى عناصر وأبعاد سابقة فهذا مقبول، بشرط أن نبيّن أنّه لم يكن مدمجا فيما مضى. ولكن ماذا نقصد بعبارة " تبنّي بالكامل "هذه ؟ هل كان الجانب" الذاتي" متبنّى، ولكن بالناقص، وكيف ذلك؟
ثانيا : ما المقصود بإضافة عنصر " والميتافيزيقيّة " إلى الجوانب الذّاتية ؟
هل أصبحنا بصدد ثلاثية " الموضوعية" ( البنى الاجتماعية المحيطة)، والذّاتية و كذلك الميتافيزيقيّة ؟
وهل الجوانب الميتافيزيقيّة ذاتية أم موضوعية أم هي صنف جديد من العوامل مختلف عن الذاتي والموضوعي ؟
وإذا كان "الميتافيزيقي" موضوعيّا حتى مقارنة بالمادّي والاجتماعي، إضافة لكونه كذلك مقارنة بالذّاتي الاجتماعي، فكيف سنعرفه معرفة علمية وندمجه في التحليل العلمي ؟
ألن يبقى لنا سوى الحدس والإيمان ؟
ولكن، هل يقوم علم الاجتماع على هذا الأساس؟
ج. الدّعوة إلى " فهم واستيعاب داخلي" للرّموز :
أوّلا ، ما الفرق بين الفهم والاستيعاب الدّاخلي ؟
وثانيا، ماذا نقصد بهذا الاستيعاب ؟، هل يعني ذلك أن الدّكتور يدعونا مثلا أن نصبح مؤمنين على طريقته الخاصّة في فهم الإسلام و"الرّموز الثقافيّة".؟
نعتقد أن جوهر دعوة الدّكتور تكمن هنا بالضّبط !
إنّ إضافة عامل ثالث (الميتافيزيقي) إلى الموضوعي والذّاتي، ثم دعوة علماء الاجتماع إلى " الفهم والاستيعاب الدّاخلي" إذا ارتبطت بما سمّاه الدّكتور " الرؤية الابستمولوجية القرآنية" للرّموز، لا يمكن أن تعني إلاّ هذا !
لهذا السبّب قال الدّكتور إن " منهجيته الذّاتية" هي " نوع من علم الاجتماع الفهمي" ولم يتجرأ أن يقول إنّها " علم الاجتماع الفهمي" عند ماكس فيبر مثلا.
إنّ الفرق بين الرّجلين واضح تماما، فماكس فيبر يدعو عالم الاجتماع إلى الحياد القيمي ضمن منهجه الفهمي، أما الدّكتور فهو يعرض على علماء الاجتماع العرب والمسلمين موقفه الديني ويدعوهم إلى " فهمه واستيعابه داخليّا".
ماكس فيبر لم يقدم لعلماء الاجتماع قراءته الخاصّة للإنجيل أو للدّيانة البروتستانتية ولم يدع الناس إليها لأنه عالم اجتماع وليس رجل دين. أمّا الدّكتور فقد قدّم، ضدّ كل المفسّرين المسلمين، قراءته الخاصّة للقرآن، وهو يطالبنا أن نفهمها ونستوعبها داخليا، ونصبح من أتباعه كشرط ضروري " للمصداقية العلميّة ".
ماكس فيبر دعا علماء الاجتماع إلى فهم عملية " الفهم والاستيعاب الدّاخلي" التي يقوم بها الفاعل الاجتماعي الذي يدرسونه، لفهم " المعنى الذي يعطيه الفاعل لفعله " كواحد من مفاتيح فهم وتفسير الفعل الاجتماعي. لكن في المقابل حذّر علماء الاجتماع من خصوصية التحليل السوسيولوجي بسبب احتمال تضامن أو تعارض قيم عالم الاجتماع مع القيم التي يحملها الفاعل الاجتماعي موضوع الدّراسة، وطالبهم بأقصى درجات " الحياد الأكسيولوجي" رغم صعوبته، من أجل تحقيق معرفة علمية موضوعيّة.
أمّا الدّكتور الذوّادي، فإنّه، عند دراسة الرّموز، وخاصة الرّموز العربية الإسلامية، يذوب في موضوعه و يتماهى مع الفاعلين الاجتماعيّين الذين يريد تقديم معرفة علميّة عنهم بدعوتهم إلى تبنّي تأويله الديني الخاص لرموزهم و"قراءته" لنصّهم الدّيني وكأنّها "التفسير" الوحيد الصحيح للقرآن عن الإنسان و عن ثقافته.
هل هذا هو المنهج العلمي الذي سيساعدنا على " تأصيل علم الاجتماع العربي " ؟
وهل في هذا اتفاق مع " علم الاجتماع النّقدي" عند بيار بورديو ؟
ألا يدعو بورديو، بالعكس تماما، إلى الشكّ الجذري والحيطة في نفس الوقت من الحسّ العام عند العامّة ومن الحسّ المتعالم العام عند العلماء، بل وإلى الحيطة المستمرة والمساءلة المتواصلة لموقع ووعي عالم الاجتماع نفسه في كل مرحلة من مراحل بحثه العلمي ؟
هل فعلا برهن مجهود الدّكتور " المتواضع في هذا الفصل و المتمحور على استعمال مفهوم الرّوح الثقافيّة الرّموزية" على مصداقية " المنهجيّة الذّاتية " في مساعدتنا على فهم وتفسير " الرّموز الثقافيّة في كل " المستويات المعقّدة التي تحفل بها" ؟
*****
حول الوجه الإسلامي للعلم :
في الهامش السابع بعد المائتين ، من كتاب " التخلّف الأخر" تعرّض الدّكتور إلى ما سمّاه الوجه الإسلامي للعلم" قائلا :
"...فعلى سبيل المثال، ليقارن الإنسان العربي المسلم" الوجه الإسلامي بالوجه البرومثيوسي للعلم". ونعتقد أنه سوف يكتشف أن أخلاق Ethics العلم الإسلامي جدّ عالية. إنّها أخلاق تقي البشريّة الدّمار والانتحار..." ( ص110 )
إنّ التذمّر من " الوجه البرومثيوسي " للعلوم ظاهرة مرتبطة، في العلوم الإنسانية على الأقل، بقلة التركيز على الخيالي والرّمزي من ناحية وبنزعة الصراع ضد الطبيعة ومحورة العلم حول الحقيقة والنجاعة التقنية فقط.
فقد سبق لجيلبار دوران G. Durand أن ندّد بظاهرة " تكسير الصّور المقدّسة (الايقونات )، والصّور عموما (L iconoclasme) في الحضارة الغربية، كما أنّ ميشال مافّيزولي ( Michel Maffesoli)، انتقد بشدة " الوجه البرومثيوسي" للعلوم الاجتماعية الأوروبية التي تأثرت بشدة بالعلوم الطّبيعيّة وسعيها لاكتشاف الحقيقة وتطويع الطبيعة للإنسان فقط. ( م50 )
لكن في المقابل، إذا كان نقّاد البرومثيوسيّة في العلوم الاجتماعية، والعلوم عموما يدعون لتثمين ما هو رمزي وخيالي، فهم لا يعنون بذلك التراجع عن الرّوح العلمي، بل أنسنته، وفهم أهمّية النشاط الرّمزي الذي لا يتناقض بالضّرورة مع النشاط العلمي بل يتقاطع معه. والمعروف أن أصحاب هذه الفكرة يقولون أنه، حتى إذا كانت العمليّة الرّمزيّة غير عقلانية، بالمعنى العلمي للكلمة، فهذا لا يعني أن المنطق غائب فيها. إنما هنالك، إن شئنا منطق رمزي خاصّ، يختلف عن المنطق العقلي العلمي لكنه يتكامل معه عبر تكوين المخيال الاجتماعي العام الذي يعبر عن علاقة الإنسان بكل ما "يحيط به" في الطبيعة و المجتمع.
من ناحية أخرى، وربطا بالمسألة " الخلقية العلميّة " L Ethique، ينقسم حتى المدافعون عن الوجه البرومثيوسي للعلم بين دعاة ونقّاد ما يسمّى " الأداتيّة " في الفكر العلمي.
فمدرسة فرانكفورت مثلا تنقد كثيرا التصّور ألأداتي للعلم، المرتبط عندها، بالاستعمال البور جوازي له، وتنادي بأخلاقية علمية جديدة "علائقيّة " أو إن شئنا " بروميثيو-جماعيّة " إنسانيّة.
أمّا الدّكتور الذوّادي فإنّه على ما يبدو، يضع كل العلوم الغربيّة في صف " الوجه البرومثيوسي " ويعارضها " بالوجه الإسلامي للعلم "
إذن، بقطع النظّر عن موقفنا من التصوّرات البرومثيوسيّة أو الدّيونيزيّة للعلم، لا يجب على عالم الاجتماع العربي حسب رأينا، أن يعارض " الوجه الإسلامي للعلم " مع الوجه البرومثيوسي " الغربي له.
أولا، لأنه حتى في الغرب هنالك صراع حقيقي، اجتماعي وفكري حول العلوم والأخلاقية العلميّة.
وثانيا، لأنه حتى في " العلوم الإسلامية "، أو عموما في " الثقافة العربية الإسلامية"، كان هنالك صراع أيضا داخل الحقل وحول الأخلاقية العلميّة
أمّا الاكتفاء بالقول : " أن أخلاق العلم الإسلامي جدّ عالية.إنّها أخلاق تقي البشرية الدّمار والانتحار... " فهذا أمر في حاجة للإثبات عند الدّكتور، خاصّة إذا تذكّرنا تحليله لعملية الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك والهالة العجائبية التي غمرها بها، عبر ربطها بميتافيزيقيا القيم وبعدها الماورائي المتعالي.
فإذا كانت " أخلاق العلم الإسلامي " العالية هذه، هي التي توظّف المعرفة العلمية والتكنولوجيّة لقتل الأبرياء في مراكز عملهم في البرجين الشهيرين وفي مسارح موسكو ومحطات قطارات برشلونة ولندن، فهي لا تختلف في شيء عن أخلاق مفجّري القنابل في هيروشيما وناكازاكي ومبيدي فيتنام والعراق، سوى كونّها ردّة فعل بائسة ، باسم الجهاد !
*******
ومادمنا وصلنا إلى "العلم الإسلامي " فلنتذكر ابن خلدون : رأينا في الجزء الأول من هذا العمل كيف أن " سوسيولوجيا ميتاقيزيقا الرّموز الثقافية " توسع مفهوم العصبية القبليّة الخلدوني ليصبح "عصبية ثقافية إسلامية عربية". كما رأينا كيف أن الدّكتور، عندما يدعو لتأصيل علم الاجتماع العربي، يقول إن ابن خلدون أسسّ علما عربيّا.
في كتابه " التخلّف الأخر... " يتعرض الدّكتور لنفس النقطة قائلا :
"...إنّ نجاح ابن خلدون في تأسيس علم اجتماعي (علم العمران البشري) يعود إلى أن صاحب المقدّمة التزم في تحاليله الاجتماعية بدراسة خصوصيّات هذا المجتمع العربي الكبير (...) فكل باحث في " الظّاهرة الخلدونيّة " لا يسعه إلا أن يرجع تميّز مؤلّف المقدمة، في تفكيره الاجتماعي عن سابقيه ولاحقيه من أبناء هذه الأمّة، إلى أن مادة دراساته وملاحظاته وتحليلاته كانت مادّة عربيّة و مغاربيّة على الخصوص (...) فالواقعيّة الخلدونيّة المتمثلة: أولا : في التزامه باستعمال معطيات عربيّة صرفة في فهم المجتمع العربي، واتسامه ثانيا : في تحليلاته الاجتماعية بروح علميّة وبموضوعيّة عاليتين مكّنتاه فعلا من ابتكار علم العمران، ليس فقط بالنّسبة للحضارة العربية الإسلامية وإنما بالنّسبة للحضارات الإنسانية جمعاء التي سبقت زمانه" ( التخلف الأخر ص77)
إنّ الدّكتور الذوّادي "يتأرجح " بين الدّعوة لعلم اجتماع عربي إسلامي معاد للعلوم الغربية بمناهجها وأخلاقيّتها والدّعوة لعلم " للحضارات الإنسانية جمعاء..."
وإذا كان ابن خلدون عالم اجتماع عربيا مسلما، فإنّ علمه ملك للبشرية جمعاء فيما أرساه من مبادئ منهجيّة في زمانه، وليس فقط في خصوصيات القوانين الاجتماعية العربية الإسلامية التي حاول كشفها، رغم أن ذلك الوجه من علمه أساسي في مشروعه العلمي. بنفس الطريقة، إن علم الاجتماع العربي يأخذ من " العلوم الغربية"، ليس تحاليلها الخصوصيّة، بل مناهج وقواعد بحثها العلمي، اذا أثبتت كونيّتها طبعا !
أمّا في خصوص " علم العمران البشري " وعلاقته بالبرومثيوسيّة فلعلّه من الضروري التنبيه أن " العلم الإسلامي " الذي أسسّه ابن خلدون ليس خاليا من البرومثيوسيّة التي يرفضها الدّكتور.
أن موقف ابن خلدون من الشّيعة والصوّفية، هو موقف " شبه برومثيوسي " يتأطر داخل منظومة " علوم الدين" السّنية الرّسميّة الرّافضة " للرّموز الثقافيّة " للآخر المسلم. وهذا الموقف داخل العلوم الإنسانية العربيّة القديمة منتشر كثيرا، في إطار الصراعات داخل " الحقل الرّمزي " وداخل الحقل الاجتماعي " العام أيضا.
فإذا كانت البرومثيوسيّة هي، في جانب منها، " عبادة للحقيقة "، فإنّ " العلم الإسلامي لم يكن براء منها بهذا المعنى، ولا داعي لمقابلة " الوجه الإسلامي بالوجه البرومثيوسي للعلم " بوجه عام ودون تدقيق.
إنّ الصّراعات التي عرفها " العلم الإسلامي " داخليا، لم تكن خالية من نزعة تأليه الحقيقة على حساب الرمزي والخيالي، ليس فقط بين العلمي والدّيني عموما، مثلما عبر عن ذلك صراع الحكام والفقهاء ضدّ بعض علماء العرب المسلمين وحرق كتبهم وقتلهم، بل كذلك داخل " العلوم الدّينية " نفسها، حيث الفقيه الرّسمي السني يضيّق الخناق على المتصوّفة والشيعة، بسبب " خيالهم الرّمزي " في المجال الدّيني او العكس.
كما أن موقف ابن خلدون من الاجتماع البشري في صراعه مع الحيوانات ( الضواري) التي تفوق البشر في القوة والبطش، بينما يتفوق الإنسان بالعقل والعمل والسياسة، هو موقف برومثيوسي في جانب الصراع مع الطبيعة. أما موقفه من الحقيقة، فهو وإن كان رجلا مؤمنا، فقد سعى إلى تأسيس علم جديد- علم العمران- لأنه وعى في عصره إنه لا بدّ من البحث عن حقيقة الاجتماع البشري وقوانينه، وعدم الاكتفاء بالتصور الديني التقليدي ذي الطابع التقديسي للمجتمع والطبيعة.
من ناحية أخرى ،يمكن القول أن فكرة تسخير الله الطبيعة في خدمة الإنسان هي برومثيوسية ، أو هي شبيهة بها تقريبا. بل ان التسخير، في جزء من المنظور القرآني موجود حتى بين البشر،أي هنالك "برومثيوسية اجتماعية إسلامية " لان الله خلق البشر درجات وفضل بعضهم على بعض و جعل بعضهم مسخرا لخدمة البعض حسب التصور القرآني الذي يدعونا الدكتور الى تبنيه في علم الاجتماع العربي .
يبدو أن الدكتور يتذمر من «برومثيوس"، الذي سرق النار من معبد الآلهة و أعطاها للشعب وعلمهم الصنائع..، يخاف على علماء الاجتماع من ذلك ، نرجو منه ألا يستعمل رمزية النار و علاقتها بإبليس في "المنظور القرآني" و ألا "يأبلس" علماء الاجتماع العرب من غير "الرموزيين الإسلاميين" مثله ( اذ يوجد غيرهم يعتقد ، و من منظور إسلامي أيضا ، أنه "لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله " ) ويعاقبنا جميعا كما فعل "زيوس" مع " برومثيوس" بأن يسمرنا في "جبل عرفات" و يدعو "طير الأبابيل " تفقأ عيوننا .
*******
إضافة إلى المسائل السّابقة، حول علم الاجتماع بصورة عامّة، نودّ التعّرض باختصار، إلى نقاط حول علم اجتماع التبعيّة والتخلّف والتنميّة والغزو الثقافي، وهي المواضيع الرئيسية التي يعالجها كتاب " التخلف الآخر..."
أهمّ ما يميّز الدّكتور في هذه المسائل هو تناقضه الدّاخلي الصّارخ، بين دعوته إلى اعتماد منهج " كلّي اجتماعي " وتعقيدي يأخذ بعين الاعتبار " كل عناصر الظاهرة " من ناحية، ثم تراجعه التام عن ذلك عندما ينقد التيارين الليبرالي والراّديكالي في علم اجتماع التبعية والنموّ.
فمن ناحية، وكما رأينا ذلك عند التعرّض لنقطة " تعريف الإنسان " ينقد الدّكتور تصوّر اللبيراليين وخاصّة الرّاديكاليين، من أمثال أندري قندر فرانك وسمير أمين، حول " الإنسان الاقتصادي "، ويدعوهم إلى اعتماد منهج تعقيدي وشامل. ولكن من ناحية أخرى، خاصّة في مرحلته الميتافيزيقيّة "، يقول إن " الغزو الثقافي هو أخطر أنواع الغزو ، بسبب كون الإنسان له طبع " رموزي ثقافي". ( التخلّف الأخر صفحات 19 -14 - 08 )
من ناحية، يدعو الدّكتور إلى تحليل التخلّف باعتباره تخلّفا " مادّيا ومعنويّا " في نفس الوقت (نفس المصدر ص 64-63)
ويدعو إلى تحليل التبعيّة ك " مركّب متعدّد الملامح " أو كتبعيّة " ذات رؤوس"؛ ( ص66 )
كما يدعو إلى اعتبار التنمية " عملية كلّية تشمل كل النّواحي التي تساهم في بناء وتميّز المجتمع " ثم يقول : " أو ليست ثقافة المجتمع هي المميّز الأسا سي لشخصيته " (ص 65 ) ليكتفي بالعامل المميّز فقط ويهمل عوامل " بناء المجتمع" الأخرى .
من ناحية يقول لنا إن التخلّف ذو وجهين، خارجي وداخلي" (بمعنى اقتصادي...ونفسي ثقافي) (ص75 )
و يدعونا إلى ممارسة عمليّة تنمية تحقق التحرّر من " لفيف التبعيّات "( ص 66 )
لكن بعد ذلك يعود ليقول لنا ان الغزو الثقافي، وبالتالي إن التبعيّة والتخلّف الثقافيين، هما أخطر أنواع التخلّف والتبعيّة ( نفس المرجع ص ص 47-46-45 ) بسبب كون "الإنسان رموزيا بالطبّع" وكون الرّموز الثقافية هي المكوّن المركزي في "كينونة الإنسان ".
وهذا يؤدّي طبعا إلى اعتبار التنمية " الرّموزية الثقافيّة " أهم أنواع التنمية على الإطلاق، لأنها تنمية " جوهر الإنسان !"
إنّ نظرية الدّكتور في التبعية والتخلّف والتنمية هي ببساطة ردّة فعل على الماركسية بالدّرجة الأولى،و خاصة على " نظرية التبعيّة "، ومع الأسف، ردّة الفعل لا تكون غالبا علمية، لأنها تقلب اتجاه التفكير فقط دون الإحاطة " بمختلف أبعاد الظّاهرة"
لكن من غرائب الدّكتور، أنه عندما ينفد الرّاديكاليين و الوضعيين مثلا يتّهمهم بما يلي:
" هنالك تجاهل فاضح لواقع موضوعي جديد في هذه المجتمعات "
وهو قد كتب هذا سنة 1986. ولا نعرف كيف يمكنه أن يبقي على مثل هذه الملاحظات في كتاب فيه حديت عن جوانب " ميتافيزيقيّة " ويدّعى أنّه قام ببعض التعديلات على المقالات الأصلية المنشورة سابقا في مجلاّت مختلفة " وذلك لتحاشي التكرار قدر المستطاع ولتدعيم الرّباط الفكري القويّ بينها...وهكذا تبقى وحدة فصول الكتاب منيعة وقويّة " ( ص 62)
إنّ " الواقع الموضوعي الجديد" الذي يشير إليه الدّكتور سنة 1986 هو" الواقع النفسي- الثقافي الجديد ". فهل في هذا قطع مع " موضوعية الوضعيّة " أو الماركسية، أم بالعكس تدعيم لهما ؟ وهل في هذا وصل مع "ميتافيزيقيا الرّموز" ؟
4. حول بعض القضايا العربية و المغاربية :
أ- حول فرادة الوطن العربي و" الثقافة الإسلامية العربيّة "
ليس بعيدا عن ماكس فيبر وماركس و دوركهايم ، ولكن في ردّ فعل على علم الاجتماع الغربي، يقدّم لنا الدّكتور فكرة أخرى حول " فرادة الوطن العربي " بعد فرادة " الثقافة الإسلامية العربية ".
رأينا سابقا كيف أن الدّكتور يعتبر اللّغة أمّ ـوأصل وأهمّ ـ الرّموز الثقافية، وافترضنا، أنه لو كان بحث الدّكتور منطقيّا لصنّف المجتمعات حسب " العنصر الأهم ". لكنه يقول لنا انه يفضل استعمال " الثقافة الإسلامية العربية " على لفظ " الثقافة العربيّة الإسلامية "،(ناهيك عن "الثقافة العربيّة")، " لأهمية ثقل دور الإسلام في التأثير في جوهر ومعالم ظهور الثقافة في الوطن العربي "
لقد اكتفينا فيما سبق (الجزء الأول) بالإشارة إلى مسألة العنصر الأساسي وعملية التّصنيف. والآن نهتم بعنصر آخر هو عمليّة " ظهور الثقافة " في الوطن العربي "
إنّ هذا الشّاهد المقتبس من الهامش الأول " من أجل تأصيل علم الاجتماع..." في مجلة " عالم الفكر" يدلّ على أن الدّكتور لا يعتبر الدّين الإسلامي صاحب أكبر " ثقل ودور" في الثقافة العربية كعنصر من عناصرها فقط، بل وكذلك، في "ظهور" الثقافة في الوطن العربي !
إذن، علم الاجتماع يصطف هذه المرّة مع تصوّر عدمي تماما تجاه الإنتاج الثقافي العربي قبل ظهور الإسلام، سواء منه " الجاهليّ " أو المسيحي أو غيرهما.
إنّ ربط " جوهر ومعالم ظهور الثقافة في الوطن العربي " بالإسلام هو، حتى من وجهة نظر دينيّة أمر غير مقبول تماما، فلا يوجد من المسلمين من يقول إن " ظهور الثقافة في الوطن العربي " ارتبط بالإسلام !. فظهور الإسلام كان مسبوقا بوجود اللّغة العربية والشّعر والتدّين العربي سواء الإبراهيمي الحنفي أو المسيحي أو اليهودي أو غير ذلك، والأساطير والفنون والعادات والتقاليد...الخ.
إنّ موقف الدّكتور هو موقف ديني خاص جدا ، على ما يبدو، وليس موقفا علميا اجتماعيا وتاريخيّا !
******
هذا بخصوص "فرادة " " الثقافة الإسلامية العربيّة "، فماذا عن فرادة الوطن العربي ؟
قلنا أن صدى فلسفة التاريخ حاضر في هذه الفكرة ولكنّه مقلوب على ما يبدو.
المعروف أن "فرادة " أوروبا في الفكر الاجتماعي والعلوم الإنسانية الأوروبية ارتبطت تاريخيا بفكرتين : المركزيّة الأوروبية و فرادة التقدم الأوروبي . وقد ظهر ذلك بطرق مختلفة سواء في الوضعيّة أو الماركسية أو الفيبريّة أو غيرها من المدارس الأخرى.
إنّ نقد المركزية الأوروبية مهمة مطروحة على علم الاجتماع العربي بإلحاح شديد، لكن على شرط ألا يؤدّي ذلك إلى مركزية مضادّة وإلى نكوصية أو سكونية مقابل "التقدمية".
فما هو موقف الدّكتور الذوّادي ؟
بداية، نذكر أن الدّكتور سبق أن قال في " نداء حول ضرورة تأصيل علم الاجتماع العربي " ما يلي : " ...فمعطى الوحدة العربيّة الثقافيّة بين الشّعوب العربيّة هو إذن أمر سابق لعوامل الوحدة الجغرافية والاقتصادية والعسكريّة والسياسية ومتغيّرات الزمان والمكان..." (عالم الفكر، م1، ص 59 )
ويبدو أن هذه الفكرة هي وليدة تطوّر فكرة أخرى حول ما يسمّيه الدّكتور ب " الانصهار الثقافي " وكذلك حول خصوصية ما قام به " الفاتحون العرب المسلمون "
في العنصر الثالث من الفصل الأول من كتاب " التخلّف الأخر..." درس الدّكتور ما سمّاه :" أنماط التأثير الثقافيّة بين المجموعات البشريّة " ومن بين الأفكار التي عبّر عنها في هذا العنصر ما يلي : " أمّا ظاهرة الانصهار الثقافي الكامل أو شبه الكامل في رموز ثقافة الآخر فهي ظاهرة نادر وقوعها بين الشعوب في القديم والحديث ". ( التخلّف الأخر... ص 24) ولكن العنصر الرّابع من نفس الفصل حمل عنوان :" الأمة العربية كظاهرة فريدة للانصهار في الرّموز الثقافيّة للأخر". ( ص 25)
ويبدو أن الدّكتور أراد أن يهيئنا بواسطة حديثه عن ندرة ظاهرة " الانصهار الكامل أو شبه الكامل " إلى قبول فكرة " فرادة الوطن العربي ". فلنتتبع أفكاره بالتدقيق من خلال الفصلين الأول والثاني من كتاب " التخلّف الآخر..."
- أوّلا : يستعمل الدّكتور عبارة " الانصهار الكامل أو شبه الكامل" باستمرار في الفصليين المذكورين دون تحليل للفرق بين " الانصهار الكامل " و " الانصهار شبه الكامل ". وهذا طبعا يثير شكا في دقة التوصيف و ميوعته.
- ثانيا : عندما يعرّف الدّكتور " الوطن العربي"، لا يقدم لنا أفكارا واضحة عنه، فهو يقول مثلا : " ...فبرزت ظاهرة ما نسمّيه اليوم الوطن العربي، أي هذه المنطقة من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي التي تشترك أغلبّيتها الساحقة في اعتناق الرّموز الثقافية الدّينية الإسلامية، من جهة ورموز الثقافة العربية من لغة وفكر وتقاليد، من جهة أخرى." (ص26 )
ثم يقول : " إن التأريخ لما يطلق عليه اليوم اسم العالم العربي أو الوطن العربي أو الأمة العربيّة..." ( ص40)
فهو إذن، يتردّد بين مصطلح " العالم العربي" الذي هو مصطلح جغرا سياسي بالدّرجة الأولى ومصطلح " الوطن العربي " وهو مصطلح سياسي بالدّرجة الأولى ومصطلح " الأمة العربيّة " وهو مصطلح اثنوغرافي بدرجة كبيرة يغلب عليه الطّابع الوصفي عنده .
- ثالثا : يقدّم لنا الدّكتور " الوطن العربي كنتيجة لعالم الرّموز الثقافية" ( ص40 ،)
وليس "كنتيجة" لفاعلين اجتماعيين أساسا، رغم أنّّه يتحدّث عن دور " الفاتحين العرب المسلمين "، ولكن بما أن "الفاتحين" هم أنفسهم نتيجة " للنفخة الإلهية الأولى " وبما أن " الوحدة العربيّة أمر سابق لعوامل الوحدة الجغرافيّة والاقتصادية والعسكريّة والسياسيّة ومتغيّرات الزمان والمكان "، " فطبيعي " أن " الوطن " لا يصبح نتاج هذه " الوحدة " !
- رابعا : عندما يحلّل الدّكتور دور الفاتحين العرب المسلمين يقول ما يلي :" فتجربة الفتوحات العربية الإسلاميّة تفيد بأن الانصهار الثقافي الكامل أو شبه الكامل يتم بتوفر عاملين :
1. نشر الرّموز الثقافيّة الدّينية بين فئات الشّعوب. فالفاتحون العرب المسلمون عملوا في المقام الأول خارج الجزيرة العربيّة على نشر العقيدة الجديدة في البلاد المفتوحة.
2. عملوا في مرحلة لاحقة على تعليم اللّغة العربيّة لأهل بعض البلاد المفتوحة، وبالتالي ثقافتها.
فبرزت ظاهرة ما نسمّيه اليوم الوطن العربي، أي هذه المنطقة من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي التي تشترك أغلبيتها السّاحقة في اعتناق الرّموز الثقافيّة الدّينية الإسلامية، من جهة، ورموز الثقافة العربيّة من لغة وفكر وتقاليد من جهة أخرى. فالوحدة الثقافيّة بمفهومها الشّامل أصبحت واقعا مجسّما..." ( ص26-25)
وكما نلاحظ، إنّ اللّعب على تكرار عبارة " الانصهار الثقافي الكامل أو شبه الكامل" هي سبب المشكل.
يفترض في الدّكتور أن يقوم، على العكس ممّا ذهب إليه، بتنسيب استنتاجاته لسبب بسيط جدا هو التالي، بما أنّه يقول أن " الأغلبية الساحقة " لسكان الوطن العربي" وليس " كلّ سكانه" أصبحوا عربا مسلمين، فكان عليه أن يقول أن هنالك انصهارا " شبه كامل" فقط، وبالتالي يكفّ "الوطن العربي"، وفق هذا المقياس عن أن يكون ظاهرة فريدة ! لكنه يصّر على الحديث عن "الانصهار الكامل أو شبه الكامل" معا، في سلّة واحدة، ويصل في النهاية إلى القول إن " الوحدة الثقافية بمفهومها الشامل أصبحت واقعا مجسّما" وكان عليه أن يوضح لنا معنى
" المفهوم الشّامل" هذا ؟
إنّ الدّكتور لا يريد أن يرى في اتّجاه من لم يتعرّب لسانه ولم تتأسلم "رموزه الدّينية" في العالم العربي "، إنّهم على ما يبدو مجرّد أقلية ساحقة" ! لا مكان لهم في "البحث العلمي الأساسي"
أكثر من ذلك، إنّه يقول إن مفهومه للرّموز يساعدنا على تحليل الظاهرة كما يلي :
"...فالرّموز الثقافية، كما أشرنا، ذات مركزيّة أولى في تركيبة هوّية الإنسان والمجتمع. إن الاستيلاء عليها هو استيلاء على أعمق ما في الإنسان والمجتمع. إنّه روحهما. وهذا ما تمّ فعلا، إلى حدّ، على أيدي الفاتحين العرب والمسلمين في ما يسمّى اليوم الوطن العربي . فإسلام معظم فئات هذه الشعوب يعني تبنّيهم الرّموز الثقافية للعقيدة الإسلامية وتخلّيهم عن الرّموز الثقافية لدياناتهم السّابقة. وتعريب لسان أغلبية سكان تلك الأقطار المفتوحة يعني تهميش، ثم انقراض اللّغات واللّهجات الأخرى أمام زحف لغة القرآن..." ( ص26)
ونتيجة لهذا تحدّث الدّكتور بعد ذلك عن سطوة الثقافة العربية الإسلامية المسيطرة وعن انصهار أجناس مختلفة في بوتقة الحضارة العربية الإسلامية...
إنّ الدّكتور وهو يتحدّث عن " استيلاء الفاتحين العرب والمسلمين" على لسان الآخرين وعقيدتهم ، ينسى ملاحظة ذكرها بخصوص علاقة فرنسا بالجزائر ، حينما فسّر فشل فرنسا في تحقيق " الانصهار الثقافي الكامل " للجزائريين باقتران الهيمنة الفرنسية " بعوامل الهيمنة والعنف الاستعماريين " ( ص 26) ولكنّه، مقابل حديثه عن غزو "أسبانيا" كما رأينا في الجزء الأول من هذا العمل، يتردّد بين "الفتح" و "الاستيلاء على الرّموز" داخل "الوطن العربي" !
إن الشجاعة العلميّة في تسمية الأمور بأسمائها، كما كان يفعل المسلمون الأوائل حول "غزوة أحد" و"غزوة بدر" وغيرها، مطلوبة في علم الاجتماع العربي، فذلك لا ينقص من عروبة وإسلام الشّخص. وفي المقابل، ذلك يسهل تفسير سبب إبقاء ملايين العرب المسيحيين على دينهم وملايين البربر المسلمين على بربريّة لسانهم. هذا إضافة إلى الأكراد والكلدوآشوريين وغيرهم، وكلهم يسكنون معنا " العالم العربي" الواقع بين الأطلسي والخليج !
كلّ هؤلاء لا يذكرهم الدّكتور لأنّهم يقوّضون فكرته عن " فرادة الوطن العربي " الذي حققّ " الانصهار الثقافي الكامل (!) أو شبه الكامل "
من ناحية أخرى، وفي المقابل يركّز الدّكتور على عناصر "الانصهار" وعلى "التجانس" لأنّه "ليس من المبالغة القول إنّ الوطن العربي كظاهرة ثقافية متجانسة ظاهرة فريدة من نوعها..." (ص28)
كما أن الوطن العربي، على عكس أوروبا، حيث يوجد "تشابه" ثقافي فقط، يتميز " بالتطابق الثقافي الكامل أو شبه الكامل" ( ص 27) وهذا التجانس والانصهار والتّطابق الثقافي يوجد حسب الدّكتور " رغم تصارع الحكّام في منطقة مابين الخليج والمحيط في الماضي(...) والمستقبل" ( ص 28)
والغريب أن الدّكتور عندما يتعرّض لمسألة صراع الحكام العرب هذه يقدّمها كما يلي :
" فقد تصارع الحكّام لأسباب سياسيّة واقتصادية وحدودية في الماضي والحاضر. وممّا لا ريب فيه أنهم سوف يتصارعون في المستقبل القريب و البعيد. فكانت المجابهة حول مسألة الخلافة بين علّي ومعاوية بعيد وفاة النّبي. وتليها المصادمة في الصّدر الأول للإسلام بين الأمويين والعّباسيين..." ( ص 41-40)
إنّه يقدّم صراعات الحكام فقط في الميدان السياسي والاقتصادي والحدودي...ورغم أنّه ذكر الصّراع حول " مسألة الخلافة بين علّي ومعاوية" فانه لا ينتبه إلى أن ذلك له علاقة مباشرة أيضا مع " الرّموز الثقافيّة " ! هذا إذا "غفرنا" للدكتور إيهامه للقارئ إنه لا شيء رمزي في " الميدان السياسي والاقتصادي والحدودي".
إنّ صراعات الحكام تبدو وكأنّها خارج " الثقافة الإسلامية " المتجانسة، المنصهرة والمتطابقة ! ولا نعرف من أين خرج الانقسام بين السّنة والشيعة والمتصوّفة والمعتزلة والخوارج وغيرهم.
إنّ ذكر مسألة الصّراع حول الخلافة بين علّي ومعاوية تذكّر أي مسلم عادي، ناهيك عن باحث في علم الاجتماع الثقافي، بانشقاق كبير، بل هو الانشقاق الأكبر، في " الرّموز الثقافية" الدّينية الإسلامية و إننا نستغرب هذا الأمر من زميل لهشام جعيط الذي وضح بما فيه الكفاية "جدلية الدين و السياسة في الإسلام المبكر" . (م51).
لكن الدّكتور لا يهتم بذلك تماما لأنه يصرّ على " فرادة الوطن العربي" و فرادة " الثقافة الإسلامية العربية " ! وهو نفسه الذي حلّل ظاهرة " العزلتين في المجتمع الكندي " بوجود تعدّد لغوي (فرنسية وأنقليزيّة) ، وتعدّد ديني (كاثوليكي وبروتستانتي) ( ص45-41)
ومن البديهي التذكير بأن التعدّد اللّغوي والدّيني و المذهبي موجود أيضا في "العالم العربي" أو "الوطن العربي" أو "الأمة العربية ". بين العربيّة والبربرية والكرديّة والكلدوآشوريّة...من ناحية وبين المسيحيّة والإسلام وكذلك بين السنّة والشيعة وغيرهم داخل الإسلام نفسه وبين الأرثوذكس والكاثوليك وغيرهم داخل المسيحية العربية نفسها.
لكن، رغم هذا، لا يرى الدّكتور سوى أن " تجربة العرب المسلمين خارج الجزيرة العربيّة تجربة فريدة من حيث تمكنّها تمكنا كاملا من تحقيق الصّهر الثقافي الكامل أو شبه الكامل "للآخر" في بوتقة الحضارة العربية الإسلامية". ( ص28)
ولا نعرف ماذا يقصد الدّكتور "بالتمكّن الكامل " من الصّهر" شبه الكامل" ؟.
كما أننا نستغرب منه أن يضع عبارة الآخر بين هلالين مزدوجين وهو يتحدّث عن "الصّهر"، فهل ينفي على من تمّ "صهره" حتى صفته كآخر؟.مثلا، هل ينفي عنه أنه لم يكن عربيا ومسلما في مرحلة ما، وبالتالي انه كان آخر، مقارنة بسكان الجزيرة العربية المسلمة الأولى ؟
إنّ ما يهمّ الدّكتور على ما يبدو، ليس دراسة الواقع، بل تطويعه، غصبا ، لتصوّره النظري المسبق، حتى لو كان ذلك ضدّ كل الوقائع التاريخية أو المنطق السّوسيولوجي.
وإضافة إلى مسألة التماسك والتجانس والانصهار، يختم الدّكتور تحليله الميتافيزيقي "للرّموز الثقافية" للوطن العربي قائلا :" :" إنّ الرّباط الثقافي المتجانس بمعناه الشامل بين الشعوب الشرق أوسطية منذ إسلامها وتعرّب لسانها وثقافتها وفكرتها أعطى لتواصلها روحيا وثقافيا شيئا من الخلود والأبديّة " ( ص40)
وذلك لأن "...الرّوابط الثقافية بين الأفراد والجماعات والمجتمعات تطبع حبل التواصل والتّضامن بينها بطابع الأزليّة الذي لا تعرفه الأحلاف العسكرية ولا التجمّعات الاقتصادية بين الأمم والشعوب". ( ص41)
وسبب كل هذا حسب الدّكتور هو أن " لروابط الرّموز الثقافيّة منطقها الخاصّ، فهي لا تعبأ كثيرا بمثل تلك الأحداث العارضة بين بني البشر. إنّها ذات قدرة شبه ميتافيزيقيّة في تجاوز تلك الأحداث مهما كانت طبيعة مأساويتّها. فالرّوابط الثقافية العربية الإسلامية المتجانسة (الرّموز الدينيّة الإسلامية والرموز اللّغوية والثقافية العربية) مكّنت العرب المسلمين من التواصل والتّضامن شعورا وممارسة منذ أكثر من أربعة عشر قرنا." ( ص41).
إذن الصراعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحدودية وغيرها، حتى تلك التي دارت حول "الخلافة"، هي أحداث "عارضة"، أمّا تماسك الرّموز وتجانسها فهو " جوهري"، له منطقه الميتافيزيقي الخاصّ، الذي يتميّز على ما يبدو "بالتماسك الأزلي".
مقابل فرادة الغرب ذات النزعة المركزية الأوروبية و"التقدمية" ، عندنا نحن، حسب الدّكتور فرادة عربية إسلامية مضادّة ذات نزعة تماسكيّة أزلية وخالدة.
هكذا إذن، عوض الاكتفاء بالبحث عن خصوصيات المجتمع العربي، الموجودة بالتأكيد والتي تعبر عن "فرادة ثقافية" ما، على الأقل في خصوصية اللّغة، وخصوصية جوانب أخرى من الثقافة العربية، (دون سقوط في ردّ فعل مركزي مضادّ ونكوصي سكوني ذي طابع تجانسي تضامني مفتعل)، لا يفعل الدّكتور سوى قلب مساوئ علم الاجتماع الغربي على رأسها وإلصاقها بعلم الاجتماع العربي.
حول "التخلّف الأخر" عربيا و مغاربيّا :
من بين أهم المواضيع التي عالجها الدّكتور حول التبعية والتنمية والتخلّف موضوع الازدواج اللغوي والثقافي بمختلف تفرعاته.
وللحقيقة، يحتوي كتاب " التخلّف الأخر" أفكارا جيّدة كثيرة حول هذا الموضوع، في المقالات التي كتبها الدّكتور قبل وصوله إلى " المرحلة الميتافيزيقيّة " من بحثه العلمي.
إنّ أهم وأخطر الخلافات معه تظهر بعد التّسعينات، عندما بدأ يركّز على " المعالم الميتافيزيقيّة للثقافة". لكن ، رغم الطابع الإيجابي العام ، نريد تقديم الملاحظات التالية :
أولا : عندما يعرّف الدّكتور " التخلّف اللغوي الثقافي"... يطرحه كما يلي :"...إن اللّغة والثقافة الوطنيتين، مثلا، تصبحان متخلّفتين في مجتمعهما إذا لم تستعملا بالكامل في كلّ شؤون مجتمعهما..." ( التخلّف الأخر ص 5 )
ويحتوي هذا التعريف على عنصرين مترابطين
- استعمال اللغة والثقافة بالكامل
- استعمالهما في كلّ شؤون المجتمع
وإذا كان المعنى الثاني مقبولا عموما، فإنّ العنصر الأول غير مقبول علميّا وغير ممكن عمليّا.
إن استعمال اللّغة والثقافة بالكامل، أمر غير ممكن لأن الاستعمال، سواء عند الفرد أو حتى عند المجتمع، لا يمكن أن يغطّي كامل اللّغة الوطنية والثقافة الوطنية. إن كل علوم اللّغة واللسانيات الاجتماعية وعلوم التواصل والاتصال تردّد دائما أن الإنسان لا يستعمل من لغته الوطنية سوى جزء فقط يزيد أو ينقص حسب معطيات عديدة. وحتى المجتمعات، بكاملها، رغم أنّ عملية قياس الاستعمال الاجتماعي للّغة صعب جدّا، لا تستعمل بالكامل لغتها الوطنية أبدا، وتكفي قراءة أيّ معجم لغوي في أيّة لغة كانت لمعرفة حقيقة الاستعمال الجزئي للّغة عند كل الأفراد والمجتمعات، والأمر نفسه ينطبق على الثقافة، حيث توجد داخلها عناصر تهمل تدريجيّا وتدخل ضمن ما يسمّى "الفولكلور" وتموت تماما في وقت لاحق.
وبهذه الطريقة، إذا عرّفنا التخلّف اللغوي والثقافي بغياب "الاستعمال بالكامل"، فإن كل المجتمعات تصبح متخلّفة لغويّا وثقافيا ! لكن الدكتور يتجاهل جدلية الاستعمال و الإهمال التي تعرض إليها حتى أوائل اللغويين العرب القدامى.
ثانيا : عندما يتعرّض الدّكتور للواقع اللّغوي في الوطن العربي أو بعبارته هو " العالم العربي" ( ص93-89) يقول ما يلي :
" تنتشر في المجتمعات العربيّة ثلاث لغات مهمّة بما للّغة من معنى في العلوم اللّغوية الحديثة. إنّها
العربية الفصحى والإنجليزية خصوصا بالمشرق العربي والفرنسية بالمغرب العربي. ومن ناحية
أخرى، هنالك اللّهجات العامّية العربية المتحدّثة التي يتشابه البعض منها أكثر وذلك حسب منطق
مؤثرات تاريخية ولغويّة و جهويّة خاصة في مجتمعات الوطن العربي..." ( ص 89)
هكذا، وكما رأينا سابقا، يؤدّي الخلط بين مصطلحات "العالم العربي" و"المجتمعات العربيّة" هذه المّرة، إلى نسيان الدّكتور لباقي اللّغات واللّهجات الموجودة في "العالم العربي" مثل البربريّة و الكرديّة
والكلدوآ شورية السريانيّة واللّهجات الإفريقيّة المختلطة بالعربية في السّودان و موريتانيا مثلا وكذلك اللّغة العبريّة، ليس فقط في فلسطين المحتلة، بل وفي دول عربية أخرى حيث توجد أقلّيات يهوديّة.
إنّ الصّورة النمطية عن اللّسان العربي الذي هو فصيح وعامّي من ناحية ومرتبط بالفرنسية أو الإنجليزيّة من ناحية أخرى ، تنسي الدّكتور الواقع اللّغوي الأكثر تعقيدا في "العالم العربي" أو "المجتمعات العربية"
إنّ الدّكتور يعرف، بالطبع جيدّا هذا الواقع، لكنّ النّسق الفكري الذي يقوده يجعله يهمل هذه المسائل في تحليله.
إنّ مفهوم "اللّغة الوطنية" عنده، مثلا، هو دائما مفهوم العربيّة الفصحى وهو على ما يبدو لا يعتبر، أو ربّما لا يريد القبول بالبربريّة والكرديّة مثلا كلغات وطنية أيضا، في البلدان العربية المتعدّدة اللّغات.
ويقول الدّكتور ما يلي على سبيل المثال :
" في الوقت الحاضر تعلن دساتير تونس والجزائر والمغرب بأنّ اللّغة العربية هي اللّغة الوطنية، لكن مشكلة اللّغة البربريّة يزداد طرحها في الجزائر والمغرب. لكن هنالك إجماع على أن العربيّة هي اللّغة الوطنية في كل من هذين المجتمعين. ولذا فاستعمالنا لعبارة " اللّغة الوطنية" يعني العربيّة المكتوبة والمحكيّة". (الهامش رقم255 في الصفحة 132 من " التخلّف الأخر...")
إنّ الدّكتور يحدّد تعريفه لوطنية اللّغة من خلال الدّستور المعمول به في هذا البلد أو ذاك، وهو يحلّل " المجتمعين" وليس "الدّولتين" الجزائرية والمغربيّة. وهذا الأمر لا يفترض أن يقبله عالم الاجتماع الذي لا يهمّه علميّا وجود أو عدم وجود "إجماع" سياسي على أمر ما. لكن، يبدو أنّه، مع الأسف يقبل ذلك "الإجماع" من أجل خدمة تصوّره الفكري بالأساس.
ثالثا : عندما يتعرض الدّكتور للتخلّف الثقافي، ويربطه بالاستعمال "بالكامل" للثقافة الوطنية"، يطرح على نفسه مشكلا كبيرا، من ناحية، لأن الثقافة تحتوي العلم حسب تعريفه لها، لكن العلم لا وطن له، بوصفه خطابا، وليس بوصفه ممارسة (خاصّة العلوم الصحيحة والطبيعيّة).
من ناحية ثانية : الثقافة الوطنّية بداخلها عناصر سلبية وأخرى ايجابية. وفي مرحلة التحرّر الثقافي للبلدان المستعمرة والتابعة، لا يمكن لعالم الاجتماع أن يطرح على مجتمعه " استعمال الثقافة الوطنية بالكامل في كل شؤونه الوطنية"، لأن بعض عناصر الثقافة الوطنية هي عناصر تخلّف و جذب إلى الوراء ، على عكس بعض عناصر الثقافة الأجنبية التي يمكن استعمالها وطنيا للنهوض بالثقافة الوطنيّة نفسها.
إنّ طرح الدّكتور لمسألة الاستقلال اللّغوي والثقافي، بهذا المعنى يكاد ينفي عن الثقافة أي جانب إنساني عامّ. وهو طرح " شوفيني وطني " أكثر منه علمي وإنساني للمسألة.
رابعا : مقارنة بالمرحلة ما قبل الميتافيزيقيّة، يصرّ الدّكتور في مرحلته الجديدة، ابتداء من التسّعينات، على " الجوانب الميتافيزيقّية للرّموز الثقافية"، ويمكن الاستعانة بالدّكتور ضدّ أفكاره الخاصة. فبينما يركّز في مقالاته الأخيرة على الأبعاد الميتافيزيقيّة والأزلية واللاّمحسوسة للرّموز، بقطع النّظر عن الحدود والاقتصاد والسّياسة والزمان والمكان...نجد في بعض مقالاته القديمة، في الثمانينات، مقاربات سوسيولوجيّة تأخذ بعين الاعتبار " القرار السيّاسي" و"التكوين الثقافي للقيادة السياسيّة" و"إيديولوجيا القيادة السياسيّة"...الخ. في دراسة " أسباب نجاح وتعثر توطين اللّغة في كلّ من المجتمع الجزائري و التونسي والكيباكي" مثلا.." ( ص ص 155-136)
كما نجد تحليلات دقيقة نسبيّا لمسائل التعدّد اللّغوي والازدواج والمزج والتفسخ والاغتراب، مقارنة بالصّيغة العامّة التي وردت في مقال " في أبجدية الرّموز الثقافية..." الذي نشره الدّكتور في مجلّة " الآداب"، وبالتأكيد لعبت دواعي النّشر دورا في هذا، لكنّ ذلك لا يمنع من تدقيق بعض التعريفات على الأقل.
- حول المرأة المغاربية:
يركّز الدكتور على خصوصية " التخلف الآخر" عند المرأة المغاربية عموما والتونسية تحديدا من خلال ما سماه بـ"الفرنكو- آراب الأنثوية".
يقول الدكتور: " فالملاحظات المتكررة بهذا الشأن تدل على أن هذا الصنف من المرأة المغاربية المتعلمة يميل أكثر من نظيره المغربي، مثلا، إلى استعمال الكلمات والعبارات الفرنسية أثناء كلامه بالعامية العربية: "الفرنكو آراب الأنثوية ". كما أن هذه المرأة المغاربية تميل أكثر من نظيرها الرجل إلى الاحتفال بأعياد الميلاد، سواء كانت بالنسبة إلى الأطفال أو إلى نفسها أو إلى زوجها" (ص22).
إن المرأة إذن هي، بعبارات الدكتور الذوادي تعاني أكثر من الرجل المغاربي، من " التخلف الآخر". أما أدلة الدكتور على ذلك فهي:
أولا: الملاحظات المتكررة حول استعمال الكلمات والعبارات الفرنسية
ثانيا: الاحتفال بأعياد الميلاد
إن الملاحظات التي يذكرها الدكتور، داخل صفوف " المرأة المتعلمة " هي على ما يبدو ملاحظاته الشخصية. وإذا كانت الملاحظة هي واحدة من تقنيات البحث السوسيولوجي فإنها تبقى ضعيفة المصداقية من الناحية العلمية لأنها ، من ناحية، مرتبطة بالشخص الملاحظ وبمعتقداته الشخصية ومن ناحية ثانية بمحيطه الشخصي الذي هو غير قابل للتعميم بالضرورة على " مجتمع البحث". إن العينات التي تفترض أن الدكتور لاحظها من " المرأة المتعلمة" ليست بالضرورة ممثلة. وقد كان من الجدير به القيام بأبحاث ميدانية تعتمد تقنيات أخرى لتحويل تلك الملاحظات إلى حقائق علمية.
من ناحية أخرى، إن مؤشر " الاحتفال بأعياد الميلاد" الذي ذكره الدكتور، على أنه يدخل ضمن " التخلف الثقافي" المرتبط بتقليد الغرب، يمكن تنسيبه إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المرأة المغاربية ليست أكثر احتفالا من الرجل المغاربي بأعياد الميلاد فقط، بل وكذلك ، ربما، بالأعياد الإسلامية.
إن وضعية المرأة المغاربية الدونية مقارنة بالرجل، تحمّلها مسؤولية " المنزل والأسرة" أكثر منه وتحرمها من الاحتفال خارج المنزل، وهي بذلك تحاول استغلال أية فرصة لخلق جو احتفالي داخل المسكن يخرجها من روتين عبوديتها المنزلية وإقصائها الاجتماعي في الميدان الترفيهي. ولكن هذا الأمر ينطبق ليس فقط على أعياد الميلاد. التي يبدو أن الدكتور يصّر على إعطائها صفة مسيحية حتى لو كان عيد ميلاد الابن أو الزوج، بل كذلك على الأعياد الإسلامية. فالرجل ليس أكثر احتفالا من المرأة المغاربية بعيد الفطر أو الأضحى أو غيرهما.
بعد تسجيل ملاحظاته السابقة، يقترح الدكتور تفسير الظاهرة كما يلي: " إن التلهف على كسب رهان الحداثة بشكلها ومضمونها الغربيين هو السبب الرئيسي المفسر لمثل تلك السلوكات" (ص22) وهو يعود مرة أخرى إلى " السبب الرئيسي"، ولا يقدم لنا " مركب الأسباب" الذي يفسر الظاهرة. كما يفترض في باحث يدعو إلى اعتماد الفكر التعقيدي المركب. ثم هو يركز على سبب نفسي- اجتماعي يسميه " التلهف على كسب رهان الحداثة"، دون أن يفسر لنا أسباب ذلك التلهف نفسه إلا بالفكرة الخلدونية حول " ولع المغلوب بتقليد الغالب"، أي " بسبب رئيسي" واحد!
وعندما حاول الدكتور إنصاف المرأة قال:
" ولكن المرأة المغاربية يبدو أنها تتعرض أكثر من زميلها المغاربي إلى ضغوط اجتماعية تقليدية في سعيها في مجتمعها للتمتع بمكاسب الحداثة بمعناها الغربي. فتقاليد مجتمعات المغرب العربي العربية الإسلامية وأعرافها وقيمها تتشدد أكثر إزاء المرأة بالنسبة إلى ممارساتها للتجربة الحداثية. ومن ثم فاندفاع المرأة المغاربية المتعلمة تعليما غربيا إلى تقليد أكبر في اللغة والرموز الثقافية هو عبارة عن احتجاج سلمي ضد مجتمع الرجال من ناحية، وتعويض ما فقدته من الممارسات الحداثية بسبب العراقيل الاجتماعية المحافظة من ناحية أخرى" (ص 23).
لكن هذه الطريقة في التحليل يمكن معارضتها تماما، خاصة في استنتاجاتها، انطلاقا من نفس المقدمات المتعلقة بوضعية المرأة.
فإذا كانت المرأة تتعرض أكثر من الرجل للضغوط الاجتماعية والتقاليد والقيم والأعراف، وهذا صحيح، فيمكن القول إن المرأة تحتج في نفس الوقت ضد " الحداثة التابعة" التي يديرها الرجال وضد " تقاليد مجتمعات المغرب العربي العربية الإسلامية وأعرافها وقيمها ، إنها تحتج ضد الحداثة الممزوجة بالتقاليد المتشددة، هذه الحداثة المشبوهة التي يحتل الرجال فيها موقع المغلوب- الغالب، المغلوب وطنيا والغالب جنسيا، بينما تحتل فيها المرأة موقع المغلوب المضاعف وطنيا وجنسيا.
لهذا يمكن القول إن احتجاج المرأة المقموع بشدة، مثلما تدل على ذلك وضعية الحركات النسوية في المغرب العربي، لا يدخل ضمن درجة من " التخلف الآخر" أعلى من الرجل، بل ضمن حركة عامة اعتراضية على تشوه الحداثة المرتبط بشدة العادات والتقاليد والأعراف والقيم العربية الإسلامية في ازدواجية متأزمة تعبر عنها الدولة الوطنية ونموذجها التحديثي.
إن الدكتور الذوادي يعترف بهذا الواقع الخاص عند المرأة المغاربية المتعلمة التي يرى هو أيضا أنها تعيش في " تحقير مزدوج" من المستعمر والرجل على حد السواء (ص168-170).
لكن، مع الأسف، يبدو أنه لا ينتبه إلى احتجاج المرأة إلا عندما يكون شكل ذلك الاحتجاج "مريبا"، يعكس فقط " التحقير" الذاتي للمغلوبة ( المغاربية) وطنيا وجنسيا ومحاولة إيجاد " حل تعويضي لكسب رهان المساواة مع الرجل" (ص 169) دون أية إشارة إلى أن ذلك يعكس أيضا تطلعا إلى تحرر حقيقي ( وليس فقط حلا تعويضيا من خلال الفرنكوـ أراب).
فإذا كان الدكتور يعترف أن " نمط الفرنكو ـ آراب الأنثوية بالمغرب العربي هو حصيلة لصنفين من ممارسات القهر الناتج عن علاقة المستعمر بالمستعمر و القهر الناتج من تقاليد وعقلية مجتمعات المغرب العربي" (ص170) ، فإنه لا يدفع التحليل إلى أقصاه بالنظر إلى ما تتطلع إليه المرأة من مساواة فعلية مع الرجل ضمن حداثة فعلية، ضد الحداثة التابعة و" تقاليد وعقلية" (فقط) مجتمعات المغرب العربي في نفس الوقت.
إن الفرنكو ـ آراب الذكوري والأنثوي على حدّ السواء، ظاهرتين سلبيتين إذا ارتبطتا بعقدة نقص عند الإنسان التابع عموما. لكن محاولة تقديم المرأة المغاربية على أنها غارقة أكثر من الرجل في " التخلف الآخر" هو جلد للضحية مقابل تسامح مع " الجلاد". فإذا كان الرجل نفسه عنده مزج لغوي، وهو المسؤول الأساسي- كجنس- عن التبعية للمستعمر. فهو يتحمل المسؤولية الأولى عن وضعية المرأة المهمشة، والمقصاة ليس فقط عن: " قدسيات ومحرمات ثقافات مجتمعات المغرب العربي، وفي طليعتها تلك التي لا يقبل الرجال تشويهها و دوسها مثل فضاءات الحانات والمقاهي" (ص: 23 ) .بل في طليعتها فضاءات الحكم والعمل والعلم.
إن تصوير الرجل المغاربي على أنه" مفرنس "وبالتالي يحتكر فضاء الحانة والمقهى ، وكأن الرجل العربي المسلم غير المفرنس يقبل يتقاسمها ، وإن تصوير المرأة المغاربية المتعلمة على أنها أكثر " تخلفا لغويا وثقافيا" من الرجل وأكثر تبعية للمستعمر، ولو من باب " الاحتجاج السلمي" هو برأينا محاولة كاريكاتورية ظاهرها تحليل سوسيولوجي لخصوصية وضع المرأة، لكن باطنها محاولة ذكورية متعالمة تحمّل المرأة أوزار "الرجل المغاربي"، الذي يقدّم هو بدوره أحيانا على أنه يكاد يحتاج إلى " فتح عربي إسلامي" جديد!
إن الطريقة التي يعالج بها الدكتور ظاهرة " الفرنكو آراب الأنثوية" رغم احتوائها على بعض الملاحظات الجيدة فعلا، تهمل نقطة مهمة وأساسية تتمثل في ما يلي: ماذا تخفي تلك الظاهرة وراءها؟
هل " القهر المزدوج" فقط أم كذلك "الاحتجاج المزدوج" ضد المستعمر والرجل؟
يبدو أن الدكتور يركز أساسا على " القهر المزدوج" مع الاحتجاج السلمي على الرجل فقط، يقول: " ومن ثم، فاندفاع المرأة المغاربية المتعلمة تعليما غربيا إلى تقليد أكبر في اللغة والرموز الثقافية هو عبارة عن احتجاج سلمي ضد مجتمع الرجال ، من ناحية وتعويض ما فقدته من الممارسات الحداثية بسبب العراقيل الاجتماعية المحافظة، من ناحية
أخرى" (ص23)
.
ثم يضيف: " فالفرنسية كسلاح رمزي عند هؤلاء النساء المغاربيات تقوم بوظيفتين لديهن (1) محاولة الاقتراب من صورة ومكانة الغالب (الفرنسي) وذلك باستعمال لغته قصد التخلص من الشعور بالدونية أمام الغالب.(2) إن استعمال الفرنسية هو سلاح رمزي يستعمله الجنس اللطيف كعملية احتجاج سلمي على هذه المجتمعات التي لا تزال بها عراقيل كثيرة تقف أمام مساواة الرجل بالمرأة " (ص169-170).
إذن، عندما يتعلق الأمر بفرنسا، بالمستعمر ، تستعمل المرأة اللغة الفرنسية للاقتراب من الغالب وللتعويض على ما فقدته من الممارسات الحداثية بمعناها الغربي.
أما عندما يتعلق الأمر بالرجل وبالثقافة العربية الإسلامية، فالمرآة تستعمل اللغة الفرنسية كسلاح احتجاجي...
هكذا، إذن المرأة لا تستعمل الفرنسية مثلا كسلاح ضد فرنسا، النساء المتعلمات لا ينطبق عليهن قول كاتب ياسين حول اللغة الفرنسية كونها " غنيمة حرب" ... إنهن يستعملن الفرنسية احتجاجا على الرجال وعلى الثقافة العربية الإسلامية فقط. إن هذه الثنائية يمكن اختراقها طبعا، فالمرأة قد تستعمل الفرنسية ضد المستعمر ومن أجل الاقتراب من الرجل بحثا عن المساواة معه في إطار حداثة ليست تابعة و"رثة" (حسب عبارة الدكتور برهان غليون ) بالضرورة.
فإذا طبقنا لغة الغالب والمغلوب الخلدونية التي يريد الدكتور استعمالها، قد يصبح التعريب سلاحا مسلطا من الرجال تجاه النساء فقط للأسباب التالية:
- الرجل مغلوب من المستعمر وبالتالي يتفرنس تقليدا للغالب.
- المرأة مغلوبة من المستعمر وبالتالي تتفرنس تقليدا للغالب الأول: المستعمر
- المرأة مغلوبة من الرجل، الذي هو نفسه متفرنس، وبالتالي تزاحمه في التفرنس
ماذا يبقى حسب هذا المنطق؟
- فرنسا هي الغالب الأكبر تفرض لغتها وثقافتها على الرجال والنساء
- الرجل غالب أصغر للمرأة يفرض العربية على المرأة حتى لا تتحرر من سلطته وتزاحمه في خدمة فرنسا بتفرنسها مثله.
إن المسألة كلها لا يجب أن تختصر في ما يشبه التسليم بحتمية أحادية تتمثل في أن " المغلوب مولع دائما بتقليد الغالب". إنها لا بد من أن تطرح من زوايا عديدة. فقد يوجد قسم من المغلوبين يرفض تقليد الغالب ويقاومه وآخر يقوم بالتقليد.
وقد يوجد قسم من المغلوبين يقلد الغالب من باب الندية والعمل على المزاحمة والانتصار.
وقد يوجد قسم من الغالبين يتعاطف مع المغلوبين أو مع قسم منهم، فيضغط من أجل قلب العلاقة باتجاه المساواة...إلخ.
إذن، إن الاكتفاء بتكرار بعض الجمل الخلدونية واستعمالها بصورة متعمدة لتوجيه التحليل السوسيولوجي وجهة أحادية يضر ذلك التحليل مهما حاولنا إلباسه ثوب الشرعية من خلال الاستشهاد بأعلام علم الاجتماع العالمي أو العربي. في مثل هذه الحالات، المهم ليس الاستظهار بالاستشهادات التي تقوم مقام " صكوك الغفران"، المهم هو " التخيل السوسيولوجي" من أجل الانتباه إلى تعقد الظاهرة ومحاولة مقاربتها من كل الجوانب، وابن خلدون نفسه يشهد على ذلك، فهو نفسه الذي حلل تحول المغلوبين إلى غالبين وبالعكس، كلما اشتدت أو ضعفت شوكتهم واشتدت أو هزلت عصبيتهم القبلية.
إن التحليل الذي يقدمه الدكتور " للفرنكو آراب الأنثوية" ولوضعية المرأة المغاربية والتونسية مخترق حسب رأينا بصورة دونية عن "المرأة المتعلمة" خاصة، لأسباب خاصة بالدكتور تماما ولم يقم بإثباتها بجدية عبر مسوحات ميدانية وذات مصداقية.
إن هذا التحليل مخترق، ربما، بعلموية " سوسيولوجية – إسلامية" لفكرة المرأة " الناقصة العقل و الدين " والمحولة إلى ما يشبه فكرة " المرأة الناقصة لغة وثقافة" وبالتالي، المرأة المعبرة أكثر من الرجل عن "التخلف الآخر".
لكن الأمر لا يتعلق فقط بالمرأة، فالدكتور، عندما يتعلق الأمر بتونس يصب جام غضبه على الجميع، رجالا ونساء، نخبا ومؤسسات.
5 . حول " التخلّف الأخر" في تونس :
في الجزء الأول من هذا العمل، عندما تعرّضنا إلى ما كتبه الدّكتور حول تونس في مجلّة "الآداب"، قلنا إنّه تعامل مع التبعية في تونس بطريقة غير سليمة سواء من حيث التّناول النّظري للمؤسسّات والنـخب التونسية أو من حيث التعاطي مع معطيات التاريخ الاجتماعي لمسائل التبعيّة وخاصّة مسألة التعريب والمناداة بالثقافة الوطنية.
وعندما رجعنا إلى كتاب "التخلّف الأخر..." زادت قناعتنا بما ذهبنا إليه سابقا، مع تغيّرات "طفيفة" في بعض المسائل.
اعترف الدّكتور مثلا ان المجتمع التونسي "ثلاثي اللّغة " وليس ثنائيا، أي بوجود مزج بين الفرنسية والعربية الفصحى والعامية ( ص 181).
ولكن خلافا لمرونة تحليله للمجتمع الجزائري، رغم أن ظاهرة الفرنكفونية موجودة فيه أكثر على ما يبدو، من المجتمع التونسي، تعامل الدّكتور مع المثال التونسي بطريقة تكاد تكون مخترقة بتصّور بعض الشيوخ "الإسلاميين" وبعض رجال السيّاسة " العروبيين"، كما قلنا سابقا، وقدّم لنا صورة ،أقل ما يقال عنها أنّها، قاتمة.
تتلخّص هذه الصّورة في ما كتبه في الفصل الأوّل من الجزء الأوّل من الكتاب إذ قال : "...فإن مقاومة بعض الفئات المتعاطفة مع بقاء لغة "الآخر" وثقافته لعملية التوطين اللّغوي والثقافي مازالت قائمة على قدم وساق. فبروز ظاهرة الفرنكفونيين منذ أحداث نوفمبر1988 بالجزائر مثال حيّ على ذلك. أمّا سطوة الفرنكفونيين بتونس المستقلّة فهي لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا على كل المستويات." (ص 20)
هكذا إذن، في الجزائر هنالك فقط "مقاومة " الفرنكفونيين، "وبعد أحداث نوفمبر1988". أمّا في تونس، فهناك "سطوة" الفرنكفونيين "لا تزال مستمرّة إلى يومنا هذا على كل المستويات"
إنّنا نعتقد أن هذا التوصيف مبالغ فيه، ليس فقط في جانبه المقارن مع الجزائر، ولكن أيضا في مساحته الزمنيّة "تونس المستقلّة"، رغم وجود الظاهرة طبعا، فهدفنا ليس إنكارها بل تنسيبها فقط.
إن الملاحظة السابقة حول "سطوة الفرنكوفونيين" واردة كما قلنا في الفصل الأوّل من الكتاب، الفصل الذي كتب في "المرحلة الميتافيزيقيّة" من مراحل تطوّر المشروع البحثي للدّكتور.
قبل هذا، كان الدّكتور قد كتب سنة 1975 يميّز بين صنفين من المزج اللّغوي عند التونسسين، مزج لغوي "استعمالي وعملي" "ضروري نوعا ما وغرض المازج أساسا هو غرض استعمالي وعملي. فهو إذن مزج لا يحتم علينا تأنيب فاعله لأنه خلو إلى حدّ كبير، وفي غالب الحالات، من الدّوافع النفسيّة والاجتماعية التي لها انعكاسات غير سليمة على الفرد والمجتمع". ( ص 178)
ومزج آخر :" يترقب من ورائه الفرد نفعا نفسيّا واجتماعيّا(...و) يغالط الفرد في تقييم نفسه نفسيا واجتماعيا. وهو أيضا تصوّر خاطئ ..". ( ص 178)
لكن، بعد هذا الطّرح المرن نسبيا للظّاهرة، يشدّد الدّكتور تدريجيا من أحكامه كلما تقدّم في اتجاه " المرحلة الميتافيزيقيّة" من تفكيره ليصل في الأخير إلى ما يشبه الشّتم الموجّه للتونسيين جميعا، مع استثناءات قليلة سنذكرها لاحقا.
في مقاله :" سلوكات ومواقف التونسيّين إزاء الالتزام الواعد بالتّعريب" وهو الفصل الثاني من آخر أبواب الكتاب، استعرض الدّكتور "مكانة اللّغة العربيّة عند السّلطة في تونس المستقلّة وقسّم هذا العنصر إلى قسمين، المرحلة البورقيبيّة و ما بعدها.
- في العهد البورقيبي : يقدّم لنا الدّكتور صورة سلبيّة عن السّلطة" التي تميّزت سياستها في الميدان اللّغوي والثقافي "بالتذبذب"، وذلك لأن " موقف أغلبيّة أعضاء القيادة
السيّاسية التونسية في العهد البورقيبي لم يكن متعاطفا بالقدر الكافي مع مشروع تعريب المجتمع التونسي تعريبا شاملا". ( ص 185)
- بعد العهد البورقيبي : أي في عهد " حركة السّابع من نوفمبر"، اعتبر الدّكتور ان هنالك "حركة تغيير شاملة "كان لها "تأثير عام على عمليّة تّعريب المجتمع" ( ص 185)
لكنه استطرد لاحقا وقال إن " هنالك معطيات أخرى لا تزال مفقودة في ملف التّعريب الشامل..." ( ص 186)
وفي الفصل الثالث من الباب الأخير أيضا، المعنون "تقنين المسألة اللّغوية : تلك الحلقة المفقودة ". تحّدث الدّكتور عن "المناداة منذ تغيير السّابع من نوفمبر، بالمصالحة مع الذّات..." (ص 193)
ثم في الفصل الرّابع من نفس الباب، وهو آخر فصل في الكتاب و حمل عنوان :" القيادة التونسيّة سبّاقة لشعبها في تجسيم التّعريب" (ص 208-199)
تحدّث الدّكتور عن "حسم الأمر" وإنهاء "الترددّ والتذبذب الذي ساد في المجتمع التونسي منذ الاستقلال بخصوص تطبيع العلاقة بالكامل بين التونسي ولغته الوطنية في الدّوائر الحكوميّة، من ناحية، وفي تعامل المواطنين معها، من ناحية أخرى" ( ص 199)
ومقابل هذا التّعامل مع السّلطة، "السّباقة لشعبها في تجسيم التّعريب" يعطينا الدّكتور صورة سلبية تماما عن كل نخب الشعب التونسي ومؤسساته، بل وكل فئاته وشرائحه.
يقول :" إنّ المتفحّص لملف سياسات التعريب للمجتمع التونسي منذ الاستقلال يلاحظ أن تلك السياسات لم تنجح في خلق عقليّة تونسية واسعة تحترم بعفويّة اللّغة الوطنية (العربية) وتعتزّ بها" (ص 200)
وبعد ذلك يقول لنا حول الأسرة التونسيّة ما يلي : " الأسرة التونسيّة المتعلّمة على الخصوص شبه فاقدة لوازع وحسّ احترام اللّغة العربية". ( ص 200)
ثم يقول حول المدرسة :" لا يكاد الدّارس لملف التّعريب في هذه الأخيرة يجد انتشارا للموقف المتحمّس والمعتز باللّغة الوطنية بين أغلبية كلّ من التلاميذ ومعلّميهم وأساتذتهم" ( ص 201-200).
وحول الإدارة التونسية : يقول :" هنالك أدّلة كافية، حتى بعد تنفيذ القرار الرّئاسي لإكمال تعريب الإدارة التونسية مع نهاية عام 2000، تفيد استمرار انتشار فقدان التحمّس والاحترام والاعتزاز باللّغة الوطنية بين هؤلاء الذين يطبّقون قانون التّعريب" (ص 202).
وحول "الشّارع التونسي" يقول :" لا يكاد يوجد اليوم أي وعي ملموس وبالتالي أيّ تحمّس لدى المواطن التونسي بمشروعيّة تعريب حديثة كتكملة للمشروع الوطني في تعريب الإدارة التونسيّة الذي أنجز منه الكثير بفضل قرار السّلطة السّياسية العليا للبلاد (ص 202)
وبصورة عامّة إذن، يتحدّث الدّكتور عمّا يسمّيه :" العمى الجماعي لدى التونسيين إزاء اللّغة العربيّة..." ( ص 202)
ويعود ويؤكّد أن المسألة ليست مسألة وعي بأهمية التّعريب فقط بل مسألة فقدان "موقف الاحترام والاعتزاز باللّغة العربيّة ". وغياب "الافتخار" بها بين كلّ شرائح المجتمع" باستثناء " أقلية صغيرة من التونسيين" (ص 205) يبدو أنّهم، "الزّيتونيون" و "أفراد السّلطة السّياسية العليا" فقط !
إنّ هذه الصّورة الكارثيّة التي يصف بها الدّكتور المجتمع التونسي نابعة كما قلنا سابقا، من ناحية أولى، من تحليل الأجهزة والنّخب بوصفها متجانسة، لا صراع داخلها أو فيما بينها، ومن ناحية ثانية من إغفال كل التاريخ التونسي المعاصر لشخصيات وأحزاب سياسية ومفكّرين ومبدعين رفعوا دائما شعارات التعريب والثقافة الوطنية، بما في ذلك من داخل السّلطة.
ولقد وصل الأمر بالدّكتور إلى درجة الشّتم والتحدّي لكلّ قرّائه التونسيين إذ قال في آخر فقرة من كتابه :
" كمواطن يلتزم باحترام اللّغة العربيّة والاعتزاز بها داخل المجتمع التونسي وخارجه، طالما أثير في لقاءاتي مع التونسيين أفرادا وجماعات (...) مسألة تعثّر تطبيع التونسي لعلاقته مع اللّغة العربيّة بالمعنى الوارد في هذا الفصل. ولم أذكر مرّة واحدة أن أحدا قام بالاعتراض على ذلك وأنا أنتظر أن لا يكون الأمر مختلفا مع القراء التونسيين لهذا الفصل وغيره من فصول هذا الكتاب. أي أنّهم سوف يكونون عموما عاجزين على تكذيب مصداقية هذه الملاحظات لأنّهم هم أنفسهم فاقدون للمواصفات المذكورة هنا والتي تؤهّلهم لتطبيع علاقتهم مع اللّغة العربيّة. فمن خلال العشرة أمثلة التي أوردتها يتّضح أن حالة اللّغة العربية بالمجتمع التونسي قبل قرن كانت أفضل ممّا هي عليه الآن من حيث انتشار استعمالها في شؤون هذا المجتمع ومن حيث التقدير و الاحترام و العزة التي كانت تلقاها عند سواد
الشعب التونسي". ( ص208)
إنّ تطوّر التعليم وكلّ الممارسات الفكريّة والثقافيّة والإعلامية، ذات الصّلة بالعربية كلغة، تجعلنا نجزم ، ضد الدكتور ، أن وضعيّة اللّغة العربية في المجتمع التونسي هي الآن، وبكلّ المقاييس، أفضل حالا من وضعيّتها في بداية القرن الماضي، عندما كانت تونس مستعمرة من ناحية، وتنتشر فيها الأمية الأبجديّة بشكل مطلق تقريبا من ناحية ثانية.
هذا في خصوص "الاستعمال في شؤون المجتمع" .أمّا في خصوص "الاعتزاز والاحترام والتّقدير" فالأمر يتطلّب إمّا دراسة ميدانية مقارنة، غير قابلة للإنجاز علميا لأنه لا يمكن المقارنة بين شعور الاعتزاز عند الأموات وعند الأحياء ، أو استعمال مؤشّرات جزئية قد لا تفي بالغرض العلمي.
لكن، من الضّروري التأكيد على أن شعور الاعتزاز باللّغة الوطنية، كجزء من الهويّة، قد يزداد كثيرا عندما توجد محاولات واضحة للقضاء على تلك اللّغة، مثلما كانت تفعل فرنسا، أمّا في مجتمع غير مستعمر مباشرة، ولا تتعرّض فيه اللّغة إلى ضغوطات مباشرة بمنع استعمالها، فإن " الشعور بالاعتزاز" يخفت، ليس لأنّه غير موجود، بل لأنه لا يوجد ما يهدّده مباشرة وبصورة مفتوحة فيستفزّه بوصفه شعورا حسيا.
إنّ تهديد اللّغة يصبح أمرا معقّدا، على علماء اللّغة و الاجتماع والسياسة وغيرهم تحليله، ولكنه يكون تهديدا "خفيّا" عن المواطن العادي وحتى عن الإنسان المتوسط التعليم. لذلك، فمن باب الأمانة العلميّة، المهّم ليس في تجريم كل فئات المجتمع ومؤسساته السياسية والإدارية والتّعليمية والعلميّة وغيرها، بل في تحليل رصين للمشكل العلمي، بعيدا عن لغة التخوين والتحدّي التي يفترض أن تغيب في العمل العلمي، ولكن دون احترامية شعبوية هدفها التزلف إلى الشعب أو احترامية وصولية هدفها التقرب من السلطة.
لكن ، و مع الأسف ،عوض أن يستنتج الدّكتور من عدم اعتراض التونسيين على " مصداقية ملاحظاته " أنّهم يعتزّون بالتالي بلغتهم ويأملون منه المساعدة على تحويل ذلك الاعتزاز إلى وعي ثم إلى ممارسة ، يدخل الدّكتور في مهاجمة قرائه ،الذين "هم أنفسهم فاقدون للمواصفات" ، وفي تحديهم لأنهم "سوف يكونون عموما عاجزين..." عن" تطبيع علاقاتهم مع اللّغة العربيّة".
ملحق ؛ حول سوسيولوجيا الأسرة و المرأة
( أهدي هذا الملحق و ما ورد سابقا " حول المرأة المغاربية " إلى الأستاذتين الرائعتين ليليا بن سالم و درة محفوظ مدرستي علم الاجتماع في تونس اعترافا بالجميل.)
نظّم المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر في تونس، يومي الثالث و الرابع من فيفري 1994، ملتقى حول " الهياكل العائلية والأدوار الاجتماعية" شارك فيه الدكتور الذوادي بدراسته عنوانها " قراءة سوسيولوجية لقضايا النشوز والشقاق والطلاق بين الزوجين في القرآن" ( م52 ).
كان بالإمكان أن نتعرض إلى هذه الدراسة عندما ناقشنا تصوّره حول المرأة المغاربية ضمن كتابه "التخلف الآخر"، لكننا فضلنا النقاش في الموضوع بصورة منفصلة، من ناحية أولى، حتى تبقى المواد المرتبطة بكتاب « التخلف الآخر" في جزء خاص بها، رغم عدم ابتعاد الدراسة الحالية عن إشكالية " التخلف الآخر" ومن ناحية ثانية، حتى نسلط الضوء على الخلفيات التي قادت الدكتور في التعامل مع واحدة من أهمّ القضايا المرتبطة " بعلم الاجتماع الإسلامي"، ألا وهي قضية المرأة.
بداية، نشير أن الدكتور يحاول كالعادة إعطاء هالة تعقيدية لأفكاره مستشهدا مرة أخرى بالمفكر الفرنسي إدغار موران Edgar Morin و يدعونا إلى أن نتعامل مع الظواهر على أنها ذوات " معقّدة وليست بسيطة" (ص 72) ونوّد فعلا، لو أن الدكتور يلتزم بما يدعو الناس إليه من تعقيد وروح علمية حديثة في علاج المسألة النسائية ونرجو ألا يخيّب آمالنا كما فعل في ما مضى من أعمال تعرضنا إليها وفيما سيأتي لاحقا.
أ- حول ضرورة الزواج للمجتمع البشري:
كتب الدكتور ما يلي: ".... وما الزواج في واقع الأمر إلا ظاهرة من ظواهر التنظيم لفطرة أودعت في الإنسان، كما أودعت في غيره من أنواع الحيوان. فمن المنظور الإسلامي، لو لا الزواج الذي هو تنظيم لتلك الفطرة المشتركة بين الإنسان والحيوان، لتساوي الإنسان مع غيره من أنواع الحيوان في سبيل تلبية هذه الفطرة عن طريق الفوضى والشيوع" (ص64).
إن هذا التقديم للزواج " من المنظور الإسلامي" لا علاقة له لا بالعلوم الحديثة ولا بالإسلام في نفس الوقت.
فعبارتا " غيره من أنواع الحيوان" هي اختراق علمي للغة " الإسلامية المنظور" عند الدكتور، الذي يبدو أنه، من كثرة محاولاته التوفيق بين العلم والدين، وصل إلى خليط غريب فيه مزج بين اعتبار الإنسان نوعا " من أنواع الحيوان" الذي " أودعت" فيه " فطرة الجنس " من الله مثلما أودعت في الحيوانات.
إننا ، و مرة أخرى ، لا نعرف من تصدّق المسلم في الدكتور أم عالم الاجتماع؟
من ناحية ثانية، يبدو أن الدكتور يعتقد أن كل أنواع الحيوان تتزاوج، وهذا طبعا، من الناحية العلمية، غير صحيح، فهنالك كائنات حيوانية لا تتكون من أزواج منفصلة (فهي أنثى وذكر في نفس الوقت)، بل وهنالك أخرى لا تتزاوج تماما وتتكاثر بطرق غير جنسية عبر الانقسام، مثل بعض الحيوانات الوحيدة الخلية، القريبة جدا من الكائنات النباتية.
من ناحية أخرى، يبدو أن الدكتور يتصّور أنه خلافا للإنسان، كل أنواع الحيوانات تعيش " الفوضى والشيوع" في تلبية الفطرة الجنسية، بسبب عدم وجود الزواج المنظم عندها.
إن همّ الدكتور هو على ما يبدو تثمين علاقة الزواج بين الشر، لكن للقيام بهذه العملية، يتجاهل أبسط المعارف العلمية عن سلوك عدد كبير من الحيوانات التي لا تمارس " الفوضى والشيوع" الجنسيين بل
وتمارس الوفاء الزوجي أكثر من الإنسان، دون حاجة إلى " منظور إسلامي" أو مسيحي أو يهودي عن الزواج !
إن العلوم الحديثة، بل وحتى بعض الملاحظات القديمة جدا، عند الجاحظ، في كتاب الحيوان مثلا، تفيد أن بعض الحيوانات منظمة جنسيا ولا تمارس لا خيانة ولا زنا ولا لواطا ولا سفاحا ولا غير ذلك بينما " الانسان العاقل" يمارسها !
إنه من الغريب أن يدعو الدكتور قرّاءه للاستفادة من إدغار موران، هذا العالم العظيم بميادين السلوك الحيواني والإنساني، وهو يتجاهل أبسط المعلومات العلمية التي يعرفها التلامذة منذ التعليم الأساسي حول التكاثر الحيواني والإنساني.
إن " تثمين" الزواج لا يجب أن يكون على حساب أبسط المعارف العلمية. كما أن الحديث حول تميّز الإنسان عن الحيوان لا يجب، علميا، أن يؤدي تجاهل حقيقة الاتصال/ الانفصال بين عالمي الحيوان والإنسان.
لكن، عزاؤنا أن الدكتور عندما يعرّف الإنسان هذه المرة، وفق " المنظور الإسلامي" الذي يتبناه، يكتب ما يلي: " وفي غياب الزواج كوسيلة لتنظيم تلبية غرائز الجنس وتمدين عملية الإنجاب والإبقاء على النوع البشري، لا يمكن أن يكون الإنسان في نظر الإسلام ذلك المخلوق الذي سوّاه الله ونفخ فيه من روحه ثم منحه العقل والتفكير وفضّله على كثير من خلقه واستخلفه في أرضه وسخّر له عوامل كونه ثم هيأ له مبادئ الروابط السامية التي يرتفع بها عن حضيض الحيوانية البحتة" (ص64)
فيبدو أن الدكتور، سنة 1994، لم يكن قد وصل بعد إلى تعريفه " الرموزي الميتافيزيقي" للإنسان، فهو هنا، يقدّم أشهر التصورات المسلمة عن الإنسان دون ذكر " العامل الأساسي" الذي يعطيه لاحقا " للنفخة الإلهية الأولى". لكن، من الناحية العلمية، يبقى السؤال مطروحا على الدكتور.
ما الذي يجعل بعض الحيوانات لا تمارس الشيوع والفوضى رغم أنها لم تودع " العقل والتفكير" و "مبادئ الروابط السامية" ؟
وما الذي يجعل بعض البشر ينزلون إلى " حضيض الحيوانية البحتة" طالما أن الله وهبنا جميعا " العقل والتفكير" و " مبادئ الروابط السامية" ؟
إذا واصل الدكتور تفسير الأمور وفق "المنظور الإسلامي" الجبري تقريبا، فإنه سيدخل نفسه في مشاكل عويصة في معالجة مسائل الانحراف الجنسي، وما عليه، على الأقل، سوى العودة إلى النزعات المعتدلة أو العقلانية في الفكر الإسلامي ألمعتزلي وغيره حتى لا يحمّل الله ما قد لا يحتمله باسم " علم الاجتماع الإسلامي".
ب- حول المساواة بين الرجل و المرأة في الإسلام
يعترف الدكتور محمود الذوادي بأن الرجل كانت له السيادة في المجتمع الإسلامي في عهد الرسول ثم يحاول تبرير ذلك بكل الطرق بما في ذلك " العلمية" ليصل في خاتمة دراسته إلى رفض "المساواة المطلقة" بين الرجل والمرأة والدعوة إلى النظر إلى مسألة المساواة بين الجنسين نظرة " معقدة" لأنها " ذات مستويات تأبى التبسيط الساذج والمشوّه لطبيعتها وتلك في رأينا، الرؤية القرآنية للمساواة بين الذكر و الأنثى" (ص79).
لنتفحص المسألة معه ولنر كيف يحلّل مسألة المساواة.
يقول : " إن قراءة الآيات والسور القرآنية التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالزوجة وزوجها، أو بالرجل والمرأة بصفة عامة، تفيد أن السيادة والسلطة كانتا في الأساس للرجل (الذكر) في المجتمع العربي الذي عرفه الرسول" (ص67).
ثم يضيف: " إن القرآن قد فتح باب المساواة واسعا بين الذكر والأنثى على عدة جبهات من ناحية، وأبقى على السلطة المهيمنة للذكر (الرجل) على عدة مستويات من ناحية أخرى" (ص68).
فلنر، إذن، ما هي هذه المستويات وتلك، أي مستويات المساواة من ناحية و مستويات الهيمنة الذكورية للرجال من ناحية ثانية، ولنر كيف يفسر الدكتور سبب بقاء هيمنة الرجل.
نبدأ بالنقطة الثانية:
يقول إن السبب في بقاء الهيمنة هو " الخلفية الثقافية الاجتماعية للمجتمع العربي في صدر الإسلام" (ص68).
ونحن نسأله ؛ طيب، وإذا تغيرت " الخلفية" اليوم، فهل هو مستعد للمطالبة بمزيد المساواة مقارنة بالقدر الذي كان متوفرا في " صدر الإسلام"؟
هل هو مستعد للتعامل التاريخي مع المسألة بحيث يرفض اليوم مستويات " السلطة المهيمنة للذكر" التي أبقى عليها الإسلام الأول؟
الأرجح أن يكون الجواب بالرفض للسبب التالي، الذي برّر به بقاء اللا مساواة في الإسلام الأول نفسه:
قال: " فبالتعبير السوسيولوجي الحديث يمكن القول بأن ثقافة المجتمع العربي ألذكوري وبناه الاجتماعية كانت تقف حجر عثرة أمام تبني المساواة كموقف وكقيمة ثقافية لأفراد المجتمع العربي نساء ورجالا من جهة، ووضع سياسة المساواة موضع التنفيذ في واقع المجتمع العربي من جهة ثانية.
فثقل الموروث الثقافي الاجتماعي بخصوص مسألة التمايز بين الأنثى والذكر (المرأة والرجل) كان موروثا قاهرا، وبتعبير عالم الاجتماع الفرنسي ( دوركهايم Durkheim) كان هذا الموروث الاجتماعي الثقافي يمثل واقعا اجتماعيا قاهرا للأفراد والجماعات والمشرع الذين يرغبون في إحداث تغييرات جذرية شاملة في هذا المجال فالحتمية الاجتماعية حتمية متعنتة وشديدة المراس تقف بقوة أمام أي تغيير كاسح وشامل من هذا القبيل" (ص67)
.
إذن، هذه هي الخلفية الثقافية التي جعلت القرآن يفتح باب المساواة من جهة ويبقي على باب الهيمنة من جهة ثانية.
هكذا إذن ! دوركهايم لا يستعمل إلا لتبرير تواصل وجود " الواقع الاجتماعي القاهر" و المفارقة أنه يستعمل في نفس الوقت الذي يتناول فيه الدكتور فكرة " التعقيد" ويذكّر بالمفكر الفرنسي إدغار موران الذي يدعو صراحة إلى تجاوز الوضعية وإلى رفض النزعة الحتمية الدوركهايمية ـ بالنظر إلى تفاعل المجتمع/ الأفراد والجماعات والمشرع ـ ولا يعتقد أن الحتمية الاجتماعية " متعنتة وشديدة المراس تقف بقوة أمام أي تغيير كاسح وشامل" بل يعتبرها "حتمية مرنة" يمكن تغييرها حتى بصفة "كاسحة و شاملة".
من ناحية أخرى ينسى الدكتور أنه يتحدث عن الله " القهار" وعن الرسول في مواجهة ذلك " الواقع القاهر".
إنه ينسى أنه يتحدث عن الله و الرسول، حسب التصور الإسلامي الذي يدعو إليه، في مواجهة" حتمية متعنتة وشديدة المراس" وليس عن بشر عاديين، و لا عن الفاعل الدوركهايمي الذي هو الإنسان العادي.
فهل يمكن، من " منظور إسلامي"، تطبيق تصورات دوركهايم عن الظاهرة الاجتماعية الخارجية والضاغطة حتى على الله والرسول إلى درجة إعاقة " أي تغيير كاسح و شامل" حتى لو كان من قبل
الله و الرسول ؟
في الواقع، يتردد الدكتور بين أمرين، من ناحية يحاول تبرير بقاء هيمنة الرجل داخل العلاقات الاجتماعية بالطابع القهري للموروث الاجتماعي، ومن ناحية ثانية يدّعي أن الإسلام حقق المساواة بين الجنسين في "معظم نواحي الحياة".
وإذ نسجّل له الفضل في الاعتراف بأن الإسلام أبقى على السلطة المهيمنة للذكر/ للرجل، نلاحظ أنه لا يستقر على رأي واضح ، فهو يقول إن الإسلام فتح باب المساواة كبيرا ويعطى خمسة أمثلة في الصفحتين الثامنة والستين والتاسعة والستين وهي:
- الاعتراف بإنسانية المرأة مثل الرجل.
- المساواة في عقوبة الزنا.
- المساواة بخصوص دم الرجل والمرأة عند القتل.
- المساواة في إسناد الخطيئة الأولى.
- شهادة اللعان.
وفي المقابل، في الدراسة التي بين أيدينا، لا يذكر أي جانب أبقى فيه الإسلام على الهيمنة الذكورية للرجل كأنما بتجاهله ذلك يتصور أنه يدافع عن الإسلام.
إنه يكتفي بما يلي: "الموضوعية تقتضي أن نقول بأن النصّ القرآني قد سوّى بين الأنثى والذكر في معظم نواحي الحياة، وأبقى على بعض ملامح التميز والاختلاف بينهما، مما أدّى إلى عدم تساوي المرأة مع الرجل مساواة مطلقة في بعض التشريعات الإسلامية كنتيجة لفروق طبيعية خلقية بين الرجل والمرأة كما تعبر عن ذلك آية القوامة: ( الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم). ( النساء، 34). أما في ما عدا ذلك فالزوجان متساويان في جميع الحقوق ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة (متمثلة في القوامة) ( البقرة، 228)" (ص69).
إن الدكتور يتعمّد، على ما يبدو، خلط الأوراق حتى لا يعترف اعترافا واضحا ودقيقا بما قاله هو نفسه إذ كان من الأجدر به مثلما ذكر خمسة أمثلة حول المساواة. ( لن نناقشها هنا)، أن يذكر أمثلة واضحة حول عدم المساواة.
كان بإمكانه ذكر بعض الأمثلة ،على سبيل الذكر لا الحصر، مثل:
- الخلافة للرجل.
- القضاء للرجل.
- الإمامة للرجل، إلا في حالات نادرة و عند بعض الفقهاء فقط.
- الشهادة: رجل مقابل امرأتين، مع أن البعض يقبل بشهادة امرأتين في إثبات الرضا ع مثلا.
- الميراث: للرجل مثل أنثيين في حالات عديدة
- تعدد الزوجات للرجل.
إنه من البديهي القول أن الإسلام غيّر وضعية المرأة مقارنة بما كانت عليه قبله، لكن دون مبالغة في اتجاهين، من ناحية في اتجاه تصوير عهد " الجاهلية" وكأنه لم يحتو تماما على أية ايجابيات في العلاقة بين المرأة والرجل، وهذا ما يكذبه " الشعر الجاهلي" مثلا.
ومن ناحية ثانية، في اتجاه نفي أي تحسن عرفته وضعية المرأة في الإسلام الأول خاصة، قبل أن يحنط الفقه الإسلامي السائد الوضعية ويقضي بجموده على ما كان يمكن أن يحدث من تطورات لاحقة وئدت هي الأخرى لأ سباب اجتماعية وتاريخية عديدة.
إذن، نعتقد أنه من الموضوعي تجنب صياغة تتحدث عن المساواة في " معظم نواحي الحياة" مع " بعض" ملامح التميز والاختلاف التي يحاول الدكتور حصرها في " فروق طبيعية خلقية".
إن الفروق الطبيعية الخلقية معترف بها من قبل الجميع، ولكن هل أن الاختلاف يؤدي بالضرورة إلى التفضيل والهيمنة؟ هذا هو جوهر الخلاف بين المساواتية و الذكورية.
أما استشهاده بالآية 228 من سورة البقرة، التي جاء فيها " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة" فنكتفي بتنبيه الدكتور أن الآية ليست في صيغة المساواة بين الرجل والمرأة، إذ " للرجال عليهن درجة"، بل في صيغة المساواة بين الذي للنساء والذي عليهن فقط وهنالك فرق كبير بين المعنيين.
فلو كانت الآية على معنى " ولهن مثل الذي لهم وعليهن مثل الذي عليهم" لاعتبرناها تدل على المساواة بين الجنسين، لكن الواقع عكس ذلك وبصريح العبارة الأخيرة، " وللرجال عليهن درجة".
ج/ حول النشوز والشقاق والطلاق:
عندما يتعرض الدكتور لنقاط النشوز والشقاق والطلاق في الإسلام، يحاول بكل جهده الدفاع عن " المنظور الإسلامي" الذي يختلف فيه حتى مع تصورات إسلامية مستنيرة معاصرة.
ففي خصوص النشوز مثلا، يدافع الدكتور عن ضرب الرجل للمرأة كواحد من الحلول لمنح نشوز المرأة كما يلي:" فالعقاب الجسدي للزوجة يبرز بوضوح تمكين الزوج من الهيمنة على زوجته قصد جرّها إلى التوقف عن حالة العصيان والتمرد والقبول بالصلح مع زوجها. فالسماح للزوج باستعمال تلك العقوبة المادية ضد زوجته يعكس بشفافية عقلية المجتمع العربي الذكوري الذي يتمتع فيه الرجل بأولوية السلطة والسيادة. وهي عقلية قاومها التشريع القرآني على عدة مستويات كما رأينا، ونجح فعلا في هدم العديد من أعمدتها دون أن يكون ممكنا القضاء عليها جملة وتفصيلا" (ص71).
وهو يقارن بين ضرب الزوج لزوجته والضرب الذي يزاوله الأب مع أبنائه وكما يزاوله المربّي مع تلميذه" (ص71) وكأن الزوجة طفل أو تلميذ يجب ضربه، فهي قاصر في " المنظور الإسلامي" عند الدكتور على ما يبدو.
وكأنه لا بد من ضرب التلميذ والطفل أيضا، بحجّة أنه " ليس هناك في أدبيات علم النفس ما يشير إلى إلغاء العقاب المادي إلغاء كاملا كوسيلة لتقويم السلوك المعين"(ص72).
طبعا، الدكتور يذكّر بأن ضرب الزوجة " لا يكون مبرّحا"(ص72) بل هو" الضرب التأديبي الذي لا يترك أثرا في جسمها ولا يكون سببا في توسيع شقة الخلاف بينهما..." (ص70).
إن التصورات الإسلامية عند الدكتور تتراجع حتى عن " مجلة الأحوال الشخصية" في تونس، التي تعطي المرأة حق طلب الطلاق للضرر عند تعرّضها للضرب، حتى لو كان ذلك الضرب " غير مبرّح" و " تأديبي".
كما أن تصوراته تتراجع حتى عن "مجلة حماية الطفل" التونسية والقوانين التربوية التي تمنع تماما " الضرب التأديبي" ونرجو ألا يتهمنا الدكتور " بتحريم ما أحلّ الله" بحجة الدفاع عن النص في حرفيته!
إن صورة الكائن القاصر التي يقدمها للمرأة تتزاوج عند الدكتور، وفق " المنظور الإسلامي" الذي يحمله ، مع صورة المرأة " موضع الإغراء والجاذبية" أيضا . فعند تعرضه إلى حلّي "الموعظة " ثم "الهجر في المضجع" كتب عن الحل الأخير، أي الهجر في المضجع، أنه:
" يرمي في الأساس إلى إضعاف الزوجة نفسيا، إذ المضجع موضع الإغراء والجاذبية التي تبلغ فيها المرأة الناشر المتعالية قمّة سلطانها، فإذا استطاع الرجل أن يقهر دوافعه تجاه هذا الإغراء، فقد أسقط من قيد المرأة الناشز أمضى أسلحتها التي تعتز بها، وكانت – في الغالب- أميل إلى التراجع والملاينة أمام هذا الصمود من رجلها وأمام بروز خاصية قوة الإرادة والشخصية فيه من أحرج مواضعها" (ص71).
هكذا، إذن، الرجل له " قوة الإرادة والشخصية" والقدرة على " قهر دوافعه"، أما المرأة فلها على ما يبدو " ضعفا في الإرادة والشخصية" وهي لا تصمد أمام غرائزها الجنسية!
وطبعا، من المنطقي أن يضيف لنا الدكتور أنه ليس من المساواة في شيء أن تهجر المرأة زوجها في المضجع أو تضربه إذا كان هو الناشز. فهي ضعيفة أمامه يستطيع، إن لزم الأمر "أن يلتحق بها و ينال مبتغاه بالقوة" أو " إن هي أرادت ضربه فإنها تعرّض نفسها لخطر أكبر" (ص73) لكن الدكتور يتناسى أن " المنظور الإسلامي" لا يقف عند مسألة القدرة على الضرب أو الهجران، إذ أن اللعنة الإلهية تحلّ بالزوجة التي ترفض طلب زوجها في الفراش. ، إلا لأسباب قاهرة، وإن " المنظور الإسلامي" يجعل من النساء "حرثا جنسيا" للرجال فلا تدخل الزوجة الجنة وبات زوجها غير راض عنها...الخ.
أما بخصوص قضايا الشقاق فيكتفي الدكتور بأهمية تدخل الأهل للمصالحة عند الخوف من الشقاق المؤدي إلى الطلاق. لكنه يعطي لهذه المسألة لبوسا سوسيولوجيا عبر تقديم تدخل "حكم" من أهلها وآخر من أهله" على أنه استجابة لمبدأ "عدم الغرابة"، أي أن يكون الحكم من " الجماعة الأولية للزوج أو الزوجة، وهذا ما يجعل مما سميناه بالتدخل الخارجي، وكأنه ليس خارجي عن الزوجين" (ص74).
إن تدخّل حكمين من أهل الزوج والزوجة يعكس قوة تأثير علاقات القرابة في الإسلام الأول، لكن الوقوف عند تمجيد هذا الحل قد يجعل تدخل الأصدقاء مثلا، تدخلا "خارجيا" غير مرغوب فيه " شرعا" لأنهم ليسوا من " الجماعة الأولية للزوج أو الزوجة"
إن محاولة الدكتور تحويل المبادئ التي عالج بها الإسلام قضايا الشقاق إلى مبادئ " علمية سوسيولوجية إسلامية"، قد تحنّط القراءتين السوسيولوجية والدينية لأنها ركّزت على " البنى القرابية" أكثر من "المقاصد الإصلاحية" للتدخل الخارجي.
أما بخصوص الطلاق فإن الدكتور يعيد نفس الحجج المتخلفة حتى عن تشريعات واجتهادات إسلامية معتدلة ومستنيرة.
إنه مثلا يبقى عند حدود حق الزوج في الطلاق دون اللجوء إلى القضاء على عكس التشريع التونسي الذي فرض إتمام الطلاق في المحكمة سواء طلبه الزوج أو الزوجة.
يقول: " ومن ثم فالطلاق بيد الزوج وليس بيد القاضي (هذا الشخص الغريب) إلا إذا كان بطلب من الزوجة" (ص75). ويبرّر ذلك بالحرص على عدم تدخل " طرف خارجي" في شؤون الأسرة حتى لو كان القضاء !
كما يبرّره بـ" علم النفس الاجتماعي" بالقول إن المرأة " تحكمها العاطفة" والرجل "أكثر تعقلا وأقل تأثرا بجيشان عواطفه" (ص 75) لأنه القائم بالإنفاق والقوامة، وبالتالي: " هذه المعطيات تجعل الزوج أكثر التزاما من الزوجة للمحافظة على الزواج"(ص75) والرجل هو " الطرف الأكثر مسؤولية باعتباره الطرف الموكل له قوامة الزوجة والأولاد" (76 ) وهذا طبعا غير واقعي لأن كل الملاحظات الواقعية تفيد أن المراة أيضا مسؤولة عن عائلتها وتحاول هي الأخرى المحافظة على الزواج بل إنها تخاف الطلاق أكثر من الرجل بسبب موقف المجتمع من المرأة المطلقة و وضعية المرأة الاقتصادية.
ومن الغريب أن الدكتور يقول من ناحية إن المرأة أكثر عاطفة ثم يقول ، من ناحية ثانية ، إنها أقل حرصا على بقاء الزواج والعائلة وهذا تناقض صارخ على ما يبدو .
وعندما يتعرض لحق الزوجة في طلب الطلاق عبر القضاء، يضيف: "...بعد أن يوافق زوجها وبعد أن تدفع له مقدارا ماليا ... (أو) ... إذا كان لديها سبب شرعي، مثل أن يكون زوجها عاجزا على النفقة، أو يشكو من عَيب مستحكم لا يمكن البرء منه، أو كان مصابا بحالة عقليّة خطيرة مثل الجنون، أو إذا غاب أكثر من سنة كما هو الأمر في المذهب المالكي." (ص 78) وأغلب هذه الأحكام غير مقبولة منطقيا واجتماعيا في الوقت الحالي، فما معنى تطلب الطلاق " بعد أن يوافق زوجها"؟ طيب، وإذا لم يوافق؟ هل تبقى معه غصبا عنها؟
ثم ما معنى العجز عن دفع النفقة، هل يعني أن أي زوج يتم تسريحه من العمل حاليا يحق، حسب الدكتور، لزوجته أن تطلب الطلاق؟ ألا يطالب القانون التونسي مثلا، المرأة بالمساهمة في الإنفاق ان كان لها دخل مما يساعدنا على تنسيب الأحكام الحرفية للمجلة و للفقه الإسلامي على السواء؟
إ
أخيرا، ومن غرائب الأمور، أن الدكتور الذي يدافع عن "المنظور الإسلامي" يكتب: " لقد وضع التشريع الإسلامي ضوابط من شأنها أن تحدّ من نسبة الطلاق في المجتمع المسلم، (...) –ج- أن لا يقع طلاق النساء أثناء فترة العدة ، ففترة عدة المرأة هي أحد موانع الطلاق في التشريع القرآني" (ص77) وهذا طبعا خطأ معرفي، لأن عدة المرأة هي مانع مؤقت لمعاودة الزواج بعد وفاة الزوج أو الطلاق، وليست مانعا للطلاق نفسه.
إنه من غير المعقول أن دكتورا في علم الاجتماع، يريد تأسيس " باراديغم إسلامي" جديد ويقترح " قراءة سوسيولوجية" لقضايا الأسرة والمرأة دون أن يعرف ألف باء المبادئ العلمية في الزواج و المبادىء الإسلامية في الطلاق مثلا.
المصادر و المراجع و الملاحظات
44- الذوادي، محمود، التخلف الآخر، عولمة أزمة الهويات الثقافية في الوطن العربي والعالم الثالث، الأطلسية للنشر- تونس، 2002.
45- الذوادي، محمود، حول كتاب " المخيال العربي الإسلامي" لـ: مالك شبل، الحياة الثقافية، تونس، عدد 94، أفريل 1998.
46- WILLAIME, Jean- Paul, Sociologie des religions, PUF, que Sais-je ? Paris, 1995, pp 114-125.
47- بوكراع ، رضا، المعنى الإيديولوجي لتطبيق النظرية الألسنية على اللغة العربية، ضمن ندوة: اللسانيات واللغة العربية، الجامعة التونسية، مركز الدراسات و الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، ديسمبر 1978 تونس، المطبعة الثقافية تونس، 1981.
48- BOURDIEU, Pierre, la distinction, critique sociale du jugement, Ed minuit, 1980, reed CERES, Tunis.
49- CABIN, Philipe, la distinction, critique sociale du jugement (1979), Sciences Humaines, Numéro Spécial 2002, L’oeuvre de pierre Bourdieu.
50- DURAND, Jean- Philippe, et WEIL, Robert (SS.dir), Sociologie Contemporaine, Vigot, paris, 2 édition, 1997, pp 286-298.
51 – جعيط، هشام، الفتنة ( جدلية الدين و السياسة في الإسلام المبكر)، تعريب خليل أحمد خليل، دار الطليعة، بيروت، 1992
.
52 - الذوادي، محمود، حول قضايا النشوز و الشقاق و الطلاق، ضمن؛ الهياكل العائلية و الأدوار
الاجتماعية، مؤلف جماعي، سراس للنشر/ المعهد الأعلى للتربية و التكوين المستمر،
تونس ،1994 .
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. خدمة جناز السيد المسيح من القدس الى لبنان

.. اليهود في ألمانيا ناصروا غزة والإسلاميون أساؤوا لها | #حديث_

.. تستهدف زراعة مليون فدان قمح تعرف على مبادرة أزرع للهيئة ال

.. فوق السلطة 387 – نجوى كرم تدّعي أن المسيح زارها وصوفيون يتوس

.. الميدانية | المقاومة الإسلامية في البحرين تنضمّ إلى جبهات ال
