الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
كائنات ضوئية تصعد الباص
سلمى مأمون
2013 / 1 / 24الادب والفن
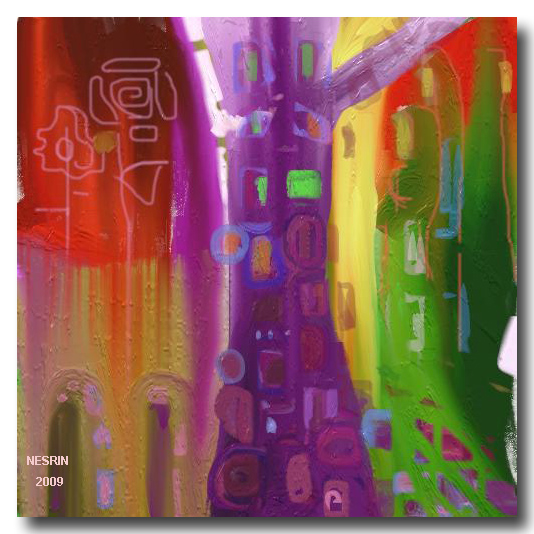
التقيه صباحاً بالزي المدرسي للمرحلة الثانوية؛ بالقميص الابيض ذو الاكمام القصيرة و (الشورت) الكاكي، جالساً بين رفاقه بالباص برحلة الذهاب الى المدرسة. اكتشفت لاحقاً أنه كان طالباً بذات المدرسة في القسم الخاص بالبنين بالجوار إلاّ أنني لم أعرف أبداً اسمه ولا بأي صف كان يدرس. ابتدأ الأمر عندما كنت بالصف الثاني الثانوي، يوم التقطته عدساتي و زلزل وجوده قلبي الجديد فصار ينقشه سرا على خلفية الدفاتر الخارجية بين قوسين (ملاكي الباسم) فقد كانت لملامحه تلك الابتسامة الغامضة التي لا تنطفيء. تلتق أعيننا من بعيد، فاتجمد رعباً من عذوبة ذاك الكائن الجميل المجهول الذي اريده وحده لي بدون ادنى تردد و لكن بطريقة لا ادرك ابعادها، و اجهل كلية كيف ساتوصل لمعرفة اسمه بداية و اتحدث اليه أسمع صوته و ضحكته ثم و بأي لغة سنتحدث و عن ماذا بالضبط سنتحدث؟ داخلتني حيرة عظيمة دون ان تتبعها ارادة لاختراقها بفعل. رغم أنني كنت كلما احسست بلسع نظرته انزوي في الخجل و يكاد قلبي يجلس الى جواري، إلا أنني بنفس الوقت، و كلما اسعدني الصباح برفقته في ذات الرحلة تمنيت أن يحدث أي طاريء لكيلا يصل الباص الى قبلته بسرعة، فقط لاحيا تلك الصعقة اطول مدة ممكنة. خضني ذاك الولد كزجاجة دواء و لم ينمحي عن ذاكرتي ليل نهار حتى اصبح وجوده حافزاً ضرورياً يخفف غلظة الدروس و الاستذكار. لدرجة أنني كنت احيانا اخرج في الصباح أبكر من وقتي المعتاد و أفوّت عددا من الرحلات على أمل العثور عليه و التطلع الى محياه. كانت مشاعري الطفلة بليغة و لكن لساني ابكم. لأنني بنت تلك الايام التي كان مجرد رؤية البنات ل(اولاد المدارس) متحلقين حول مدارسهن ، مشهداً رهيباً يكفي لتذوب رُكبهن، فيسرعن الخطى و يتفرقن بابتسامات مرتبكة. ترى هل كن مثلي، كل اولئك البنات؟ يضج بدواخلهن ذاك الحس المتناقض الذي خبرته؛ ذلك التأرجح المضني بين اغراء اللقاء الساحر المترع برؤى المراهقة الساخنة، في تلك المرحلة التي يبدأ فيها المجتمع تفعيل مخططاته للدور المرتب لنا لنؤديه باذعان تزامناً مع انطلاق (الشكل الجديد) بحياة كل منا؟ تسري جميعها كعناصر متفاعلة و مصطرعة مع تقديراتنا الشخصية لذلك الحدث الضخم؛ اكتشاف ان لنا (مشاعراً أخرى) تجاه الاولاد أي بلغة المجتمع؛ فارس الاحلام - عريس المستقبل بل المستقبل بعينه و لكن الناس آنذاك كانوا يدفعون البنات للتحصيل و عدم الانشغال بهمّ العريس في تلك السن المبكرة لأنه سيأتي حينما تنجز هي (الشهادة). و كانت البنات طموحات مثابرات على الدرس. و كان الأهل يحترمون العلم و كانت البلاد غير الآن. لم أعرف ابدا إن كن جميعهن مثلي آنذاك، و هل كن يتقلبن في المشاعر المشبوبة؟ خبرت اننا عانينا جميعاً آنذاك من نقص الدراية او التهيؤ من البيئة أو التعليم أو الاعلام ولا حتى من الامهات، (و لكن الاخيرات معظمهن آنذاك كن انفسهن يجهلن المعلومات العلمية السليمة) لخوض تلك المرحلة و لاستيعاب ما يعترينا او حتى المام كافي بابعد تلك الالفاظ التي لا تتداولها الالسن، كاللفظ الجذاب الضبابي (حُب)!؟ هل كن يتقلّبن بين ان يطاوعن مشاعرهن و بين ترسانة التحذيرات القاطعة من ارتكاب الجرأة! أم انني وحدي التي كنت المفرطة الخجل، و هُن الشجاعات الممتلكات للقدرة على المواجهة و التعبير عن انفسهن؟ لقد انعكس لنا منذ ذلك الوقت تعقيد (سياسة) المجتمع معنا كاناث دون الذكور، و ذلك خلال الاحاديث المتبادلة بين زميلات الدراسة. احسسنا في وقت واحد كأنما وزع الاهل على كل البنات تعميماً أو (وصفة طبية) بمحاذير موحدة. فقد كنا جميعاً نتداول ذات (الوصايا) على لسان امهاتهن. و تتذمر البنات من (صعوبة) الامهات و الجدات المتحالفات لاحكام سيطرتهن و يشرن الى تلك اللهجة القاسية للحث على تحمل المسؤولية الجديدة (خلاص ما عدتي طفلة! لقد اصبحتي امرأة، و عليكِ أن تمشي بهدوء وتجلسي مضمومة الساقين و تتحدثي بصوت خفيض... "ابقي بت رايقه و راسيه"...) و التطبيق العملي المباشر لتلك الجرعة، كان يقتضي بالضرورة؛ ألاّ نبتسم لأي من الذكور في الفضاء العام فتلك (مسخرة)، و حذار أن نضحك حتى لو كاد الموقف يمزقنا بطرافته فذلك (قلة أدب و عيب) لان الصوت الانثوي يجب ان يظل حبيس الضلوع و الغرف المغلقة، و الاّ نبادر بالحديث مهما اقتضى الظرف فتلك (لماضة) مستهجنة، و ان ابتدروا الحديث علينا أن نتوارى و نتردد و أن يأتي الرد مقتضباً و بحذر و الافضل الاّ نرد بالمرة أو الصيغة النموذجية: (ما عارفه) لنأمن شر الوقوع في شباكهم.
بديهي، و الذاكرة تنبش الحقب بوعي اليوم، أن الاولاد أنفسهم كانوا مثلنا مشوشين. رغم اننا كبنات كنا نلاحظ تصرفهم بجرأة تامة (على النقيض منا) احيانا الى درجة الوقاحة، غير مبالين بأي قيود ان شاءوا اظهار مشاعرهم تجاهنا. فقد كانوا يفعلون كل شيء على عكسنا بالضبط: يركضون بعرض الطريق و يتهاوشون، يطلقون الصفير و يتحدثون بالصوت العالي و يضحكون باصوات مجلجلة و يحدقون في البنات بلا خجل و يطلقون صوبهن تعليقات و صفيراً و اشارات بالعيون و الحاجبين تثير استياء البنات و احيانا خوفهن اكثر منها الى توصيل مشاعر التحبب. و الغريب ان كل ذلك كان يمر بدون ان يعلق احد بعبارات (مسخرة...قلة ادب.....عيب...او يقال للولد: ما عدت طفلاً! أبقى راسي) او يكونوا موضع مساءلة و حساب عسير مع الامهات كما يحصل معنا كلما عدنا الى البيت. يالها من محاباة غير مفهومة لعقل انثوي ناشيء! اذن فقد منحوهم منذ النشأة الاولى و بالتربية براعة متفوقة علينا. ولا غرابة، إذ ربتهم الامهات حسب تعاليم اشبه بالمقرر الدراسي الصارم: الجهر و الحسم لانهم (ما عادوا اطفال!) حسب مفهوم الرجولة الكاملة القائم على نقيض ما تتأسس عليه الانوثة. بينما عكفت ذات الامهات على (توصية) البنات بالتضاؤل و تجنب مجرد النظر في عيون الاولاد لانها بؤر غواية مليئة بشرور لا نستطيع الاحاطة بمراميها، بل شددوا بالذات على ان "نكسر عيننا" - نسبل رموشنا - و ننظر الى اسفل، إن نظر الينا الاولاد و إلا فسوف لن نكون بنظر المجتمع (بنات محترمات)!
كبنيّة، لم تختبر بعد حدود ارادتها ولا طرَح عقلها شكوكه و تساؤلاته و هي مازالت بشرنقه الطفولة، عايشتُ (الملاك) بداخل الابعاد التقليدية الصارمة و بتكتم تام خشية رد فعل الاهل ان بلغهم (هَول) ما يجري (وراء ظهرهم)! و اكتفيتُ بتأمل ملامحه العذبة كلوحة اخاذة لا اطالها و اعتبرت ابتسامته البسيطة لصباحي سبباً لفرح يخصني وحدي لا يحق لاحد مشاركتي اياه. و لكنني تساءلت في دخيلتي باستغراب، إذن، مادام هؤلاء الاولاد المحظوظين كائنات حرة و مجبولة على المجاهرة و غير خاضعة للمساءلة، لماذا لم يجرؤ ملاكي على سؤالي ولو عن اسمي؟ اليس رجلاً؟ الم تخبره امه انه ما عاد طفلاً؟ و هل كان يتوقع من صبية مذعورة باكتشاف عواطفها للمرة الاولى، ان تبادر هي و تسأله؟ مستحيل.
ظللنا نرنو الى بعضنا بالنظرات الحنونة بصمت بريء، يوما بعد يوم حتى اكملتُ الثانوية و لم اعرف أبداً الى اي برّ ساقته الحياة!
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. فيلم وثائقي عن الانتهاكات بحق العاملين في المجال الصحي بغزة

.. بعد فنانة دنماركية وفنان فرنسي.. رسامة ألمانية تطل باتهام جد

.. -ما فينا نلوم المنتج دائما-... هذا ما قاله الممثل طوني عيسى

.. تابعوا العرض الكوميدي The Blue Comedy Show للممثل فادي رعيدي

.. وزيرة التنمية المحلية ووزير الثقافة ومحافظ القاهرة يزورون مو
