الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
السلطة، هوية الجسد، والاغتراب 2 الاستعمار والجسد
سعد محمد رحيم
2014 / 5 / 17الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
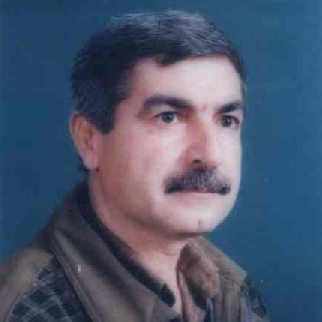
الجسد المعرّف نتاج تجربة في التاريخ وثقافة متشكِّلة؛ الجسد حيثما ينظر إلى نفسه وإلى الآخر، وحيثما يُثبّت مرمىً لنظر الآخر.. والنظرتان، بعد أن يدرك كل طرف، أو يظن أنه يدرك، ماهيته وماهية الآخر، لن تلبثا مثلما كانتا، لاسيما حين يحصل الأمر بعد خوض تجربة مشتركة برضا الطرفين ( الأطراف ) كما في علاقة حب أو صداقة أو تحالف جماعات، أو قسراً كما في ظل الحكم الفاشي أو الاستعمار.. يلتقي الاستعمار مع الفاشية في أكثر من صفة وممارسة ومجال، فكلاهما يرى العالم موضوع اغتصاب، ويفعل في ضوء ذلك.. وفي كلتا الحالتين يقوم الطرف الأقوى/ الفاشية، أو الاستعمار، بتمثيل ( آخره ) في خطابٍ سلوكاً وموقعاً ووظيفة.
إن نقش المستعمِر على جسد المستعمَر هو عملية فرض هوية.. أنت هذا الذي أوصمك به، أعرِّفك به، وهو التسويغ الذي أعتمده للهيمنة عليك. وإذن أنت موضع أثر السلطة وموضوع آليات سيطرته.. أنت هدفها وأداتها ومرآتها التي تتعرف السلطة على نفسها ومدى قوتها فيها.
جسد الشخص المستعمَر، في عرف المستعمِر، هو الجسد الخام/ البدائي والوحشي، الجسد العاري الذي لم يُشذّب ولم يكتسب ثقافة. الجسد المغفل الذي لم يُسيّس بعد.. تعيد السلطة الاستعمارية إنتاج هوية ذلك الجسد وعياً بالذات، وموقعاً ودوراً ووظيفة.. إن هوية الأفريقي المجتث من بيئته لغرض الاسترقاق ستتضمن محتوى جديداً غير ذاك الذي كانت تنطوي عليه وهو ينعم بالاستقرار والمكانة في ضمن جماعته القبلية في الأحراش. سواء من وجهة نظره هو، أو من وجهة نظر خاطفه.. وإذن، تصبح الواقعة من شأن الحقل الثقافي، أيضاً.
ينقش المستعمِر، كما قلنا، على جسد المستعمَر.. يعلِّمه باللون والملامح والصفات والاسم.. يسبغ عليه هوية مغايرة، ملفّقة، غير أنها صادمة وموقظة كذلك.. يقول فرانز فانون: "إن الاستعمار، من حيث هو نفي منظّم للآخر، من حيث هو قرار صارم بإنكار كل صفة إنسانية على الآخر، يحمل الشعب المستعمَر على أن يتساءل دائماً هذا التساؤل: من أنا في الواقع؟".
الأنانية هي جعل الجسد مركز العالم، والشعور بأن العالم بكل ما فيه ينبغي تطويعه لخدمة الجسد الأناني. ولكن ماذا عن الجسد المنزوع الأنيّة، مختل الأنيّة؟.
يتحدث فانون عن العربي الجزائري، مثالاً، المغترب في بلده في العهد الكولونيالي، والذي "يعيش في حالة من اختلال الأنيّة المطلق. فالبنية الاجتماعية القائمة في الجزائر تقف في وجه أية محاولة لأن يسند المرء ظهره إلى حيث ينتمي" على حد قوله.. واختلال الأنيّة هي حالة شبه مرضية "تنتاب الفرد ويفقد خلالها شعوره بحقيقة ذاته كشخص واقعي، أو يفقد الإحساس بجسده، وربما شعر أنه ميت".
إن خطاب الاستعمار يوصم جسد المستعمَر في إطار دلالي، فالأبيض يرى نفسه في اختلافه ( متفوقاً حضارياً ) عن الأسود والملوّن. لون الجلد يتخذ بعداً كنائياً في المتن العنصري لذلك الخطاب بإسقاطات نفسية تفضي بالمستعمَر لا إلى إقرار دونيته قبالة الأبيض ( المستعمِر ) وازدراء ذاته فحسب، وإنما كي يحاول التشبه بالمستعمِر هرباً من شكل حضوره المخجل في العالم. بيد أن الأمر، كما صار معلوماً، لا يجري بسلاسة ولا ينتهي بتسوية مُرْضية.. ويصل فانون إلى تلك الثنائية المتناقضة التي تخلّف علاماتها الجارحة؛ ( بشرة سوداء، قناع أبيض ) في الكون النفسي للمستعمَر/ الآخر الذي تُنكر آدميته فيلجأ من أجل نيل الاعتراف والتحرر إلى ممارسة العنف بعد سنوات من القلق والتمييز والبارانويا والشتات والهامشية.. يبرر سارتر عنف المستعمَر في سعيه لاسترداد إنسانيته وهويته، قائلاً؛ أن الأوروبي "لم يستطع أن يجعل نفسه إنساناً إلا بخلق عبيد ومسوخ". وأسوأ ما في الأمر، يضيف سارتر: "ما دام الآخرون يصبحون بشراً بمقاتلتنا، فنحن ( الأوربيين ) إذن أعداء النوع الإنساني. إن الصفوة ( الاستعمارية ) تكشف عن طبيعتها الحقّة؛ إنها عصابة.. إن قيمنا الغالية تفقد أجنحتها. فلو نظرت إليها من كثب لم تجد منها واحدة غير ملطخة بالدم".
يلاحظ فانون أن المستعمِر في وصفه للمستعمَرين يستخدم استعارات مأخوذة من عالم الحيوان للحط من قدرهم مثل ( أرواث المدينة الأصلية، قطعان الأهالي، تفريخ السكّان، تنمّل الجماهير، هذا القطيع الذي لا رأس له ولا ذنب، هذا الكسل المستلقي تحت الشمس، الخ.. ). ولن يلبث المستعمَر أن يكتشف في النهاية أنه ينتمي إلى النوع الإنساني عينه الذي ينتمي إليه المستعمِر، بالجينات الوراثية نفسها تقريباً، وأنه ليس أدنى منزلة إنسانية من سيده. وأن لون جلد ذلك السيد الأبيض لا يسوِّغ له بالرجوع لأيٍّ من قيم ومعايير الطبيعة والثقافة والأخلاق أن يُخضع مَنْ جلده ملوّن أو أسود ويُحيله إلى عبد.. يقول فانون: "يكتشف المستعمَر إذن أن حياته وتنفّسه وخفقات قلبه لا تختلف عن حياة المستعمِر وعن تنفّسه وعن خفقات قلبه. ويكتشف أن جلد المستعمِر ليس خيراً من جلد رجل من السكّان الأصليين. ويُحدث هذا الاكتشاف هزّة أساسية في العالم".. هنا سيتغير كل شيء.. سيعي المستعمَر هوية ذاته الحقيقية.. هويته التي تخلّقت وتتخلّق عبر مراحل التماس والاحتكاك والمواجهة والصراع مع المستعمِر، ومن ثم التحرر منه.
يناقش هومي بابا أطروحة فانون الخاصة بالصورة النمطية المكوَّنة في الفالق الامبريالي العنصري؛ "حيث يقدّم الأبطال البيض والشياطين السود كمواضع للتعيين الإيديولوجي والنفسي للهوية". ويستعير بابا طقماً من المفاهيم الخاصة بعالم النفس لاكان ليحلل إشكالية أن يكون المستعمَر مرئياً أمام تحديقة الكولونيالي النرجسية ـ الاستيهامية والمنكِرة جاعلاً موقع المنظور إليه ( المستعمَر ) في ضمن ترسيمة علاقة خيالية. واستناداً إلى طقم المفاهيم تلك وأهمها ( الخيالي، طور المرآة ) يصوِّر بابا الخطاب الكولونيالي/ العرقي بمركزية الصورة النمطية فيه على وفق استراتيجية رباعية الأطراف، وحيث، بتعبير بابا: "نجد ارتباطاً بين وظيفة الفيتش الاستعمارية أو التقنيعية والاختيار النرجسي للموضوع. كما نجد تحالفاً معاكساً بين التصوير الكنائي للنقص والطور العدواني من أطوار الخيالي. وبذا يكون ما يُشكِّل الذات في الخطاب الكولونيالي هو مخزون أو ذخيرة من المواقع المتصارعة. حيث يكون اتخاذ أي موقع محدد، ضمن شكل خطابي نوعي، وفي ظرف تاريخي معين، إشكالياً على الدوام؛ موضع ثبات واستيهام على السواء". فالذات ( النرجسية ) تؤكد هويتها بوجود الآخر الذي يغدو ضرورة للتعرّف على الذات تلك، ولكن، ويا للمفارقة، يجري إنكار الآخر في الوقت نفسه. فيكون نظرة التمييز والتفرقة الأثر أو المفعول السياسي للخطاب الكولونيالي/ العرقي.
يعود بابا إلى فانون الذي يقول بغير قليل من التهكم: "ثمة سعي وراء الزنجي، فالزنجي هو حاجة، لأن المرء لا يستطيع أن يواصل من دونه، فثمة حاجة إليه، إنما ليس من غير أن يُجعل مستساغاً على نحو معيّن، ولسوء الحظ، فإن الزنجي يطيح بالمنظومة ويخرق المعاهدات". وهنا تصبح البشرة، أو ترسيمة البشرة، بحسب فانون "الدال الأساسي على الاختلاف الثقافي والعرقي في الصورة النمطية". الصورة النمطية المثبتة في الخطاب هي التي تمنح المستعمَر هويته وشكل وجوده.. ويمضي بابا في مسار تحليلي متعرج ومعقّد بناءً على مفاهيمه المبتكرة والمستعارة ليصل إلى موضوعة الاغتراب.. الاغتراب الذي يولِّده الآخر/ المنظور إليه، الفاعل فعل المرآة، ليعيد صورته إلى الذات الرائية على نوع حاسم. وفي ذلك، كما يرى، أثر الضياع والغياب.
إن الخطاب الكولونيالي المتبلور ليكون مُعيناً في تحديد الهوية، ومن ثم الاستمرار بالسيطرة والتحكّم لا يفلت، أبداً، من مأزق اضطرابه وهو يصوِّر الآخر بصورتين متناقضتين في ضوء تبدل المصالح والحالات ومواقع الرؤية ومعايير وأحكام التقويم.. وبدءاً تعشّقت السلطة الاستعمارية الخابرة وخطابها مع خطاب الاستشراق المنشئ لنمط من المعرفة التي اُستثمرت في ممارسات السلطة الاستعمارية. إذ تكون المعرفة نتاج السلطة وشرط فاعليتها واستمرارها.
أُسبغ على الفضاءات التي يسكنها الآخرون في كثر من نصوص الرحّالة والمستشرقين، وفي الخطاب الكولونيالي عموماً ملمحٌ جنساني.. تلك الفضاءات التي تمنح غير الأوروبيين/ الغربيين البيض تسمية ( الغير ). وفضلاً عن عملية الجنسنة تلك "تم إضفاء الصفة الغرائبية على الجنس" لتصبح "الجنسانية أحد المحاور التي يمكن على امتدادها بناء الذاتية والغيرية". وقد جرى تأنيث بلد الآخر كنتيجة لفرضية حق الاستيلاء الذكوري على الجسد الأنثوي بتمثيل حالة التملك عبر فاعلية الاستيلاء هذه حجةً للاستعمار، وبدعوى أن الآخر/ المؤنث، أو المخنث، اللاعقلاني والشبق، غير قادر على حكم نفسه.
الجسد الذي كان محلاً للنقش، للتمثيل والسيطرة في العهد الكولونيالي لم يبرأ تماماً بعد زوال الكولونيالية بشكلها التقليدي المباشر.. لم يخرج المستعمَر من التجربة سليماً.. ففي عهود ما بعد الكولونيالية بقيت نفوس المستعمَرين المحرَّرين تحمل آثار تلكم الجروح الغائرة التي أحدثها الحكم الكولونيالي فيها طوال عقود ببطء مؤلم وعميق.. أضحى اغتراب المستعمَر مركّباً الآن، ولم يشف من مرض اختلال الأنيّة، لاسيما في ظل السلطات الوطنية الاستبدادية والفاسدة، والفاشيات المستعارة الرثة الحاكمة التي راحت تعيد إنتاج الأجساد الطيّعة على وفق مصلحتها ومصلحة من تتبع، تحت شروط أشد مكراً وقسوة، متنكِّرة لآدمية مواطنيها/ رعاياها.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. السودان الآن مع صلاح شرارة:

.. السودان الآن مع صلاح شرارة: جهود أفريقية لجمع البرهان وحميدت

.. اليمن.. عارضة أزياء في السجن بسبب الحجاب! • فرانس 24

.. سيناريوهات للحرب العالمية الثالثة فات الأوان على وقفها.. فأي

.. ارتفاع عدد ضحايا استهدف منزل في بيت لاهيا إلى 15 قتيلا| #الظ
