الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
التوثيق في زمن الحرب. تأملات حول الكتابة المنتمية والملتزمة
سارة العظمة
2023 / 11 / 27دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
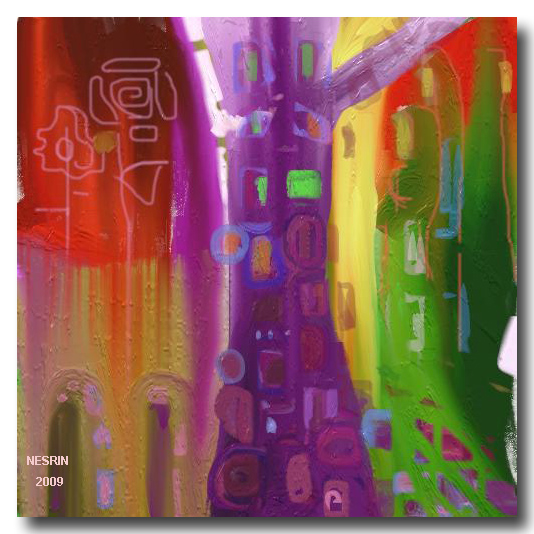
على شاطئ تركي تمدد جسد الطفل السوري الكردي آلان بلا حراك بينما الأمواج المتلاحقة تغسل وجهه المطمور في الرمال. الحفاضة الظاهرة تحت سرواله القصير تضاعف من مفعول الصدمة. كان عمره ثلاث سنوات فقط عندما أعاده البحر إلى لشاطئ الذي تركه مع عدد من الهاربين من الجحيم السوري على متن زورق سيء التجهيز ومكتظّ بحمولة بشرية. تمكّنت هذه الصورة، هذه القطرة من بحر المأساة السورية، أن تغزو العالم. وعلى الرغم من أهمية الرسالة التي أوصلَتْها وقيمتها الأخلاقية الجوهرية فقد بقيت كل القصص الأخرى للمحنة تُعاش وتنتهي في عمق مظلم بعيداً عن السطح وأنوار الكاميرات الإعلامية وعيون ومسامع باقي شعوب الكوكب.
ولعلّ هذه مشكلة أيّ إعلام يغطي أحداث حربٍ لا تخصّ مواطنيه أو جيرانهم، تسليط الضوء نحو صورة رمزية تثير وتؤجّج العواطف، وتقديم ملخّص تاريخي مكثّف للنزاع الجاري، وتغطية الحدث بمعلوماتٍ مجموعةٍ بشكلٍ يبدو اعتباطياً وخاضعاً للصدفة في بعض الأحيان. ينتج عن هذا صورٌ غير مترابطة تتضمن عناصرَ متضخّمةً وفراغاتٍ كثيرة مما يضعف إمكانية القارئ لتكوين تصوّر واضح عما يجري وأسبابه وتداعياته المحتملة. وتعمُّ ظاهرة الآنيّة بشكل واضح أيضاً. بعد زمن قصير جداً من انفجار نزاع مسلح أو اندلاع حرب، ربما بضع ساعات فقط، يصل المراسلون الغربيون للمكان ويشرعون بتقديم التقارير الإخبارية والتحليلية للقنوات الإعلامية. يتبع هذا بعد وقت قصير نسبياً صدور الكتب التوثيقية وتدفّقها السريع في الأسواق. وللأسف فلا يمضي وقت طويل قبل أن تعلو جلجلة السلاح وتُقْرَع طبول الحرب في مكان آخر، فما يكون من المدراء الإعلاميين إلا أن ينقلوا كوادرهم على وجه السرعة، ويلحق بركبهم المراسلون والمراسلات المستقلين/ات لعلمهم/نَّ بأن السلعة المرغوبة والمنتَج القابل للبيع أضحى أخبار النزاع المسلح الجديد وليس تطورات الحرب "القديمة"، وهكذا تختفي الكاميرات والميكروفونات والأقلام من الساحة التي ما تزال تنوء تحت ثقل كابوس ولَمَّا تنفض بعد رماد الحرب عن سطوح أبنيتها المتداعية وحقولها المحترقة وإنسانها المرهق.
قصص الحروب كسلعة تجارية
لا أبالغ ولا أفتري عندما أزعم أنّ الحروب الدائرة هي مصدر كسب لدى مؤسسات الإعلام ودور النشر الغربيين. المنتج جيد بدون شك وفيه فائدةٌ إخبارية ومعرفية، كما لا يسع الواحد منّا إلّا أن يعتبر عمل المراسل/ة الصحافي/ة الذي تـ/يخرج فيه عن دائرة الأمان والراحة وتُـ/يُعرِّض نفسه/ا للخطر مجهوداً مشرّفاً. وأرى صدق بعضهم واعترافهم بمحدودية فهمهم وقصور شرحهم لما يحدث على أرض أجنبية بالنسبة لهم والتعبير عن خوفهم مستحقًا للاحترام والمديح.
هكذا استهلّ صحافي سويدي حائز على عدة جوائز عمله في أفغانستان أثناء فترة من الحرب فيها:
" خلال الفترة المبكّرة من تواجدي في كابول كان تركيزي منصبَّاً على أمني الشخصي، وكنت في قمة الحذر. أينما تحرّكت كنت أستقلّ سيارة مع مرافق محليّ يسوقها، ولم يكن من الوارد أبداً أن أمشي على قدميّ بين الناس" يسبر هور Jesper Huor.
أوّل خروج له عن قواعد الأمان التي وضعها لنفسه كان عبر رحلة طولها حوالي مائتي متر والهدف منها شراء معجون لتنظيف الأسنان من البقالية المجاورة لسكنه " لقد شعرت حينها وكأنني قد خضت مغامرة بطولية". بالإضافة إلى حاجز الخوف والتوجّس، يخبر هور عن حواجزَ لغويةٍ وثقافيةٍ أدّت إلى صعوبة ولوج الدوائر الاجتماعية في أفغانستان: "بينما كان التواصل مع الأجانب الآخرين العاملين في الحقل الإغاثي والدبلوماسي والجواسيس والصحافيين والمصوِّرين متاحاً وبغاية السهولة .... كنّا ننتمي لطبقة أجنبية عليا متعددة الجنسيات، وطالبنا بالخدمات وتلبية كل حاجاتنا"
استغرق عمله سنة كاملة ونتج عنه كتاب بعنوان بانتظار الطالبان. أفغانستان من الداخل. صدرعام 2010 باللغة السويدية.
قراتُ الكتاب حين صدوره وتركتْ خاتمته أثراً من الاستياء الخفيف لديّ دون أن أتعمّق حينذاك بماهية الشعور الذي داهمني: " حبي لأفغانستان انتهى. مازلت معجباً بالطبيعة القاحلة والأناس الكرماء الشجعان، ولكنّ مشاعر التعب والنفور قد تسللت لنفسي تجاههم أيضاً ". كان الصحافي سعيداً لانتهاء مهمته وانقطعت بذلك أي صلة وصل للبلد الذي جابه طولاً وعرضاً لمدة سنة كاملة.
لم يختلف انطباعي كثيراً عندما قرأت لآخرين، ولا أعتقد ان للحالة تفسيراً جندرياً، أي أنّ الأنثى تتفاعل شعورياً مع المكان الذي تقيم فيه لفترات طويلة أثناء عمل صحافي توثيقي. الكاتبة الصحافية المرموقة يني نوربرغ Jenny Nordberg سويدية النشأة والمقيمة في نيويورك غادرت أيضا أفغانستان ببرود بعد إنجازها كتاباً بعنوان فتياتٌ يتخفين بثياب الصبيان في كابول الصادر عام 2015
"في المطار أنزع بحذر غطاء الرأس الأسود وأضعه في حقيبة يدي... أشعر بالراحة وأعود تلقائياً للوقوف بظهر أكثر استقامة ويتمدّد جسدي ليحتلّ مكاناً أكبر. لا أفكر بالحرب الآن، ما أفكر به هو الآيس كريم المجمَّدة التي سأشتريها حال وصولي لدبي... أعبر قاعة المغادرة. أمشي خلف المسافرين الآخرين، ومرة أخرى أفعل ما نفعله كلّنا، أصعد على متن الطائرة وأغادر هذا البلد"
أتى هذا التمدُّد الطولي والعرضي للمعلِّقة على صفحات صحف من الوزن الثقيل The Guardian New York Times ، Svenska Dagbladet بعد إقامة شهور طويلة في مختلف أنحاء أفغانستان للكتابة عن القهر الذي تعانيه المرأة في ظل نظام أبوي ذكوري شديد الصرامة. ولم يكن اختيارها محض صدفة أو تعبيراً عن موقف نسوي ثابت ومستدام، فقد اختارت إجراء هذا البحث الصحافي في وقت طَغَتْ فيه رغبة/ حجّة الدفاع عن حقوق النسوة الأفغانيات على الخطاب الأمريكي، وكانت من بين المبرّرات الأساسية لاستمرار تواجد القوات الأمريكية في تلك البلاد النائية. ومع خاتمة الكتاب توقف نشاطها النسوي ولم تكتب كتاباً سواه. لحد تاريخ اليوم تنشر نوربرغ المقالات في الصحف المذكورة مع تركيز على المواضيع التي تهم القارئ الأوروبي والأمريكي.
وربما كانت مراسلة الحرب والكاتبة النرويجية الشهيرة أوسنا سايشتا Åsne Seierstad مؤلفة بائع الكتب في كابول الأفضل على المستوى الأوروبي وصاحبة الإنتاج الغزير والمبيعات الأعلى رقماً ضمن هذا النمط الكتابي، فقد غطّت أحداث العديد من الحروب خلال السّنوات المنصرمة وألّفت الكتب الوثائقية عن عدد من البلدان التي عانت من أوزار الحرب كأفغانستان والبلقان والعراق وسوريا. بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان عادت سايشتا مجدداً إليها تحت ضغط طلب الأسواق الغربية لمعلومات عما يؤول إليه حال السياسة والمجتمع في ظل حكم إسلاميين أصوليين. ويبدو كأن نسبة لا يستهان بها من القراء في دول الغرب أصبحوا يعتمدون على منظار وإدراك وانتقائية امرأة صحافية نشأت في بلد من أغنى دول العالم وسط جيل لم يختبر أي شكل من أشكال الاضطهاد أو الجوع والحرمان.
أضحى من المفهوم أنّ أي نص يخبر عن كاتبه وقارئه المستهدف أكثر مما يخبر عن الواقع الموضوعي الذي يعالجه. لذلك لا بدّ من اعتبار العبارات المكررة "الكليشيهات" التي تَعِدُ القارئ باختراق الأسوار المحصّنة، وولوج الغرف المحجوبة عن الغرباء، وكشف الستار عن العالم "الحقيقي" في الشرق الأوسط حيلًا تسويقية لترويج بضاعة إعلامية من صنع أجانب لخدمة أسواقهم المحليّة ليس إلا.
لقد قرأت العديد من هذه الكتب بلغاتها الأصلية، وبرأيي فإن الطرح يعاني على الأغلب من السطحية وانتقاء ما هو مختلف "شاذ" في نظر القارئ الاسكندنافي/الأوروبي/الأمريكي والغربي عموماً، كما أن الأسلوب المعتمد القائم على الموضوعية الباردة من جهة، واختيار أفراد بالتحديد لتجسيد واقع مختلف من خلالهم وحدهم، يمكن في كثير من الأحيان أن يُنتج صوراً غير تمثيلية للمجتمع الموضوع تحت المجهر. الحفاظ على مسافة عاطفية أثناء نقل صور من حرب شعواء يشبه توزيع أوراق تتضمن شرحاً رياضياً لمقطوعة موسيقية على الحضور في دار للأوبرا. ستمنحهم الورقة معلوماتٍ دقيقةً وصحيحةً عن بنية مقطع غنائي في تصاعده وهبوطه، صخبه وهدوئه، ولكنّها ستسلب منهم الأهم؛ ألا وهو التجربة الشعورية التي تحصل عند التفاعل الوجداني مع انسياب لحن الموسيقى. أما انتقاء شخص أو عائلة لنقل صورة مجتمع فيحجب أكثر مما يضيء، كما أن التنقل من بلد لآخر والقفز من قارة لأخرى في محاولة للاندماج في عصر السرعة لا تسمح للكاتب التوثيقي أن يتعرف على ثقافة أي مكان بشكل مرضٍ. ألم يُقِم الباحثون الأنثروبولوجيون الأوائل حقباً من الزمن وسط الأدغال أو على جزيرة معزولة حتى ينقلوا لنا ثقافة قبيلة واحدة لايزيد تعداد أفرادها عن العشرات؟! فما بالكم بثقافة شعب متنوع الأعراق والإثنيات وحتى اللغات والعادات يستوطن رقعة جغرافية ضخمة ممتدة بين غابات وأرضً زراعية وصحاري؟
ماذا أريد من هذا الكلام كله؟ سأوضّح. ثمة فرقٌ جوهري بين خلق معنىً كثيفٍ أو هزيل لمعاناة شعب أثناء ظرف تاريخي استثنائي، ولا يكون الخط الفاصل بالضرورة واضحاً منذ البداية. فعلى العكس من الكتاب الغربيين المشهورين الذين تتهافت دور النشر في مختلف أنحاء العالم على ترجمة أعمالهم حتى قبل صدورها بلغتها الأصلية، يبقى كتّاب كثيرون ممن يحفرون بعمق وتروٍّ وجَلَدٍ وصبر في المكان نفسه بحثاً عن طبقات الحكاية العديدة مغمورون في العتمة، وأحياناً متّهمون بتشويه الحقيقة.
على الضفة المقابلة للسوق التجاري والترندات، هناك نمطٌ كتابيٌّ جادٌّ له علاقة وطيدة بالانتماء، ويعبّر عن نداء أخلاقي يستدعي سيرورة خاصة من البحث والاستقصاء والحوار والسرد. وسأطرح عبر السطور القادمة مثالين، الأول عن كاتبة أوكرانية- بيلاروسية والثاني عن كاتبة سورية.
أصوات من اليوتوبيا وقصة الحرب السوفياتية
عبر عشرين عام ونيّف قامت الكاتبة الصحافية سفيتلانا أليكسيفيتش Svetlana Aleksijevitj بجمع شهاداتِ وذكرياتِ مَنْ عاصروا فترة الحرب العالمية الثانية في بلادها بكل إصرار ومثابرة. وُلدت أليكسيفيتش في أوكرانيا في زمن الاتحاد السوفياتي ونشأت في عاصمة روسيا البيضاء وتَرَبَّت على قيم الثقافة السوفياتية المكتوبة منها وغير المكتوبة. عندما بدأت تجمع ذكريات الشعب أو بالأحرى الشعوب التي شكّلت القوة العظمى سابقاً لم يكن ثمة حماسٌ لمشروعها. رفضتْ دور النشر مخطوطتها الأولى كما تجاهلتها وسائل الإعلام، وفي الحالات القليلة التي تمكَّنت فيها من نشر أجزاء من عملها أتى رد الفعل على شكل فيضانٍ من النقد، جارفٍ وشامل.
كان رأي النقاد باختصار أنّ نصوص أليكسيفيتش مبنيةٌ على المذهبِ الطبيعي البدائي، الواقعيةِ السمجة، فاقدةٌ للترابط القصصي أو المنطقي بين حلقاتها وغير متسلسلة أو مرتّبة زمنياً فما هي إلا عملية تجميع تفاصيل حياتية عديمة القيمة عن أفراد ليس لهم أيُّ تأثير في حركة المجتمع والتاريخ. بالإضافة لذلك فلم يعجبهم أسلوب النصوص اللغوي البسيط ونقل ذكريات الناس بلهجاتهم المحكية التي وصفوها بلغة "الرعاع"، واعترضوا على عدم قيام الكاتبة بإضافة أي قيمة فنية جمالية أدبية لهذا الخليط الفوضوي.
كانت السرديّة التي قدمتها أليكسيفيتش مختلفة عن السرديّة السوفياتية للحرب العالمية الثانية آنذاك، والتي كتبها المؤرخون مركزين فيها على بطولات الجيش والقيادات السياسية الحكيمة. كانت الكتب والصحف مليئة بذلك النوع من الكتابات، كلها دون استثناء يُذكر انطلقت من منظور ذكوري وطني شوفيني وصيغت بلغة فخمة متخمة بالمجاز والسجع والتشبيهات. كم من الشجاعة تَطَلَّب خرقُ هذا الاتفاق والانسجام على أسلوب ومادة الكتابة؟ كان مشروعاً وليدَ مخيّلة شخصية، الإجابة على سؤال مهم: هل هذه فعلاً هي قصة حربنا؟ خرقت الصحافية الشابة القواعد بجرأة غير معتادة، ووصفت الحرب من منظار صدم الكثيرين. ولعل تساؤلاً قلقاً من قبل ناشر مستاء يختصر عليَّ الكثير من الشرح لأسباب هذه الصدمة: " من سيتطوّع للمشاركة في حرب بعد ان يقرأ هذا النوع من الكتب ؟؟!"
وكان هذا النوع من الكتب هو بالضبط ما أرادت سفيتلانا أليكسيفيتش العمل عليه رغم التحديات والرفض والنقد، وبقيت مخلصة للمهمة التي نذرت نفسها لها عاماً بعد عام تجوب البلاد وتجري اللقاءات بدون أجر مالي أو ضمانة للنشر. لم يتمكن حتى زلزال البروسترويكا الذي ضرب البنى السياسية والاقتصادية للاتحاد السوفياتي من إضعاف تصميمها على متابعة التقصّي ونقل حكايات الناس، كما لم تدفعها تتابع الأحداث الصغيرة والكبيرة في العالم للانجراف وراء خبر سعياً لإرضاء وإشباع القراء. لم تشكّ هذه الكاتبة قطّ بأن مشروعها مهم وقائم بذاته وأنّها صاحبة رسالة في الحياة: تسجيل التجربة الإنسانية في زمن الحرب في بلادها بكل أبعادها.
كلّ من أجرت أليكسيفيتش معه مقابلة صحافية حدثّها عن حربه/ا، هو/هي، باللغة المشتركة، ولا أقصد في هذا السياق المنظومة اللسانية من أبجديةٍ وقواعدَ ولحنٍ صوتي، بل أعني اللغة كمخزون ثقافي تراثي تاريخي. هل يحق لي التساؤل هنا عن مدى استيعاب صحافي أجنبي لما يقال ويُترجم له من خلال مترجم يكون غير محترف في معظم الأحوال؟ وماذا عن طبقات المعنى وكمّ المعلومات التي يلتقطها "مجاناً" وعفوياً صحافيٌ يقوم بالاستقصاء ضمن بيئته الثقافية؟
في عام 2015 تُوِّج عمل ألكسيفيتش بجائزة نوبل للأدب. المجلدات الثلاثة تحت العنوان الجامع: "أصواتٌ من اليوتوبيا" والتي وصفها ا النقاد السوفياتيون بـ " ذكريات تافهة لرعاع" أصبحت في الحقيقة الوثيقة التاريخية الأهم ومرآةً للمجتمع السوفياتي عبر حقبة زمنية كاملة.
كُتب اليكسيفيتش تركّز على تجارب النساء والأطفال ومعاناتهم خلال الحرب العالمية الثانية وتُزوّد القارئ من خلال ذكرياتهم بمعارفَ ومعلوماتٍ تفصيلية عن الحرب على خطوط الجبهة وفي كل ركن من أركان المجتمع آنذاك، كما أنّها تخلق عالماً من الصور والأصوات فيه نبضٌ أدبي غير اعتيادي على الرغم من بساطة الأسلوب التعبيري. ولعل الواقع فعلاً متفوق على الخيال في الجمال والبشاعة معاً. مما علق بذاكرتي من الشهادات قصة عقد قران مجنّد ومجنّدة في الجيش الأحمر وسط خندق قبل الانطلاق بمهمة خطيرة للغاية، وكانت العروس قد حاكت ثوب زفافها من قماش مظلة طيار نازي تم قصف طائرته ومن ثم أسره. أتذكر القصص عن أكل الأطفال للحاء الشجر والأعشاب للبقاء على قيد الحياة، وتجمّد الكثيرين منهم حتى الموت خلال فصول الشتاء القارس البرودة في بيوت تم تجميعهم فيها بعد موت ذويهم أو سحبهم للخدمة الإلزامية. وقد تركت قصة طالب جامعي كان كثيراً ما يستفيق مذعوراً في الليل ويركض زاعقاً وسط الممر في السكن الطلابي أثرها في نفسي. كانت الحرب قد انتهت، ولكنّ كوابيسها لم ترحل معها. في ذلك السكن الطلابي لم يكن هناك شاب أو شابة لم ت/يفقد أحد والديه/ا أو كليهما...
ما فعلته هذه الكاتبة الفذّة ليس أقل من إلقاء الضوء على الزوايا المهملة وحفظ الذاكرة الجمعية من الضياع. لم تَقْبل باختزال الحرب لمعاركها في ساحات القتال ووصف الجيش الأحمر بالبطولة الملحمية، بل أثبتت من خلال مئات الأصوات والحكايات أنّ من خاض تلك الحرب الطاحنة كان الناس البسطاء وأن عناصر من الجيش ارتكبوا الجرائم والآثام الشنيعة، واستنتجت: "الناس العاديون هم من يستحقون الأوسمة. إنهم ذوو شأنٍ عظيم. أما الحرب فهي مقرفة!! أريد أن يعلم الجميع كم هي مقرفة!"
عيون في الداخل وقصة الحرب السورية
تعرّف الكثيرون من سورييّ المهجر والداخل على الكاتبة سلوى زكزك عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعبر قراءة نصوصها المتميزة لدرجة تَعَذُّرِ التقليد. فهي لا تشبه سواها، وهي تنقل التفاصيل التي لم يهتم بها مراسلو ومراسلات الإعلام الغربي والعربي، بل حتى السوري. وأجد شبهاً واضحاً بينها وبين الأوكرانية أليكسيفيتش وهو فهمٌ عميقٌ لمعنى الحرب لا يختزلها لساحات المعارك، واحترامٌ حقيقي للمدنيين المقهورين الذين يدفعون ثمن النزاع دون أن يتم منح أحدهم وساماً شرفيّاً. كلتا الكاتبتين تشعران بانتماءٍ للبشر والحجر في موطنيهما وتسجّلان دون كلل أو ملل على مدىً طويلٍ لا يُحسب بالشهور بل بالسنوات. ومن البديهي أن هذا الخيار ينبع من رسالة أخلاقية منبثقة من الذات وشغف واهتمام صادق بمصائر الناس ومستقبل البلاد.
على الرغم من هذا التشابه فهناك اختلافات ناتجة عن فردانية كل كاتبة وخياراتها من جهة، وظروف وبيئة تحركها وعملها من جهة أخرى. فبينما لجأت أليكسيفيتش للقاء الصحافي كمنهج، تقوم زكزك بالملاحظة والوصف والتصوير اللغوي ونقل بعض الحوارات العفوية عبر أسلوب تدوين حرّ وملتزم في آن معاً. وبينما ضمّ عمل أليكسيفيتش ذكرياتٍ من ساحات الحروب والخنادق وحياة الجنود والجنديات، يغيب هذا تماماً عن العالم الذي تنسجه زكزك من خيوط حكايا المدينة والريف والمخيم، وأحياناً المهجر (حيث يقيم ابنيها).
يتضح تبحّر زكزك في اللغة العربية الفصحى من خلال مجموعتها القصصية «عندما لبست وجه خالتي الغريبة» ومقالاتها العديدة المنشورة في صحف ومواقع ثقافية عربية مهمة، إنها تتقن دون أدنى شك لغة الأدب والثقافة والإعلام، اللغة الأكاديمية. لغةُ النخبة تمنح متحدثّها وكاتبها رتبة عليا في السلم الاجتماعي، لكن زكزك تختار حمل السلم بالعرض والمشي فيه في الأسواق الشعبية بدلاً من الصعود على درجاته والارتقاء والابتعاد عن حياة الناس بكل تفاصيلها المرهقة، وسواء أكان هذا الخيار واعياً ومدروساً، أم نتيجةَ انطلاقةٍ عفوية، فقد خلق كاتبة تكتب باللهجة السورية المحكية عن الإنسان السوري في زمن التيه الوطني.
«الحرب هواءٌ ثلجي في الرئتين.. نيرانٌ مستعرة في القلب» تعلن زكزك، وتُظْهِر في الكثير من نصوصها تناقضات المجتمع السوري وسقمه وعلله. هي ليست معنيَّة بالتجميل والتبرير والشرح، ولا تحتاج عذراً لجّس نبض الشام والإخبار عن أحوالها. حينما تصعد ثلاث نسوة يعملن في الخدمة المنزلية والطبخ الميكروباص الذي تستقله زكزك تتحول محادثتهن التي تنخرط فيها الكاتبة أيضاً لنصٍ لا يسعى للتغلغل التحليلي في الحدث أو بالأحرى اللّاحدث. سيدة منزل تجبر إحداهن على الوقوف بجانبها أثناء تناولها للطعام الذي طبخته لها من باب الاحتياط، فربما احتاجت مثلاً خدمة أثناء انغماسها في الأكل! لا تدعو السيدة من طبقة اجتماعية مرفّهة العاملة المنزلية للراحة أو الجلوس معها حول الطاولة الخاوية، ولا تسمح لها بتناول لقمة واحدة مما طبخت. علقت هذه الصورة بذاكرتي، التصقت، انطبعت! أما نص زكزك فكان غاية في الإيجاز والبساطة، وأمّا هذه الصورة فقد نسجتها مخيلتي من جملة واحدة إخبارية نطقت بها المرأة دون اكتراث ظاهر ونقلتها زكزك دون زيادة أو نقصان. ما هو سر توغّل عبارات بسيطة قصيرة في عمق إدراكنا؟ وكيف تقوم هذه الكاتبة بحمل واقع كامل ضمن راحتي كفّيها كأم كبرى؟ مع تتابع العبارات وتتالي القصص وتجمّع اللقطات الصغيرة تصبح لدينا مادةٌ مترابطة تحكي عن حياة العاصمة، ومدن كاملة، وريف وشعب بأسره، ونكتشف عمق المأساة التي يعيشها سوريّو الداخل. تنفذ إلى أعماق ضمائرنا كسهام حادة عبر التفاصيل الصغيرة.
سلوى زكزك ترى وتصف لنا "الأرض التي تهتز تحت أقدام الناس" ... الشروخ تتسع وتبتلع البعض "تفاصيل التعب والقهر على الوجوه. أضحت الحياة تعني الإرهاق، الهمد، القنوط، الامتلاء بالعبثية وأمامك خراب ممتد" وتعلن: "لم ينج أحد!" وتصل المأساة السورية للذروة، أو بالأحرى للقاع، عندما يغرق ثلاثة أطفال وثلاثة راشدين وسط أكوام القمامة التي يفتشون فيها عما يمكن إعادة تدويره من أجل بيعه. يموتون اختناقاً. والرمزية هنا عالية، قاسية، مؤلمة! ولا تحتاج لزيادة في الشرح.
تختصر زكزك كل الحكايات، تغليها على نار هادئة كما تطبخ على الموقد المصنوع من تنكة زيت فارغة والذي تناوبت على استعماله عائلات البناء تحت إشرافها وتنظيمها، إذ شارك كلٌّ بما لديه من مواد غذائية وتقاسموا الطبخة الواحدة، وهكذا تم توفير الطاقة وزيادة البركة. وفي خليط من السخرية والجدّ تختار زكزك لقب "مديرة المطبخ".
"كلمة حرب مطاطة، تبرّر الجوع وفقدان الأساسيات. تعيش الحرب بدلاً عنا، تتسلق علينا وتسحب من أجسادنا الروح... في الشارع جثتا قطتين تجمتدا أثناء الليل البارد وسيدة مارّة تدعو الله بصوت مسموع: "يا ربّ! خذني لجهنم فهي دافئة"
"برررررررد!!" زكزك تلتقط الصور في كل ثنايا المدينة وأحياناً تدير الكاميرا تجاه تفاصيل حياتها. إنها ترتدي عدة طبقات من الثياب وتضع كلتا يديها على الحائط حيث يمر أنبوب مدفئة الجيران الموقدة وتتساءل: "هل يعتبر فعلي هذا نوعاً من السرقة؟"
يبتعد الإعلام الغربي عن الغوص عميقاً في نتائج الحرب على شعب ما، لأن هذا قد يُنفِّر القارئ غير المعتاد على هذا النوع من الصدمات، فقد يخيفه أو يثير لديه مشاعر عنصرية. منذ شهور نشرت صحيفة يومية نرويجية «صراع الطبقات» Klassekampen مقالةً لي عن أدب الحرب أُعرّف فيه القارئ النرويجي على أدب سلوى زكزك، ومن خلالها أنقل له أحوال الناس في الداخل السوري. تم حذف فقرة تُحدّث عن موت شاب تحت عجلة حافلة ممتلئة حاول التعلق بها وسط شارع مزدحم في مدينة تمتلئ حيطانها بالنعوات. كما لم يتم نشر الفقرة التي تناولت ندرة المراحيض في المخيمات وانتشار الكوليرا، ووقوف طفل في طابور خبز طويل، ووقوع طفل صغير يجر كيساً أكبر من جسده مليئاً بالفضلات القابلة للتدوير وسط الشارع من الإرهاق أثناء موجة حر. لماذا كل هذا الحذف؟! سألت. وكان تفسير المحرر أن نصّي سيصبح «أفضل» دون هذه الأمثلة. اعتراضي العنيد أنقذ مثالين من أربعة من المحي أو ما يسمى حرفياً بالنرويجية «التنظيف».
كتب أجانب وعرب وسوريون عن الحرب في سوريا، نقلوا الأحداث وأشبعوها تحليلاً، لكنّ صوتاً واحداً برز وسط هذا الضجيج الإعلامي على الرغم من أنّه كان همساً من صفحة فيسبوكية متواضعة للغاية ليس فيها ألقاب وعناوين أو أيّ محفزّات مرئية أو صوتية. زكزك تكتب يوميات الشارع لنا، وتنخرط أيضا بالمشهد الذي تنقله، وعند ربطها بين العام والخاص والموضوعي والشخصي ينتج أدب حقيقي متجذّر بالأرض والنّاس ومؤثّر فلا يترك القارئ حيادياً.
مشروع سلوى زكزك مستمر حتى أجل غير محدد، وحتى لو أتى يوم تغلبت فيه رغبتها بالتحليق والسفر بعيداً، كما فعل ملايين السوريين، على تضامنها مع من بقوا في البلد، ما تصفه هي بـ "عصبية الجناح الناقص" وما أصفه أنا بالتزام أخلاقي استثنائي وأصالة وحس إنساني رفيع، فقد تَجَمَّع لدينا من خلال قلمها أرشيفٌ كامل عن الحرب السورية علينا حفظه من الضياع.
اللوحة الزكزكية قاتمة دون شك، لكنّ فيها نقاطاً يتدفق منها الضوء والدفء. وقفةٌ في المطار لا تتحول إلى قرع ناقوس خطر لقرب خُلُوِّ البلد من سكانها. زكزك تنقل مشهد "العجقة" وكأم سوريّة أصيلة تودعنا كلنا "لك روحوا دوروا وشوفوا الدنيا بيلبقلكن". وفي وقفتها هذه الخالية من العتب والتأنيب والتمسك الأناني والخوف من الهجر، تربطنا سلوى بالأرض التي تقف ثابتة عليها ثبات جبل قاسيون، ويتبدّد، إذ نلقي نظرة على هذه المرأة في ثيابها الشعبية البسيطة، وهمُ الولادة الجديدة على أرض غريبة ومحو الذاكرة.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. الناخبون في تشاد يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس للبلاد

.. مقتل 4 جنود إسرائيليين بقصف لحماس والجيش الإسرائيلي يبدأ قصف

.. الانتخابات الأوروبية: أكثر من نصف الفرنسيين غير مهتمين بها!!

.. تمهيدا لاجتياحها،الجيش الإسرائيلي يقصف رفح.. تفاصيل -عملية ا

.. تهديد الحوثي يطول «المتوسط».. خبراء يشرحون آلية التنفيذ والت
